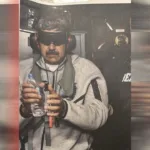مع قِدم الكتابة الأدبية في التاريخ البشري، واعتبارها ذاكرته الداخلية، فإن فعل الكتابة يظل حالة ملتبسة، لا يمكن وضعها في إطار تعريفي محدد، لأن مداها الواقعي والوجداني يمكن تشكيله على عدة أوجه، رغم ذلك، فإن أحد تعريفات الكتابة المعبرة عن نفاذها الكبير، إلى ما وراء المشاهد الظاهرة لدينا، هو أن الكتابة محاولة لتعويض المسافات البعيدة.
يتأتى المنتج الأدبي، على اختلافه، من ضرورة مقاومة الفقد، ولأن تاريخ البشر مفعم بالتغير والانتقال من شيء إلى نقيضه، فإن الذاكرة التي شكلها الأدب، حملت على عاتقها مد الفراغ بين المساحات المكانية الكبيرة، هذه الأماكن هي التي شكلتنا، بمراوغة، جوارًا إلى الحدث التاريخي الظاهر.
يعنينا من أنواع الكتابة الأدبية التي تتشارك في قطع المسافات من خلال حرية الخيال وبراح المجاز، أدب المهجر/المنفى، وهو نوع أدبي بدأ من خلال هجرة اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وغيرهم من العرب، إلى الأمريكتين، ولاحقًا، عقب الاحتدام السياسي بعد الستينيات، استحال أدب المهجر/المنفى إلى تحولات جديدة وكتابات جديدة، أكثر معاصرة، ولها طابع فردي، لكنها تشمل جماعة الهم في الكتابة عن الوطن ودواخله وأزماته الاجتماعية وضيق أفق الحرية داخله.
مرحلة النشوء
نشأ أدب المهجر خلال أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ووضع الدكتور محمد مندور أول حلقة في “جماعية” البنية الخطابية لأدب المهجر، فيقول إنه “أدب مهموس”، قائم على المناجاة، خالٍ من الخطابية والسطحية الثقافية، مفعم بالعمق والارتباط بالحياة.
أطلق اسم شعراء المهجر على نخبة من أهل الشام، خاصة اللبنانين المثقفين الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية، والبعض توزع بين الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، لم تكن فرص التحقق ورفاه الكتابة متوافرة لجيل أدب المهجر الأول، ومع ذلك، فقد بلغ عدد المهاجرين حتى 1919 نحو 60 ألف مهاجر.
في كتاب “أدب المهجر” يضع الدكتور صابر عبد الدايم، مجموعة “الرابطة القلمية” ضمن المدارس الأكثر تأثيرًا في جيل أدب المهجر الأول، تكونت الرابطة القلمية من جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي، وغيرهم، فاستحال الأدب العربي على يديهم، من حيز المحدودية إلى التناغم والاقتباس من الطابع الأوروبي الرومانسي، بالتوازي مع روح التراث العربي، بما يطويه من جوانب صوفية وثقافية.
تأسست المدرسة الثانية، على يد جيل المهاجرين إلى أمريكا الجنوبية، وأطلق عليهم “العصبة الأندلسية”، وضعت كتابات ميشال معلوف ورشيد خوري وإلياس فرحات أساسًا بنائيًا للمزاج الشرقي المفعم بالمعاصرة، واعتمدت كتابات العصبة الأندلسية على الحنين للوطن والنفاذ إلى عمق سرديات التراث العربي.
بالنظر إلى مسببات ظهور آفة الهجرة الجماعية، التي رغم تشكيلها جيلًا أدبيًا، سيلحقه جيل ثانٍ، شكلا معًا قطبًا أدبيًا فارقًا في تاريخ الأدب العربي الحديث، فإن سؤال الهجرة ذاته يمكننا من قراءة حيثيات المجتمع العربي في هذه المرحلة، فعلى مستوى اجتماعي، كانت مرحلة أواخر القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين، تطفح بصراع طبقي بين الإقطاعيين والطبقة الوسطى، وبالتالي، تشكلت عوائق التحقق الذاتي لدى المبدعين من طبقة متدنية اجتماعيًا، إضافة إلى ضغط الاستعمار الأجنبي وقيوده على مختلف الدول العربية.
ومن الناحية الاقتصادية، شاع الفقر وأهملت الزراعة، وبدأ الاحتلال على اختلاف دوله، في الاعتماد على التقنية الصناعية قبالة الصناعة اليدوية، بينما جاء الجانب المذهبي متمثلًا في الفتنة بين النصارى والمسلمين – الدروز على وجه الخصوص – في لبنان.
على مستوى عمومي، لم تنحصر تجربة أدب المهجر، في نشوئه الأول، على مدرستي الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية فقط، فقد نشأت مدارس أخرى أقل فاعلية، مثل رابطة “منيرفا” التي أسسها الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي، لاحقًا في 1948، بمدينة نيويورك، إلا أن هذه المدرسة لم تستمر طويلًا ولم تشتبك، من حيث المنتج الأدبي، مع الأثر الجماعي الحاصل في الأدب المهجري.
ضرورة الواقعي
من بين جيل شعراء المهجر الأول، يمثل منتج جبران خليل جبران حلقة مركزية في بدء تكون أدب عربي حديث ومعاصر، وذلك لأن جبران، استطاع أن يكسر عن الأدب العربي عزلته الطويلة خلال فترة الحكم العثماني، لحق جبران، بركاب الأدب الإنجليزي، وعى جيدًا تطوراته من حيث الأسلوب والقالب والموضوع، ومن ثم تمثل في أدبه تأثر شديد ومحاكة بروح عربية، للطابع الرومانسي الإنجليزي، من جهة استنطاق الجانب الشعوري الذاتي والمجرد، وتطوير بنية اللغة لتتجاوز القالب الشعري القديم وتصبح تداخلًا نثريًا.
يذكر الدكتور عيسى الناعوري في كتاب “أدب المهجر”، أن جبران وحده، يمثل أدبًا، وأطلق عليه الناعوري “الأسلوب الجبراني”، لأنه خلق محطة في الأدب العربي، تمثل تخلقًا للفن، أو ما يمكن تسميته المدرسة التعبيرية في الأدب العربي.
رغم مركزية آليات التفعيل لدى أدب المهجر، وجيله الأول، متمثلًا بصورة كبيرة في جبران خليل جبران، كانت التطورات السياسية في عشرينيات القرن الفائت، على امتداد المنطقة العربية، تطالب بضرورة اللحاق بالتيار الأدبي الواقعي، وقد نبتت هذه البذرة في ثورة 1919 بمصر، التي فرشت مساحة لنشوء مدرسة حديثة، انتسب إليها الشقيقان محمود ومحمد تيمور، بتمازج ما بين الأدب الواقعي والنزعة الرومانسية.
الحلقة الثانية في الاستجابة لضرورة الأدب الواقعي، جاءت على يد طه حسين في الأربعينيات، وهي الفترة التي بدأ خلالها تناول مفهوم “الالتزام” في الأدب الفرنسي، خاصة سارتر، وفي سياق ممتد، كان طه حسين يكتب في مجلات مثل “الأزمة الحديثة” و”الفجر الجديد”، مؤكدًا على ضرورة “المباشرة قدر المستطاع”.
خلال نفس المرحلة الزمنية، كان نجيب محفوظ يبدأ مشروعه الروائي الفارق، فقد مهد خلاله للواقعية العربية بأعمال عديدة، مثل القاهرة الجديدة وخان الخليلي وزقاق المدق، ولاحقًا استحالت واقعيته إلى اشتباك مع التطور المجتمعي ما بين مصر الملكية والجمهورية، لتشكل ذاكرة نافذة وسلم صعد خلاله مختلف الأدباء العرب.
تعاظم البعد الواقعي في الأدب العربي، بدءًا من الستينيات وحتى نهايات القرن العشرين، من خلال إعادة تفعيل أدب المهجر من جديد، لكن بصورة أكثر تركيبًا وتفحشًا عن هيكل تشكل جيله الأول، الجيل الذي تفرق في ربوع الأرض، دون تكتلات جماعية، لم يختر الهروب لأجل التحقق، بقدر ما كان منفيًا، بما يطويه المنفى من قسوة واغتراب ووحشة وجودية، نفي وتهجير متكرر، من مصر والعراق ولبنان وسوريا وليبيا، إضافة إلى فتح الجرح الفلسطيني بالنكبة، الذي من بعده استحالت المنطقة العربية إلى صراع سياسي ومواءمات بين أنظمة شمولية تنبذ الحضور الثقافي وقبول حرية الإبداع والكتابة، النقد والمساءلة.
من خلال النبش في نتوءات هذه المرحلة، ومحاولة استنطاق جروحها التي تمثل بعدًا مركزيًا من ذاكرة المجتمع العربي، انتقينا مجموعة من النصوص الأدبية، من خلال قياس التنوع والتكامل عبر الانتقال الزمني، من وطنٍ إلى آخر، ومن ظرف للنفي والتهجير إلى آخر مختلف، في محاولة لخلق صورة بانورامية لحضور المنفى في الأدب العربي الحديث.
في ملف “أدب المهجر” نقرأ معًا، نستدعي ونسائل نصوصًا كتبت إلى أماكنها من بعيد، بينما نحن الآن على مسافة زمنية مقاربة في البعد من هذه النصوص، لكننا نشترك معها في طموح القرب الذي يمكن للكتابة تحقيقه.