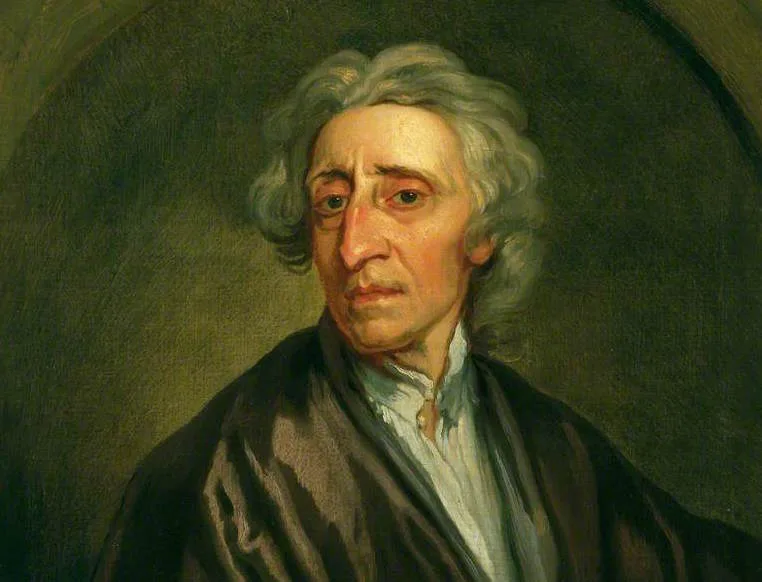ماذا فعلت الليبرالية برؤوسنا؟ حينما التفتُ إلى هموم الناس وآلامهم وأحلامهم رأيت تناقضًا طفيفًا بين ما يجب أن يكون وبين ما هو كائن، فالناس لديها أفكار خيرة وتصورات مثالية عن كل شيء، و مع ذلك تجدهم لا يتمنونها، وصار هناك – في رأيي – صراعًا هامشيًا بين ما هو صالح وما هو طالح، لم يعد هناك فروق كافية للتمييز بين الأنانية وتحقيق الذات، أو بين العقلانية والنفعية، صارت كل القيم متشابكة متداخلة، لم تعد هناك قيمة مطلقة، صار كل شيء نسبي، كل شيء متغير، كل الأشياء متساوية، فلا قيمة للأخلاق طالما أنها متساوية مع انعدامها، وبالتالي وجب على الإنسان بالمفهوم الحداثي أن يترك مقياس الخير والشر الذي علق عليه كل أفعاله وقراراته وأفكاره، وأن يتجه اتجاهًا عقلانيًا يجعل من رأسه مقياسًا لكل شيء، ما يجلب المصلحة فهو خير، وما هو غير ذلك فهو شر.
وهذا ما فعلته الليبرالية برؤوسنا، صرفت أذهاننا وضمائرنا عن الانشغال بصراع الخير والشر غير المجدي، ونبهتنا إلى ضرورة الالتفات إلى أنفسنا وحاجاتها المادية، شرعنت الصراع الإنساني الدائر منذ ظهور الإنسان على الأرض بدلاً من محاولة إنهاؤه أو توحيد الجنس البشري، لقد عظم الله تعالى قيمة التعارف بين الأقوام والشعوب، وما كان ليعظمها لولا أن طبيعة الإنسان تميل إلى الصراع وفرض السيادة، وحب الملذات واتباع الشهوات، وكذلك التوجس وسوء الظن، أما المذاهب العقلانية فهي تعلن أنه لا معنى للوقوف ضد قوانين الطبيعة، فالطبيعة تنتصر للأقوياء وتزدري الضعفاء، وفي إطار ذلك، بُررت أفظع الجرائم على الإطلاق، بُررت الحروب العالمية لما قال هتلر: “عرق واحد قوي يسود ويسحق بقية الأعراق” هذا الكلام لا يعبر عن هتلر، ولكنه صميم الفكر المادي الغربي.
لقد أعلن نيتشه فيما مضى الفضيحة كاملة حين قرر أن الأخلاق أسطورة من الأساطير التي اخترعها الإنسان بسبب فائدتها، وبالتالي لا أخلاق ولا قيم، بل قوة تضمن البقاء لصاحبها داخل دائرة الصراع، وأكمل ذلك هوبز لما قال إن الإنسان هو العدو الأول لأخيه الإنسان، ومن هنا وجب على الإنسان سحق أخيه من أجل البقاء، أو السيطرة عليه واستغلاله، إذا وضعنا هذه الأفكار إلى جوار تهميش الفلسفة التجريبية المادية الحديثة للحقيقة واعتمادها على كل ما هو حسي فقط، فإن الإنسان يولد ويموت لأجل هذه الغاية، وهي البقاء، والبقاء يستلزم سحق الآخرين.
كل الأفكار التي جاءت بعد نيتشه هي أفكار نيتشاوية، وهذا هو مضمون الفردية الحقيقي التي تتبناها الليبرالية، وأي كلام عن الأخلاق داخل الأطر الليبرالية فهي تمامًا كما قال نيتشه: صُنعت من أجل فائدتها، والذي صُنعت من أجله الليبرالية هو الحفاظ على حلبة الصراع كما هي، حتى تظل القوة للقوي والبقاء والسيطرة، ويبقى الفقراء والضعفاء مستحقون لمكانتهم هذه لأنهم فشلوا في القضاء على خصومهم، وبذلك تمت شرعنة شهوات الإنسان ورذائله وميوله الشريرة والعنيفة، بل اعتبرت الشروط اللازمة لضمان البقاء في الصراع.
ومن اللحظة التي انطلق فيها المشروع التحديثي الغربي حتى وصل إلى أذهان كل فرد، ترسخت هذه الأفكار في عقول الناس شرقًا وغربًا، صار كل إنسان ليبراليًا في كل تصرفاته حتى ولو كان غير ذلك، يدبر لنفسه ويختلط عليه الخير والشر في كل ناحية، وينتصر لملذاته دون أن يدري، وتغلغلت الفردية بمفهومها الحداثي في أعماق أعماق قلوبنا، فأطلت علينا الفردية بثوب مبهرج وقيم رنانة، مثل تحقيق الذات، العقلانية، الترشيد، النجاح، المساواة، مركزية الفرد، الحريات، أهمها الحرية المالية طبعًا، لم تكن الليبرالية اسمًا ولا صفة إلا للرد على ظهور الفكر الماركسي في أوروبا، ولم يكن التنظير للنظرية الليبرالية إلا بسبب صعود نجم الشيوعية في أوروبا الشرقية وروسيا بعد الحرب العالمية، وتضمنت في داخلها أفكار رنانة ذات بريق ومبادئ إنسانية تعتبر من بديهيات العصر الحديث، وما حوت الليبرالية هذه المبادئ إلا بسبب فائدتها، فقد تغنى الماركسيون وأعداء رأس المال بالقيم والأخلاق والانتصار للفقراء، واستطاعت بذلك جلب تعاطف الكثيرين، فكان لزامًا الانتصار لبعض القيم التي تفتقدها الماركسية لإحداث التوازن الأخلاقي والمادي، لا للقيم ذاتها.
الإيمان بهذه القيم يحملك على استغلال كل فرصة بشكل شرعي أو غير شرعي، كل ما هو متاح مباح، سمٌ دُس في العسل، بل تعتبر الليبرالية أن الانتصار للقيم أو الأخلاق حمق، وأن الدين خرافة، وأن الأخلاق أسطورة أفلاطونية، وبذلك انتصرت الليبرالية المتمدنة للسوفسطائية.
وبالتالي فإن أي كلام عن تضمُّن الليبرالية للأخلاق والقيم هو محض أوهام، والكلام عن احترام الليبرالية للدين هو محاولة يائسة لاستقطاب هؤلاء الذين مازالوا ينظرون للدين أو التقاليد بعين الاعتبار، محاولين إقناع العرب على وجه الخصوص، بأن كونك ليبراليًا لا يعني إلحادك أو تفريطك في دين الله، وأن اتباع المذهب العقلاني لا يعني تركك للصلاة والصيام، وكأن الإسلام نزل في هؤلاء ليجعلهم يعانون السهر للصلاة والجوع والعطش بالنهار، بل الأبعد من ذلك بزوع تيار الليبرالية الإسلامية المنسوب تأسيسه للإمام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وأتساءل: كيف يمكن لدين أن يستوعب أفكار الضد؟ كيف يمكن أن يصير المرء علمانيًا مسلمًا؟ فالليبرالية تجعل من الدين شعيرة أو تقليد هامشي في زاوية أو في البيت، ليس له تأثير حقيقي في حياة العامة ولا يجب أن يؤثر في حياة الفرد، ويعتبر الدين وشعائره ضمن مجموعة الحريات التي كفلتها له الليبرالية، مثل سيارته، الليبرالية تضمن لصاحب السيارة ألا يُعتدى عليها، بشرط ألا يكسر بها القانون، القانون القائم على المنفعة، فإذا كان الدين يضر بالمنفعة، وأقصد هنا المنفعة المادية، فإنه من غير المسموح لك التمسك به في هذه الحالة، أي أن الدين أيضًا يمكن أن يكون ذا منفعة، يمكن استخدامه من أجل مزيد من السيطرة، هذا هو الدين في الليبرالية.
هذا ما يتم تصديره للعرب بشكل عام، أما الغرب فهو يؤمن بأن دين المرء حتى في حياته الخاصة عائق أمام تحقيق ذاته ونجاحه الشخصي، لأنه يفرض عليه مزيدًا من القيود لا حاجة لها ولا طائل منها، الدين في نظر الغرب هو عكس العقلانية، هم يضعون الأمور في نصابها، فليس من المقعول أن يقف موسى أمام البحر وخلفه جيش فرعون ويظن أنه ناج فقط لأن قوة خفية خارج الطبيعة أخبرته بذلك، بل عليه التفكير سريعًا في حل للتسوية مع فرعون والخروج بأقل الخسائر.
ومع ذكر القوانين، فإن القوانين الوضعية لم تحسم مسألة الانضباط بشكل كامل، فمثلاً أهم مشكلات الرأسمالية هي التهرب الضريبي والجمركي وكسر القوانين، ولذلك تسعى الليبرالية الحديثة لا إلى سن المزيد من القوانين وفرض المزيد من الرقابة، بل إلى مزيد من استقلال الفرد في إدارة رأسماله، فاتجهت الولايات المتحدة مثلاً إلى تخفيف الضرائب في إطار السعي لإلغاء أي دور للسلطات المنتخبة في ضبط السوق، لم يكن هذا إلا بعد أن أثبت الفرد الرأسمالي أنه أقوى من القوانين، بل أقوى من السلطة القائمة على القوانين، وبالتالي تتنازل القوانين أمام الفرد الرأسمالي، والآن: ما مستقبل هذه التنازلات؟ بالتأكيد المزيد من السيطرة لمجموعة من الأفراد، مزيد من تقويض الآخرين وإلهائهم وإفشالهم، المزيد من الفردية والانتصار للذات.
ولكي يتم التخفيف من حدة هذا الواقع المفجع، تُرسم ألوانًا من الدعاية من أجل النجاح وتحقيق الذات، ونسمع هذه الكلمات الرنانة هنا وهناك، ويُستشهد لنا بالنماذج الناجحة المعروفة، وكذلك النماذج التي كانت تعاني في البداية ثم استطاعت التغلب على ظروفها والوصول إلى مكانة مرموقة مثلما تفعل الأنظمة الشمولية لتشجيع العمال على العمل والإنتاج، وفي الحقيقة هذه النماذج متمركزة حول لذة من ملذات الإنسان وشهواته، إما المال أو الشهرة أو النفوذ، وأتحدى أن يخرج لي أحد نموذجًا ناجحًا من هؤلاء المنتشر ذكرهم بين أوساط المثقفين والطموحين لا يتم الترويج لهم إلا من خلال واحدة من هؤلاء الثلاث، وأنا أرى أن هذا من قبيل إلقاء اللوم على الفقراء والضعفاء فقط لا أكثر، يقول أحد هذه النماذج: “ليس من العيب أن تولد فقيرًا، ولكن العيب أن تموت فقيرًا”، بالضبط مثلما قال آدم سميث: “الفقير هو من انشغل بملذاته عن أعماله”، أخبرني يا سيدي كيف يمكن أن يكون ذلك مع سيطرة فئة قليلة جدًا لا تتجاوز الواحد بالمائة من سكان الأرض على أكثر من ستين بالمائة من موارد الأرض هم وحدهم لديهم الفرصة لتضخم أموالهم وزيادة نفوذهم؟ بل كيف والصراعات السياسية الناشئة أصلاً عن تضخم رأس المال وتفشي المصالح في كل ركن من أركان الأرض تعزل شعوبًا بأكملها عما عرفه الإنسان من مأكل وملبس ومسكن كريم؟
لقد استطاعت الليبرالية توزيع بذور هذه الأفكار في رؤوس الشباب، فصاروا يعتبرون النجاح هو تحقيق مبلغ من المال وشراء سيارة فارهة والحصول على الجرين كارد وأشياء مثل هذه، وجعلت من حسابك البنكي وسعر منزلك وآخر ترقية حصلت عليها في عملك مؤشرًا على مدى نجاحك، وفتحت كل المضامير حيث لا شيء مستحيل، ولك أن تحتفل بما حققت من نجاحات ثم تواصل العمل، وفي سبيل تحويل كل شيء إلى مادة علمية يمكن أن تُقاس أو تدرس، يتم بيع الأمل في زجاجات، الثقة بالنفس، الرغبة في النجاح، كيف تحب زوجتك؟ كيف تنشئ بيتًا سعيدًا؟ هل تريد أن تصبح صاحب شركة عملاقة؟ النجاح في خطوات، علوم متخصصة من أجل هذا الهراء الذي لم نكن في حاجة إليه لولا تعزيز الغرائز المادية الفردية لدى كل إنسان، قبل ربط الجزرة أمام عينيه، وكلها أيضًا من أجل إلقاء اللوم عليك وإقناعك بأنك السبب الوحيد لحالتك المتردية، بل إن هذه يقال عيانًا بيانًا، ليس جشع الرأسمالي ولا انتفاع صاحب المصلحة.
بالطبع أنا لست ضد نجاح الفرد أو رغد عيشه، ولكني ضد أن يصير نجاحه الشخصي هي الحقيقة التي يحيا من أجلها، أن يستغل كل صغيرة أو كبيرة من أجل نفسه وملذاتها، أو أن يشعر بالرضا بعد إشباع واحدة من هذه الشهوات، الرضا الذي يتولد بعد نشوة النصر، أو قتل العدو، أو الحصول على علاوة، أن يعمل بغير أن يدرك أن هذا المنزل المطل على النهر هو الجزرة المربوطة بعصا خلف رأسه، أن العمل الذي تؤديه يصب بالأساس في نجاح شخص آخر، استطاع استنتاخ الكثير منك وفصل بينكم وأشار بانطلاق السباق إلى مكتب المدير والفائز هو جالب المنفعة بصرف النظر عن الوسيلة، وفي النهاية يصل واحد منكم إلى منصب المدير، بينما يرجع البقية إلى مكاتبهم لإخراجك من مكتبك الجديد، كل على حدى، وليس لتحقيق عمل رائع كما يُظن.
إن قيمة المسؤولية الفردية الحقيقية هي مسؤولية الفرد عن نفسه وأعماله وتأدية واجبه تجاه قومه ووطنه، وذلك ليس خيارًا لأحد ولكنه لافتقار الإنسان لأن يحيا مع بني جنسه، يحتاج إليهم ويحتاجون إليه، ومع تعقد تركيب الإنسان المكون للمجتمع، ومع تعقيد المجتمع بالضرورة، ومع اختلاف تركيب كل فرد عن الآخر، تجد الفرد والمجتمع في حالة من الانسجام التام، ومع أن المعطيات قد تكون واحدة، فمثلاً لو أن الوظائف المرموقة محددة، والوظائف الوضيعة محددة، وحب كل فرد للرفعة وازدراؤه للوضاعة واحد، لا تجد مجتمعًا يخلو من الوظائف كلها، العامل، الفلاح، الطبيب، المعلم، وهذا يشير لتلك القوة التي تدير الطبيعة من خارج الطبيعة بحكمة بالغة.
هكذا خلق الله الأرض، فيها ما فيها من النقائص والعيوب، وهنا يأتي دور المسؤولية الإيمانية والتي لا تتمثل في الصوم والصلاة التي أباحتها لنا الليبرالية، ولكن في الالتزام الأخلاقي والأدبي تجاه الآخرين، بل تجاه الأرض، فإن المسؤولية الفردية لا تكتمل إلا بالاندماج في وعي جماعي، حينئذ يشعر الإنسان بقيمته كفرد مجرد وكفرد في مجتمعه، لأن فلسفة الحياة تكمن في أن ينظر الإنسان لغيره كما ينظر لنفسه واعتبار ذلك من صميم الإيمان.
ولا يعني هذا أن يفقد الإنسان المسلم شخصيته ضمن المجموع الكلي المركب من المسلمين، وإنما يوسع من دائرة روحه الاجتماعية وارتباطه النفسي بأخيه في الإسلام، وفي القوم، وفي الوطن، وفي الإنسانية، ولم يعظم الله تعالى أجرًا ولا قيمة إلا لفساد غيابها ووجود نقيضها في نفس الإنسان، فعظم قيمة التسامح وأمر بها النفوس المنتقمة، وعظم قيمة التعارف وأمر بها النفوس المتوجسة، وعظم قيمة التواضع وأمر بها النفوس المتباهية، وإلا لما أشار القرآن الكريم صراحة إلى شهوات الإنسان وملذاته، وهي الموجدة أصلاً لفلسفة الثواب والعقاب، وإن كنا مؤمنين بها، فنحن مؤمنون بأن الله تعالى خلق الناس سواء كأسنان المشط، فلم يجعل لأحدهم فضل على آخر إلا بما قدمه له من خير وصلاح.
وعلى هذا فإن روح المسؤولية الفردية هي المباردة، “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه” وتعاظم روح المبادرة في أوقات الجور والظلم، “أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر” ولا يكون ذلك إلا بالحب لبنيك ولوطنك وتفانيك من أجلهم، ولا يتم إيمانك إلا بالحب، الذي حلت محله النفعية عند الغرب، بل دعت الليبرالية الفرد للثورة على الحكومة من أجل الحفاظ على النظام الليبرالي وانسجام العلاقات والمصالح المتداخلة بين الأفراد والجماعات، بينما يدعوك الدين للثورة بالحب على الظلم والفساد وتفشي المصالح وانتهاج النفعية في المعاملات، “واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب”.
وإن بدت الأفكار الليبرالية متماسكة حتى الآن على الرغم من التناقضات التي تحويها، فإن مستقبل هذا التماسك ليس بعيدًا، ومنظومة الأخلاق المنهارة في داخل الفكر الليبرالي لهي الثغرة التي سيخرج منها الناس من ظلام النفعية والتسلط إلى نور الحب والإخاء، حينها يعود الشر إلى مكانه الصحيح الواضح الجلي المكروه، وتكون الفضائل هي الغاية والوسيلة، وتصير ضمائرنا وأخلاقنا حكمًا على تصرفاتنا وأفعالنا، ويضحى الإنسان محور الكون وخليفة الله في أرضه.