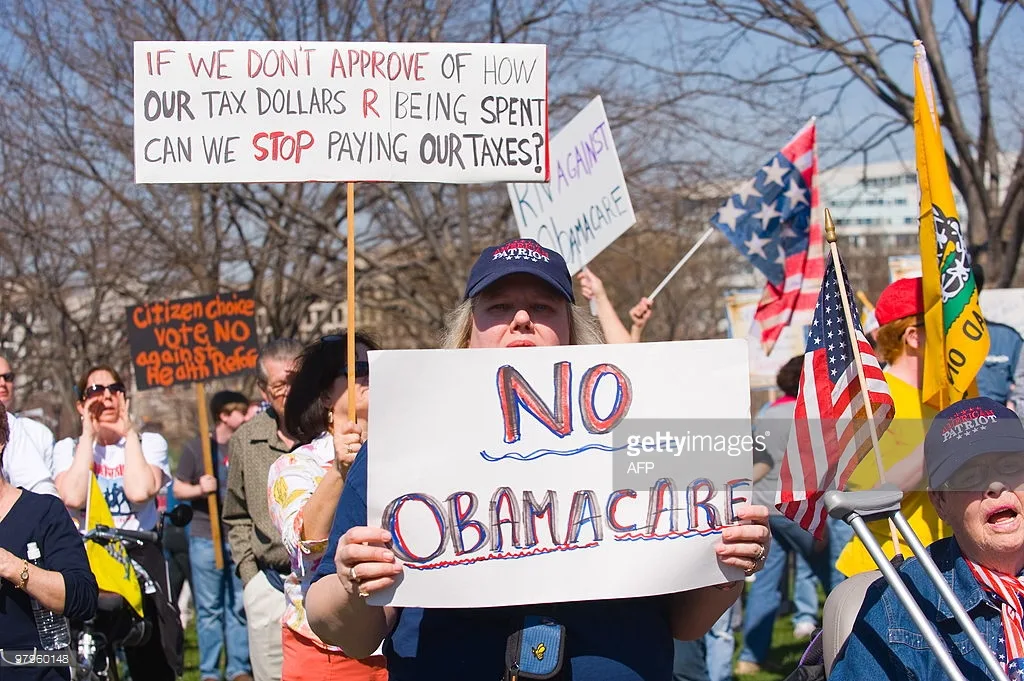أحد التصورات غير الدقيقة التي تحملها المخيلة الإسلامية عن الأزمة المعاصرة التي تعيشها الأمة وعن طبيعة الصراع الدائر في المجتمعات المسلمة هو أنه مجرد صراع مابين نموذجين حضاريين: النموذج الإسلامي والنموذج العلماني، وأن كلا النموذجين يحملان فلسفة وقيما متعارضة وتقوم عليها مؤسسات اجتماعية متباينة، وهذا التصور قد يكون ملائما للتعبير عن فترة سابقة في تاريخ الأمة المسلمة، لكن أظن أن هذه الفرضية الآن تحتاج إلى المزيد من المراجعة والتركيب، خصوصا وأن الكثير من الأطروحات التي بنيت على هذه الفرضية أثبتت عدم فاعليتها بما يدل على قصورها.
الطرح الآخر الذي أراه أكثر جدوى في فهم أزمتنا المعاصرة هو إعادة تصور هذه الأزمة على أساس أنها أزمة فشل الاستجابة لتحدي تغير السياقات المجتمعية (أيا كان سبب هذا التغير إيجابيا أم سلبيا، مثل: الهجرة، الاستعمار، ثورة المعلومات والاتصالات، العولمة، ..)، وهذا يتطلب أولا أن ندرك مسألتين هامتين: أولهما هو التفرقة بين الجزء الشعائري والعقائدي وبين الوظيفة الاجتماعية الشرائعية للإسلام، فالمهمة الأساسية للدين هو ضبط معتقد وقيم المسلم وإرشاده إلى الاجابة الناجحة على سؤال الحياة، وهذا ما ينجزه الفقه والفكر الإسلامي من جهة وابتكار المؤسسات والأبنية الاجتماعية الفعالة والملائمة من جهة أخرى، وهذا يقودنا إلى المسألة الثاني وهي أن ما نعتبره النموذج الإسلامي الحضاري “بتعريف الألف واللام” هو يمثل مجرد “استجابة ناجحة” للأمة المسلمة في سياق المجتمعات التقليدية (أو ما قبل الحداثية إن صح هذا التعبير) وليس النموذج الإسلامي بإطلاقه، فالبناء الشرائعي الفقهي والفكري والعلمي والفلسفي الذي بناه المسلمون سابقا، ثم البناء المؤسسي المتمثل في المؤسسات السياسية (دولة الخلافة والإمارة والسلطنة)، والمؤسسات العلمائية (المدارس والمذاهب الفقهية والقضاء)، وغيرها من الأبنية الاجتماعية (بيت المال، طوائف الحرف، الأوقاف،..) أظهرت درجات عالية من الرسوخ في عادات وتقاليد الأمة المسلمة ومن الفاعلية والقدرة على الإنجاز في أغلب المراحل التاريخية الإسلامية.
وهنا ننتقل إلى أزمة تغير السياق المرتبط بالحداثة والتي بدأت في التأثير على مجتمعاتنا المسلمة منذ أوائل القرن التاسع عشر، والتي حين وفدت إلينا صادفت بنية فكرية وشرعية مرهقة شائخة وأبنية سياسية واجتماعية متداعية، فكان الصدام مع الحداثة مذهلا ومربكا، وزاد من تأزم الوضع أن الحامل الأساس للحداثة إلى مجتمعاتنا كان الاستعمار بكل ما تعنيه هذه الظاهرة من سلبية وإهانة وجدانية للأمة.
والنسق الحضاري الحداثي بالتأكيد مخالف للنسق الإسلامي الذي كان سائدا، سواء في منطقه وقيمه وفلسفته، أو في مؤسساته وأبنيته الاجتماعية، فنمط الانتاج الرأسمالي وبروز ظاهرة التحضر (الانتقال من الريف إلى الحضر)، والتخصص في الوظائف الاجتماعية، ونمط التفكير العقلاني العلماني، ومفهوم الرشادة والمنفعة، والعلم التجريبي والمادية، كل هذه التغيرات وغيرها قد ضربت بشدة مجتمعاتنا المسلمة، وتداعت الكثير من الأعراف والعادات والتقاليد “الممثلة للتنزيل الشعبي للإسلام” لصالح هذا النموذج الجديد، وفُرضت علينا طوعا أو كرها المؤسسات الملائمة له، بدءا من الدولة الحديثة، مرورا بالمؤسسات القضائية والمؤسسات التعليمة المدنية، إلى غير ذلك من الأبنية الحداثية.
وقد تذبذبت استجابة المسلمين لهذا التحدي بين الأنماط الثلاثة الكلاسيكية: الرفض والسلفية أو الإذعان والتغريب أو محاولة التوفيق والتحديث، وأنتجت العقلية المسلمة الحداثية الأيديولوجيا الإسلاموية (بديلا عن مقولات السياسة الشرعية التقليدية)، كما ظهرت الأبنية الاجتماعية الجديدة، فتراجع دور المؤسسة العلمائية التقليدية والمذاهب الفقهية والمدارس الكلامية وظهرت الحركات الاجتماعية الإسلامية، والأحزاب الإسلامية، والبنك الإسلامي، والدستور الإسلامي وصولا إلى الجمهورية الإسلامية.
وبغض النظر عن الأسباب، فإن هذه الاستجابات لم تحرز النجاح أو الفاعلية المرجوة، ربما لأنه لم تكتب الهيمنة لأي من هذه الاستجابات وظل الصراع دائرا بين المدارس الثلاث (التغريبية والسلفية والتحديثية) مما أصاب البيئة الإسلامية بالانقسام والشلل، أو ربما كانت الأزمة أن هذه المحاولات التحديثية جرت في مجتمعات ليست حداثية خالصة، بل هجينة بين التقليدية والحداثة، أو ربما لأن مشروع الحداثة برمته هو مشروع فاقد للشرعية في الضمير والوجدان المسلم نتيجة ارتباطه بصدمة التأخر الحضاري والاستعمار الغربي، بما جعل هنالك شعور عام بالعدائية للحداثة (فكرا وفلسفة وأبنية).
ومما زاد الطين بلة، هو دخول مجتمعاتنا تحت تأثير العولمة المتغولة إلى حقبة ما بعد الحداثة (ربما مع الألفية الجديدة)، وأزعم أن الثورات العربية كانت حدثا مفصليا في هذا الإطار، فالتفكيكية والنسبية الشديدة والسيولة في القيم والمفاهيم، وتراجع مفهوم المرجعيات قد ألقى بظلاله على مجتمعاتنا، لتزداد حيرة على حيرة، وتيها على تيه، وأصبحت الاستجابات الإسلامية الحداثية (المعتلة أصلا) مثل الفكر الإسلامي الحداثي والأيديولوجيا الإسلاموية وآليات الحزب الإسلامي والحركة الاجتماعية الإسلامية أكثر اعتلالا وأقل قدرة على الفعل.
ومن هنا يمكن أن نوجز أن الأزمة التي نحن بصددها الآن هي أزمة مركبة بشدة، فمن جهة هناك النسخة الإسلامية التقليدية والمتوارثة عبر المؤسسات العلمائية، والراسخة في العادات والتقاليد والأعراف، والتي تستقر في وجدان الأمة على أنها “الإسلام”، ومع ذلك فإن هذه النسخة لا تستطيع الاستمرار وتفتقد إلى الفاعلية نتيجة تفكك المجتمعات التقليدية التي أنتجتها والتي كانت استجابة لتحدياتها، ومن جهة ثانية فإن النسخة الإسلامية الحداثية (الأيديولوجيا الإسلاموية والحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية و…..) ولدت معتلة ومطعونا في شرعيتها مما حجّم قدراتها على الفعل، ثم في هذه اللحظة الراهنة أصبحت تشهد تراجعا شديدا تحت وطأة التحولات المابعد حداثية التي بدأت تبرز في مجتمعاتنا، وأخيرا بخصوص سياق مابعد الحداثة، فإن الفاعلين الإسلاميين مازالوا عاجزين عن توليد أفكار أو ابتكار مؤسسات تستطيع أن تستجيب بشكل فعال لتحدياتها بنسبيتها وسيولتها ومعاداتها لمفهوم المرجعيات والقيم المعيارية، وهكذا غدا الإسلام (فكرا وأبنية اجتماعية) حائرا بين نسخ ثلاث: أحدها تراثي منتهي الصلاحية، والثاني حداثي مشوَّه ومعتل، والثالث مابعد حداثي لم تتبلور أفكاره ومؤسساته بعد.