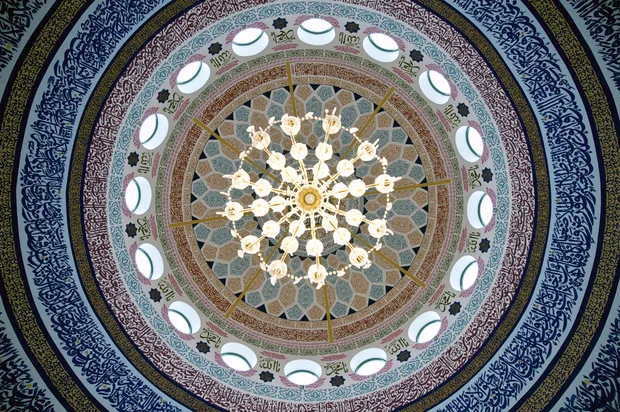تحتفل فرنسا هذه الأيام باليوم الوطني، في أجواء حزينة، وأجواء حرب كذلك، بعد حادثة نيس التي أشارت تقديرات أولية إلى أن ضحاياها قد تجاوزوا السبعين، وهو رقم مدهش يعكس بالفعل طبيعة فريدة للواقعة ولمنفذها ولكل شيء محيط بها.
بدا المشهد دراميًّا، فبعد خطاب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ظهيرة يوم الرابع عشر من يوليو، والذي أبدى فيه الكثير من التحدي للأزمات التي تواجهها بلاده؛ معلنًا تصعيدًا عسكريًّا خارج بلاده، وخصوصًا في الشرق الأوسط، بنشر المزيد من القوات والمستشارين العسكريين في المنطقة؛ جاء المساء حاملاً له وللفرنسيين مفاجأة بالرغم من أنها محزنة؛ إلا أنها اتسقت مع السياق العام الذي تعيشه فرنسا منذ يناير 2015م، وحتى الآن.
وحالة الحرب التي تعيشها فرنسا هذه ليست قومية، وإنما هي جزء من صراع دولي أعظم ترتبط به مصائر شعوبنا وأوطاننا في العالم العربي، ومن وراءه العالم الإسلامي الكبير.
وبالتحديد يبدو أن فرنسا تدفع ثمن تحالفاتها مع مصر وروسيا، ومعاداتها – في المقابل – لأطراف إقليمية ودولية أخرى، ضمن صراع الديناصورات العالمي الذي تخوضه بالوكالة عن الجميع، قوى إقليمية، دول وجماعات!
ولقد بدا المظهر جليًّا وواضحًا في ميدان الشانزليزيه قبل الحادث بساعات؛ حيث لم يكن الاحتفال الكبير الذي تم الخميس، 14 يوليو، مراسيميا؛ وإنما بدا وكأنه بالفعل ترتيبات حرب، جاء حدث نيس لكي يثبتها، وكأن فرنسا كانت تتنبأ بما سوف يحدث لها في المساء!
كان الشكل الافت هو الانتشار العسكري الاحتفالي والتأميني؛ حيث إنه بجانب العرض العسكري السنوي، انتشر 13 ألف جندي من القوات المسلحة والقوات الخاصة الفرنسية في شوارع هذه الدولة العظمى، لحفظ الأمن.
حادثة نيس جاءت لكي تؤكد حالة الحرب التي تعيشها فرنسا وعبر عنها خطاب هولاند قبله بساعات
هؤلاء الجنود الـ13 ألفًا لن يرحلوا إلى ديارهم بعد الاحتفالات؛ حيث إنهم جزء من حالة تعبئة شاملة أعلنتها الدولة الفرنسية باعتبار أنها في حالة حرب – رسميًّا – شملت تجنيد 25 ألف شاب في القوات الفرنسية، تطوعوا للخدمة، لأن فرنسا ألغت الخدمة العسكرية الإجبارية في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك، عام 1997م.
سياسيًّا، وفي إيجاز، جاءت “الاحتفالات” الفرنسية باليوم الوطني هذا العام في ظل مجموعة من الأزمات السياسية الداخلية والخارجية، أو فلنقل الملفات ذات التأثير على الدولة والمجتمع بشكل عام، ومن بينها أزمة قانون العمل الجديد الذي أدى إلى إضرابات ومظاهرات واسعة، وأزمة الانقسام داخل اليسار الفرنسي الحاكم، قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
التحركات الفرنسية الدولية ومصالح أمن قومي!
لكن لعل في الأزمات السياسية الخارجية، والأمنية في الداخل والخارج ما هو أخطر من ذلك، ويمس الأمن القومي الفرنسي ذاته كما يبدو من التحركات والسياسات الفرنسية.
فهناك أولاً الخروج البريطاني المثير للجدل من الاتحاد الأوروبي، والذي رأى البعض فيه خلخلة لأسس الاتحاد، وربما مقدمة لانهياره، بما يهدد أهم معالم السيطرة والسيادة الفرنسية في أوروبا، مع ما تشكله فرنسا بجانب ألمانيا كقاطرة للاتحاد الأوروبي.
يرى مراقبون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضمن صراع دولي يهدف لإضعاف المركزيات الكبرى في العالم
ثم هناك التهديدات الأمنية التي يمثلها تنظيم الدولة “داعش”، والذي ضرب أكثر من مرة سواء داخل فرنسا أو في المجال الحيوي الفرنسي في الجوار الأوروبي، كما في بروكسل، واستهدف أو هدد باستهداف مصالح حيوية فرنسية في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا جنوب الصحراء وفي غرب القارة السوداء، وفي مناطق أخرى من العالم.
ومؤخرًا، كشفت رئيس الاستخبارات العسكرية الفرنسية، الجنرال كريستوف جومار، أمام لجنة تحقيق برلمانية بشأن اعتداءات باريس التي وقعت في نوفمبر 2015م الماضي، أن فرنسا تلقت تقارير وتحذيرات بشأن مخططات لشن اعتداء ضد رياضييها خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في أغسطس المقبل.
وفي الفترة الأخيرة أخذت فرنسا، سلسلة من الإجراءات التي توضح تمامًا أن الدولة بالفعل في حالة حرب، وتشمل هذه الإجراءات نشر المزيد من القوات في مناطق النزاعات الأساسية التي تهم المصالح الفرنسية، بما فيها المشرق العربي والبحر المتوسط، وتوجيه المزيد من الدعم العسكري والسياسي لحكومات بعينها تتعاون معها فرنسا في موضوع التهديدات الأمنية، مثل إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى العراق.
كما أعلن الرئيس الفرنسي هولاند في خطابه الذي ألقاه قبل العرض العسكري الذي أقيم احتفالاً باليوم الوطني الفرنسي، أن مجموعة القتال التي تشمل حاملة الطائرات “شارل ديجول” سوف تعود إلى المشاركة مرة أخرى في عملية “الشمال”، وهو اسم العملية التي تشنها فرنسا ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.
يبدو هاجس “داعش” حاضرًا بقوة كما قال هولاند في خطابه الذي برر فيه هذه الإجراءات الجديدة في الشرق الأوسط؛ حيث قال: “من واجبنا الرد على من هاجمونا هنا في يناير ونوفمبر 2015.”
وبشكل عام؛ فإن فرنسا تملك واحدة من أكبر جيوش الدول العظمى انتشارًا في العالم لحماية المصالح الفرنسية المترامية الأطراف والمتوارثة من أيام الحقبة الاستعمارية، حتى وإن كانت تنتشر ضمن قوات حفظ السلام الدولية.
ففرنسا لها عشرون ألف جندي خارج الأراضي الفرنسية، غالبيتها – 12 ألفًا – تعمل كقوات سيادية في بعض الدول، و8 آلاف جندي آخرين يعملون مع قوات حفظ السلام حول العالم.
تنتشر غالبية هذه القوات في أفريقيا، وبالتحديد في جيبوتي ومالي وتشاد وأفريقيا الوسطى، وأكبرها الكتيبة الفرنسية المتمركزة في مالي، ويبلغ عديدها 2470 جنديًّا فرنسيًّا، ينتشرون كجزء من اتفاقية موقعة بين الطرفين عام 1977م.
أما ما يرتبط بشكل مباشر بموضوع التهديد “الإرهابي” لـ”داعش”، فهي تلك القوات المنتشرة في مالي وتشاد وغرب أفريقيا؛ حيث توجد قواعد عسكرية فرنسية في جاو في مالي، تضم ألفي جندي، وألفين آخرين في تشاد، و940 في السنغال.
تتحرك هذه القوات في المناطق الأهم بالنسبة للمصالح الفرنسية، وهي كما ذكرنا المشرق العربي، وغرب ووسط أفريقيا، من خلال منظومة من القواعد العسكرية تشمل عشرات الطائرات المقاتلة، بجانب الوجود البحري في المتوسط، والذي سوف يتم تعزيزه في خريف العام الحالي كما قال هولاند.
أما على المستوى الداخلي، فبجانب نشر الـ13 ألف جندي، فإنه، وفي الخامس والعشرين من مايو الماضي، أقر البرلمان الفرنسي قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب، سيحل محل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الفرنسي في عموم البلاد في نوفمبر الماضي عقب هجمات باريس، بحلول نهاية يوليو الجاري.
هل حقًّا “داعش” هي الهدف؟!
لا يمكن بحال من الأحوال، الوقوف عند الإطار المعلن الذي يقوله صُنَّاع القرار في فرنسا في صدد موضوع التهديدات الإرهابية و”داعش”؛ حيث الصورة أعقد من ذلك، وسبق وأن تناولناها في أكثر من موضع.
تقف فرنسا في الوقت الراهن على طرف نقيض في صراع دولي يشمل جبهات عدة، في مواجهة قوى استعمارية أخرى، أهمها وأكثرها تأثيرًا على المصالح الفرنسية، التحالف الأنجلوساكسوني، المعزز بقوى دولية عدة تضمها الرابطة الأنجلوفونية التي تضم أممًا ودولاً على قدر كبير من عوامل القوة.
في هذا الإطار، فإن التنافس الفرنسي الأنجلوساكسوني، في المشرق العربي؛ إنما هو فقط جزء من صراع دولي يشمل جبهات أخرى، أهمها بالنسبة لفرنسا بسبب المصالح الاقتصادية، هو منطقة أخرى قريبة من العالم العربي؛ بل تُعتبر جزءًا من العالم الإسلامي ومنطقة تخوم مهمة للعالم العربي جنوبًا، وهي أفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث تملك فرنسا أهم مصادرها في مجال الطاقة التقليدية وغير التقليدية، وهي النفط واليورانيوم، ومصادر معدنية أخرى هامة في الصناعات النوعية ذات الأهمية للاقتصاد الفرنسي، مثل الكوبالت والبوكسايت والألومنيوم.
يُعتبر نشاط جماعة “المرابطون” من ضمن أهم مهددات المصالح الفرنسية جنوب الصحراء
في هذا الإطار من المدرَكَات، تتحرك، وهي تعلم تمامًا أن “داعش” إنما هو أداة وظيفية لقوى إقليمية ودولية أكبر، تحركه للتأثير على المصالح الفرنسية، بدلاً من المواجهات المباشرة.
وتدرك فرنسا كذلك أن تركيا أحد أهم الأدوات التي تتحرك من خلالها الولايات المتحدة على وجه الخصوص في المنطقة الأهم الآن للمصالح الأمنية الفرنسية، وهي المشرق العربي والهلال الخصيب.
ولا أحد يدرك على وجه الدقة طبيعة الحسابات التركية، فتركيا وفرنسا المفترض أنهما حليفان وليسا خصمان، بموجب عضويتهما في حلف شمال الأطلنطي “الناتو”، كما أن أكثر أطراف الإقليم تأذيًا من السياسات الإقليمية للولايات المتحدة، هو تركيا بعد حصول الأكراد على حكم ذاتي فعلي في شمال سوريا، وتحقيقهم جزئيًّا شكل من أشكال الاتصال الجيوسياسي مع الإقليم الكردي جنوب شرق تركيا.
ولكن هذا الإدراك الفرنسي، دفع باريس إلى إغلاق مختلف مصالحها الدبلوماسية في تركيا والأسباب المعلنة، أمنية، مع إلغاء احتفالات اليوم الوطني الفرنسي في السفارة في أنقرة، والقنصلية الفرنسية في أزمير، بسبب “وجود خطر كبير”.
وهو إجراء لم تأخذه فرنسا في بلدان أخرى يمكن أن تواجه فيه مصالحها الدبلوماسية، من سفارات وقنصليات، تهديدات مماثلة، مثل مصر أو السعودية أو حتى مالي التي يوجد فيها جماعات مسلحة ناشطة تهدد الدولة والمصالح الفرنسية كافة هناك.
الإجراء الفرنسي بحق تركيا يفتح المجال واسعًا حول الثمن الذي دفعته أنقرة نتيجة سياساتها في الإقليم في مرحلة ما بعد الربيع العربي؛ حيث تحولت أنقرة من وسيط موثوق فيه، لعب أهم الأدوار حتى في أعقد الملفات، مثل المفاوضات السورية الإسرائيلية في النصف الثاني من العقد الأول للألفية الجديدة، إلى بلد محاصَر، لا يوجد بينه وبين جيرانه أي ود، بينما تتهدده الكثير من المخاطر الأمنية والسياسية التي قد تهدد بالفعل وحدة أراضيه الترابية.
تُعتبر الخطوة الفرنسية بحق تركيا من الأهمية والدلالة بمكان؛ بحيث يجب في هذا الموضع من الحديث التفصيل فيها.
وتأتي الخطوة الفرنسية، كجزء من الحرب التي تدور تحت السطح بين قوى عظمى ووكلاء إقليميين، وهو ما دفع فرنسا إلى دعم الحكومة العراقية بعدد إضافي من المستشارين العسكريين، كما تقدم، واستضافة عدد من قيادات الأكراد السوريين والأتراك في خطوة غير معلنة، ولكنها تأتي ضمن هذا السياق.
والمتأمل في السياسات التركية الأخيرة، والتي دفعت بها أوساط في الدولة وليس في الحزب الحاكم وحكومته فحسب، ومن بينها الجيش التركي، بعد وصول المشكلات الأمنية والسياسية في البلاد إلى نقطة حرجة.
فتراجعت أنقرة عن الكثير من السياسات الأردوغانية في الداخل، وفي الإقليم، بما في ذلك التراجع عن مشروع التحول للنظام الرئاسي، ومحاولة تصفير المشكلات التركية في الإقليم، من خلال مصالحات بدت ناجحة إلى الآن مع كل من روسيا وإسرائيل، ولكنها لا تبدو ناجحة في الموضوع السوري والمصري.
سياسات تصفير المشكلات التي وصفها البعض مثل زهير قصيباتي في الحياة اللندنية، يوم 13 يوليو، بسياسة “صفر ثوابت”، غير ناجحة لأنها متأخرة كما يبدو من جانب أنقرة، تمامًا مثل قرار التدخل البري في سوريا، الذي تأخر؛ فصار خطرًا على تركيا نفسها.
إعلان تركيا على خلفية مشكلاتها، بأنها على استعداد لتحسين العلاقات مع سوريا والعراق، من دون ذكر مصير بشار الأسد بوضوح، قاد إلى الكثير من الجدل، وربما الغضب في أوساط أخرى، وعلى رأسها السعودية، التي سوف ترتبك كل خططها فيما يتعلق بتعهداتها برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، سلمًا أو حربًا، إذا ما استعادت تركيا علاقاتها الطبيعية مع دمشق في وجود الأسد.
وليس هذا هو المظهر الوحيد للصراعات التي تخوضها فرنسا في الإقليم، ففرنسا لا تتحرك وحدها، وإنما من خلال تحالف قد يكون غير معلن، ولكنه واضح المعالم، ويضم في الإقليم مصر، بالإضافة إلى روسيا.
وقد يبدو ذلك عجيبًا في ظل موقف الاتحاد الأوروبي من روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية؛ إلا أن فرنسا تتحرك في منطقة المشرق العربي في ملف مكافحة الإرهاب، بتطابق كامل مع الموقف الروسي، بما في ذلك موضوع اعتبار جبهة النصرة وعدد من الفصائل التي تدعمها تركيا في سوريا، مثل لواء السلطان مراد، بمثابة جماعات إرهابية، في مقابل الموقف الأمريكي الذي لا يرى ذلك.
وفي الأخير؛ فإن الحقائق التي أعلنها الإعلام الفرنسي، والرئيس هولاند خلال احتفالات اليوم الوطني، الذي يُعرف بيوم الباستيل؛ حيث هُدِم هذا السجن الرمز خلال أحداث الثورة الفرنسية؛ يقول بأن فرنسا فعليًّا في حالة حرب مع قوى دولية أخرى، وجزء رئيسي منها يدور على أرض عالمنا العربي والإسلامي، ولكن من دون أن يبدو لنا أي أثر فيها.
ثم جاء حادث نيس لكي يؤكد أن الرؤية القائمة لدى القيادة السياسية الفرنسية، والتي عبرت عنها كلمة هولاند والإعلام الفرنسي الدولي؛ ليست من فراغ، وأنها قائمة على معلومات أكيدة في صدد التهديدات التي تواجه الدولة الفرنسية ومصالحها.
لكن لم يكن أحدٌ ليتصور أن يكون ذلك بهذا العمق، وبهذا التأثير في الداخل الفرنسي نفسه!