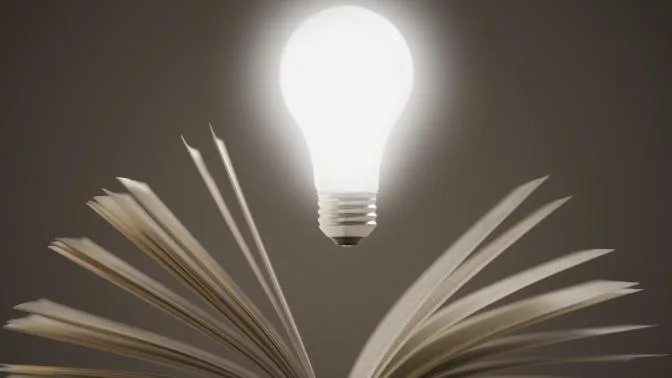واكب استقالة د. أحمد داوود أغلو من رئاسة الحكومة التركية، في أيار/ مايو الماضي، قدر واسع من المراهنات والتكهنات بخصوص سياسة تركيا الخارجية، ما قيل وقتها، أن داوود أغلو، الذي كان أصبح وزيرًا للخارجية بلاده في 2009، قبل أن يرأس الحكومة في الفترة من 2014 ـ 2016، تبنى سياسة خارجية أدت في النهاية إلى عزلة تركيا، إقليميًا، وتراجع وزنها، دوليًا، لم تقتصر التكهنات والمراهنات على المراقبين من غير الأتراك، بل وصدرت من داخل دوائر الحكم في أنقرة، أيضًا، سيما بعد أن أعلن رئيس الحكومة الجديد، بنعلي يلدريم، في خطاب طلب الثقة من البرلمان، أن سياسة حكومته الخارجية ستعتمد نهج تقليل الأعداء وزيادة الأصدقاء.
خلال الأسابيع الأولى من ولاية يلدريم، برزت سوريا، الأزمة الأكثر تعقيدًا والتصاقًا بالمصالح التركية الإقليمية، باعتبارها بؤرة معظم توقعات التغيير المنتظر في سياسة تركيا الخارجية، في حزيران/ يونيو الماضي، نجحت جهود وساطة متعددة في وضع حد للقطيعة بين موسكو وأنقرة، التي استمرت منذ إسقاط القوات المسلحة التركية طائرة روسية مقاتلة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقد راجت في أوساط أنصار نظام الأسد، على وجه الخصوص، صورة غير حقيقية ولا صائبة للتطور الإيجابي في العلاقات التركية ـ الروسية، بما في ذلك وصف هذا التطور بالتراجع الكبير في الموقف التركي، الذي سرعان ما سينعكس على سياسة تركيا تجاه الأزمة السورية، في الأيام التي سبقت وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، وصلت مبالغات دوائر أنصار الأسد مستوى ترقب حدوث لقاء بين مسؤول تركي كبير وحاكم دمشق.
تحسنت العلاقات التركية ـ الروسية بالفعل، وبصورة متسارعة منذ اتصال إنهاء القطيعة بين أردوغان وبوتين في يونيو/ حزيران، ولكن الواضح، أن لقاء سان بترسبورغ بين الرئيسيين في الشهر الماضي نجح في تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، بدون أن يصل إلى توافق بين الدولتين حول تسوية الأزمة السورية، إن كان ثمة تطور إيجابي فيما يتعلق بسورية، فقد أصبحت روسيا أكثر استعدادًا لتفهم طبيعة المصالح الحيوية التركية، كما بدأت الدولتان عملية تنسيق سريعة لمنع وقوع حادث مشابه لإسقاط الطائرة الروسية.
بغير ذلك، لم يزل مستقبل النظام السوري ورئيسه محل خلاف كبير بين موسكو وأنقرة، في النهاية، إن كان ثمة صفقة ستؤسس لاتفاق سياسي ولحل للأزمة السورية، فإن موسكو لن تعقد هذه الصفقة مع تركيا أو إيران، بل مع الولايات المتحدة، من وجهة النظر الروسية، تقف تركيا وإيران في الصف الثاني من تموضع القوى في الأزمة السورية، بينما الولايات المتحدة، فقط، من تملك أوراق العقوبات القاسية المفروضة على روسيا، شرعية أو عدم شرعية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ونظام الدرع الصاروخي المضاد للصواريخ، الذي تقوم واشنطن بنشره في جوار روسيا الأوروبي.
مهما كان الأمر، فما حدث في النهاية أن تركيا لم تنسحب من سوريا، لم تفتح قنوات اتصال مع نظام الأسد، ولم تقدم تنازلات تذكر لروسيا أو إيران، ما حدث، أن السياسة التركية في سوريا أصبحت أكثر تدخلية مما كانت عليه في أي وقت سابق منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.
ما إن أدركت الحكومة التركية أن عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي تعتقد أنقرة أنه ليس سوى فرع سوري لحزب العمال الكردستاني، لم تنسحب من المواقع التي كسبتها غرب الفرات من داعش، وأن الحزب بصدد توسيع نطاق انتشارها باتجاه جرابلس والباب، حتى تقدمت وحدات مدرعة وقوات خاصة تركية، بصحبة قوات من الجيش السوري الحر، عبر الحدود إلى شمالي سوريا.
خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، نجحت قوات الجيش الحر، بدعم من القوات التركية، في السيطرة على طول الشريط الحدودي السوري غرب الفرات، من جرابلس إلى إعزاز، وتبدو الآن في طريقها إلى مدينة الباب، والأرجح، أنه ما لم تنسحب وحدات الديمقراطي الكردستاني المسلحة من غرب الفرات إلى شرقه، فستجبر هذه الوحدات، في النهاية، على الانسحاب بالقوة.
ليس ثمة مخطط تركي لحسم الأزمة السورية بقوة السلاح، وتركيا لا تستطيع تحقيق هكذا هدف على أية حال، وليس لدى أنقرة مخطط للبقاء طويلًا في الأرض السورية، مهما كانت مواقف أطراف الأزمة من التدخل التركي في الشمال، والواضح أن هذا التدخل جاء لحراسة مصالح تركية حيوية، بدا في الشهور القليلة الماضية، أنها أصبحت عرضة لتهديدات كبيرة.
الحقيقة، أن مشروع التأمين النسبي للشريط الحدودي السوري يعود إلى العام الماضي، عندما توصلت حكومة داوود أغلو وإدارة أوباما إلى اتفاق حول قيام الجيش التركي بتحرير المنطقة من جرابلس إلى إعزاز كلية من سيطرة داعش وتحويلها إلى منطقة خالية من الإرهابيين، لجأت تركيا إلى هذا الخيار كبديل عن فكرة المنطقة الآمنة، التي عارضتها إدارة أوباما، بدون تقديم مسوغات كافية، منذ طرحت للمرة الأولى في 2012.
بمعنى، أن تركيا، التي تعي حجم التعقيد الذي بلغته الأزمة السورية، رأت من الضروري وجود منطقة شبه آمنة لإيواء الأعداد المتزايدة من اللاجئين السورية، منطقة ملاصقة للحدود التركية بحيث يسهل توفير المساعدات والعون لمن يلوذ بها من السوريين، ولكن المشروع لم يعد ممكن التنفيذ بعد القطيعة التركية ـ الروسية في نوفمبر/ تشرين ثاني، عبور قوات الديمقراطي الكردستاني إلى غرب الفرات، ورفضه الانسحاب من المنطقة، جعل التدخل التركي العسكري أكثر إلحاحًا، من جهة أخرى، وفر التحسن المتسارع في العلاقات التركية ـ الروسية مناخًا مواتيًا لهذا التدخل.
ليس ثمة شك أن وضع تركيا الإقليمي والدولي لم يكن في أفضل أحواله في النصف الأول من هذا العام؛ ليس بفعل مغامرات ما، أو أهواء قيادي تركي ما، بل بفعل التحولات المتسارعة في منطقة المشرق.
ترك الانقلاب العسكري على الديمقراطية الوليدة في مصر أثرًا بالغ السلبية على وضع تركيا ودورها، وتراكمت المؤثرات السلبية، بعد ذلك، بفعل سياسات إدارة أوباما قصيرة النظر في سوريا والعراق، سيما بسط الحماية الأمريكية على الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد وصلت المتغيرات السلبية ذروتها مع إسقاط الطائرة الروسية والقطيعة مع موسكو.
وليس ثمة شك أن أنقرة، التي بدأت، منذ نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام، في رؤية صعوبة موقفها، كانت بحاجة لاتخاذ خطوات سريعة من أجل إعادة بناء المناخ الاستراتيجي المحيط بها، ولكن الجغرافيا السياسية للدول تميل أكثر إلى الثبات منها إلى التغير، وعندما تتغير، فإنها عادة ما تفعل ذلك ببطء شديد، ومهما كانت توجهات الأفراد والقادة، مهما كانت ميولهم وأمنياتهم، فإن الوقائع الصلبة للجغرافيا السياسية تفرض نفسها في النهاية، سوريا لن تنتقل إلى جوار موزمبيق، وداعش لا يمكن أن تكون جارًا عاقلًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني لن يصبح فجأة مصدر اطمئنان، وهذا ما دفع الرئيس التركي للقول، معلقًا على عملية قوات بلاده في شمالي سوريا، أن على العالم أن يدرك أننا نوجد في هذه المنطقة.
ليست تركيا قوة عظمى، ولكنها تبدو في طريقها إلى التحول لقوة رئيسية في إقليمها، وضع شبيه بموقع ودور ألمانيا في أوروبا، وتشترك القوى الصاعدة في العالم في أنها ما إن تأخذ في الوعي بذاتها، حتى تبدأ في ممارسة النفوذ في جوارها القريب، وتركيا لن تكون استثناءً، بغض النظر عن الحكومة التي تقبض على مقاليد الأمور في أنقرة.