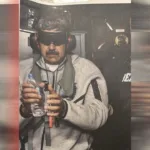لماذا لا يمكن الاستغناء عن التنين؟
أضحى الكلام عن الاستغناء عن الدولة القومية الحديثة –أو كما يطلق عليها الدكتور عبد الوهاب المسيري الدولة التنين- دربًا من الخيال لا يمكن تصوره في أى مجال من مجالات المجتمع ماديًا كان هذا المجال أو ميتافيزيقيًا، وذلك من خلال تطبيق مبدأ يسميه الفيلسوف ميشيل فوكو المراقبة والمعاقبة، من خلال بث سلطات لا يمكن الاستدلال عليها ماديًا أوحتى معنويًا فصارت كيد خفية تحكم وتقنن وتشرع وتعاقب وتثيب وأيضًا لا صلة ظاهرة لها بكل هذا التمثيلات الواقعية.
تَغَلغُل التنين داخل المجتمع على المستوى المادي والميتافيزيقي كان أيضًا بسبب تمثيله الدور الوسيط بين احتياجات الناس وبين الناس أنفسهم؛ فاندس التنين يأكل وظائف المجتمع والأمة ويبتلعها ويذرها لنفسه فقط محاربًا أي شخص أو جماعة تحاول أن تعيد لذلك المجتمع وظيفته، فتعددت وظائف التنين داخل المجتمع الواقع في رقعة من الأرض ومحدد بحدود لا تتجاوزها سلطته بين ردع الغزاة والتعليم وسن القوانين.
أولًا: ردع الغُزاة
دخل نابليون بونابرت مصر ولم يكن بها قوة عسكرية مدربة سوى المماليك الذين لم يتركوا السيف والحصان عند مواجهتهم للجيش الفرنسي الحديث المُجهز بالمدافع والرشاشات، فكانت الغلبة للفرنجة وخسر المماليك خسائر فادحة لكن عندما صعد المُنادي مأذنة المسجد ونادى حي على الجهاد؛ هَبَّت جموع عامة المسلمين الغير مدربين على المعارك لصد قوات الجيش النظامي الفرنسي فما لبث الجيش الفرنسي إلا وقد وجد قواته تموت بالمئات على يد الفلاحين وتُكَبَّد خسائر فادحة ورحل عن مصر بعد 3 سنوات أذاق الفلاحين فيها جيش الغزاة شتى أنواع العذاب.
خلال ما يُعرف بحملة فريزر، دخلت القوات الإنجليزية مدينة رشيد ولم يجدوا شخصًا يسير في الشارع ظنوا أن أهلها قد أصابهم الرعب وخرجوا من القرية ولكن كانت الحامية بين الأهالي متوارية بالمنازل داخل المدينة، فتقدم الإنجليز ولم يجدوا أي مقاومة، فاعتقدوا أن المدينة ستستسلم كما فعلت حامية الإسكندرية، فدخلوا شوارع المدينة مطمئنين، وما كادوا يستريحون، حتى انطلق نداء الآذان بأمر علي بك السلانكي من فوق مئذنة مسجد سيدي زغلول مرددًا: “الله أكبر، حي على الجهاد”؛ فانهالت النيران من الأهالي وأفراد حامية رشيد من نوافذ المنازل وأسطحها، فقتل جنود وضباط من الحملة، وهرب من بقي حيًا.
ولكن ما حدث بعد سنواتٍ ليست بعيدةً عن الحَدَثَين السَابِقَين وبعد إنشاء الجيش المصري الحديث المدرب على استخدام السلاح ومواجهة الأعداء الذي كانت صيحاته مثل تلك الصيحات “الله أكبر”، و “حي على الجهاد”، والتي كانت تدل على أنه جيش مسلم.
ما لبث أن دخل الإنجليز مصر ليقوموا بحماية واليهم الخديوي توفيق حتى ركن إلى جيش الغزاة وأخذ أوامره منهم بل وساعدهم على القبض على المتمردين الذين يكافحون ضد المحتل الأجنبي.
إذًا منذ بضعة عقود كان عوام الناس يهُبُّون للنكاية بالمحتل والإيقاع به ثم بعد ذلك عندما أصبح هناك جيش مسلح ومدرب من صلب هؤلاء العوام ساعدوا المحتل على السيطرة على بلدهم ومحاربة من يجاهدونه. ماذا حدث لعقل المسلم الذي هب دون وازع من أحد ليجاهد ودون أدوات مادية ثم بعد مدة يسيرة قام مدربًا مسلحًا فلم يرفع بندقيته إلا على بني جلدته؟
كان الجهاد وحمل السلاح وردع الغزاة إحدى وظائف الأمة المسلمة فكان العلماء والشيوخ يحثون العامة على الخروج للجهاد ويخرجون معهم لملاقاة العدو، لكن بعد إنشاء الجيش الحديث المدرب، وبعد نزع السلاح من العامة، وتجريم حمل السلاح إلا بترخيص قانوني؛ تم نزع أول وظيفة من وظائف الأمة وهي حماية نفسها والاعتماد على قوة عسكرية مدربة تتبع للقوة السياسية الحاكمة، فبعد أن كان الجهاد متاحًا لجميع المسلمين، أصبح حكرًا على فئة تتدرب بأمر من الحاكم وتُجمَع بأمر من الحاكم ولا تخوض حربًا إلا بأمر الحاكم؛ فأصبح الجهد والعمل المسلح مرتبطًا بكون الحاكم يريد ذلك أم لا ومع تغير الحاكم وتغير الفئة الحاكمة أصبحت الدولة التنين هي المسيطر على القوة العسكرية من خلال النظام البيروقراطي ومن خلال الدستور والقوانين الملزمة باتباع أوامر ونواهي السلطة الحاكمة، أصبح رد الغزاة مهمة التنين فقط لا يشاركه فيها أحد، ولا يحركه سوى منفعته ومكسبه المادي.
ثانيًا: التعليم
كان الصبي أو الفتاة لا يكاد يستطيع إنشاء جملة كاملة وينطقها حتى يذهب إلى الكُتَّاب؛ فيتعلم القرآن ويحفظه ويتعلم علوم اللغة العربية من نحو وصرف ويتعلم الحساب والرياضيات ويتعلم فقه الطهارة والصلاة والمعاملات اليومية؛ فيخرج الصبي أو الفتاة مُلِمًا بأمور دينه الأساسية. كان الفرد الذي يقف عند هذا الحد يعتبر فردًا عاديًا داخل المجتمع المسلم وكان هذا الفرد الذي إذا سمع نداء الجهاد؛ أسرَع ولبَّى.
أما من كانت عنده ملكة الفهم والحفظ التحق بالأزهر، وكان نظام الدراسة بالأزهر ينم عن تعلق حقيقي بالوحي وتمثيل واقعي لمسجد يخلف المسجد النبوي في تعلم أمور الدين والعبادة من حيث منهجية التعلم والشكل الحلقي للتعلم.
كان درس “القرآن” يبدأ بعد الفجر مباشرة ثم يتلوه درس “السنة” ويليه درس “شروح القرآن والسنة” ثم درس “أصول الدين” بعده درس “أصول الفقه” ويأتي بعده “المذاهب الفقهية”. كان هناك هدف من التعلم وكان هناك نظام للتعليم وهو عبادة الله بمعرفة شرعه باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وكان هناك نظام منطلق من مركزية التوحيد المتمثل في الابتداء بتعليم الوحي ثم فروعه ثم فروع فروعه.
جاء التعليم الجديد في المدارس النظامية لينافي -وبشدة- نظام تعلم الكتاب والأزهر، فكانت هيئة مُعينة من قبل الحاكم السياسي هي التي تضع مناهج التعليم كما أن نظام التعليم كان يحاكي النظام الكنسي في جلوس الطلاب وفي وقوف المعلم؛ فجاءت المناهج متمركزة حول إخراج إنسان يصلح أن يكون فردًا صالحًا داخل هذا المجتمع البيروقراطي الجديد، يكون له دور مُحدد مسبقًا داخل هذا المجتمع الجديد.
فأعاد التنين صياغة الهدف من العملية التعليمية والمركز القائمة عليه ولم يكتفي بهذا القدر بل حَقَّرَ من قيمة التعليم الأزهرى واستهزأ بشيوخه وقلل راتبهم؛ فأضحى الإقبال عليه ضعيفًا ولم يكن أمام الناس بديل آخر سوى هذا التعليم الجديد؛ فتحول التنين من كونه يعطي بديلًا آخر للعملية التعليمة لكونه يعطي حلًا واحدًا داخل منظومته الجديدة وهكذا استولى على العملية التعليمية وأضاف شيئًا جديدًا لوظيفته السابقة ألا وهي إخراج الأفراد المهيئين للعمل تحت سيطرته وبمقتضى حكمته نحو مصلحته ومنفعته، وخَلق مجال ميتافيزيقي لا يُخرِجُهم عن مساره المعهود بل يمدهم بأفكار يألفها التنين ولا يخرجون بها عن المسار المُعد من قِبَلِه.
ثالثًا: سَن القوانين
لم تظهر داخل المجتمع الإسلامي القوانين كشيء حادث من داخله وإنما أدخلها الخلفاء؛ لسد بعض مناطق الاجتهاد الإنساني داخل المجتمع كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب، فقد كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي التي يرجع إليها المجتمع ثم أتت القوانين المستوردة بعدها وقد تم إضافتها بعد تخليتها من شركيات مجتمعاتها التي أثرت عليها.
كان أمر التشريع فيما يتعلق بالأحكام الفقيه قائم على الاجتهاد بالأدوات الفقهية من علم باللغة العربية وأصول فقه داخل إطار الوحي من قرآن وسنة وكان نسق الاجتهاد متاح لأى فرد يأخذ بالأدوات المعروفة وكان الفقهاء أنفسهم مدركين لهذا الأمر، فهذا الإمام مالك جاءه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ليطلب منه تعميم كتاب “الموطأ” ليكون هو المذهب الذي تتم من خلاله اتخاذ أحكام القضاء والمعاملات؛ لكن الإمام مالك رفض ذلك بسبب إدراكه أنه بتعميم “الموطأ” يغلق باب الاجتهاد في وجه المسلمين وينغلق نظام التشريع داخل الدولة على مذهب واحد ويتم إهمال باقي المذاهب والاجتهادات.
لكن الدولة التنين خالفت ما تعارف عليه جموع علماء المسلمين والأمة الإسلامية، فقامت بوضع دستور يضم عددًا من القوانين التي تم وضعها بواسطة خبراءه البيروقراطيين المُنتَجين بواسطة مدارسه ونظام تعليمه وبمجال ميتافزيقي يدعم وجوده، فجاءت هذه القوانين كلها كأنها شرع جديد لا يفعل الفرد شيئًا إلا بمقتضى هذا الشرع، أما من حاول مخالفة هذه القوانين –حتى لو كان منطقيًا في فعله- فإنه يُعد خلية سرطانية نشأت داخل جسد التنين فيتم التعامل معها بإرسالها لجاهزه المناعي ألا وهو”سجن الدولة”، حتى يتم فترة عقوبته ويخرج بعدها خلية سليمة يمكن أن تزاول عملها مرة أخرى داخل المجتمع البيروقراطي، فكأن التنين نصَّب نفسه إلهًا ووضع لنفسه تشريعًا ووضع عقوبة لكل مخالفة، فطبع ذلك على عقول الأفراد فمدَّهم بمخزون روحاني تم فقده عندما تم رفض الرجوع إلى التعاليم السماوية.
فأتم بذلك دينه الكامل الذي أرتضاه لهم وأخذ وظيفة الإله والمُشرع في المجتمع ولم يتركهم فارغي الروح بل مدهم بحلم يوتوبي يكون دافعًا روحانيًا لهم محققًا بذلك السيطرة الكاملة على المجتمع من خلال تبديل دوره ووظائفه فبعد أن كان المجتمع هو الذي يدافع عن نفسه أصبح يلجأ إلى التنين، وبعد أن كان يعلم أبناءه أضحت هذه مهمة التنين، وبعد أن كان الاجتهاد بالشرع مفتوحًا ومحددًا بأدوات، أمسى حِكرًا على مجموعة من الأشخاص لا يمثلون سوى رغبة التنين وخط سيره ومنفعته، وأخيرًا أصبح لا يمكن أن يخطر في مجال أفكار المجتمع أن يستغني عن التنين بل أصبح من المسلمات التي لا تقبل النقاش ولا تخطر على باله.
فهنيئًا للتنين وظائفه الجديدة فهو الحامي والمُعلم والمُشرع وهو القاضي وواضع الخطط، أما هؤلاء البشر فهم أدواته في تنفيذ خططه في تحقيق منفعته وفي تحقيق أعلى درجة من السيطرة على مجتمعه الجديد.