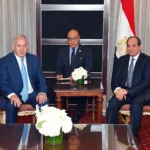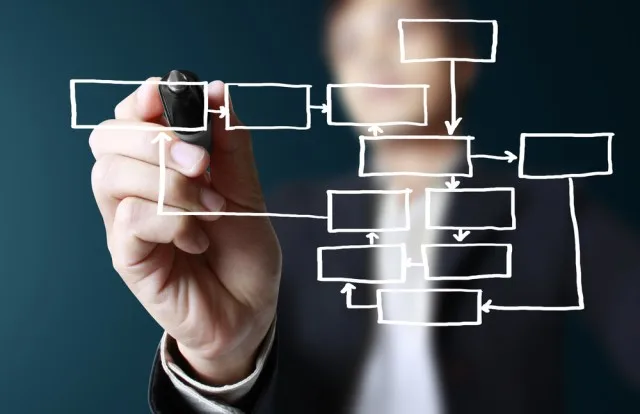مع انطلاقة أحداث الربيع العربي 2011م، برزت إلى السطح، أو فلنقل أخذت أدوارًا أكبر، العديد من القوى الإسلامية في مختلف المناطق ذات الخلفية الإسلامية، كحزب الإخوان في مصر، جمعية الوفاق في البحرين، الحركة الإسلامية في تونس، التنظيمات المسلحة كتنظيم الدولة والقاعدة وغيرها.
على الرغم من أن التجارب مختلفة بالنسبة لكل من هذه التنظيمات باعتبار اختلاف الظروف السياسية والثقافية والفكرية التي ينطلق في ضوئها كل منهما، وباعتبار اختلاف الأنساق التي بها تظهر أفكارها، غير أن ذلك لا ينفي كون الجميع منها يدعو للإسلام السياسي وتطبيقه.
في الواقع، لم تكن أحداث الربيع العربي هي ما أسست للتفكير في العلاقة بين كل من الدين والسياسة في الجانب العربي، بل هي مسألة قديمةٌ أخاذة في جذور التراث الإسلامي والفقهي والعربي، صحيح أن المعالجات الفقهية القديمة كانت ناظرةً للإسلام السياسي بما هو سلطة لا بما هو دولة، الأمر الذي خضع لنفس ظروف الفكر السياسي آنذاك، إلا أن الجذر واحد، إنه تطبيق الشريعة، أو تفعيل الدور السلطوي الدستوري للدين الإسلامي في الحياة السياسية فضلًا عن الخاصة.
الخلافة – كأبرز مصداقٍ لدولة الإسلام والشريعة – ألغيت رسميًا فيما بعد الحرب العالمية الأولى بقليل، وبذلك أسدل الستار على أكثر من ألف ومئتي سنة من الحكم الذي استقر باسم الإسلام، نعم، لسبب أو لآخر أعدم النظام الإسلامي بأبرز صوره، وكخطوة في الطريق، استبدلت أغلب الدول التي كانت تحت تلك الخلافة بأنظمة علمانية تدعي أنها ستفصل الدين عن الدولة، أو على الأقل، ليست الشريعة هي المصدر الرئيس فيها للتشريع بقدر ما هي مصدر ثانوي تُخالف أحكامه غالبًا.
إذا كانت الدولة سابقًا تستمد سلطتها من إسناد الشريعة لها، والمواطنون مؤمنون بالشريعة فسيتبعون الدولة تبعًا للشريعة، أصبحت بعدئذٍ الدولة تستمد سلطتها من الوطنية
الذي جرى – من أحد جهاته – هو استبدال الدولة الإسلامية بالدولة الوطنية، الدولة القومية، الدولة الفئوية، فإذا كانت الدولة سابقًا تستمد سلطتها من إسناد الشريعة لها، والمواطنون مؤمنون بالشريعة فسيتبعون الدولة تبعًا للشريعة، أصبحت بعدئذٍ الدولة تستمد سلطتها من الوطنية الإقليمية السياسية والقومية كالدولة التركية والسورية والمصرية.. إلخ.
إذا كان شخصٌ قد اعتقد أن هذا الإلغاء للخلافة واستبدالها بدول وطنية يمكن أن يشكل حلًا لمشكلة ما، فإن هذا الاعتقاد خاطئ حتمًا، ولكن لنا أن نسأل ما الذي حدث؟ لماذا بعد أن قضي على الدولة الإسلامية واستبدلت بأنظمة أخرى نجد الروح الإسلامية السياسية تعاود الظهور؟
في نظري فإن الأمر أكبر من كونه مجرد عقيدة، صحيحٌ أن المسلمين تأخذهم عواطفهم الدينية، أو فلنقل عقيدتهم الدينية تأخذهم نحو إرادة إقامة دولة إسلامية وإعادة الخلافة، غير أننا نعلم أيضًا أن العقيدة تحتاج إلى ما يدعمها حتى يكتب لها البقاء، تحتاج إلى أمور مادية خارجية – بالإضافة للروحية والفكرية – تجعلها قائمةً ومستمرة، هناك علاقة متجانسة بين الأمور المادية والروحية والفكرية في بقاء العقيدة حيةً راسخةً على مدى الأجيال.
في أواخر القرن التاسع عشر، بدأ الحكم الإسلامي في الدولة العثمانية التي كان سلطانها قائمًا على الانتساب للإسلام يتداعى شيئًا فشيء، ولم يكن المسلمون أنفسهم راضين عن أداء الدولة، باعتبار أن مصالحهم لم تكن متوافقة مع الدولة، الأمر الذي يفسر وجود حركات انفصالية آنذاك، بالإضافة إلى تطور الدول الغربية مقارنة بوضع الإسلامية، على أي حال، بعد الحرب العالمية الأولى انهارت رسميًا الخلافة الإسلامية وأعلن قيام الدولة العلمانية محلها، وقسمت تركتها وفق تقسيمات سياسية بحتة.
على الرغم من أن عددًا من المسلمين آلمهم قرار إلغاء الخلافة، فإنهم في الوقت نفسه كانوا يعلمون أن ذلك النظام حقق فشلًا ذريعًا في الفترة التي عاشوها، الأمر الذي أثر بشكل كبير في إقامة الدول والملكيات اللاحقة، حيث كان مؤملًا منها تحقيق الرفاه والتقدم.
لكن المشكلة التي حصلت هو أنه كان هناك نوعًا من عدم المواءمة بين طبيعة البيئة التي خرجت عنها الخلافة وطبيعة أنظمة الدول المستوردة التي طرأت، وكان من نتائج عدم المواءمة هذا – فيما أخمّن – بروز وظهور عدد من الثورات على تلك الأنظمة.
لكن، ما الذي يجعل هذه الثورات راجحة لجهة الإسلاميين كما أفادت نتائج الاقتراع في غير بلد منها؟ هذا يعني أن الإرادة الشعبية – على نقاش في هذه الملازمة – اتجهت وأرادت الإسلام، نعم، نفسه الذي ألغي مع الخلافة، ولكن هذه المرة في صور أخرى.
لنعد لعدم المواءمة تلك ونسأل: كيف كان نظام الخلافة، أو دولة الإسلام مدارًا وشرعيًا؟
قامت دولة الإسلام في البداية على الركن الديني بالأساس، والدنيوي كفرع على ذلك
يمكن القول إنه في البدء كان هناك حاكمًا دينيًا ودنيويًا هو رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وبعد موته حصل نوع من توزيع السلطات، لقد كان الرسول يستند في السلطة الدنيوية على السلطة الدينية، لو لم يكن رسولًا لم يكن حاكمًا، ولما أن توفي – صلى الله عليه وسلم – حصل نوع من الاختلال بين هذين الركنين، وفق نظرية الإمامة، فإن الاختلاف لم يكن هناك باعثًا لوجوده، لأن الإمامة امتداد النبوة، لكن هذا تبرير نظري أكثر من كونه عمليًا، والذي حصل أن منصب الخليفة استحدث، رغم أنه في البدء كان هناك نوعًا من الغموض المفاهيمي، هل هو خليفة الله أم خليفة رسوله، واستقر في الأخير على أنه خليفة رسوله.
إذًا قامت دولة الإسلام في البداية على الركن الديني بالأساس، والدنيوي كفرع على ذلك، وما حدث كان أن الخليفة امتداد للجانب الدنيوي، والعلماء، الفقهاء، رجال الدين لاحقًا، امتدادٌ للجانب الديني، وعلى الرغم من أن بعض النصوص الواردة عن أبي بكر – رضي الله عنه – وبعض الصحابة بعيد وفاته – صلى الله عليه وسلم – تشير إلى الجمع بين الجانب الديني والدنيوي في سلطات الخليفة، إلا أن الواقع العملي كان يحتّم نوعًا من الانفصال بين هاتين الثنائيتين في شخص الخليفة سرعان ما أخذت تتبلور بشكل أكبر، حيث يمكن مقارنة هذا مع تطور حركة الاجتهاد الفقهي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
هكذا إذًا استمر جوهر فكرة الخلافة، وهو وإن خضع في أحايين عديدة لتجاذبات السلطة، إلا أن الحكام الذين أتوا كان لا بد لهم من الاستناد على شرعية العلماء، ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن أهمية العلماء في هذا النظام السياسي أخذت بعدًا آخر، فالعلماء من جهة هم الجهاز القضائي الذي يفصل في خلافات الناس، وهم الذين يلتصقون بالناس يبينون لهم أحكام الدين من عبادات وأحوال شخصية وغير ذلك من شؤون الدين، لذا، وإن كان دور العلماء أحيانًا قد استغل من قبل بعض الحكام، لبث بعض الأفكار أحيانًا كالجبر، إلا أنه ظل دورًا محوريًا يستند عليه الحاكم الدنيوي في شرعية خلافته، وهو أمرٌ يمكن تلمسه أيضًا في الدول المسيحية في العصور الوسطى.
السلطة الدنيوية بحاجة لما يسندها ويقوّمها دائمًا
هذا النظام، وبطبيعة تركيبته الدينية – السياسية – الاجتماعية لم يتخذ بعدًا سياسيًا حسب، بل كان له دور كبير في تكوين التراث والثقافة والبيئة الفكرية العربية والإسلامية، وإذا أضفنا لذلك أن الإسلام الحنيف بطبيعته نظام (دين ودنيا، دنيا وآخرة، علاقات خاصة وعامة، عبادات ومعاملات..)، يمكن لنا أن نخرج بأن طبيعة تطبيق الإسلام تحتم على معتنقيه السعي لتطبيقه التام، وهو ما يتحقق في إطار السعي للتطبيق على الدولة كلها.
فالحاصل أن السلطة الدنيوية بحاجة لما يسندها ويقوّمها دائمًا، وهي في التجربة الإسلامية امتداد النبوة والعلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء، ووفق منظرين غربيين العقد الاجتماعي، وآخرين إرادة الأمة وغير ذلك.
الذي حصل هو أن عدم المواءمة حصل في هذا الأساس الذي يجب أن تقوم عليه السلطة، بالإضافة إلى المعارضات الكثيرة بين الدين والدولة في مجال التشريع، ولهذا كلام آخر.
لكن هذه النتيجة ليست على إطلاقها، ذلك أن هذا التطبيق سيبقى محملًا بالأثقال التاريخية التي طبق الإسلام في هيئتها، نظام الخلافة مثلًا، من هنا، نظر المسلمون لعدد من أشكال الحكم الإسلامي في ضوء الدولة الحديثة، وربما تفسر لنا هذه الأسباب إعادة نهوض القوى الإسلامية من جديد.
إن تطور التحليل في هذه المسألة يبقى مرهونًا بتشابك عناصر معرفية تاريخية وفقهية وسياسية وقانونية، نأمل أن نجد لها مزيدًا من الآثار عمّا قريب.