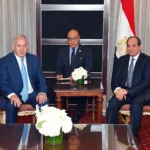ترجمة وتحرير: نون بوست
لم يكن من المفترض أن تنجح اتفاقية أوسلو، اتفاقية السلام التي وقّعتها إسرائيل مع الفلسطينيين في سنة 1993، بل كان من المفترض أن تفشل. وبعد خمس سنوات كان من المفترض أن يكون كلاهما دولا ذات سيادة ضمن حدود ثابتة، لتصبح الصفقة المؤقتة بائدة. لكن خمس سنوات أقبلت ومضت، ثم خمس سنوات أخرى، وتلتها أخرى، وبذلك باتت الفترة المؤقتة دائمة.
بحلول اليوم (13 أيلول/ سبتمبر) يكون قد مضى على إبرام هذه الاتفاقية 30 عامًا. وقد تمثّلت إنجازاتها الدائمة في إنشاء حكومة فلسطينية محدودة يعارضها معظم الفلسطينيين، وتحقيق قدر من الاعتراف المتبادل بين الجانبين بينما لم تتحقق وعود السلام.
لقد أمضى الإسرائيليون والفلسطينيون عقودًا من الزمن في الجدال حول الخطأ الذي حدث. لو أن قادتهم – بنيامين نتنياهو أو إيهود باراك أو ياسر عرفات أو محمود عباس – قبِلوا إحدى الصفقات التي تم طرحها في المفاوضات اللاحقة. ليت يغال عمير لم يغتَل إسحاق رابين، وليت حماس والجهاد الإسلامي لم تشنّا حملة من التفجيرات الانتحارية. ولكن ربما لم يحدث أي خطأ. لقد عملت الاتفاقية بالطريقة التي صُممت من أجلها، وهذا يعني أنها لم تنجح على الإطلاق. لقد كانت عملية أوسلو معيبة على الدوام، ومع ذلك لم يكن من الممكن أن تحدث بأي طريقة أخرى.
أبرِِمت هذه الاتفاقيات بعد سلسلة من الاجتماعات في مطلع سنة 1993 في العاصمة النرويجية. في البداية، كان من غير القانوني للإسرائيليين التحدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعتبرها حكومتهم جماعة إرهابية. ولكن المسؤولين النرويجيين أقنعوا يوسي بيلين، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، بمواصلة عقد اجتماعات سرية مع أعدائه القدامى.
كان أحمد قريع (المعروف باسم أبو علاء)، وهو مسؤول حكومي دمث الأخلاق ومقرب من الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، يقود الفريق خلفًا لنظيره الأكاديمي الإسرائيلي يائير هيرشفيلد ثم بعدها أوري سافير، المدير العام لوزارة الخارجية. لقد عاشوا معًا لعدة أيام في أوسلو، وكانوا يجتمعون في وقت متأخر من الليل، وكانوا يحتسون النبيذ ويتناولون الأطعمة المنزلية أثناء محادثاتهم (كانت زوجة وزير خارجية النرويج تقوم بإعداد بعض وجباتهم). وما حدث لم يكن ليشكل نهاية الصراع بل بداية النهاية.
لم يتمكن المفاوضون من الاتفاق على القضايا الشائكة، مثل وضع القدس، فأجّلوها واتفقوا على خطوات مؤقتة، ليتولّى كيان جديد يسمى السلطة الفلسطينية سيطرة محدودة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتلا ذلك سلسلة من الإضافات، حيث حدد بروتوكول باريس في سنة 1994 العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقد حددت اتفاقية طابا سنة 1995 الترتيبات الأمنية.
لم يكن أي من هذا بمثابة تسوية نهائية، بل كان مجرد علاقة بين الاحتلال والمحتل وكان المقصود منها أن تكون قصيرة الأمد. واتفق الجانبان على بدء المحادثات حول اتفاق نهائي بين الدولتين الذي ينطلق بحلول أيار/ مايو 1996 وينتهي بحلول أيار/ مايو 1999. كان هذا تمرينًا على التدرّج. وبعد نصف قرن من الصراع، كان الاعتقاد السائد أن لا أحد يستطيع أن يتوقّع من الإسرائيليين والفلسطينيين أن يتوصّلوا إلى اتفاق شامل لأنهم كانوا بحاجة لبناء الثقة.
ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 58 بالمئة خلال تلك السنوات، من 116.300 إلى 183.900 مستوطن، حتى مع ارتفاع إجمالي عدد سكان البلاد بنسبة 17 بالمئة فقط
لكن الطبيعة التدريجية للعملية تركتها عُرضة للمفسدين. ويشير جويل سينغر، المستشار القانوني الإسرائيلي في سنة 1993، إلى قرار إنشاء قوة شرطة فلسطينية مسؤولة عن الأمن في أجزاء من الضفة الغربية. ومع ذلك، لم يكن الفلسطينيون على استعداد لمساعدة الجيش الإسرائيلي. لقد قُتل عدد أكبر من المدنيين الإسرائيليين على يد الفلسطينيين في السنوات السبع التي تلت إبرام اتفاقية أوسلو مقارنة بالسنوات السبع التي سبقتها – وكان ذلك قبل أسوأ أيام الانتفاضة الثانية، أو الانتفاضة الفلسطينية.
كثيرًا ما أشار قريع إلى خطأ آخر، فقد فشلت الاتفاقات في منع إسرائيل من بناء المستوطنات. بل خلقت شعورًا بالإلحاح. ولو أن إسرائيل رسمت الحدود بحلول سنة 1999، لكان أمام المستوطنين سوى بضع سنوات للاستيلاء على المزيد من الأراضي. فما بين 1993 و1999، أقاموا 43 بؤرة استيطانية، وهي مستوطنات غير معترف بها من قبل الحكومة. وتم ترخيص البعض منها لاحقًا أو دمجها في المستوطنات القائمة.
ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 58 بالمئة خلال تلك السنوات، من 116.300 إلى 183.900 مستوطن، حتى مع ارتفاع إجمالي عدد سكان البلاد بنسبة 17 بالمئة فقط. ولا تزال أعدادهم ترتفع. وفي سنة 1993، كان المستوطنون يشكّلون 2 بالمئة من سكان إسرائيل وثلاثة بالمئة من سكانها اليهود، واليوم بلغت هذه الأرقام خمسة بالمئة وسبعة بالمئة، وقد نمت قوتهم السياسية أيضًا.
ساعدت هذه التطورات في تخريب العملية، وإرهاق الشعبين بشأن فكرة السلام. واليوم، يؤيّد 28 بالمئة فقط من الفلسطينيين حل الدولتين مقارنة بـ 53 بالمئة قبل عقد من الزمان. ويريد نصف الفلسطينيين حل السلطة الفلسطينية، وهو الإرث الأكثر ديمومة للاتفاقيات. وفي إسرائيل أيضا، وصل الدعم إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، حيث يؤيّد هذه الفكرة ثلث اليهود الإسرائيليين فقط. لقد نشأ الشباب الإسرائيليون خلال الانتفاضة الدموية، وبلغ الشباب الفلسطيني سن الرشد وهم يشاهدون المستوطنين يستولون على الأراضي المخصصة لدولتهم المستقبلية. لذلك ليس من المستغرب أنهم فقدوا الثقة في الحكومة.
يستشهد الدبلوماسيون بالاتفاقية وكأنها تعاليم دينية تحتضر، وكأنها ممارسة أخرى لبناء الثقة أو جولة من المفاوضات التي ستفتح المجال أمام سلام حقيقي
مع ذلك، من غير المفاجئ أيضًا أن تسير العملية على هذا النحو. ففي بعض الأحيان، يشبّه الإسرائيليون والفلسطينيون فكرة حل الدولتين بإنهاء زواج غير سعيد. تخيّل أنك تُقدّم طلبًا للطلاق ولكنّك توافق على العيش مع زوجتك لمدة خمس سنوات أخرى بينما تقرر كيفية تقسيم الأثاث. إنها وصفة لعداوة أعمق.
في خضم التفاؤل الذي ساد في مطلع التسعينات، ربما بدا من المنطقي أن يتمكن قِلة من الرجال الشجعان من رسم الطريق إلى السلام، وأن تتبع حكوماتهم هذا الطريق بحسن نية. لكن اتفاق السلام الحقيقي يحتاج إلى دعم أوسع من كلا الشعبين. لم يكن مثل هذا الدعم موجودًا في التسعينات، وهو ليس موجودا اليوم حتى – لا بوجود حكومة يمينية متطرفة تحكم إسرائيل المنقسمة بشدة، ولا بوجود محمود عباس المتقاعد مسؤولاً عن السلطة الفلسطينية الضعيفة التي لا تسيطر على أجزاء كبيرة من فلسطين. وقد فقدت القوى الغربية اهتمامها بلعب دور الوسيط، بينما يريد القادة العرب أن ينسوا الصراع.
في الوقت الحالي، تظل اتفاقية أوسلو هي الحل المتبقي. ويستشهد الدبلوماسيون بالاتفاقية وكأنها تعاليم دينية تحتضر، وكأنها ممارسة أخرى لبناء الثقة أو جولة من المفاوضات التي ستفتح المجال أمام سلام حقيقي. وسوف يبقيهم الجمود موجودين إلى أن يصبح جيل جديد من الإسرائيليين والفلسطينيين على استعداد لتجربة شيء جديد – سواء كان للأفضل أو للأسوأ.
المصدر: الإيكونوميست