“لا تودع قلبك غير السماء”.. رحلة في الأدب الصوفي

“ما أسهل حياة البرازخ، أن تتأمل الحياة وأنت مجرد من الإرادة، لا تفعل ولا تنفعل، يحملك رجل وامرأة إلى بيت غريب، يجسانك ويحوقلان ثم يحجبان عنك العالم بعباءتك، تحملك المحفّة إلى بيت مألوف، أسمع أصواتهم وأشم روائحهم، وإذا تحرك جفناي المسدلان لمحت وجوههم الباكية، صفية تبكي ترمّلها للمرة الثانية…”.
في الخامس والعشرين من أبريل الفائت، أعلنت لجنة الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورتها العاشرة، فوز رواية “موت صغير” للروائي السعودي “محمد حسن علوان” بالجائزة.

الروائي السعودي محمد حسن علوان يتسلم جائزة البوكر عن روايته “موت صغير”
ورحب الكثير من القراء والنقاد بهذه النتيجة، حيث أكدوا أن هذه الرواية تُعد تحفة أدبية تفيض بالروحانيات وتسمح لمحبي الشيخ ابن عربي بالولوج إلى عالمه الخاص غير المطروق.
حيث تتناول الرواية سيرة متخيلة للفيلسوف محيي الدين بن عربي منذ ولادته في الأندلس في منتصف القرن السادس الهجري وحتى وفاته في دمشق، وكتب علوان هذه الرواية – كسابق كتاباته – على لسان الشيخ ابن عربي.
وطرق الأديب رواية تراث التصوف الإسلامي، من خلال سيرة أبرز رموزه الشيخ محيي الدين ابن عربي، ليأخذ القارئ في رحلة إلى عالم التصوف الإسلامي وتقاليده، والعلاقات مبهمة وغامضة – لمن خارج هذا العالم الأثير – بين المريد والمراد، وطبقات المتصوفة، وعملية الجذب النفسي والكرامات، بلغة رائقة ورصينة، حيث نسّق الروائي الأحداث بالتوالي في دقة تُحسب له، إلى جانب توظيف الحقب التاريخية وأحداثها، من أجل إصباغ السرد بصبغة مكانية وروحانية تليق بسيرة ابن عربي.

غلاف رواية “موت صغير” للروائي السعودي محمد حسن علوان
في هذه الرواية، تناول الكاتب كل تلك الشؤون في متن سردي، أطلق عليه “الأسفار” وملأ الجزء الأكبر من الرواية، حيث رصد تطورات الشيخ الأكبر النفسية والجسدية، منذ ولادته في مرسية في عهد الموحدين، ومن ثم تنقلاته المتعددة في مدن هذا العالم، قبل سقوط بغداد على يد التتار، ووصولاً إلى وفاته في دمشق عن عمر ناهز 70 سنة.
كما تحوي الرواية إلى جانب الأسفار عنوانًا رئيسيًا آخر موازيًا يتكرر فيه ذكر المخطوط والمدينة التي استقر فيها والسنة التي وقع فيها الحدث.
“كل بقاء يكون بعده فناء لا يعوّل عليه”
ويرى النقاد أن علوان قد صيّر ابن عربي شخصية روائية، وجعل لغته في “موت صغير” متداخلة بنثر ابن عربي، مبتعدة عن التهويمات والمبالغات التي يمكن لها أن تكون محط غواية عندما نتطرق إلى الحديث عن رمز صوفي، لكن لا ينفصل السرد عن التاريخ، وتلك القلاقل والفتن والحروب التي شهدتها حياة الشيخ الأكبر منذ الولادة في مرسية (الأندلس).
كما أنه لم يقدم الشيخ الأكبر في سياق الأسطورة، بل ألبسه رداء الإنسانية الخالصة البعيدة كل البُعد عن القداسة، وابتعد بالقارئ عن إشكاليات الانغماس في فكر ابن عربي وأرائه – اللهم إلا التي أتت في سياق الأحداث والسرد – ودون الغوص في عرض ما اعتبره الفقهاء زندقة وشطحات وتجديف.
ورغم أن هذه الرواية، تُعد الأولى التي تتناول عن قرب سيرة رمز من رموز الصوفية، فإن الأعمال الأدبية التي يُمكن تصنيفها كأدب صوفي، متعددة في الأدب العربي، وفي هذا التقرير، نتناول الحديث عن بعض الأعمال الأدبية الأخرى التي تميزت بطابع روحاني وصوفي، بعدما تسبب فوز “موت صغير” في جلب الضوء إلى هذا الصنف من الأدب.
قواعد العشق الأربعون

رواية “قواعد العشق الأربعون” للتركية إليف شافاق
“حياتك حافلة، مليئة، كاملة، أو هكذا يخيل إليك، حتى يظهر فيها شخص يجعلك تدرك ما كنت تفتقده طول هذا الوقت، مثل مرآة تعكس الغائب لا الحاضر، تريك الفراغ فى روحك، الفراغ الذي كنت تقاوم رؤيته”
واحدة من أكثر الروايات انتشارًا، تتمحور حول ثلاث حكايات، وفي خطين زمنين مختلفين تفصلهم ثمانية قرون تقريبًا.
الخط الزمنى الأول يُمثل الأحداث التي تمر بها “إيلا”، السيدة الأمريكية التي تقترب من الأربعين، وتعيش حياة رتيبة عادية، زوجها طبيب الأسنان الناجح، وأبنائها، أما الخط الزمني الثاني فيقع في القرن الثالث عشر، حيث قصة اللقاء العجيب بين الشيخ “جلال الدين الروميّ” والصوفيّ “شمس الدين التبريزى”، وما تبع ذلك من أحداث عاصفة انتهت بمقتل التبريزي وتحول الرومي إلى أهم شاعر صوفي في تاريخ الإسلام، ثم تتقاطع الأزمنة، فحول “شمس التبريزي” حياة “إيلا” إلى الأبد، لتتحول من مجرد امرأة عادية خاملة، إلى عاشقة مجنونة تضحي بكل شيء فى سبيل الحب.
ورغم أن الرواية تبدو وكأنها تدور حول “جلال الدين الرومي” فإنها تحكي رحلة “شمس التبريزي” التي تمتد من سمرقند وبغداد، إلى قونية التركية، مرورًا بدمشق، ليلقي حتفه في قونية، على يد قاتل مأجور بعد أن أكمل رسالته التى خُلق من أجلها، وهي البحث عن الله ومعرفته، ونقل حكمته التي جمعها من رحلاته حول العالم إلى الشخص المناسب “جلال الدين الرومي”.
“ما لم نتعلّم كيف نحبّ خلق الله، فلن تستطيع أن نحبّ حقًا ولن نعرف الله حقًا”
فشمس الدين التبريزي مؤسس “قواعد العشق الأربعون” استطاع أن يغير شخصية صوفية كجلال الدين الرومي ليصبح شاعرًا، حيث تحول جلال الدين الرومي الفقيه الخطيب المفوه، الذي استحوذ على مشاعر الناس في القرن الثالث عشر – قرن الصراعات الدينية والطائفية -، إلى داعية عشق صوفي لا نظير له، فخرج من لباسه الديني الثقيل، إلى ردائه العادي ليدعو إلى وحدة الأديان وتفضيل العشق الإلهي على غيره من متع الحياة.
الرواية من تأليف الروائية التركية “إليف شافاق”، وصدرت طبعتها الأولى باللغة التركية عام 2009، ونشرتها دار “طوى” في ترجمة عربية عام 2012.
شجرة العابد

رواية “شجرة العابد” للروائي عمار علي حسن
“كل شوق يسكن باللقاء لا يعول عليه”
تدور أحداث هذه الرواية التي يرى البعض أنها تُشبه روايات الواقعية السحرية المعروفة في الأدب اللاتيني، في حين يراها البعض الآخر رواية صوفية، في أواخر القرن الخامس عشر في عصر المماليك، في لحظة فارقة من الصراع بين الشرق والغرب.
بطلة الرواية المتفردة، شجرة عجيبة مقدسة، يتطلع الجميع إليها على اختلاف مقاصدهم، فهناك من يراها تعبير عن الذات الإلهية، وهناك من يعتقد أنها جنة المأوى، ويوجد من يتصور أن الشجرة هي الحقيقة المطلقة التي يعجز أغلب الناس عن بلوغها ولا يصل إليها إلا من يصل إلى أعلى نقطة في التماهي بالحقائق السرمدية، وهناك من يعتقد أن هذه الشجرة كنز ثمين من الجواهر عليه أن يغتنمه، مثلما أراد السلطان المملوكي الذي جاء بالسحرة والدراويش ليساعدوه على بلوغ الشجرة، وكذلك شيوخ القبائل البدوية الذين توارثوا أسطورة الشجرة أبًا عن جد، واعتقد البعض الآخر أن في الشجرة ترياق يشفي الأمراض المستعصية، مثل حاكم منفلوط، الذي بذل كل جهد مستطاع في الوصول إلى الشجرة لينقذ ابنته من مرض عضال.
أما مُحرك أحداث الرواية، فهو “عاكف” طالب العلم الأزهرِيّ، الذي سعى في شبابه إلى الثورة على السلطان المملوكي الجائر فانتهى به الحال إلى درب التصوف هربًا من العسس والسجن والتعذيب ومن ثم الشنق الذي ينتظره.
“آه يا حفصة، آه يا وجعي الجميل، استدار الزمن، وتسربت الأيام من بين أصابعي، أنت مستريحة الآن في الملكوت الأعلى، وأنا معذب بالانتظار، أروض النسيان، لكنه يأكل روحي بلا هوادة، ما يزيد على مئة عام وهيئتي على حالها، كأنني لا أزال أدب وراء شيخي القناوي في شوارع المحروسة منتظرًا لحظة الانقضاض على السلطان الجائر، تعاقب السلاطين، وغارت أمامي كل حالات التمرد، واحدة بقيت مشتعلة طيلة الوقت، إنها محاولة الانتصار على نفسي، ألم تبوحي بذلك ذات يوم يا حفصة؟ ألم تطلبي هذا وأنا أقول لك: أنت شيخي وأنا مريدك”
في أيامه الأولى، عشقت عاكف جنية فاتنة، واستخدمته كي تصل إلى غرض ملكهم الذي يسعى للاستحواذ على الشجرة الغريبة المقدسة، بينما اتكل هو عليها في تصريف أموره، فحسبه الناس شيخ طريقة صوفية ومن أهل الولاية، لكن أرملة جميلة، مات عنها زوجها في قتال الفرنجة عند جزيرة قبرص، علمته كيف يكتشف الطاقة الكامنة بين جوانحه، فوصل إلى ما أراد بالمصالحة بين العقل والروح، خاصة حين اختلى إلى نفسه سنوات طويلة في زاوية صغيرة بناها إلى جانب أحد أديرة الأقباط بصحراء مصر الشرقية ليس معه فيها، إلا كتابين “القرآن الكريم” و”طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي”.
فروض نفسه وشهواتها، وعلا فوق التفاصيل الصغيرة والمواقف العابرة، وتوغل في سبر أغوار ذاته حتى وصل إلى قاعها، فاكتشف أن داخله طاقة جبارة وقدرة لا ترد على صناعة المعجزات، هذه القدرة لم يمتلكها وهو يصاحب الجنية التي عشقته، وأخذته معها إلى دنياها، برغم ما للجان من قدرات خارقة.
الرواية من تأليف الدكتور عمار علي حسن، وصدرت طبعتها الأولى في عام 2011، ثم توالت الطبعات تباعًا.
مَم وزين
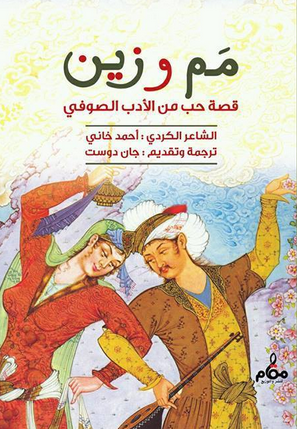
غلاف رواية “مم و زين”
“في كُل قِصّة حِصة من الغُصّة والألم، وفي كُل مَثل لو تعرفون حِكمة وموعظة
لكن غرضه من كُل هذا الكلام والحديث، وقصده من هذا السَعي
هو إظهار جمَال العِشق، وإثبات كَماله”.
ملحمة عشق كردية كتبها الشاعر أحمد الخاني الذي ولد عام 1641م – ويقال في عام 1650 – في بلدة “بايزيد” كردستان تركيا، وأحمد الخاني واحد من أعظم الأدباء والشعراء الأكراد، كان إمامًا ومدرسًا في مسجد بايزيد وكاتبًا في ديوان الأمير محمد، ويتحدث العربيّة والفارسية والتركية والكُردية، سافر كثيرًا وزار دمشق ومصر، وهو أول من ابتدع الشعر القصصي في الأدب العربي، وكان مولعًا بالفنون المختلفة، بالإضافة إلى نزعته الفلسفية الصوفية وأفكاره عن التدلّه في محبّة الله، والعشق الدُنيوي والسماوي، والتي تجلّت في معظم أشعاره وما تركه من آثار، كتب معظمها بالكردية، وبعضها بالعربية والفارسية والتركية، وتوفي “الخاني” عام 1706 م، ويقال إنه “طار إلى ربه” كما كُتب على شاهد قبره في بايزيد، قبل ذلك في عام 1685م.
“حسبك طيشًا أيها القلب، وكفاك ابتعادًا وتوغلاً في المجاهل منفردًا عن قبس روحك وسراجها، فإن الطريق أمامك، ويحك، مظلمة، والهدف أمامك بعيد.
إنها، ويحك، روحك! روحك التي هي جزء منك، أيها القلب عد، عد لا تخدعنك مفاتن الغرور والأصداغ، ولا تصدقن شيئًا من ابتسامات الثغور والشفاه، ولا يأخذنك سحر العيون النجل، أو يجذبنك إشراق الوجوه بين ظلمة الشعور الملتوية.
فكل هذا الذي يتألق في عينيك نوره إنما هو نار وجمر، سرعان ما يتوقد عليك لهيبًا وتهلك في لظاه”.
وقصة “مم وزين” قصة شعبية كردية، لها مكانة في التراث الأدبي كألف ليلة وليلة وملحمة جِلجامش والشاهنامة، وأخذ الخاني القصة الأصلية، ورواها بطريقته الشعرية، مسبغًا عليها صبغة فلسفية وصوفية.
وتحكي الملحمة الشعبية عن قصة عشق بين “مم” ابن كاتب ديوان الأمير و”زين” أخت أمير إمارة بوتان، وكيف استطاع أحد الخبثاء والذي يعمل حاجبًا لدى الأمير، من أن يوغل صدره تجاه “تاجدين” قائد إحدى القوات الخاصة في جيش الأمير، وتجاه صديقه المقرب “مم”، فأقسم الأمير ألا يُزوج “مم” من “زين” أبدًا.
لتتجلى المآسي وتبدأ رحلة عذاب العاشقين، اللذين حُرما من بعضهما البعض، ويغالي “بكر” في المكائد لـ”مم”، حتى يتم سجنه في أحد أبراج القلعة، وخلال عام كامل، يخلو الحبيبان إلى الله، “مَم” في سجنه/ صومعته، و”زين” في غرفتها، مُتضّرعين إليه آملين أن يجمعهما من بعد الشتات، فيتحوّل الحُب الدنيوي في قلبيهما رويدًا رويدًا، إلى حُب سماوي ينتظر الجنّة، السبيل الوحيد للتلاقي والاجتماع.
التـبـر
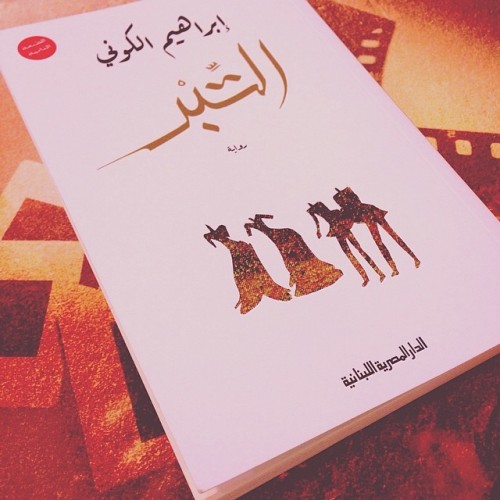
غلاف رواية “التبر” للأديب الليبي إبراهيم الكوني
“لا تودع قلبك في مكان غير السماء”
ترتكز رواية التبر على موضوعين أثيرين لدى الأديب الليبي إبراهيم الكوني، ألا وهما الخطيئة والحرية، وإن كانت الخطيئة في هذه الرواية، لا تعني الإثم الجنسي بين الذكر والأنثى، بل تتخطاه إلى المعنى الصوفي للخطيئة حيث ارتهان قلب الإنسان بالدنيا وتعلقه بها، سواء كان هذا التعلق حب الأب أو الابن أو الزوج أو حب الزعامة وجمع المال.
والصحراء عند إبراهيم الكوني هي الأصل ونقطة الارتكاز وبؤرة الانبعاث والتجدد والاستمرار، بل هي رمز القداسة، في مقابل “التبر” ذلك الرمز المادي الذي يطغى على الإنسان ويجبره على الانحناء والتخلِّي عن الارتقاء.
وتدور الرواية حول “أوخيد” ابن شيخ القبيلة، المتعلق بمهريّه الأبلق، الذي يصيبه الجرب بسبب تردده على النوق، ليلجأ أوخيد إلى الشيخ موسى، آملا في أن يجد عنده دواءً لمهريّه، فينصحه بعشبة “آسيار” من “قرعات ميمون”، هذا المكان الذي يُنهى عن الذهاب إليه لأن أعشابه تصيب بالجنون.
وأمام حالة الأبلق المزرية، لا يطيق أوخيِّد صبرًا، ويضطر إلى ركوب المصاعب، ويذهب هو ومهريَّة، إلى قرعات ميمون، فيتذوقا طعم الموت، حتى توهب لهما الحياة من جديد.
“يا ربي: هل من الضروري أن يمرَّ الشفاء عبر الجحيم؟ هل يعدم الخلاص إلا في أقصى الألم؟ هل ثمن الإثم فادح إلى هذا الحد؟”
ثم يتزوج “أوخيد” من الحسناء “أيور” دون موافقة أبيه، وبعد أن تنجب له ولدين، يبدأ الدين والفقر في دق عنقه، فيرهن حيوانه الأثير لابن عم زوجته في مقابل جَمل يسد به رمق أطفاله، فيعفيه ابن عم زوجته من الدين، مقابل أن يُطلق “أيور”، فيطلقها في مقابل “المهريّ الأبلق” وفوقه كيس من التبر، ليشاع في الصحراء أن “أوخيد” طلق زوجته بكيس من التبر، فيعود أوخيد ويقتل ابن عم زوجته، ويعتزل الناس ويتخلى عن الولد والتبر والقبيلة، في محاولة للانعتاق والطهارة.
لتنتهي الرواية باستسلام أوخيد للثأر منه وتقطيع أوصاله محققًا نصيحة الشيخ موسى، رغبة في الانعتاق والتحرر من الدنس والخطيئة.