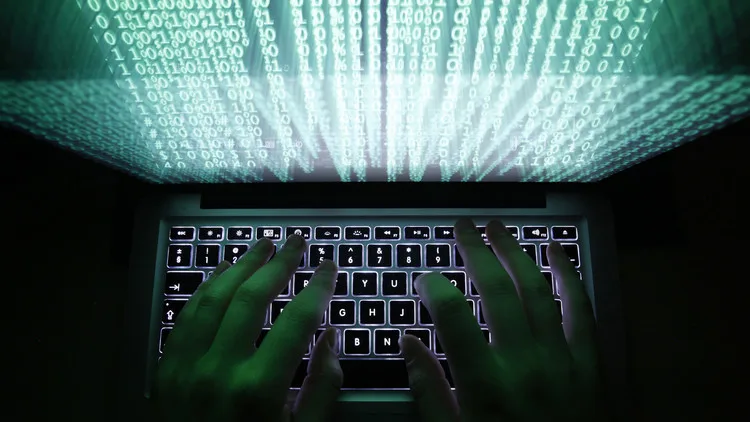يرى العطاس أن الإنسان في هذا العصر مبتلع بنظرة مُعلمنة للوجود، سببتها سلسلة طويلة من الأفكار المتراكمة والمتعاقبة في الفكر الغربي، والتي تعاضدت مع بعضها البعض لتعيد تعريف الواقع والمعرفة والعالم وفق رؤية علمانية للوجود.
وحاول العطاس أن يستعرض من خلال كتابه “مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية” السيرورة التاريخية للعلمنة، وكيف ابتلعت المسيحية ضمنها، وكيف أعاد رجال الدين تعريف المسيحية بصيغ تحديثية معلمنة تناسب الواقع المعلمن.
ينتقل العطاس محاولًا تشخيص المشكلات الكبرى التي تواجه المجتمعات المسلمة اليوم وتعيق إمكانية وصولهم للفهم الحقيقي للوجود، كما يريده الإسلام، ولذا فالمشروع المقابل للعلمنة الذي يقترحه هو “الأسلمة” والذي يعرفه بوصفه عملية تحرير للإنسان من رؤيتين الرؤى الأساطيرية وكذلك الرؤى المعلمنة للوجود
والعلمنة عند العطاس ليست رؤية فلسفية محصورة في الغرب والمسيحية، بل رؤية كونية تهيمن على إنسان اليوم، حتى المسلمين أنفسهم، أفراد ومجتمعات، تجرد الكون من أي قداسة وتحول بين الإنسان وطبيعته الفطرية.
وينتقل العطاس محاولًا تشخيص المشكلات الكبرى التي تواجه المجتمعات المسلمة اليوم وتعيق إمكانية وصولهم للفهم الحقيقي للوجود، كما يريده الإسلام، ولذا فالمشروع المقابل للعلمنة الذي يقترحه هو “الأسلمة” والذي يعرفه بوصفه عملية تحرير للإنسان من رؤيتين الرؤى الأساطيرية وكذلك الرؤى المعلمنة للوجود.
ولا تنتهي مداخلات العطاس عند هذا الحد، بل يقدم دراسة حالة Case study كنموذج عملي مطبق على مشروع الأسلمة وهو مشروع الأرخبيل الملايوي الإندونيسي.
ويمكن أن ندرك عمق ونباهة العطاس جيدًا إذا ما عرفنا أن هذه التحليلات وهذه التشخيصات كان قد قدمها منذ ما يقرب الـ40 سنة متنبئًا ومستشرفًا واقعًا نحن نحياه اليوم يطابق إلى حد بعيد ما كان قد سبق وأن ذكره من قبل.
وسنقتصر في الجزء الأول من هذه المقالة على محورين رئيسيين هما: الجذور التاريخية للفكر الغربي المسيحي، ومفهومي العلمنة والعلمانية، ثم نعالج في الجزء الثاني من المقال، مفهوم الأسلمة، والمأزق الإسلامي.
الجذور التاريخية للفكر الغربي المسيحي
“إننا بدلًا من أن ندخل العالم في المسيحية، نريد أن ندخل المسيحية في العالم” – ماسكال، علمنة المسيحية
مر الفكر الغربي والمسيحية، بعدد من المحطات التاريخية الفارقة، والتي تلاحقت مسببة أزمة حادة للفكر الغربي والدين المسيحي، كانت ناجمة عن خوض تجربة العيش في الحضارة المدينية والحضرية، والتي بدورها أعادت فهم الواقع وتأويل الحياة.
وتشمل هذه المراحل:
– حركة الإصلاح الديني البروتستانتي
– عصر النهضة الأوروبية Renaissance
– عصر التنوير الأوروبي Enlightenment
– صعود النزعة العقلانية والتجريبية
– التقدم العلمي والتقني
ودعمت هذه المراحل تكوين فكر غربي جديد قائم على نظرة جديدة للوجود، تجرد الواقع، وتنتزع القداسة من الكون، وتعالج الدين كظاهرة طبيعية وتخضعه للدراسة والتفكيك.
وتجلى ذلك على عدد من المستويات، ففي القرنين الخامس والسادس عشر وإبان ما عرف بعصر النهضة، رفض الإنسان الغربي ما كان ينتمي إلى العصور الوسطى، فأخذوا يكتشفون الكون والإنسان، بأدوات جديدة لصالح التفسير العلمي الجديد بدلًا من التفسيرات الدينية والميتافيزيقية.
وكانت ثورة ديكارت في القرن السابع عشر خطيرة من حيث آثارها في ترسيخ العلمانية على مستوى تطور العلوم في الغرب، فهي التي أقامت ثنائية دائمة بين الجسد والروح بصورة جعلت الطبيعة مطواعة لعلم ذي نزعة علمانية، ثم كان أن جاء الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، فنظر إلى الميتافيزيقيا بوصفها دليلًا غير ضروري وخادع في البحث عن الحقيقة، وأن الحقائق الروحية والميتافيزيقية لا يمكن إدراكها وإثباتها لأنه لا يمكن الجزم بها.
وعلى المستوى الفلسفي الاجتماعي رسم أوغست كونت صورة لصعود العلم وتراجع الدين وانحداره، وفقًا لمنطق التقدم الذي صاغه، والذي يرى أن المجتمع الإنساني يتطور ويتقدم من البدائية والتخلف إلى التقدم والحداثة، واستحضار الغيب والتفسير الغيبي ما هو إلا تصرف بدائي ومجرد حلقة في المسلسل التطوري من التفكير الأساطيري إلى التفكير العلمي.
ما حدث للمسيحية من علمنة، لم يكن سببه – وفق العطاس – سيرورة الفكر الغربي أو عوامل خارجية فحسب، وإنما مجموعة خصائص داخلية في بنية الفكر المسيحي والتي شكلت ثغور مهدت للعلمنة اختراقها وابتلاعها
وعلى المستوى النفسي، قدم سيجموند فرويد كتابه “مستقبل وهم” والذي أعلى فيه من سلطة العقل وحجته وأقصى أي إمكان معرفي آخر، وتحديدًا الدين والمعرفة الدينية، مخضعًا إياه للتحليل النفسي، واختلطت صيحات فلسفية وثقافية متتابعة تعلن موت الإله من جهة وموت المسيحية واندثارها إلى الأبد من جهةٍ أخرى.
وكل ما سبق بالطبع على سبيل المثال لا الحصر، فالمنتج الفلسفي والأدبي والعلمي الكثيف والمتداعي، كان يعزر العلمنة في الوقت الذي يستقي رؤيته منه، فهي حلقة دائرية تفضي إلى بعضها.
ولكن ما حدث للمسيحية من علمنة، لم يكن سببه – وفق العطاس – سيرورة الفكر الغربي أو عوامل خارجية فحسب، وإنما مجموعة خصائص داخلية في بنية الفكر المسيحي والتي شكلت ثغور مهدت للعلمنة اختراقها وابتلاعها وجعلت الدين المسيحي قابلاً للعلمنة.
ويمكن إجمال هذه العوامل الداخلية بالآتي:
- مشكلة الألوهية
- الفلسفة الهيلينية
- التأويل المتغير للدين
إن مفهوم الإله بالفكر الغربي والمسيحي قد قام على أساس خليط من التصورات المتباينة والتي جرى دمجها في كيان واحد غامض، وهذه التصورات هي:
المقدس (Theos) في الفلسفة الإغريقية، ويهوه (Yahweh) إله العبرانيين، ومفهوم الإله (Deus) في الفكر الميتافيزيقي الأوربي وعدد من الآلهة التي تحفل بها التقاليد الجرمانية ما قبل المسيحية.
وكذلك فإن وضع المسيحية في قوالب الفلسفة الهيلينية هو المسؤول عن تصور المسيحيين للإله على أنه شخص ذو عقل خارق، وشكلت نظرية بارمنيدس عن الحقيقة¹ شكل قاعدة الفكر المتمحور حول ميتافيزيقا الوجود عند توما الإكويني، والذي سيدخل بدوره الكاثوليكية في دوامة الثورة على الأفكار الدينية المسيحية.
وأجرى علماء الدين المسيحي على الدوام تأويلاً متعددًا للمسيحية، قائم على النسبية، وأنهم على الدوام قادرون على صياغة جديدة للدين، تتغير وتتبد وتحل كل صيغة محل الأخرى، حسب متطلبات التغيرات الاجتماعية.
وهذه النسبية تجعل المؤمن حرًا في تبني أي فكرة تناسبه عن “الله” وفق هواه، بحيث يتواءم إيمان الشخص مع التجربة المعاصرة التي يعايشها، وفي إطار هذا الاعتقاد المتبدل والمستمر بالتحول، يمكن أن نفهم ما ردده الفيلسوف المسيحي الدنماركي، من خلال تجربته الوجودية: “إننا نصير مسيحيين باستمرار”.
لكن العطاس رغم كل هذا يشير، إلى أن المسيحية الأصيلة كانت قد حاربت العلمنة وحاولت مقاومتها، فهو يرى أنه لا جذور للعلمنة في العقيدة المسيحية الأصيلة، لكنها اخترقت بسبب تأويلات رجال الدين لها، وتحريفهم النصوص، وتبنيهم الأفكار الفلسفية، بوصفها عقائد دينية.
ولما فشلت المسيحية في احتواء تيار العلمنة، بدأ رجال الدين من أصحاب الاتجاه التحديثي، يدعون المسيحيين للانضمام إلى هذا التيار، بل وأكدوا أن انتهاء العالم إلى العلمانية، له جذوره في الكتاب المقدس، فكانت محاولات من الداخل لإنقاذ المسيحية من مأزقها، لكنها كانت في الحقيقة عملية هدم ذاتي وتآكل داخلي، بل وأكثر من هذا، فحتى أولئك المسيحيين الذين كانوا يظنون أنهم يحاربون العلمنة، كانوا في الحقيقة دون وعي شركاء في تعزيزها وهو ما أسماه الفيلسوف المسيحي جاك ماريتان بـ”الردة المستحكمة”.
مفهوما العلمنة والعلمانية
“في العلمنة، الأمر أشبه بأن يدير الإنسان ظهره لعالم الغيب وما وراء الطبيعة، ويولي وجهه شطر هذا العالم this World وأن يحصر نفسه في الزمن الحاضر this Time” – سيد محمد نقيب العطاس، بتصرف.
ترجع لفظة “علماني” Secular إلى الكلمة اللاتينية saeculum وهي تعبر عن دلالة مزدوجة تتعلق بالزمان والمكان، فالزمان يشير إلى “الآن” والمكان يشير “هذا العالم”، وبالتالي فهي تشير بمجملها إلى ما معناه “العصر الحاضر”.
لكن يميز العطاس بين “العلمنة” و”العلمانية”، ويرفض الخلط بينهما، ويؤكد أن نقده في مداخلاته الفلسفية متجه بصورة رئيسية للعلمنة بوصفها الأخطر ولأنها لا تقتصر على الجوانب السياسية والاجتماعية فحسب كما “العلمانية”، وإنما لأنها تخترق المجال الخاص وعقول لأفراد والمجتمعات وتصك لهم معرفة ثقافية تحدد رؤيتهم لذواتهم وللوجود.
“العلمانية” عند العطاس، تمثل منظومة إيديولوجية، تسعى لفصل أي مرجعية دينية عن الأمور الدنيوية، كما في السياسة والمجتمع، لكنها لا تمتهن مسألة القيم بشكل مطلق، إذ إنها تقدم نسق قيمها الخاص ساعية إلى جعل القيم كلها نسبية، وتقدم الانفتاح والحرية كقيم ضرورية للفعل الإنساني وحركة التاريخ، ولذا فهي في الغالب تتحول لإطار إيديولوجي للدولة ورؤية مغلقة وهذا ما يجعلها تفترق عن العلمنة، التي ترفض الرؤى المغلقة للوجود.
وتعني “العلمنة” تحرير الإنسان من النظرة الدينية أولًا، ومن النظرة الميتافيزيقية ثانيًا، على عقله ولغته وموقفه حيال الوجود، ونبذ جميع الرؤى الكونية المغلقة وتحطيم أي تفسير غيبي للوجود، وتخليص التاريخ من الحتميات والقدريات، وهي عملية تاريخية، ومسار لا نهاية له ولا حدود، والإطار الذي تحدث فيه العلمنة هو الحضارة المدينية، حيث المجتمع ليس تجمعًا بسيطًا وبدائيًا وفق روابط مشتركة، وإنما مجتمع جماهيري مركب وعمراني ضخم.
أما دلالات العلمنة فيمكن إجمالها بالآتي:
– زوال وظيفة الدين في تحديد الرؤى الكونية والجوانب الثقافية للمجتمع.
– حصر الدين في مجال ضيق ومحصور جدًا بحيث لا يكون له أي أثر في المجال الاجتماعي والسياسي.
– العلمنة، مسار تاريخي لا راد له، يتحرر بمقتضاه المجتمع والثقافة من وصاية الدين والأنساق الميتافيزيقية المغلقة.
– التاريخ ليس إلا سيرورة لتحقق العلمنة، والعلمنة تطور تحرري، وثمرتها النهائية النسبية التاريخية.
وأما أبعاد العلمنة، فهي:
– نزع القداسة عن الكون والوجود.
– نزع القداسة عن القيم والأخلاق.
– تجريد السياسة من القداسة.
– تعريف الدين بوصفه ظاهرة تاريخية.
ويعني نزع القداسة عن الكون والوجود²: تجريد الطبيعة والكون من مغزاه الروحي واعتباره مجرد شيء مادي خالٍ من أي معنى علوي قدسي، وتجريد الوجود من الإحالات الدينية الزائدة.
وأما نزع القداسة عن القيم، فيعني: أن ينظر إلى كل إنتاج ثقافي وكل منظومة قيم على أنها أمور مؤقتة ونسبية و وليدة ظرفها التاريخي وشرطها الاجتماعي، وعليه فهي جميعها أمور لا ينبغي التمسك بها أو تطبيقها أو تعميمها.
ويقصد بتجريد السياسية من القداسة، إلغاء أي أساس أو مرجعية مقدسة في النفوذ السياسي والتشريعي ونظام السلطة، وإقصاء أي حكم سياسي ذي توجه ديني أو مرجعية دينية.
وفي السياق التاريخي الذي سبق ذكره، فإذا كانت كلمة النهضة تعني حرفيًا “الولادة” فإن التنوير يعني أن الإنسان الغربي قد “بلغ رشده” وتجاوز مرحلة الطفولة، تلك التي كان عقله يعتمد فيها على التفسير الغيبي وطلب العون من قوى ما ورائية، ودخل مرحلة الرشد والنضج وأصبح قادرًا على القيادة وتولي أموره بنفسه.
وفي الجزء الثاني تتمة المداخلات الفلسفية، وفيها حديث عن الأسلمة والمأزق الإسلامي والمشكلات الكبرى التي تواجه المجتمع المسلم.
عن الكتاب والكاتب
مؤلف الكتاب هو سيد محمد نقيب العطاس، ولد في إندونيسيا سنة 1931، فيلسوف ومفكر إسلامي حصل على الماجستير في الفلسفة الإسلامية من جامعة ماكغيل الكندية، وهناك تعرف على عدد من المفكرين منهم المستشرقين، مثل فلفرد كانتويل سميث وهاملتون جب، والمفكر الباكستاني فضل الرحمن، والإيراني سيد حسين نصر، والفلسطيني إسماعيل راجي الفاروقي، والياباني توشيهيكو إزوتسو.
ثم حصل على الدكتوراة في الفلسفة الإسلامية والتصوف، من جامعة لندن، بتشجيع من المستشرق الشهير ومترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية الأستاذ أرنولد أربري. وقد أسس الأستاذ العطاس المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية ISTAC في كوالاملبور.
صدرت الطبعة الأولى للكتاب عام 1978م وجاءت ترجمته للعربية متأخرة سنة 2000 – وهو مما استهجنه العطاس نفسه – بعدما سبقتها ترجمات للغات عالمية أخرى، حيث كانت الترجمة العربية رغم تأخرها، ترجمة بديعة، قام بها الأستاذ محمد طاهر الميساوي، ونشره المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية.