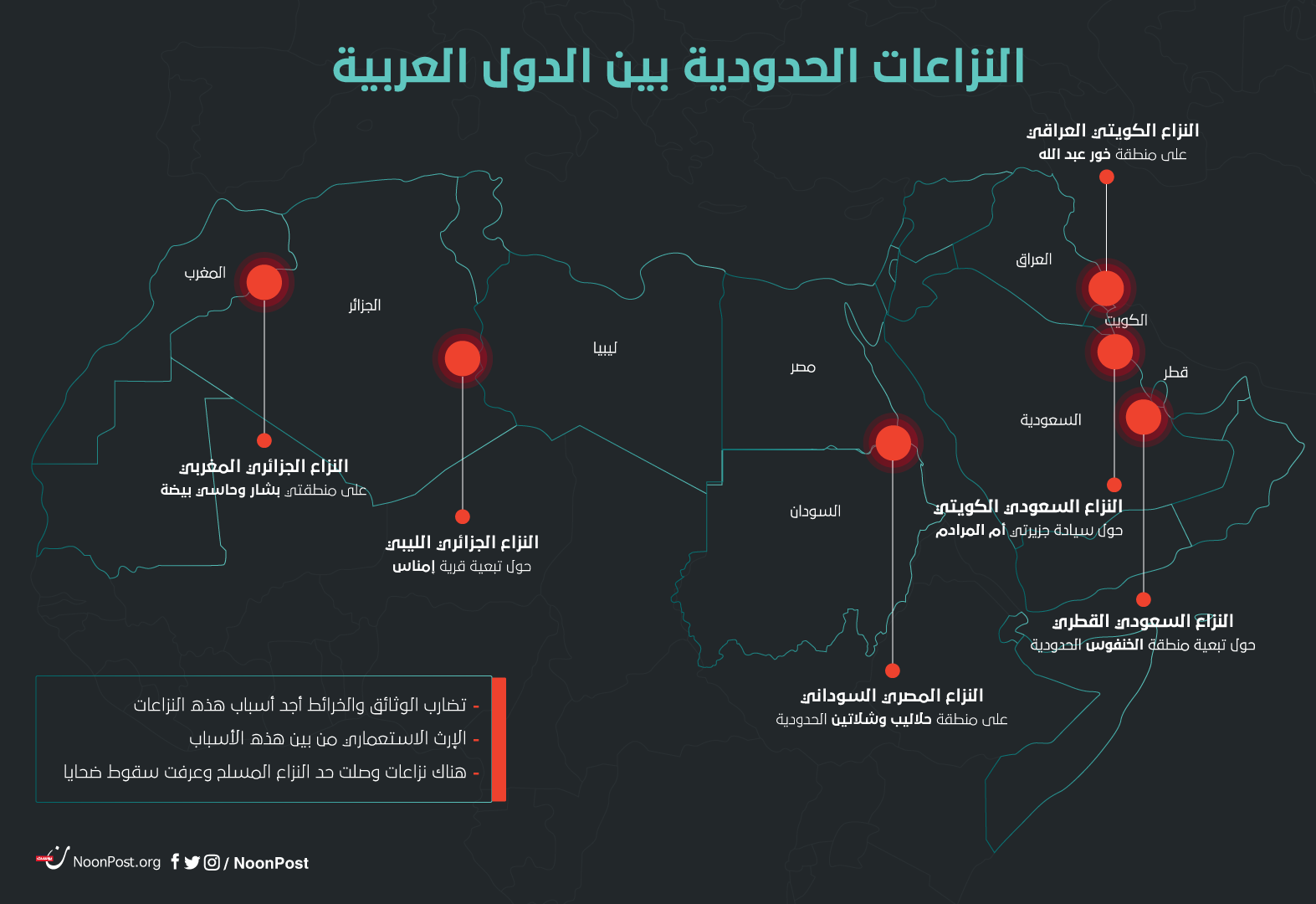اعتمدت الولايات المتحدة في السابق، وتحديدًا في سبعينيات القرن العشرين، على سياسة الدعامة المزدوجة والتي قامت بالأساس حينها على كل من إيران (زمن الشاه) والسعودية وذلك من أجل إبقاء الاتحاد السوفيتي وحلفائه الإقليميين بعيدًا عن الهيمنة على مياه الخليج.
فبعيد انسحاب الأسطول البريطاني من مياه الخليج بداية السبعينيات، تشكل واقع إقليمي جديد، فلأول مرة منذ قرنين تخلو مياه الخليج من الوجود الفعلي لأحدى الدول العظمى.
أخذت الخطوة البريطانية، الولايات المتحدة على حين غرة، فلم تكن واشنطن في وضعية تسمح لها بملء الفراغ الناتج عن الانسحاب البريطاني من الخليج، وذلك نظرًا لانخراطها الواسع في الحرب الفيتنامية، ولذلك قامت، وبهدف الإبقاء على منطقة الخليج خالية من النفوذ السوفيتي، بالاعتماد على كل من حليفتيها إيران والسعودية للاضطلاع بهذا الدور من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية خصوصًا الجانب العسكري.
وقع العبء الأكبر على كاهل إيران نظرًا لما كانت تتمتع به من تفوق نوعي على السعودية من ناحية الحجم، والموقع الجغرافي المطل على مضيق هرمز.
ظهرت الأهمية الاستراتيجية لإيران من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي نيكسون إلى طهران في مايو/أيار 1972 ومقابلته للشاه، حيث خاطبه بشكل مباشر وقال: “احمني”، وافق نيكسون على صفقات سلاح غير مسبوقة لإيران، فقد تم ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الموافقة على بيع إيران جميع أنواع الأسلحة غير النووية، وهو امتياز لم يكن قد حصل عليه حينها غير “إسرائيل”.
بعد أزمة النفط عام 1973 تعزز دور إيران، حيث ساهم تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية على إثر استخدام سلاح النفط في الحرب ضد “إسرائيل”، وما نتج عن ذلك من ارتفاع كبير في أسعار النفط، في دفع إيران لتأخذ دورًا إقليمًا أكثر فاعلية، وتصبح بلا منازع شرطي الولايات المتحدة في الخليج.
ومع ذلك فقد اتخذت إيران مواقف تصالحية مع جيرانها العرب ولم تسع للتصعيد، كان الشاه يدرك أن مكانة إيران الإقليمية لا يمكن أن تتحقق من غير التقارب مع العرب، ولذلك قامت إيران بالكف عن دعم المتمردين الأكراد في شمال العراق، والتوصل مع نظام بغداد إلى اتفاقية الجزائر التي على إثرها تم تطبيع العلاقات بين البلدين بعد تاريخ طويل من الصراع على “شط العرب”، كما وقفت إيران مع العرب ضد “إسرائيل”، وطالبتها بشكل صريح بضرورة الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام1967، وصوتت في الأمم المتحدة لصالح اعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، وأصبحت تطفو على السطح العلاقة الشخصية القوية التي جمعت كل من الرئيس المصري أنور السادات وشاه إيران محمد رضا بهلوي.
في الوقت الحالي، يبدو أن إدارة ترامب تعود إلى المنطقة بذات المنطق من خلال التبني مجددًا لسياسة الدعامة المزدوجة، ولكن هذه المرة بالاعتماد على دولتي الإمارات والسعودية، حيث استضافت الرياض القمة الأمريكية العربية التي ألقى فيها الرئيس ترامب خطابه الشهير الذي عبر فيه ضمنًا عن محورية السعودية في الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى محاربة الإرهاب والنفوذ الإيراني في المنطقة من خلال إنشاء تحالف يضم بعض الدول العربية و”إسرائيل”، وفي هذا السياق فقد وقع الرئيس ترامب على “اتفاقية القرن” التي تضمت صفقات أسلحة بين الرياض وواشنطن بقيمة 110 مليارات دولار.
وقد بعثت زيارة ترامب، وأجندتها خصوصًا فيما يتعلق بملف النفوذ الإيراني، و”أزمة التطرف الإسلامي” برسائل واضحة إلى مدى النفوذ الذي وصلت إليه كل من الرياض وأبو ظبي داخل الإدارة الأمريكية، فقد أصبح وأضحًا أن هناك علاقة شخصية قوية بدأت تتشكل بين كل من ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (الذي يتم تجهيزه لخلافة والده على عرش السعودية) وصهر الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر الذي وصفه سلمان أنصاري، مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية، بأنه (أي كوشنر) “سكرتير كل شيء”.
أما أبو ظبي ومن خلال سفيرها الأكثر نشاطًا في الولايات المتحدة يوسف العتيبة قد ضمنت لنفسها مكانًا متقدمًا في عملية التأثير على البيت الأبيض، فبالإضافة إلى علاقة السفير بكوشنر أيضًا، فإنه ينشط داخل دوائر اللوبي اليهودي في واشنطن من خلال استخدام مؤسسات التأثير مثل “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” التي تم تأسيسها بعيد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتصنف على أنها قريبة من تيار المحافظين الجدد في حميلة التأثير على توجهات إدارة ترامب الشرق أوسطية.
ووفق الأجندة السعودية الإماراتية فإن سياسة الدعامة المزدوجة الجديدة سوف تقود إلى تسعير الجبهات ضد تيارين هما: التيار الإيراني وإشكالية نفوذه في المنطقة، وتيار الثورات العربية والإسلام السياسي، وهذا يعني أن مستوى التوتر في الإقليم سوف يشهد تزايدًا ملحوظًا، وستشمل بؤر الصراع ساحة أوسع مما هي عليه الآن، فكل من السعودية والامارات ترى أن نفوذها في المنطقة بشكل خاص، أو في الفضاء الإسلامي بشكل عام لا بدّ أن يمر من خلال إخضاع هذين التيارين تمامًا.
فعلى الجبهة الإيرانية ربما تعمد الولايات المتحدة مرحليًا وبدعم من حلفائها العرب إلى منع إيران من تحقيق هدفها المتمثل بتشكيل جسر بري يصل الأراضي الإيرانية بالضفاف الشرقية للمتوسط من خلال ربط الحدود السورية بالحدود العراقية خصوصًا بعد طرد تنظيم الدولة من مدينة الموصل وباقي المناطق المحيطة بها، وذلك من خلال زيادة دعم الأكراد للسيطرة على الرقة وربما دير الزور أيضًا، والإبقاء على طريق بغداد دمشق مغلق من خلال الاستمرار بالسيطرة على منطقة التنف، وهي منطقة المثلث بين الحدود العراقية والسورية والأردنية، والعمل على التوسع شمالًا نحو البادية السورية من خلال دعم ما يسمى بجيش سوريا الجديد.
وفي هذا السياق تعتبر الضربة العسكرية الأمريكية على قافلة من المليشيات الشيعية المدعومة إيرانيًا والتي كانت تتقدم نحو قاعدة التنف في بداية مايو/أيار 2017، مؤشرًا مهمًا على هذا التوجه.
أما جبهة تيار الثورات العربية والإسلام السياسي، فقد بدأت أولى الجولات ضده بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا بتاريخ 15 من يوليو 2016، ثم بإحكام الحصار حاليًا على قطر، الأمر الذي ربما يفضي إلى إجبار الدوحة على تعديل بعض سياساتها الخارجية، والانتقال بعد ذلك ربما إلى تصفية الأزمة الليبية لصالح خليفة حفتر، وحرمان حزب النهضة من الأغلبية في أي انتخابات قادمة، ولكن ربما الأمر الحاسم يكون بإخضاع قطاع غزة من خلال القضاء على سيطرة حماس على القطاع عن طريق تحرك عربي “إسرائيلي” شامل.
في الختام، لا يمكن لأحد التنبؤ بمآلات هذه السياسة، وبآثارها سواء على الصعيدين المتوسط والبعيد، ولكن حتمًا ستكون نتائجها حاسمة في تحديد وجهة وهوية الشرق الأوسط للعقود الطويلة القادمة.