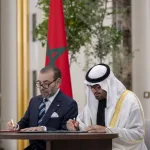غالبًا ما يحصر الخبراء العسكريون الحروب في 3 ساحات: البر والبحر والجو، وفي كل منها يكافح المقاتلون المسلحون لهزيمة خصومهم، لكن المنطقة التي غالبًا ما يتم تجاهلها في المناقشات المتعلقة بالحرب، اُستخدمت على مدى قرون طويلة كوسيلة لكسر الحصار عن المدن والتحصن من هجمات العدو وتجاوز دفاعاته بل وتهديده، وساعدت المقاتلين الأضعف على تحويل ساحة المعركة لصالحهم، وأحدثت مؤخرًا تأثيرًا كبيرًا ضد بعض أقوى الجيوش في العالم.
هذه المنطقة المنسية هي استخدام الأنفاق كوسيلة للتقدم الخفي نحو العدو تحت الأرض، وعلى الرغم من أنها قد لا تمتلك مقومات مناطق الحرب الأخرى، إلا أنها غالبًا ما كان لها تأثير حاسم طوال التاريخ المسجل للصراع البشري منذ آلاف السنين وحتى اليوم، إذ أصبحت فيه هذه المتاهات أداة أكثر فاعلية في أيدي حركة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
حرب الأنفاق.. اختراع وُلد من رحم الحاجة
للأنفاق تاريخ طويل في الحروب، ويشير مؤرخون لعمليات حفرها إلى أكثر من 4000 عام، حيث كان الآشوريون يقتربون من أسوار المدن قدر الإمكان ويحاولون تقويض أساسها، ونظرًا لأن الحفر استغرق وقتًا طويلًا وتعرضوا للاستهداف من أعلى، فقد أدركت الحضارات القديمة أن النهج الأكثر أمانًا هو إنشاء نفق بعيدًا والحفر باتجاه أسوار المدن.
ويعود جزء من تاريخ أنفاق الحروب إلى القرن الأول قبل الميلاد، حيث استخدمها السكان المحاصرون لأغراض مختلفة من بينها الاختباء من الأعداء ومهاجمتهم، المفارقة أن هذا حدث بشكل خاص في المنطقة التي تقع فيها فلسطين و”إسرائيل” اليوم، فقد عثر علماء الآثار على مئات الأنفاق في الأراضي المقدسة، التي استخدمها المتمردون اليهود لشن هجمات على غرار حرب العصابات ضد الرومان خلال الثورة اليهودية الكبرى (من عام 66 إلى 70).

لكن استخدام عمليات حفر الأنفاق لم يقتصر على عمليات التمرد، ولم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ الإمبراطورية الرومانية في استخدامها كسلاح هجومي في فتوحاتهم، وبحسب وصف المؤرخ الأمريكي آرثر هيرمان كانت سمعتهم كمهندسين عظيمة لدرجة أن رؤية الأرض المحفورة والتي قد تشير إلى وجود الأنفاق كانت كافية لإثارة الاستسلام.
سرعان ما ألهم استخدام الأنفاق بهذه الطريقة تطوير الأنفاق المضادة لاعتراض وتعطيل جهود العدو، ففي حصار مدينة دورا يوروبوس التي كانت تحت سيطرة الرومان في عام 256، عندما هددت الأنفاق الفارسية الأسوار والأبراج التي تحرس المدينة، تمكن المدافعون الرومان من اعتراض العديد منها وتدميرها، وحفروا الأنفاق المضادة لفك الحصار الفارسي قبل وقت طويل من تجويع سكان المدينة وإجبارهم على الاستسلام.

بالإضافة إلى تدمير أساسات الأسوار الدفاعية، استخدم اليونانيون والرومان شكلًا من أشكال الحرب الكيميائية المبكرة جنبًا إلى جنب مع حرب الأنفاق للتسلل إلى المدن، وخلال معركة عام 189 قبل الميلاد، أحرق اليونانيون القدماء ريش الدجاج واستخدموا المنفاخ لنفخ الدخان في أنفاق حصار الغزاة الرومان كما تقول أدريان مايور مؤلفة كتاب “الحرب البيولوجية والكيميائية في العالم القديم”.
كذلك أدَّى حصار الإمبراطورية الفارسية لمدينة دورا يوروبوس الرومانية إلى تطور جديد آخر، فعندما اصطدم الفرس الذين كانوا على علم باستراتيجية عدوهم بنفق روماني مضاد ملأوه بدخان سام مصنوع من الكبريت والقار لخنق الجنود الموجودين بداخله، وهو أول استخدام معروف لحرب الغاز.

استمرت عمليات حفر الأنفاق والأنفاق المضادة طوال العصور الوسطى، حيث هيمنت حرب الحصون والقلاع، وكانت الجيوش تبحث باستمرار عن طرق للظفر بالمعارك، على سبيل المثال، أثناء حصار شاتو جيلارد (1203–1204)، وهي القلعة التي بناها الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد، واجه الجنود الفرنسيون ثلاثة جدران دفاعية قوية، وتمكنوا في النهاية من اختراقها عن طريق حفر الأنفاق التي أوصلتهم إلى مجرى مرحاض غير خاضع للحراسة يسمح بدخول القصر، مما أدى إلى قلب مجرى الحصار.
وفي القرن السادس عشر، كان لإدخال البارود إلى ساحة معركة حفر الأنفاق نتائج تدميرية، فقد أوجدت وسيلة بديلة لإنهاء الحصار بسرعة بدلًا من حرق الأخشاب الموضوعة لدعم الجدران، وطورت الجيوش الأوروبية تقنيات لزرع براميل البارود في خنادق مخفية من أجل تقويض أو تفجير تحصينات العدو، والمعروفة أيضًا باسم “العصارات”، ومن هنا جاء مصطلح خبير المتفجرات، الذي أُطق على المهندسين المقاتلين الذين قاموا بهذا النوع من العمل الخطير الذي غالبًا ما كان له تأثير جانبي يتمثل في انهيار النفق في نفس الوقت.

وصلت هذه التقنية إلى ذروتها خلال الحرب الأهلية الأمريكية في “حصار بطرسبورج” في يوليو/ تموز 1864، عندما استخدمت قوات الاتحاد عمال المناجم في صفوفها لحفر نفق بطول 510 قدم تحت قوات الولايات الكونفدرالية، وملئه بأربعة أطنان من البارود، وبعد أسابيع من التحضير، فجر جنود الاتحاد النفق، لكنهم عجزوا عن الخروج من الحفرة الناتجة.
على الرغم من أن الهجوم أدَّى إلى سقوط مئات الضحايا من الأعداء، إلا أن جنود الاتحاد وجدوا أنفسهم في قاع حفرة محاطة بالجنود الكونفدراليين الذين اصطفوا ببساطة حول حافة النفق وأطلقوا النار على أعدائهم العاجزين، وأسفر الهجوم عن سقوط 4000 ضحية من جنود الاتحاد و1800 ضحية من الكونفدراليين فقط، فيما أصبح يعرف باسم “معركة الحفرة“.

في الحرب العالمية الأولى، لعبت الأنفاق دورًا رئيسيًا وعُرفت بالاستخدام الكثيف لحرب الأنفاق والمتفجرات، واستخدمتها قوات الحلفاء لكسب اليد العليا في المعارك العسكرية، ووفرت الحماية من مجموعة من التقنيات العسكرية الجديدة التي جلبتها الحرب إلى ساحة المعارك، مثل المدافع الرشاشة والطائرات والدبابات.
حيرت تكتيكات حرب العصابات التي اتبعها مقاتلو الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام المعروفة بـ”الفيت كونغ” الأعداء وأثارت غضبهم.
وفي عام 1917، في معركة ميسينز، ابتكر الجيش البريطاني استراتيجية مفصلة لحفر شبكة من الأنفاق المنفصلة التي وصلت إلى 22 نفقًا تحت الخطوط الألمانية على مدار 18 شهرًا، وأصبحت كبيرة بما يكفي لاستيعاب 25 ألف رجل.
استعدادًا للهجوم، تم تعبئة الأنفاق بـ450 طنًا من مادة “تي إن تي”، أي ما يعادل حوالي مليون رطل من المتفجرات، وقبل وقت قصير من التفجير، قال الجنرال البريطاني تشارلز هارينجتون لجيشه: “أيها السادة، قد لا نصنع التاريخ غدًا، ولكننا بالتأكيد سنغير الجغرافيا”، وكانت النتيجة أكبر انفجار قبل العصر النووي، أدَّى إلى مقتل ما يصل إلى 10 آلاف جندي ألماني على الفور.

في مثل هذه الحالات، تأتي الأنفاق بمكاسب كبيرة، لكن لم تكن كل محاولات حفر الأنفاق ناجحة، فخلال فترة ما بين الحربين العالميتين، وصلت حرب الأنفاق إلى أقصاها كنظام دفاعي، واستجاب بعض العسكريين لمحاولة وضع جيوش بأكملها في مجمعات متصلة بأنفاق تحت الأرض، وأنفق الجيش الفرنسي، الذي دمرته تجربة الحرب العالمية الأولى، 9 مليارات دولار لتصميم نظام تحصين منيع على طول الحدود مع ألمانيا في الثلاثينيات.
أُطلق عله اسم “خط ماجينو“، وهو نظام متطور من الأنفاق بطول 280 ميلًا، متصلة بواسطة سكك حديدية تعمل بالديزل، وتربط بين العشرات من الحصون والمستوصفات والمخابئ ومستودعات المدفعية وحقول الألغام وبطاريات الأسلحة، وتم تعزيز الأنفاق بالخرسانة المسلحة و55 مليون طن من الفولاذ مغمورة في أعماق الأرض، وصُممت لمقاومة نيران المدفعية الثقيلة والغازات السامة وأي شيء آخر يمكن أن يرميه الألمان ضده.
وعلى الرغم من براعة الأنفاق التقنية، فإن الفرنسيين أمضوا وقتهم في التحضير لأساليب الحروب الماضية، وفي عام 1940، تجاوزت تكتيكات الحرب الخاطفة والآلات العسكرية في ألمانيا “خط ماجينو” بالكامل عبر بلجيكا، وكانت فرنسا قد خسرت الحرب تقريبًا قبل أن يتمكن آلاف الجنود في الأنفاق من إطلاق رصاصة واحدة.

إحدى التجارب العسكرية الأمريكية الكبرى مع تحديات حرب الأنفاق جاءت خلال حرب فيتنام (1955 – 1975)، فعلى مدار عقود من القتال ضد الفرنسيين أولًا ثم حكومة فيتنام الجنوبية المدعومة من الولايات المتحدة، حيرت تكتيكات حرب العصابات التي اتبعها مقاتلو الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام المعروفة بـ”الفيت كونغ” الأعداء وأثارت غضبهم، ومن بين هذه التكتيكات كانت شبكة أنفاق هائلة أشبه بمتاهات ضيقة مدججة بالفخاخ والمستوصفات والمطابخ وحتى دور السينما لعرض الأفلام الدعائية.

وكانت هذه الأنفاق منتشرة في جميع أنحاء فيتنام، وامتدت حوالي 200 ميل باتجاه الحدود الكمبودية، خاصة في مقاطعة كو تشي بالقرب من سايغون، وفي إحدى الحالات، أقام الجيش الأمريكي معسكر كو تشي مباشرة فوق سلسلة من أنفاق “الفيت كونغ”، وبينما كان الجنود نائمين، كان “الفيت كونغ” يخرجون من أنفاقهم ويحدثون الفوضى في المعسكرات، وعلى الرغم من قصف الجيش الأمريكي للمنطقة، ظل “الفيت كونغ” آمنين في أنفاقهم.
كانت تجربة “الفيت كونج” مثالًا شهيرًا على ما يمكن أن تؤديه الأنفاق من أدوار حاسمة في الحروب، فوسط بيئة من الغابات الرطبة غير المألوفة للقوات الأمريكية، وفرت هذه الشبكة المأوى ضد القوة الجوية الأمريكية الساحقة، وسهلت أسلوب الكر والفر في الحرب التي خرج منها الجيش الأمريكي مهزومًا هزيمة ساحقة خلال 20 عامًا من الحرب رغم ترسانته المسلحة.
لم يفلح الدخان أو الغاز المسيل للدموع أو القنابل في الوصول إلى عمق هذه الأنفاق، لتوكل مهمة دخولها وتنظيفها لفرقة متخصصة في اختراق وتفتيش الأنفاق عُرفت باسم “الفئران“، ضمت جنودًا أمريكيين وأستراليين ونيوزلنديين مدربين، سلاحهم داخل السراديب المظلمة كان سكاكين يدوية لنبش التربة، ومعدات يدوية أخرى مثل المصابيح اليدوية، فكان الموت منتظرهم عبر الكمائن المتنوعة، وفي نهاية المطاف، بلغ معدل ضحايا الأنفاق الفيتنامية بين قتلى وجرحى 36% من جنود فرقة “الفئران”.

توقف حفر الأنفاق مع نهاية الحرب في فيتنام، لكن الأمر لم يكن كذلك في كوريا الشمالية التي زادت شهيتها للأنفاق بعد الحرب الكورية (1950-1953)، واستعدادًا لغزو جديد لكوريا الجنوبية، حفرت بيونج يانج أنفاقًا عبر المنطقة المنزوعة من السلاح إلى كوريا الجنوبية.
وبين عامي 1974 و1990، عثرت حكومة كوريا الجنوبية على 4 أنفاق ضخمة تمتد من كوريا الشمالية تحت الحدود، كل منها مدفون على عمق أكثر من 100 متر تحت السطح، ويبلغ ارتفاعه مترين وعرضه مترين، وهو عرض يسمح بمرور ثلاثة جنود كوريين شماليين عبره، وهو ما يكفي لاستيعاب مرور 30 ألف جندي في الساعة.
أغلقت السلطات الكورية الجنوبية الأنفاق، ويقع أحداها على بعد حوالي 30 ميلًا جنوب العاصمة سيول، ويقدر البعض أنه لا يزال هناك المزيد من الأنفاق تحت المنطقة المنزوعة من السلاح المؤدية إلى كوريا الجنوبية، ولكن لم يتم العثور على أي منها خلال العقود التي تلت الاكتشاف الأخير.

وكما هو الحال مع الجهود ضد “الفيت كونج”، اكتشفت القوات الأمريكية التي هاجمت مواقع تنظيم القاعدة وطاردت أسامة بن لادن في عام 2002 مجمع أنفاق ضخم يربط بين تشكيلات كهف تورا بورا الطبيعية في أفغانستان، كانت هذه الأنفاق تضم مرافق المستشفيات وغرف التخزين الضخمة ومعدات الاتصالات الإلكترونية المتطورة، ونظام التحكم في المناخ القادر على تصفية الملوثات الكيميائية.
كانت الجهود المبذولة للاستيلاء على الأنفاق وتدميرها بمثابة فشل استراتيجي جديد، حيث هرب معظم مقاتلي القاعدة وجميع كبار القادة بينما تمكنت حفنة من صد قوات التحالف التي اكتفت بهدم وإغلاق أجزاء من الأنفاق التي سيطر عليها تنظيم داعش في عام 2017.
كان تنظيم داعش معروفًا أيضًا باستخدام شبكة من الأنفاق التي تمر تحت مدن وقرى مختلفة في العراق وسوريا، وكانت أشبة بـ”مدينة بأكملها تحت الأرض” بحسب وصف العقيد فلاح العبيدي، وهو جزء من قوات مكافحة الإرهاب العراقية، لصحيفة “واشنطن بوست“، وأتاحت لعناصره التحرك بسرعة بين المباني ومواقع القتال وتجنب اكتشافهم بواسطة الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، وقد ساهم هذا الانتشار المعقد في خوض أكثر من مائة ألف من قوات الأمن العراقية معركة لمدة 9 أشهر في الموصل لتحريرها من التنظيم.

وخلال الثورة السورية، برعت فصائل المعارضة في تشييد الأنفاق في حربها ضد نظام الأسد، فقد استخدمت الأنفاق لكسر الحصار عن المناطق التي طوقتها نظام الأسد ومنع عنها الطعام والشراب والوقود، في حمص وحلب وريف دمشق، كما استخدمت كأداة لتدمير معكسرات نظام الأسد عبر تفجير الأنفاق من تحتها.
أنفاق غزة.. سلاح المقاومة الاستراتيجي
رغم ما تُوصف به أنفاق “الفيت كونج” التي عجز أمامها الجيش الأمريكي، فإنها تعد “لعبة أطفال” أمام المتاهات الموجودة تحت قطاع غزة، التي لطالما وُصفت بكابوس الاحتلال الإسرائيلي القديم الجديد، وشريان حياة المقاومة الذي تبدع في استخدامه، ويصنع الفارق في معارك غير متكافئة ضد جيش يتصدر قوائم أقوى جيوش المنطقة.
تُوصف هذه الأنفاق بأنها “مدينة تحت الأرض”، وأحيانًا بأنها “وجه غزة الآخر”، أو حتى بأنها “غزة سفلى” لا يعرف أسرارها ولا يدرك خباياها إلا المقاومون، أمَّا الاحتلال فيسميها “مترو”، ويشبهها بـ”مصيدة الموت”، الوقوع فيها آخر ما يتمناه جنوده.
صُممت “غزة الصغرى” لتجتاز اختبار الزمن، وتؤدي بفاعلية أدوارًا لوجستية من إدارة معارك وتخزين عتاد، وأدوارًا هجومية تتمثل في التوغل داخل الأراضي المحتلة.
تعود بدايات حفر هذه الأنفاق إلى مطلع ثمانينات القرن العشرين نتيجة لترسم الحدود بين مصر و”إسرائيل”، وعلى طول طرفي الشريط الحدودي الذي فصل مدينة رفح المصرية عن رفح الفلسطينية، شرعت العائلات في حفر أنفاق بدائية تحت المنازل تخترق الحدود لتحافظ على أواصر القرابة بين المصريين والغزيين، كانت حينها أنفاقًا بدائية ضيقة تُهَّرب من خلالها البضائع والأسلحة الخفيفة من مصر إلى القطاع.
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، شهدت الأنفاق عهدًا جديدًا، فقد استخدمتها الفصائل الفلسطينية لتهريب السلاح إلى القطاع، ثم في عام 2001، استخدموا نفقًا طوله 150 مترًا، لتفجير موقع “ترميد” العسكري الإسرائيلي جنوب قطاع غزة من خلال زرع عبوات ناسفة أسفل الموقع، فكان هذا التاريخ تدشينًا لما عُرف بـ”سلاح الأنفاق”، وهو سلاح هجومي نفَّذت من خلاله عمليات نوعية استهدفت مواقع للاحتلال داخل غزة، وكبدته خسائر بشرية كبيرة، وعجَّلت بذلك انسحابه من القطاع عام 2005، ما جعل حفر الأنفاق أسهل.

في العام الذي تلى الانسحاب، استخدمت قوة مشتركة من فصائل المقاومة الأنفاق، وتوغلت بعمق 600 متر مستهدفة هذه المرة موقع كرم أبوسالم العسكري داخل الأرض المحتلة عام 1948، انتهت العملية بمقتل جنديين إسرائيليين وأسر ثالث هو جلعاد شاليط، لتتحول إلى جبهة حرب خفية هي الأخطر على الكيان المحتل.
وبعد فوز حماس بالسلطة في انتخابات عام 2006، فرضت “إسرائيل” حصارًا على المواد التي تعتبر مهربة في غزة، بما في ذلك مواد البناء بزغم ازدواجية الاستخدام، وعلى وجه الخصوص، كان استيراد الخرسانة يخضع لرقابة مشددة، وهو القرار الذي أثار سخرية كبيرة في المجتمع الدولي.
ومع ذلك، لم يتوقف العمل يومًا داخل الأنفاق، لكنها ظلت محظورة عن الأعين الخارجية، واستمر تهريب البضائع والاحتياجات الأساسية في ظل اشتداد وطأة الحصار مع صعود حماس للحكم عام 2007، وتواصل تشكيل ترسانة السلاح، وكُثِّف الحفر يدويًا وبالمجارف، وازدادت أعمال التطوير والتوسيع تحت الأرض.
وفق بعض التقديرات، تمتد شبكة الأنفاق على طول 500 كيلو متر، ويبلغ عدد الأنفاق فيها 1300 نفق، يصل عمق بعضها إلى 70 مترًا (230 قدم) تحت الأرض، وهي مزودة بشبكة اتصالات مشفرة، وأنظمة تهوية، وخرائط تستخدمها “القسام” في كثير من المهام والعمليات القتالية التي تستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتضم غرف قيادة ومرابط لإطلاق الصواريخ ومخازن أسلحة وأغذية وأدوية وكل ما يلزم للصمود.
صُممت “غزة الصغرى” لتجتاز اختبار الزمن، وتؤدي بفاعلية أدوارًا لوجستية من إدارة معارك وتخزين عتاد، وأدوارًا هجومية تتمثل في التوغل داخل الأراضي المحتلة، إضافة إلى أسر الجنود وصد الاجتياحات البرية، وأخرى دفاعية، أبرزها الاحتجاب عن أنظمة التجسس وطيران الاستطلاع الإسرائيلي.
والنتيجة، شبكة عنكبوتية محكمة البناء على درجة عالية من التعقيد والتجهيز، تم تعزيزها بقضبان خرسانية وحديدية، وبعضها كبير بما يكفي لاستيعاب شاحنة.
ويعترف الاحتلال بعجزه عن مواجهتها، فقد انتشر مؤخرًا فيديو لمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال فيه إن “قطاع غزة عبارة عن طبقة للمدنيين ثم طبقة أخرى لحماس، ونحاول الوصول إلى الطبقة الثانية التي بنتها حماس”.
لمواجهة خطر الأنفاق، شن الاحتلال حملات ردم وتفجير، مستعينًا بأحدث أجهزة الرصد والتتبع، وأرسل جنوده إليها خلال الحملات البرية السابقة على غزة، في عامي 2008 و2014، لكن ذلك كله لم ينجح في النَّيل من الشبكة، وهو ما يقدم أدلة حول ما يمكن توقعه في الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي مايو/ أيار عام 2021، ادَّعى الاحتلال أنه دمَّر الجزء الأكبر من الأنفاق بالغارات الجوية خلال حملة قصف استمرت 11 يومًا، ردت حماس، وقالت إنها لا تشكل سوى 3% من حجم أنفاقها، وأنها أعادت بنائها أو استبدالها، وأفرجت كتائب القسام للمرة الأولى في الشهر التالي عن صور لهذا النوع من الأنفاق، ما أثار الجدل حول حجم الضرر الذي أوقعه الاحتلال فيها، وأكد في الوقت نفسه وجود مئات الكيلومترات من البنية التحتية المعقدة والعميقة للأنفاق في غزة.
استفز الأمر “إسرائيل”، وردت بإنشاء جدار فولاذي، أنفقت عليه أكثر من مليار دولار، وامتد كيلومترات تحت الأرض في محاولة لتحصين نفسها من تسلل مقاتلي المقاومة من تحت الأرض وفوقها، إلا أنه لم يضع حدًا لها، فقد شكَّل حفر تلك الأنفاق وتوسيعها داخل القطاع المحاصر والمراقب متاهة مربكة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتحطمت أسطورة هذا السد المنيع الذي يخترق الأرض، ومزود بأحدث تقنيات الاستشعار، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن تمكنت المقاومة من اختراقه، وعلى إثر العملية غير المسبوقة، تعهد الاحتلال بأن “مهمته العسكرية في القطاع لن تكتمل دون القضاء على الأنفاق بالكامل”، وهو هدف طموح لكنه وفق خبراء “غير واقعي”.
هل تتجاوز “إسرائيل” متاهة الأنفاق هذه المرة؟
منذ نحو عقدين، شكَّل دك أنفاق المقاومة هدفًا لاعتداءات الاحتلال على قطاع غزة، وما زال الوعيد بتدميرها ضمن عملياتها البرية يشغل حيزًا كبيرًا من خطابات المسؤولين الإسرائيليين وتصريحاتهم الإعلامية، لكن المهمة لم تكن سهلة، ويزيد من تعقيداتها اليوم ما شهدته الشبكة من تطور على مدار عقود.
هذا التطور – الذي يبدو أن قدرات الاحتلال الاستخباراتية عاجزة عن مجاراته وتعقبه – تُرجم مؤخرًا في صورة مقاتل فلسطيني يخرج من نفق، يوجه ضربته القاسمة ثم يختفي، هكذا يجري الأمر كل يوم، وكل جنود الاحتلال الإسرائيلي القتلى منذ بدء اجتياح غزة سقطوا بالطريقة ذاتها.
وبعد شهرين على عملية طوفان الأقصى، تركز “إسرائيل” على نشر فيديوهات تشيع فيها أنها تدمر الأنفاق أكثر مما يعنيها أن تخبر الداخل الإسرائيلي والعالم كم تقدمت في قطاع غزة وإلى أين وصلت قواتها وكم قتلت من الفلسطينيين.
على الرغم من كل هذه الأجهزة والمعدات فائقة التطور إلا أن جيش الاحتلال ما زال عاجزًا عن تحديد الكثير من مواقع الأنفاق.
بحسب تقرير نشره معهد دراسات الحرب الحديثة الأمريكي، فإنه لا يمكن التعامل مع الأنفاق والمخابئ العسكرية بشكل متماثل نظرًا للتنوع الكبير والاختلاف من مكان ودلة عن أخرى، وهنا يتضح ما يميز الأنفاق التي حفرتها وأنشأتها الفصائل الفلسطينية بعاملسن رئيسيين، أولها المساحة المساحة الضيقة للغاية نتيجة الجوانب الخرسانية الجاهزة، ما يجعل الدخول إليها والتحرك فيها والقتال داخلها مستخيلًا على الإسرائيليين، فيم يتجلَّى العامل الثاني في العمق الكبير على الأنفاق، ولا أدلً على هذا من عثور “إسرائيل” على نفق في غزة بعمق 230 قدمًا تحت سطح الأرض.
ووفقًا لوكالة “رويترز” تشكل تلك الأنفاق ملاذًا آمنًا للفصائل والذخائر لما تقدمه من مرونة في تكتيكات القتال سواء بالاختباء أو المناورة أو الحركة بعيدًا عن عيون الرصد، وهي السبب الرئيسي الذي يجعل حماس أقوى في غزة منها في الضفة الغربية التي تحتلها “إسرائيل”، حيث القواعد العسكرية وأجهزة المراقبة الإسرائيلية تجعل من الصعب إدخال أي شيء من الأردن.
ومن أجل ذلك، زوَّدت الولايات المتحدة جيش الاحتلال بأكثر القدرات التكنولوجيا تقدمًا لكشف الأنفاق وتدميرها، وأشرف الجيش الأمريكي بنفسه على إنشاء وحدات إسرائيلية متخصصة للتعامل مع الأنفاق، من بينها وحدة “سامور” التي أنشات عام 2014، ووحدة “ياهلوم” التابعة لفيلق الهندسة القتالية، والتي انبثقت عنها قوة “سيفان” الإسرائيلية في عام 2016، وهي اليوم على رأس قوات النخبة لمتخصصة بأنفاق غزة، لكن السخرية منها أيضًا باتت كبيرة بعد أن فشلت في كشف هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وعلى الرغم من كل هذه الأجهزة والمعدات فائقة التطور إلا أن جيش الاحتلال ما زال عاجزًا عن تحديد الكثير من مواقع الأنفاق، وهو ما يفتح الحديث عن القنابل التي تستخدمها “إسرائيل” اليوم لتدمير الأنفاق، وهي القنابل عالية التدمير – مثل القنابل الزلزالية وMK-84 التي يُشار إليها غالبًا باسم “القنابل الغبية”- التي تقصف بها بشكل عشوائي لعجزها عن تحديد أماكن الأنفاق.
ولم تتوقف الاقتراحات والخطط لتدمير الأنفاق أو وقف فاعليتها حتى اليوم، آخرها تمثل في استخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق وشلها، هذه الخطة تحدثت عنها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع ما لا يقل 5 مضخات كبيرة على بعد كيلو متر تقريبًا إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين منتصف الشهر الماضي، لسحب آلاف الأمتار المكعبة من مياه البحر المتوسط في الساعة الواحدة فقط وضخها إلى الأنفاق ما قد يغرقها في غضون أسابيع في محاولة لإخراج مقاتلي المقاومة، لكن “إسرائيل” لم تكشف عن الموعد الذي تعتزم فيه تنفذ هذه الخطة.
بالنسبة للاحتلال فإن هذه الخطة أقل تكلفة مادية وبشرية، وقد لاقت ترحيبًا لدى قادة جيش الاحتلال، لكن هناك الكثير من الجوانب التي قد تعيق أو تؤخر تنفيذ الخطة، فهذا الإغراق سيكون له تبعات بيئية، فبحسب الخبراء سيؤثر على المياه في القطاع، إضافة إلى تربة غزة الملوثة أصلًا، وبالتالي قد تتسرب هذه المواد الخطيرة المخزنة في الأنفاق، كما أنه قد يؤثر على استقرار المباني المجاورة للأنفاق، وقبل كل ذلك، ليس معروفًا ما إذا كانت “إسرائيل” تفكر في تنفيذ خطتها قبل إطلاق جميع الأسرى لدى حماس الذين قالت إنها أخفتهم في أماكن وأنفاق آمنة.

ولم تكن هذه الخطة الخيار الوحيد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام، فقبل نحو شهر، قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية “إسرائيل” تدرس خيار استخدام “قنابل إسفنجية”، وزعمت ان جيش الاحتلال طوَّرها منذ عدة سنوات بهدف استخدامها لإغلاق الأنفاق، بينما أشارت تقارير أخرى إلى خطط لتدمير أنفاق حماس من استخدام الروبوتات وغيرها من التقنيات التي تعمل عن بعد إلى الغازات المحرمة دوليًا، خصوصًا غاز الأعصاب، لكنها غالبًا تحمل تداعيات قد لا تكون محمودة العواقب على الجانب الإسرائيلي.
ومع مرور الوقت، باتت عملية العثور على كل الأنفاق وتدميرها أشبه بمهمة مستحيلة بسبب الطبيعة الحضرية لقطاع غزة، كما أن الترجيحات تؤكد أن الفصائل الفلسطينية وضعت الأسلحة والمتفجرات في الأنفاق، ما قد يؤدي إلى انفجارات تنتقل عبر أجزاء أخرى من شبكة الأنفاق وصولًا إلى أماكن لن يتوقعها جيش الاحتلال، وقد تقتل جنوده أينما كانوا في غزة.
يشير ذلك إلى أن ما تمتكله “إسرائيل” وما ستمتلكه يومًا ما ينفي حقيقة أن ما أعدته غزة أكبر من أن تبيده هذه الأسلحة، فتحت غزة يكمن توأم لها، إذا كانت الأولى مكشفوفة لطائرات الاحتلال فإن الثاني لا يزال السر مستودعًا فيها، تخبئ مفاجآت ستنفجر في وجه الاحتلال حممًا ونارًا وثأرًا لغزة الأولى، وما دامت هناك حرب، فمن المؤكد أن الأنفاق ستكون ساحة لجزء من المعركة.