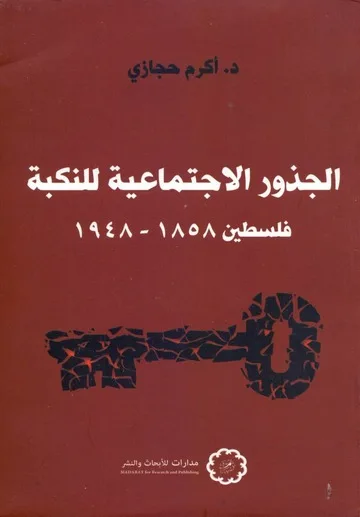إحدى أكثر المقولات التي روج لها بشكل متعمد على مدى عقود، هي أن الفلسطينيين باعوا وفرطوا في أرضهم للمحتل، وهي مقولة مرت عليها أجيال وما زالت تمرّ على عقول بعض الناس إلى اليوم، لدرجة أنها أصبحت شعارًا، لكن يبدو أن مردديها يستخدمونها كتبرير للتخاذل والتملص من تحمل المسؤولية.
وفي بعض الأحيان، أصبحت المقولة تستخدم ليس فقط كدليل على تفشي السلبية واللامبالاة عند قائلها، بل كسلاح على رقبة من يدعم القضية الفلسطينية.
ورغم أن الدماء الفلسطينية التي ما زالت تنزف حتى اليوم خير دليل على أكذوبة بيع الفلسطيني لأرضه، خصوصًا أننا نشاهد اليوم نكبة جديدة تبث على الهواء مباشرة، لكن من المفيد أن نفند تلك المزاعم عبر تسليط الضوء على تاريخ الاحتلال، وبدايات تكون الكيان الصهيوني والكيفية والطريقة التي سيطر بها الصهاينة على الأراضي الفلسطينية.
أحد أهم الكتب التي فككت هذه المقولة بالتفصيل، هو الكتاب الصادر عام 2015 عن دار مدارات للنشر والأبحاث تحت اسم “الجذور الاجتماعية للنكبة: فلسطين 1858 – 1948” للدكتور أكرم حجازي، الذي سنناقش أهم ما جاء بين طياته.
من “المشاع” إلى “الطابو”
تاريخيًا كانت حياة غالبية المجتمع الفلسطيني تتمحور حول الزراعة ويغلب عليها طابع الحياة الريفية، وخلال العهد العثماني، اعتمدت البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني على أن الأرض ملك للشخص الذي يفلحها وينتفع منها، وحتى إن كانت الأرض ملك للدولة أو لشخص ما، فقد كان على الفلاح استئجارها وزراعتها للانتفاع بها.
وإلى أواخر العهد العثماني، لم تكن الأرض تعامل كسلعة تُمتلك إلى الأبد، وإنما كانت مشاعًا بين الناس، وبحسب الدكتور أكرم حجازي فـ”نظام المشاع” الذي أقرته الإدارة العثمانية، كان من خصائصه أن تُقسم الأرض بين جميع أفراد القرية، ولكل فرد حصة ومساحة من الأرض.
ومسؤولية التقسيم كانت تقع على عاتق “مجلس الاختيارية” وهو من أهل البلد، كما يقسم المشاع حسب ظروف الفلاح وقدرته على زراعة الأرض، والقاعدة المتعارف عليها أن يمنح فدان واحد من الأرض لكل محراث يجره زوجان من الثيران، أي أن الفلاح الذي يملك زوجين من الثيران يعطى فدانان.
وتنتهي حقوق الفلاح في التصرف في الأرض حال انقضاء فترة القسمة، ثم يُعاد تقسيم وتوزيع الأراضي الصالحة للزراعة عادة بالقرعة وفي فترة زمنية تتراوح بين سنة و5 سنوات، لتستفيد أسرة غير التي سبقتها.
ولم يسبق أن أجبر فلاح على إخلاء أرضه طالما يشغلها، إلا في حالة أن يهمل الأرض ويتركها دون زراعة لمدة تزيد على 3 سنوات، أو في حالة عدم الوفاء بدفع رسوم استئجار الأرض، أو انقطاع ورثتها، فعند الإخلال بهذه الشروط، تنزع الأرض من يد صاحبها وتحال لمن يطلبها. وهكذا كانت الأرض تدور بين الفلسطينيين بحسب العرف ودون بيع أو شراء أو سندات الملكية.
وهذا النظام بحسب ما أوضح حجازي، كان بمثابة عقد اجتماعي بين الإدارة العثمانية والمجتمع، بني على العرف من جهة، والقانون والشريعة من جهة أخرى، وبالتالي فقد تغلغل نظام المشاع داخل المجتمع الفلسطيني ولعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، إذ لم يكن من حق الفلاحين الأثرياء الاستئثار وحدهم بأغلبية مشاع القرية، وبعبارة الدكتور أكرم كانت الآلية المتبعة في التعامل مع الأرض هي”أسلوب تصرف لا تملك”.
يقول حجازي: “حيثما وجدت القرية، كانت الأراضي المحيطة بها من حقول ومراع ومحاطب ومشات ومسارح وكروم.. إلخ، مساحة خاصة، فيها حقوق لجميع سكان القرية، حتى الدولة لا تستطيع أن تنازعهم فيها، ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منها أو المساس بها إلا بإذن الجماعة القبلية”. صـ 27.
لكن الإصلاحات السياسية والإدارية التي سنتها الإدارة العثمانية في عهدها الأخير وأقرتها تحت ضغط التحديات الخارجية، ألغت مفهوم الملكية العامة التي تقسم وفقًا للمشاع لتتحول إلى إقرار الملكية الفردية للأرض.
إذ يوضح أكرم حجازي في دراسته “الجذور الاجتماعية للنكبة” أن إصدار الدولة العثمانية قوانين تسجيل ملكية الأراضي بداية من عام 1858، بغرض تنظيم وتقنين ملكية الأرض، أدى إلى تغيير علاقة المجتمع بالأرض، وكانت هذه بحسب حجازي بداية تحول الأرض إلى سلعة يمكن شراؤها وامتلاكها للأبد، وأيضًا بداية نشوء فئة كبار ملاك الأراضي.
أحد أبرز قوانين تسجيل الملكية، قانون السماح ببيع الأراضي للأجانب في الدولة العثمانية عام 1869، وقبله “قانون الطابو” عام 1858 الذي ضمن رسميًا امتلاك المالك للأرض، وبحسب الدكتور أكرم، أدى هذا القانون إلى اندفاع العائلات الغنية والمُلاك العرب والقناصل الأجانب لحيازة العديد من الأراضي وتسجيلها والحصول على سندات ملكيتها بعد أن كان غير مسموح في السابق.
والواقع أن الإدارة العثمانية حثت الفلاحين على تسجيل أراضيهم وفقًا للنظام الجديد. لكن كيف تفاعل عامة المجتمع الفلسطيني مع القرارات الجديدة للإدارة العثمانية؟ يشير حجازي إلى أن الكثير من الفلاحين لم يَرُق لهم هذه الحال وتملصوا بصورة جماعية وعنيدة من تسجيل أراضيهم في دواوين الدولة للحصول على سندات ملكية.
كما عمدوا إلى إنكار ملكيتهم تهربًا من دفع الضرائب والرسوم المتزايدة، خاصة بسبب الذعر من التجنيد الإجباري الذي دفعهم إلى تشويه أجسادهم وقطع أطرافهم، وعدم تسجيل الأرض حتى لا تُعرف أسماء المالكين الحقيقيين وأبنائهم ويُؤخذوا إلى الجندية.
ونتيجة لذلك، لجأ الكثير من الفلاحين إلى تسجيل أراضيهم بأسماء أشخاص أموات أو وهميين أو تجار محليين، أو نقل جزء من ملكياتهم إلى الأوقاف، كما باتت مساحات من الأرض تسجل رسميًا بأسماء تُجار وسماسرة وملاك عرب (ملكية اسمية فقط)، واستغلوا هذا الوضع بالتواطؤ مع موظفي الدولة الذين تلاعبوا في السجلات وسجلوا أقسامًا من الأراضي بأسمائهم.
ثم بعد ذلك وجد آلاف الفلاحين مساحات واسعة من أراضيهم قد استحوذ عليها الوجهاء والأعيان وطبقة جديدة من كبار المُلاك العرب والفلسطينيين وعائلات من اللبنانيين والشاميين، خاصة العائلات المسيحية، أشهرها عائلة سرسق اللبنانية التي استحوذت وحدها على مساحات شاسعة في مناطق مختلفة من فلسطين.
لكن رغم ذلك، يرى الدكتور أكرم أن أسلوب الانتفاع والتصرف الجديد في الأرض لم يُغير كثيرًا من واقع عامة المجتمع الفلسطيني، ففي كل الأحوال ظل الفلاح في أرضه وحافظ على مورد رزقه وفق ما جاءت به الأعراف السائدة، وبقيت شريحة الملاك عازفة عن العمل الفلاحي المباشر، وتحوز الأرض سواء عن طريق وضع اليد عليها أم عبر تسجيلها باسمها تحت رغبة من الفلاحين مالكيها الأصليين.
كما يرى حجازي أن الإهمال واللامبالاة هما الطابع المميز عند فلاحي فلسطين، فقلة خبرتهم بالأمور القانونية ولا مبالاتهم بها، جعلتهم لا يستفيدون من التغييرات العثمانية الجديدة، وعرضوا مستقبل حيازتهم للأراضي إلى مخاطر، وبالتالي جاءت منظومة الإصلاحات العثمانية الجديدة على عكس الغاية التي من أجلها وجدت، وقبل كل شيء، فشلت في توفير موظفين أكفاء، لكنها نجحت في إقامة سلطة مركزية وبناء مؤسسات حديثة.
لبنات الاستيطان
رغم أن قوانين الأراضي العثمانية الجديدة كانت المدخل الذي تسلل منه رأس المال اليهودي إلى فلسطين، بجانب أنها تسببت في استيلاء طبقة من الملاك الجدد على أراضي الفلاحين بسبب رفض الكثير منهم تسجيل أراضيهم، فإن حجازي يشير إلى أن مساحات شاسعة من الأراضي ظلت واقعة تحت تصرف الفلاحين دون مشاكل كبيرة، فقد تساهلت الإدارة العثمانية مع الفلاحين الذين لم يسجلوا أرضهم ولم تنزع أي أرض منهم بالقوة، وبقي المجتمع محتفظًا بحقوقه في الأرض وتماسكه الاجتماعي.
وبحسب حجازي فقد كان بداية التسلل الصهيوني يقع على عاتق أثرياء اليهود الذين دشنوا بشكل فردي أولى لبنات الاستيطان على أرض فلسطين، أبرزهم الثري موسي مونتفيوري الذي أنشأ ملاجئ لليهود في القدس، والبارون روتشيلد الذي مول وحده بناء 14 مستوطنة، ثم استمر الأمر بعد ذلك في حركة منظمة بعد المؤتمر الصهيوني الأول الذى انعقد فى مدينة بازل السويسرية.
والواقع أن الإدارة العثمانية كان موقفها رافضًا للهجرة الصهيونية، وحاولت التضييق على اليهود للحؤول دون تملكهم الأرض في فلسطين، وأصدرت قانونين لمنع تملك اليهود الأرض بشكل قطعي، الأول عام 1881، والثاني عام 1892. كما ألغت دفعات مالية أرسلها البارون روتشيلد لمجموعة من اليهود بهدف شراء الأراضي.
ورغم أن هذه القوانين أبطأت الزحف اليهودي، فإن ذلك لم يحل دون تدفق النشاطات الصهيونية إلى فلسطين، خاصة أن السماسرة العرب استطاعوا التحايل على القوانين العثمانية الجديدة، بجانب فساد الجهاز الإداري.
والأهم أن القنصليات الأوروبية استغلت ضعف السلطنة العثمانية واستخدمت كل الحيل لمساعدة اليهود في التسلل إلى فلسطين، وكانت في الحقيقة توفر لهم الحماية، إضافة إلى أن العديد من القناصل الأوروبيين كانوا أصلًا من اليهود.
وعلى حد تعبير حجازي، كانت القنصليات الأوروبية بفلسطين بحجم “دولة داخل الدولة”، إذ مهدت كل السبل للوجود الصهيوني بفلسطين عن طريق الامتيازات وشراء الأراضي وإقامة مؤسسات ثقافية وصحية وتطوير خدمات وغيرها.

ويشير حجازي إلى أنه على مدار الفترة بين عامي 1856 و1918 بلغ مجموع مساحات الأراضي التي تملكها الرأسماليون اليهود والشركات الصهيونية في فلسطين نحو 634 ألف دونم من جميع أنواع الأراضي الزراعية وغير الزراعية، غالبية هذه الأراضي تم شراؤها من ملاك عرب ولبنانيين.
الاقتلاع والإحلال.. التآمر البريطاني
رغم أن الإدارة العثمانية في أواخر عهدها شهدت تغيرًا في نمط الحكم فيما يعرف بفترة التنظيمات العثمانية، لم تتغير طبيعة العلاقة مع المجتمع بشكل كبير، بعكس الاحتلال البريطاني الذي أحدث تغييرات جذرية سريعة منذ اللحظة الأولى، كتب حجازي:
“شتان بين حقبتين، ففي الأولى تسلم العثمانيون البلاد عربية إسلامية، وتركوها بعد أربعة قرون بالتمام والكمال كما هي، أما في الحقبة الثانية فقد تسلمها البريطانيون ثلاثة عقود فقط، رحلوا عنها بعد أن صيروها يهودية”. صـ 81.
كان المشروع الصهيوني في مراحله الأولى فاشلًا للغاية حتى عام 1920، لذا يرى حجازي أن السياسة البريطانية اعتمدت منذ لحظتها الأولى لاحتلال فلسطين على محورين أساسيين:
- تمرير المشاريع الاستيطانية الصهيونية وتهيئة كل السبل لتمكين اليهود من إقامة وطنهم القومي على أرض فلسطين.
- تصفية الممتلكات العربية وحصار رأس مال الفلسطيني على حساب تمكين رأس مال اليهودي من الاقتصاد الفلسطيني.

كان “نظام المشاع” بمثابة العقبة التي تقف بوجه صفقات بيع الأراضي لليهود، وبتعبير حجازي فتفكيك المشاع كان بالنسبة للاحتلال البريطاني “مسألة إستراتيجية”، لذا من اللافت أن هربرت صموئيل المندوب البريطاني في فلسطين، لم يلغِ فقط جميع القوانين العثمانية التي كانت تحول بين اليهود وامتلاكهم الأرض، بل أصدر في أقل من سنة على حكمه، 6 قوانين خاصة بملكية الأراضي والتصرف فيها، كما شكل لجنة لتفكيك وتصفية نظام المشاع، وشُرعت قوانين لحل المشاع بالقوة.

وفي لفتة غاية في الأهمية، يذكر حجازي أنه في أواخر أيام الدولة العثمانية كانت أكثر من 70% من الأراضي الفلسطينية تدار بأسلوب المشاع “العائق الأكبر أمام التملك الصهيوني” ثم تقلصت هذه النسبة عشية الاحتلال البريطاني إلى 56% حتى وصلت إلى 20% عام 1940.
ويذهب حجازي إلى أن تفكيك المشاع خلف آثارًا بالغة على بنية المجتمع الفلسطيني القائمة بالأساس على المشاع فيما يخص استعمال الأرض، لذا اعتبر شالوم رايخمان، أحد قادة الصهاينة، أن تصفية الاحتلال البريطاني المشاع، وتحويل الملكيات العامة إلى صهيونية خاصة، سهل الاستيلاء على الأرض وطرد الفلاحين منها، ويضيف رايخمان:
“إن تعيين حدود قطع الأرض وملكيتها والحقوق المرتبطة بها بشكل قانوني سهل إلى حد كبير نقل هذه الحقوق من يد إلى أخرى. كما يجب أن نرى في ذلك إسهامًا إيجابيًا من طرف حكومة الانتداب في نشاط شراء اليهود للأراضي”.
والواقع أن الاحتلال البريطاني نجح في تفكيك وضرب التركيبة الاجتماعية والاقتصادية التقليدية للمجتمع الفلسطيني، وتفريغ مساحات شاسعة من الأراضي لاستقبال هجرات جديدة لليهود، وذلك باستخدام عدة آليات أهمها:
بناء جهاز مالي لتعزيز الجهد الاستيطاني، وإغلاق البنك الوحيد في البلاد الذي كان يعتمد عليه الفلاحون، وهو “البنك الزراعي العثماني” الذي كان يقدم قروضًا ميسرة للفلاحين، لذا استبدله الاحتلال بـ”بنك باركليز”، ورغم ذلك، لم يحرر الفلاح من ديونه السابقة، بل صار مطالبًا بدفع الضرائب والقروض المتراكمة عليه لبنك باركليز.
لذا من الواضح أن سياسة الاحتلال تجاه الفلاح قامت بالأساس على حصاره ودفعه للتخلص من أرضه من خلال الإفقار المتعمد وإثقال كاهله بالضرائب والديون بصورة متراكمة، الأمر الذي جعل الفلاحين في موقف بائس، ودُفع العديد منهم إلى بيع أراضيهم تحت وطأة ازدياد الديون والضرائب، غير أنهم بقوا في أرضهم على سبيل العمالة، وكل هذا تم في مقابل تهيئة الظروف لتمكين اليهود من الأرض ومنحهم المساعدات والامتيازات المختلفة.
وهو الأمر الذي لاحظه غريغوريوس الحجار، مطران عكا وحيفا والناصرة والجليل، لذا قال في شهادته أمام اللجنة الملكية التي زارت البلاد عام 1936:
“لا يزال الفلاح العربي كما أعرف مثقلًا بالديون بخلاف زمن تركيا، لذلك سعيت لدى المندوب السامي البريطاني مرارًا وبإلحاح كي يعيد فتح هذا البنك الزراعي العثماني لاعتقادي أنه الوسيلة الوحيدة لنشل الفلاح من وهدة الخراب.. وإنكم لا تريدون فتح هذا البنك لكي يزداد الفلاح فقرًا أو يضطر إلى بيع أرضه لليهود. إن بنك باركليز هو حلقة صهيونية وجد ليستولي على الأراضي العربية بطريقة شرعية، لأنه يُسلف الفلاحين بفوائد مرتفعة نسبيًا حتى لا يتمكنوا من رد ديونهم، فيستولي البنك عليها عندئذ بأبخس الأثمان”.
أيضًا فرض الاحتلال منظومة قوانين جديدة تصب في مصلحة نزع ملكيات أراضي الفلسطينيين، وخاصةً قوانين التسوية والغابات ونزع الملكية والطوارئ، وقد كفل الدستور للمندوب السامي البريطاني صلاحيات فوق القانون، كحق التصرف المطلق في الأراضي الفلسطينية، ونزع ملكية أي أرض بما في ذلك أراضي الأوقاف دون أي اعتبار إلا ما يحدده الاحتلال.
هذا بجانب سيطرة الاحتلال على أراضي الدولة العثمانية المعروفة باسم الأراضي الأميرية وأراضي السلطان، ومنح بعضها إلى الصهاينة، وكانت هذه القوانين بحسب حجازي أكبر ضربة قاصمة للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني.
كما اتجه الاحتلال البريطاني نحو حصار الرأس مال الفلسطيني وتهيئة الظروف لاستبعاده تمامًا من بناء مشروعات على أرضه، في مقابل تشجيع الرأس مال اليهودي، فيذكر حجازي أنه في عام 1919، تقدم فؤاد سعد بمشروع لإنارة مدينة حيفا بالكهرباء، لكن حين تقدم الصهيوني بنحاس روتنبرغ بنفس المشروع ذهب على الفور إلى الأخير، وتسنى لروتنبرغ تنفيذ مشروعه.
لذا عقب حاييم وايزمان رئيس البعثة الصهيونية في فلسطين على هذه المشاريع وغيرها بقوله: “إن مستعمرتي ناحلال ودجانيا والجامعة العبرية وأشغال روتنبرغ الكهربائية وامتياز البحر الميت، هذه كانت بالنسبة لي سياسيًا أكثر من جميع الوعود الصادرة عن الحكومات العظمى والأحزاب السياسية الكبرى”.
وثمة أمثلة كثيرة على جهود الإنجليز في تصفية رأس المال والملكية العربية والفلسطينية، وهنا يرى حجازي أن هذه التصفية لم تكن مجرد خسائر مؤقتة يمكن تعويضها، إنما تصفية نهائية بهدف إخراج الملكية الفلسطينية من البلاد.
وبالتالي تضررت كل الطبقة العاملة الفلسطينية بشكل كبير، وبلغت البطالة بينهم أرقامًا قياسية، وكان ذلك تزامنًا مع سنوات حادة من القحط والجفاف في الأعوام 1922، 1923، 1928، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية العالمية 1929، ثم سنوات الثورة 1936 – 1940.

وبعد أن نجح الاحتلال في تصفية الملكيات العربية الكبيرة، اتجه نحو متوسطي وصغار الملاك المحليين، وأصبحت فلسطين تشهد نمطين اجتماعيين: الأول مجتمع يهودي زراعي-صناعي متطور يمتلك خبرات صناعية علمية، مقابل مجتمع محلي تقليدي متخلف ومحاصر، وهذا الانقسام بحسب حجازي أدى إلى انخفاض أجور الفلسطينيين وأصبحت دون الحد الأدنى الذي تحتاجه العائلة بكثير.
كما يرى حجازي أن الاحتلال البريطاني كي يسيطر بشكل كامل على الأرض، ركز في المقام الأول على تطوير شبكة الاتصالات وإعادة هيكلة البنية التحتية للبلاد من خلال بناء ميناء لليهود في مستعمرة تل أبيب، وإنشاء وتوسعة شبكة طرق وجسور جديدة وخطوط السكة الحديد في كل أنحاء فلسطين، بهدف حصر ومسح كل الأراضي والقرى وتحويل ما يمكن تحويله إلى الصهاينة، وقد استغرق المسح 10 سنوات.
وما بين عامي 1917 – 1945 ضاعفت حكومة الاحتلال مساحة الطرق البرية من 435 إلى 4225 كيلومترًا مربعًا، وهي مضاعفة تقارب 1000%، وعلى حد تعبير حجازي “لم تبق شجرة في البلاد خارج سلطة الحكومة البريطانية”.

ووفق ما وثقه أكرم حجازي، فأغلب عمليات شراء الأرض تمت برعاية وتسهيلات القناصل الأجانب والعائلات اللبنانية المسيحية التي امتلكت نحو نصف مليون دونم في فلسطين، ففئة فلاحي فلسطين، تحت الظروف القاسية التي خلقها الاحتلال، لم تبع إلا 9.4% من حجم الأرض المبيعة، بينما 90.6% باعها كبار الملاك والكنائس والشركات الأجنبية أو منحها الاحتلال البريطاني للصهاينة.
وما يلفت الانتباه أن الجزء الأعظم من الأراضي التي اشتراها اليهود حتى إقامة دولتهم، باعها لهم عرب غير فلسطينيين، خاصة اللبنانيين، وتبقى عائلة سرسق اللبنانية، صاحبة الدور الأبرز في صهينة فلسطين.
وحسب رواية إميل الغوري فقد باعت هذه العائلة نحو 400 ألف دونم من الأرض لليهود، بما فيها ملكيتهم في مرج بني عامر، لتتسبب بذلك في تشريد ما بين 20-25 قرية يسكنها قرابة 2546 أسرة تشمل نحو 15 ألف إنسان وجدوا أنفسهم فجأة بلا مأوى ولا أرض بعد أن طردهم الصهاينة من أرضهم، لذا يشير حجازي إلى العديد من الصدامات المسلحة التي وقعت بين الفلاحين والصهاينة على خليفة اقتلاع الفلاحين من أرضهم بالقوة.
والأمر نفسه تكرر في أراضي وادي الحوارث – تبلغ 32-50 ألف دونم – الذي باعته أسرة الطيان إلى اليهود، وتعود ملكية الوادي إلى 2400 فلاح أجبروا على إخلاء أرضهم بالقوة العسكرية البريطانية التي آزرت اليهود في الاستيلاء على الوادي.
وحتى عام 1930 كان عدد الفلاحين المطرودين من أرضهم يبلغ 20 ألفًا من أصل 119 ألف فلاح بفلسطين، وهؤلاء الضحايا الأوائل للتهجير لم يكن لهم أي شأن في صفقات البيع، كانوا آخر من يعلم، كما لم يكن لهم مصدر رزق غير أرضهم أو العمل في أرض غيرهم، وهذه بحسب حجازي سابقة في التاريخ، إذ قبل صدور وعد بلفور لم يسبق أن تم إخلاء أي مزارع من ملكيته كنتيجة لانتقال الأرض إلى شخص آخر.
كما يشير حجازي إلى أن أضرار إخلاء الفلاحين من أرضهم لم تتوقف على المقيمين في المكان والعاملين فيه، فعلى سبيل المثال، في حالة إخلاء وادي الحوارث، فقد فلاحو وادي الحوارث والفلاحون المجاورون أراضيهم ومراعيهم وتراثهم الزراعي، كما حرم أكثر من 10 آلاف إنسان يسكنون بالقرب من الوادي من الانتفاع به.
لكن أستاذ التاريخ الدكتور محسن صالح يرى أن بعض العائلات العربية واللبنانية التي باعت أراضيها للصهاينة، لم تتضح لها معالم المشروع الصهيوني، وباعت الأرض بسبب أن السلطات البريطانية منعتهم من دخول فلسطين بحجة أنهم أجانب، وذلك بعد أن تم فصل فلسطين عن سوريا ولبنان وفق تقسيمات الاحتلالين البريطاني والفرنسي.
المسمار الأخير.. النكبة
يرى حجازي أن سياسات الاحتلال البريطاني أضعفت وأنهكت المجتمع الفلسطيني، حتى إذا حانت النكبة، كان المجتمع هشًا منقسمًا منزوع الأنياب يعيش بين تقلبات المراحل، لا يملك جيشًا أو حكومة أو قاعدة صناعية، وقد لاحظ الخالدي أن الفترة الزمنية الفاصلة بين القضاء على مقاومة الشعب الفلسطيني عام 1939 وقرار التقسيم، هي 8 أعوام، أي أنه لم يكن في استطاعة القيادة أو المجتمع الضعيف أن يلتقطا أنفاسهما خلال النكبة.

رغم أن البريطانيين دمروا بالفعل القيادة الفلسطينية وشلوا قدراتها الدفاعية بالكامل عندما قمعوا الثورات التي سبقت النكبة، وخصوصًا عندما قمعوا الثورة العربية 1936-1939، ما أتاح للقيادة الصهيونية متسعًا من الوقت لتحديد خطواتها التالية، فمن اللافت حقيقة، أنه بعد كل هذا التواطؤ والتسهيلات والقوانين التي شرعها الاحتلال البريطاني من أجل تسهيل حيازة اليهود الأرض في فلسطين وإضعاف وإنهاك المجتمع الفلسطيني، لم يتجاوز مقدار ما استحوذ عليه اليهود بالشراء والمراباة والامتيازات 7.5% من مساحة الأراضي الفلسطينية حتى عام 1948 وفقًا لتقديرات صهيونية.
لذا يرى حجازي أن بريطانيا لم تستطع تقسيم فلسطين بسبب التفوق الكاسح للعرب في عدد السكان والمساحة، فاضطرت إلى إلقاء عبئها على الأمم المتحدة بحيث تجعلها مشكلة دولية وليست خاصة بها أو باليهود وحدهم.
وشكلت الأمم المتحدة لجنة لتشريع سرقة الأرض، معتمدة على بيانات السجلات البريطانية لعام 1945، لكن رغم أن ملكية اليهود لم تتعد 7.5%، فقد منح قرار التقسيم الصهاينة 8 أضعاف ما يملكون، منحهم 56.47% من أرض فلسطين، وللعرب مساحة 42.88%، ثم أعلنت منطقة القدس التي بلغت 0.65% من إجمالي مساحة فلسطين منطقة دولية.
وما بين قرار التقسيم في 1947 والانسحاب البريطاني في 1948، كان المجتمع الفلسطيني يتعرض للطرد المنهجي من مناطق واسعة من البلاد وعمليات قتل ونهب جماعية من الميليشيات الصهيونية، لكن مع ذلك كان الفلسطينيون يحتفظون بنحو 93% من أرض فلسطين قبل اندلاع حرب 1948.
ورغم أن اليهود كانوا أقلية، نحو 30% من مجموع السكان، كانت هذه الأقلية مسلحة ومسيطرة على البنية التحتية في البلاد، ولديها خبرة عسكرية اكتسبتها في الحرب العالمية الثانية عندما تطوع عدد من الصهاينة لخدمة المجهود الحربي البريطاني، بجانب أن الاحتلال البريطاني تنازل للقوات الصهيونية عن جميع ممتلكاته بفلسطين.
وبحسب حجازي، فالمفارقة ليست فقط في المساحة التي امتلكها اليهود خلال سنوات الاحتلال، وإنما في الزيادة الديموغرافية الهائلة، إذ ارتفع عدد اليهود بفلسطين من 55 ألف غداة الاحتلال البريطاني للبلاد إلى 650 ألف عام 1948.
ثم أعلنت القيادة الصهيونية في 14 مايو/أيار 1948 قيام “دولة إسرائيل”، وفي اليوم التالي، دخلت الجيوش العربية الحرب بجانب الفصائل الفلسطينية، واستمرت الحرب حتى وافقت الدول العربية على اتفاقيات الهدنة مع الصهاينة، وهو ما أدى بحسب حجازي إلى تضخم السرطان واستفحاله. وكان من نتائج هذه الهدنة أن توسع اغتصاب الصهاينة للأرض من 56.47% بعد قرار التقسيم إلى 77.4%، أي زيادة بنسبة 21%.
بحسب حجازي كان توقيع الهدنة بين “إسرائيل” والدول العربية بمثابة انهيار كلي للنظام الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، فعلى المستوى الديموغرافي، أفرغ الصهاينة بشكل منظم المدن والقرى الفلسطينية من أهلها.
ففي غضون 8 أشهر، كان الترهيب لتهجير الفلسطينيين واسع النطاق، حيث فُرض حصار على القرى والمراكز السكانية، كما تم إشعال النار في المنازل والممتلكات والبضائع، وزرعت الألغام في الطرقات لمنع السكان المطرودين من العودة.
وكانت النتيجة أن دُمرت نصف القرى الفلسطينية، وهُجر نحو 750 ألف فلسطيني، اقتلعوا من أراضيهم وقراهم التي سكنوا فيها هم وآباؤهم، بأبشع الأساليب، نحو الدول المجاورة، 531 قرية دُمرت بالكامل، و11 حيًا حضريًا أفرغ من سكانيه، ليتم إحلال هذه القرى الفلسطينية بمجتمع غريب هجين متمثل في مجتمع المستوطنين الصهاينة، ولتبدأ المرحلة الطويلة من الشتات، وهو ما شكل فعليًا النكبة الفلسطينية.

ثم أصدرت “إسرائيل” عدة تشريعات من أجل نهب ممتلكات الفلسطينيين المهجرين والفارين بسبب الحرب، كقانون الغائب الذي سلب كل أرض غاب صاحبها أو سافر إلى خارج حدود الهدنة، حتى الأوقاف الإسلامية سُلِبت بالقانون نفسه، واختفت هوية وتاريخ مئات القرى الفلسطينية بالكامل من الوجود.
وما حدث لم يكن بأي حال من الأحوال نتيجة غير مقصودة، أو حدثًا عرضيًا، فكما أعلن رئيس “إسرائيل” الأول حاييم وايزمان أن “كل ما حدث كان نتيجة تخطيط دقيق”، ومن اللافت أن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني كانت حاضرة في كتابات الآباء المؤسسين للصهيونية، ولعلهم استمدوها من تجربة التطهير العرقي الأمريكي بحق الهنود الحمر السكان الأصليين.
في الحقيقة، تلاشى المجتمع الفلسطيني من أرضه بسرعة خاطفة، تاركًا عشرات آلاف العائلات التي تعيش كلاجئين، وما زالت إلى اليوم تطالب بحق العودة، لكن في المقابل، ما زال الاحتلال ماضيًا في مسيرة القتل والإبادة، ورغم أن “إسرائيل” شردت ثلثي الشعب الفلسطيني عام 1948، فقد مُحي التطهير العرقي الذي قامت به من الذاكرة العالمية.