مرتكزات الخطاب الإسلامي (3): ثنائية الدين والسياسة
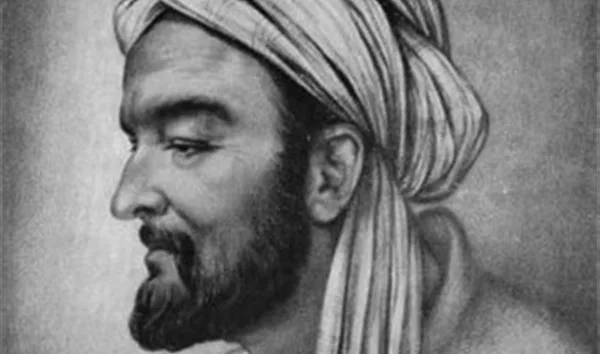
ما يقال عن الإسلاميين يقال عن بقية التيارات، فكلها ومن دون استثناء عاشت حالة الـ”دوجما” التي تحدث عنها محمد عابد الجابري، وقد تبع ذلك ظاهرتان ميزتا الفكر الإصلاحي والحراك السياسي بإجمال هما: وجود حراك كبير دون وجد أي تغيير حقيقي وغياب أي دينامية في فهم المصطلحات والأفكار والمفاهيم، وانطلق كثيرون من مسلمات لا يرضون مجرد الحوار عنها وهي في الواقع مفاهيم قد طالها الكثير من الجدل حتى في العالم الغربي (منشأ الكثير من تلك الأفكار).
فالعلمانية تعني الفصل بين الدين والسياسة، والديمقراطية تعني حق التشريع للشعب، ومن ثم انطلق الجميع للخصام بشأن هذه الثنائيات ضمن هذا الإطار، وحتى الجدل كان في تفصيل هذه المعاني الثابتة اللازبة، وانتقل الأمر للاتهام بين الأطراف المختلفة، وحشد لذلك إعلام وأموال وعنف وسجون، كل ذلك بمفاهيم ونظريات يمكن مناقشتها ومعرفتها ضمن نماذج مركبة قد تساهم في الخروج من هذه الثنائية.
من المحاولات التي حاولت خرق جدار هذه المفاهيم موسوعة العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة للراحل عبد الوهاب المسيري، والمسيري في معظم أعماله يركز على النماذج الفكرية، وهو بذلك يأتي على أبرز المفاهيم تجذرًا ليفككها ويعيد تركيبها في نموذج مركب وليس نموذجًا اختزاليًا، يبين لنا ذلك فيقول: صناعة النماذج تبدأ بالتجريد، وفق صورة ذهنية تسمى فرضية أو نسق أو نظام، والتفكيك للواقع المركب في عناصر (نشاطات بشرية) ثم يتمّ الربط بين المعلومات وصياغة النموذج بالتركيب.
التجريب يكون من خلال الارتباط بالواقع وتقييم النموذج ومعرفة قدرته التفسيرية، ولمعرفة قدرة النموذج على التفسير أو التنبؤ يتم بناءً عليه مجموعة من المؤشرات، المؤشر هو عنصر ما في الواقع يمكن ملاحظته بسهولة، والتحولات التي تطرأ عليه تطرأ على مفهوم مجرد، ويؤكد الدكتور أن المؤشرات كاستطلاعات الرأي وتحليل المضمون هي مؤشرات اختزالية لا تعبر عن تعقيد الظاهرة الإنسانية.
نموذج “العلمانية الشاملة” لا يحمل الكثير من القدرة التفسيرية فهو كما يبدو رهين للانتقال من عالم الفكر إلى عالم المادة
ولعل نموذج العلمانية الشاملة الذي عرضه يبين إحدى المحاولات لوضع نموذج ثوري للنموذج الاختزالي السائد، يتلخص هذا النموذج في مرحلة أولى تسود فيها العلمانية الجزئية، حينما يكون مجالها مقصورًا على المجالين الاقتصادي والسياسي، وحين تكون هنا كبقايا مطلقات مسيحية وإنسانية، وحين تتسم الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة (الدعاية والإعلان والسينما…) بالضعف والعجز عن اقتحام (أو استعمار) كل مجالات الحياة، وحين تكون هناك معيارية إنسانية أو طبيعية (مادية)، ولكن في المراحل الأخيرة، ومع تزايد قوة الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة، وتمكُّنها من الوصول إلى الفرد وإحكام القبض عليه من الداخل والخارج، ومع اتساع مجال عمليات العلمنة وضمور المطلقات واختفائها وتهميش الإنسان وسيادة النسبية الأخلاقية، ثم النسبية المعرفية (باهتزاز الكليات، تظهر العلمانية الشاملة في مرحلتيها، الصلبة والسائلة”.
إذًا يتحول المجتمع من مجتمع يرتبط بالمطلقات -النموذج الكامن الله والإنسان والطبيعة- ثم تزاح القيم والمطلقات، وتبقى الثنائية الصلبة (الإنسان والطبيعة)، ثم تبدأ المرحلة السائلة حين يتم تبسيط ظاهرة الإنسان، إذ يصبح مجرد عناصر موضوعية (قابلة للدراسة) غير شخصية، متماثلة إلى حد كبير، فيسهل التعامل معها، معالجتها ودراستها والتحكم فيها وإخضاعها لنماذج تحليلية بسيطة (عادة كمية) وقواعد إجرائية ذات طابع مادي كمي عام (وهذا هو الترشيد المادي للحياة).
هكذا نرى متتالية تفسر لنا الكثير في “مصطلح” لم تلم أطراف تاريخه إلا عبر نموذج يخرجنا من اختزال المفهوم إلى تعريف لا يحمل أي دلالة تفسيرية: فصل الدين عن الدولة، لكن هذا النموذج (العلمانية الشاملة) لا يحمل الكثير من القدرة التفسيرية فهو كما يبدو رهين للانتقال من عالم الفكر إلى عالم المادة، والثنائية انتقلت من السياسة والدين إلى الدين والحياة، والنقد هنا عن اعتماد النظرة التطورية للمفهوم وكيف ينتقل من مرحلة لمرحلة. هذا بالطبع لا يعني أن نموذج المسيري من دون قدرة تفسيرية، فالكثير من المؤشرات تدل على أن معدلات العلمنة في ارتفاع كما بين هو نفسه، وما تيار ما بعد الحداثة والحركات النسوية والعولمة وسيطرة رأس المال والشركات الكبرى وشركات العلاقات العامة على كثير من سياسات الدول الكبرى إلا مؤشر من مؤشرات هذه العلمانية.
هذا نموذج يعطينا سيناريو للانتقال عبر الثنائيات، نجد محاولات أخرى كثيرة ليست لفهم العلمانية بل للخروج من أسرها كإطار تحليلي، وهذا يعني عند بعضهم أن أسطورة الفصل بين الدين والسياسة لم تتحقق في التاريخ، فهو مليء بالصراعات بشأن القيم والدين والوطن والشريعة والأهم من ذلك الغرور والكبرياء تحت مسمى القيم.
مراجعة سيطرة معيارية العلمانية على الفكر الغربي ستبين حقيقة أن الحديث عن دول علمانية وفق النموذج الذي يتخيله البعض لم يحدث إلا نادرًا عبر التاريخ
فما زال البعض من الساسة والمفكرين ينتقلون من مسلمات كأن العلمانية أمر واقع، ومن ثم يصبح الحديث عن الأطراف الأخرى وخاصة الإسلامية أنها ترفض العلمانية ووصولها للحكم سيلغي مبدأ التداول على السلطة وسيبدأون في تطبيق الشريعة ثم ينقلبون على الديمقراطية، وهكذا تقع العلمانية في الشرك الذي حذرت منه وهو المعيارية للواقع، ومن ثم تصبح العلمانية مجرد صورة ذهنية للتصنيف وليست نموذجًا للتفسير والحكم.
دعنا ننظر لهذه المراجعات الثورية، والتي بالطبع ستنتقد سؤال الجدلية بين الديني والسياسي لنجد أنفسنا أمام نموذج أقدر على تفسير ما يمكن أن نقوم به دون وجود خلفيات مسبقة، يقول هانت بيكر في كتابه نهاية العلمانية “العلمانية ليست محايدة” و”هي ليست عقلانية وإنسانية أكثر من خيارات غيرها، لا يمكن أن تدعي أنها سيطرة العلم، ولايمكنها أن تتفادى النظر خلف المادة لاكتشاف القيم، وهي مجموعة خطابات جوفاء وفيقهة لا يمكن وضعها كنموذج يقدم أي فائدة عملية” و”من الأفضل لنا أن ننظر لمجتمعنا وأن يقنع بعضنا البعض بالخطأ والصواب خير من وضع حواجز وأفكار مسبقة وقواعد مصطنعة بين الدين والعلمانية”.
مراجعة سيطرة معيارية العلمانية على الفكر الغربي ستبين حقيقة أن الحديث عن دول علمانية وفق النموذج الذي يتخيله البعض لم يحدث إلا نادرًا عبر التاريخ، والكلام عن أن الدولة العربية التي تكونت بعد الحرب العالمية الثانية علمانية يحتاج لمراجعة هو الآخر، تبدو هذه المراجعة مهمة خاصة عندما يعتبر البعض أن العالم العربي يمر بما مر به إبان سقوط الدولة العثمانية، فيعيد البعض السيناريو لأتاتورك وكيف أن الرئيس السيسي يمثل أتاتورك وسيحمل مصر على الحداثة؟
الثورة الفرنسية على سبيل المثال يسود اعتقاد بأن الكنيسة قد ألغيت تمامًا وأن اللائكية أو العلمانية قد كانت النموذج السائد، ويسرى هذا الكلام بعد ذلك على أوروبا والغرب، وهذا ليس بصحيح تاريخيًا وابستمولوجيًا، فدول كإيطاليا وإسبانيا واليونان رفضت هذا النموذج الذي يقصي الكنيسة كما أن روبيسبيير إبان عصر الإرهاب كان من الداعين لعودة الكنيسة وعدم إقصائها، الأمر الذي تعزز بعد المصالحة التي أجراها نابليون بونابرت بعد ذلك بسنوات.
قبل الثورة الفرنسية كان هناك حراك للبروتستانت الكالفيني الفرنسي (hungenout )، وانتشر عبر طبقة مثقفة من المجتمع الفرنسي، وبموارد كبيرة، هذه الحركة كانت أشبه بدولة داخل دولة، فقد كانت تنتشر بين طلبة الجامعات وتسيطر على الصحف وبعض أنواع التجارة مما أهلها لبداية حرب ضد الملك والكنيسة وأن تكون بالقوة التي لا يمكن السيطرة عليها واستطاعت أن تنأى بنفسها عن الكنيسة وأن يكون لها وجود داخل العديد من المقاطعات، وتغلغلت في الحكومة، الأمر الذي انتهى مع اعتلاء لويس السادس عشر الحكم، لكنها منذ أن خرج قانون يحاول أن ينظم نشاطها إلى قيام الثورة الفرنسية كانت هي القوة التي ينظر إليها كقوة دينية ومتحررة قد تكون بديلًا عن الكنيسة التي كانت جزءًا من النظام السياسي هؤلاء هم بعض رجالات الثورة.
ومع قيام الثورة كان المجلس الوطني يعاني من صعوبات مالية جمة، وكانت الكنيسة مصدرًا مهمًا من مصادر التمويل، لذا يمكن اعتبار أول صدام حقيقي مع الكنيسة، ليس بإزالتها بل بإصلاحها وذلك في 30 من مايو حين شكلت لجنة برلمانية لإصلاح الكنيسة ومراجعة نظامها الداخلي.
هذه اللجنة حاولت أن تجعل الكنيسة أكثر ديمقراطية من حيث الانتخابات الداخلية والممارسات المتعلقة بالدولة، وقد كان في ذهن رجال الثورة حسب بعض المؤرخين أنها مؤسسة من المؤسسات التي يمكن من خلالها التأثير في الرأي العام، لذا حتى أولئك الذين نظروا إليها كأنها تقليعة قديمة يعرفون أن هناك حسابات سياسية والأهم اقتصادية من خلال التراتبية الموجودة بها يجب أن توضع في الحسبان، لقد كان الأمر أكثر تعقيدًا مما يصوره البعض على أن دين له آلاف السنين اختطف في لحظة غضب.
كان رجال المجلس يريدون أن يخضعوا الكنيسة لسلطان الدولة، ولذا كان من مهام اللجنة وضع دستور مدني تخضع له الكنيسة ، هم لا يريدون أن يظهروا كقتلة للكنيسة أرادوا لها موتًا بطيئًا كمؤسسة تابعة للملك لكنها مؤثرة في الرأي العام بلا شك، لكن هذا القانون المدني لم يكن كافيًا فالدين تأثيره أقوى مما نصوره أحيانًا فقد كان الأمر يتجلى يوم 12 يوليو عام 1790حين توجب على رجال الكنيسة الخضوع إلى القانون المدني الموضوع، وبهذا ولأول مرة يطلب من الكنيسة أن تكون تحت سلطان الدولة، وأن يقسموا على ذلك، ويصبح البابا يأخذ راتبه من السلطة المدنية ويقر أنه خاضع لسلطان الدولة، الأمر الذي رفضه نصف أعضاء الكنيسة تقريبًا (100-101)، وبالطبع سيكون هذا على حساب السلطان والمال الذي عرفت به فرنسا كدولة دينية.
ما إن انتهى عصر الإرهاب عام 1794 حتى كان لنابليون دور كبير في تنظيم العلاقة بين الكنيسة والحكومة بعد الإقرار بأن المسيحية هي الدين لغالبية الفرنسيين وأصبحت الكنيسة خاضعة لسلطة الدولة
لقد كان الأمر صعبًا واعلنت حربًا دينية حين اقتضى الأمر نزع تمثيل الكنيسة في المحاكم والسلطة القضائية، وانفسم الناس وكان النظر للكنيسة في أعين البعض أنهم أعداء للديمقراطية، برفضهم القسم والخضوع للمدنية، الامر الذي دعا المجلس بإصدار قرار بنفي كل من يرفض القسم، وهنا بدأ الإرهاب والقمع خاصة مع وجود تهديدات خارجية للثورة الفرنسية كانت تسعى لإعادة الحكم الملكي والكنيسة. هذه التفاصيل وغيرها كثير تجعلنا ننظر لتبسيط الأمر على أنه مجرد فصل للدين عن السياسة أمر محل نظر.
فتجريد الأمر قد يوحي بهذه البساطة لكن هناك تعقيدات مؤسسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية واستراتيجية قد أحاطت به، وهذا ما جعل رويسبيير أحد أهم خطباء وزعماء الثورة يسعى للتصالح مع الكنيسة وكان هناك مقترح له لتعزيز القانون المدني يقر فيه بأن شعب فرنسا يؤمن بالله وباليوم الآخر وأن العبادة أمر مهم للإنسان وأن محاربة الطغيان واجبة للحفاظ على كرامة الإنسان ….ما أن انتهى عصر الإرهاب عام 1794 حتى كان لنابليون دور كبير في تنظيم العلاقة بين الكنيسة والحكومة بعد الإقرار بأن المسيحية هي الدين لغالبية الفرنسيين وأصبحت الكنيسة خاضعة لسلطة الدولة وتصرف لها المرتبات وكان ذلك في قانون رقم 1802، وبذا وضعت الروح الوطنية والدولة في وضع السلطة الحاكمة على الكنيسة .
إشكالية الكنيسة بعكس البروتستانتية أنها في أغلب أوروبا كانت مع الملكية، الأمر الذي اختلف تماما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد كانت الكنيسة جزء من التحرك نحو الديمقراطية ، وقد كان هناك تيار داعي لنظرة أكثر عقلانية للدين باعتباره وسيلة للتصالح داخل المجتمع والسلام المجتمعى، لكن بروز الدارونية كمفسر لبدء الخليقة جعل الأمر يختلف تمامًا وتحول الأمر إلى إطار فكري جديد حتى للدين نفسه وقصة آدم وحواء.
وهنا يكثر الحديث عن التنويريين؛ ويؤخذ الأمر بإجمال دون نموذج هادي فيصور الأمر على أن التنوير كان إقصاء للدين والأمر ليس كذلك، فالتنويريون أقسام فمنهم من يرى تجاوز الدين ومنهم من يعتدل في الأمر ويرى أنه لابد من التوازن في التعامل مع العشريات التي تأخذها الكنيسة، وهناك من يرى أن العقلانية والسببية لا تتناقض مع الإيمان والعقيدة (scotland enlghtment)، هذا كان ظاهرًا في الولايات المتحدة الأمريكية فرغم هذا التنوير والحديث عن فصل الكنيسة عن الدولة إلا أن المنظرين لفصل الدين عن السياسة كانوا قلة .
هناك تناقض عند البعض و هو الحديث أن العالم الإسلامي يعاني من الجماعات الإسلامية التي تريد أن تختطف مدنية الدولة وعلمانيتها
يمكننا بالطبع أن نستمر في سرد التاريخ لكن ذلك سيأخذنا عن المقصد من الحديث وهو أن هناك تضاربًا وملابسات قد تجعل القول بأن الدين قد أقصي عن الحياة في أوروبا أمرًا يحتاج لنماذج أكثر تفصيلا ً، فما هو المقصود بالغرب هل هي فرنسا أم اسبانيا أم بريطانيا أم شرق أوروبا؟… كما أن فهم الظروف المختلفة عن الحضارة الإسلامية ومؤسساتها التي كانت أبعد عن سيطرة المؤسسة الدينية في الشأن السياسي.