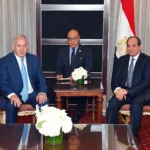يعتبر التعليم من أهم المراحل التي يمر بها الشخص، ولا يقل عنه أهمية المكان الذي يتم فيه، حيث تختلف خيارات الكثيرين بين الدراسة في القطاع الخاص أو العام، وذلك تبعًا لقناعات وأهداف كل فئة، وبالطبع، بحسب قدرتها المادية على تسديد رسوم وتكاليف الخدمات التعليمية في المؤسسات الخاصة.
هذا ويثير اختلاف قطاعات التعليم الكثير من الجدل والأسئلة، عن مصادر التمويل لهذه المؤسسات، وما الأبعاد التجارية لكل مؤسسة؟ وهل أفسد الدور التجاري جودة التعليم؟ وعما إذا كانت الطموحات التجارية في قطاع التعليم هي استثمار اجتماعي وليس ربحي؟ وبغض النظر عن الإجابات، فإنه من الطبيعي أن تتباين الآراء وتختلف خاصة عند تناقض الأهداف المأمولة لكل جهة.
وبالنسبة إلى وضع التعليم في الوطن العربي بصورة عامة، فلقد أصدرت اليونيسكو تقريرًا يوضح أن 57 مليون طفل في العالم لا يذهبون إلى المدارس، ونحو 43% من الأطفال في الدول العربية لا يتلقون أساسيات التعليم، على الرغم من التحاق بعضهم بالمدارس، وهذا دليل على تدني جودة التعليم وإهمال الحكومات لهذه القضية. وبالنسبة إلى التوقعات المستقبلية، فإن 50% من أطفال البلدان منخفضة الدخل سيتمكنون من إكمال تعليمهم إلى مرحلة الثانوية بحلول عام 2030، وذكرت أن هناك نقصًا كبيرًا في التمويل بمبلغ 22 مليار دولار، ولا يوجد أي غاية واضحة من مجتمعات العالم بشأن تمويل التعليم في إطار تعزيز التنمية المستدامة.
النفقات الحكومية على خدمة التعليم
أنفقت الدول العربية ما يعادل 5% من إجمالي الناتج القومي على التعليم، وبالتحديد تنفق دول الخليج 3.3%، مقارنة مع 5% في الدول المتقدمة، و4% في الدول متوسطة الدخل، وهذا فقًا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2013.
ويمكن تفسير تراجع الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في الوطن العربي، بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ما تشهده المنطقة من أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة، ولكن من وجهة نظر أخرى، فإن هذا التراجع في الإنفاق سببه تركيز بعض الدول العربية على سياسات الخصخصة بشكل كبير، مما ساعد قطاع التعليم الخاص على الاتساع.
أصدر البنك الدولي تقريرًا يحذر فيه من إهمال التعليم في الوطن العربي، وطالب بجعل التعليم أولوية على قائمة الدول وإتاحته للجميع، من أجل التخلص من معدلات الأمية والبطالة وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي أفضل في السنوات القادمة.
ونتيجة لهذا الاتساع، تحول التعليم بمختلف مراحله إلى مشروع تجاري واستثماري ربحي، بغض النظر عن عواقبه الاجتماعية أو المادية، فعلى سبيل المثال، يقع أصحاب الطبقة المتوسطة أو المتدنية ضحية لهذه السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى إهمال قطاع التعليم العام، دون مراعاة الفروقات الاجتماعية، لكن البعض يرى أن التعليم الحكومي لا يلبي متطلبات سوق العمل، ولا يتماشى مع تطورات العصر، بسبب جودته المتدنية وانعدام آليات تطوير وصقل المهارات والمواهب، وبالتالي يتوجه الكثير من الطلاب إلى التعليم الخاص.
ومع تراجع المسؤولية الحكومية في تنمية التعليم، أصدر البنك الدولي تقريرًا يحذر فيه من إهمال التعليم في الوطن العربي، وطالب بجعل التعليم أولوية على قائمة الدول وإتاحته للجميع، من أجل التخلص من معدلات الأمية والبطالة وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي أفضل في السنوات القادمة.
مؤسسات التعليم الخاص في الوطن العربي
تختلف منظومة عمل المدارس والجامعات في قطاع التعليم الخاص، في الوطن العربي عن الدول المتقدمة، وتختلف التكاليف المطلوبة للتسجيل والقبول فيها من دولة إلى دولة، لذلك من الصعب رصد تكاليفها أو أرباحها، ولكنها بطبيعة الحال، تعتبر جميعها مؤسسات ربحية استثمارية.
هذا ووفقًا لإحصائيات البنك الدولي، فإن خُمس التلاميذ في دول العالم الثالث يكملون تعليمهم في المدارس الخاصة، وهذه نسبة مضاعفة عما كان موجودًا قبل 40 عامًا، كما تشير الأرقام إلى أن نسبة التعليم الخاص في العالم العربي لا تقل عن 10%، ومنها المؤسسات الأجنبية التي تؤسس وفقًا لمعايير دولية ومتطلبات استثمارات كبيرة، عدا عن رسومها الباهظة والتي لا تكون غالبًا متاحة لجميع الفئات الاجتماعية، وتنتشر في دول الخليج مثل الإمارات وقطر بشكل خصوصي.
يرى البعض أن مؤسسات التعليم الخاص أنشئت لخدمة أبناء الطبقة البرجوازية، والتي لا تتجاوز نسبتهم من 5 إلى 7% من مجموع التلاميذ، والتي تهدف بشكل خاص إلى تجهيز هذه الفئة لتنصب أرقى المناصب في الدولة بغض النظر عن البقية.
ويرى البعض أن مؤسسات التعليم الخاص أنشئت لخدمة أبناء الطبقة البرجوازية، والتي لا تتجاوز نسبتهم من 5 إلى 7% من مجموع التلاميذ، والتي تهدف بشكل خاص إلى تجهيز هذه الفئة لتنصب أرقى المناصب في الدولة بغض النظر عن البقية، وهذه إشارة إلى غياب الإدارة العامة لوزرات التعليم في الوطن العربي، هذا بحسب رأي الباحث المصري كمال مغيث لموقع بي بي سي.
ورغم وجود العشرات من هذه المؤسسات في مختلف دول الوطن العربي منذ عام 1990، والتي قد يُعرف الكثير منها بالجودة التعليمية المذهلة، لا سيما في مجالات اللغة والمهارات العملية، إلا أن هذا لا يضمن توافر فرص العمل لجميع الطلبة عند تخرجهم.
المؤسسات التعليمية وسوق العمل
وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الخدمات العامة لعام 2014، فإن الشركات التجارية تحمل في جعبتها العديد من المنافع التي قد تلبي احتياجات قطاع التعليم تسد الثغرات التي يصعب التخلص منها دون مساعدة هذه التمويلات أو التدخلات التجارية.
وتوضيحًا للجانب الإيجابي للتجارة في هذا المجال، يذكر التقرير أن للتجارة القدرة على منح المؤسسات التعليمية الخاصة برامج تدريبية للطلاب، تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة في سوق العمل فيما بعد، وقد تساعد في إعداد الطلاب بالشكل المطلوب لسد الفجوات من الناحية المهنية والعملية، ولمساعدتهم على الاندماج في بيئة العمل دون قيود أو صعوبات أو نقص، وبذلك يكونوا مستعدين لتقديم أفضل ما لديهم من خبرة علمية وعملية في آن واحد، ودون إهدار للوقت.
ربط السوق بالتعليم الطريقة الأنسب للتخلص من مشاكل التعليم التقليدي والتركيز على تخصصات لها منافع اقتصادية على الدولة في المستقبل، وحالة التخبط الذي يعيشها العالم العربي بسبب فشله في إنتاج واتباع سياسات تعليمية ناجحة.
ففي دراسة نشرت عام 2013، تقول إن الشركات تعتقد أن هناك فجوةً بين المعرفة الأكاديمية والعملية لدى العاملين الجدد في سوق العمل، وهذا ما يضعف الثقة بين الشركات وأصحاب التعليم الحكومي، الذين يفتقرون إلى التدريب العملي والتفكير النقدي الضروري لمهن المستقبل، بعكس المؤسسات الخاصة التي تدعم الأنشطة البعيدة عن المناهج التقليدية والتي تشجع على الإبداع والابتكار.
ومثالًا على التجربة الناجحة في قطاع التعليم، يقول رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية في المغرب لـ بي بي سي “إن خصوصية المغرب العربي تكمن في طرح مشاكل التعليم للنقاش العام وإن كان ثمة تجربة يمكن النظر إليها في المنطقة فهي التجربة التونسية”
ويضيف أن “تونس حسمت في عدد من القضايا الإشكالية بشأن النموذج التعليمي الذي يجب السير عليه والتي تسببت في تردد دول أخرى وتأخرها، حيث ربطت التعليم بالسوق وركزت على تخصصات لها مردود اقتصادي، فتمكنت تونس من تحقيق أقل نسبة أمية فعلية في المغرب العربي، وارتفاع عدد الخريجين الجامعيين مقارنة بعدد السكان، كما أن مستوى البحث العلمي يكاد يكون الاهم في المنطقة من حيث كفاءته الدولية.”
ويعتبر بو دينار أن “الحل يكمن في بناء رؤية عن المجتمعات العربية وتحديد حاجياتها بشكل دقيق، فالتقارير الدولية تؤكد أن الدول العربية عاشت لفترات طويلة في حالة من التيه جعلتها تتخبط وتخفق في إنتاج سياسات تعليمية ناجحة”. ويأمل بودينار “في أن يؤدي التحول الذي تشهده المنطقة العربية إلى وضع مسألة التعليم ضمن الأولويات حتى لا ندخل في دورة إنتاج نفس الأزمة”.
إذ تكمن ضرورة معالجة هذا العجز من ناحية الانفاق والتفاوت في الجودة، بأهمية تنظيم وتطوير المتسوى التعليمي، وضمان منحه للجميع بمعايير عالية، حتى لا تُخلق مشاكل اجتماعية، وبالتحديد بين أبناء الجيل الواحد بسبب هذا التفاوت.