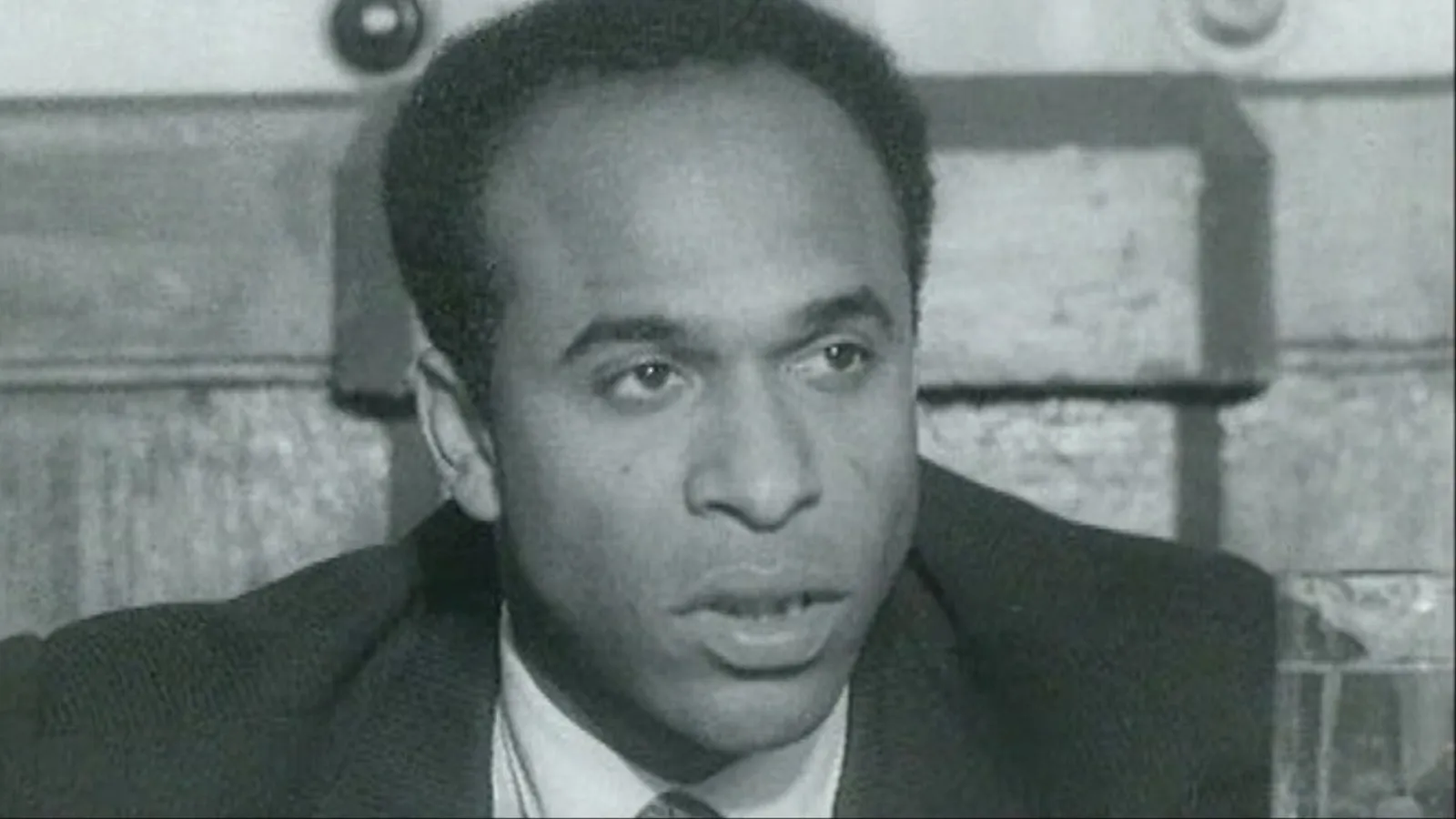بعد السابع من أكتوبر الماضي، برزت آراء بعض من النقاد والمفكرين الغربيين تجاه عملية طوفان الأقصى، وما ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وما تضمنهما من قتل وتجويع وتشريد لمئات الآلاف.
كانت من أبرز الأصوات المعلقة على ما حدث، الناقد الثقافي السلوفيني سلافوي جيجك والمنظرة الأمريكية جوديث بتلر، إذ كانت آراؤهما على التضاد، فقد أخذ الأول موقفًا أخلاقيًا صادمًا يتضمن ويبرر حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها من خلال قتل المدنيين الغزيين، أما الثانية، فوصفت ما تفعله “إسرائيل” بالإبادة الجماعية، ورأت أن حركة حماس، هي جزء من مقاومة تسعى للتحرر الوطني، رغم إدانتها ما فعلته في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
أنصاف الإنصاف
أخذت آراء بتلر احتفاءً واسعًا من المتابعين لها من أنصار التحرر الوطني وإنهاء الاستعمار في العالم الغربي، ومن بعض القراء والكتاب والمثقفين في العالم العربي، لكن لماذا إن أردنا الرجوع إلى أدبيات التحرر الحقيقة، يجب أن نتخلى عن آراء بتلر التي تُدين فعل المقاومة، والسعي نحو معرفة التنظير التحرري الحقيقي من أمثال الطبيب والمفكر الفرنسي فرانز فانون، الذي صنع تشريحًا وتفكيكًا وعميقًا حول الاستعمار وأدواته ومقاومته، وكيفية التخلص منه نفسيًا وجسديًا.
لم يكن الصراع في أي وقت سابق فلسطينيًا إسرائيليًا إلا بعد اتفاقيات التطبيع من أنظمة مصر والأردن، ومحاولاتهما المُستميتة في إقناع الشعوب العربية أن “إسرائيل” الآن، هي دولة مجاورة صديقة
لم تكن جوديث بتلر مثل المنظر والناقد الثقافي السلوفيني سلافوي جيجك أو حتى فيلسوف التواصل اللامع الألماني يورغن هابرماس، إذ اتخذ الاثنان مواقف تضامنية مع “إسرائيل” على ما وقع في السابع من أكتوبر بحق جيشها ومستوطنيها، بل وأيدا حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها، دون قيد أو شرط، ولم يوافقا على وصف ما تفعله “إسرائيل” من قتل وتجويع وتشريد لمئاتِ الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بالإبادة الجماعية، وأن “إسرائيل” هكذا، بكل عقلانية، لديها الحق في الانتقام لما حدث لها بالطريقة التي تراها، أو بوصف الطبيب الفرنسي من أصل مارتينيكي فرانز فانون أن ”مأساة الرجل الأبيض تكمن في أنه قد قتل، يومًا ما، شخصًا آخر، وإلى اليوم وهم يحاولون عقلنة هذا الموقف اللا-إنساني”.
كانت بتلر أكثر عقلانية وأخلاقية، في النظر إلى الأمر الواقع، التي عبرت من خلاله على أن حركة حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني، حركة وطنية تحررية تأسست منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، أي بعد قرابة 40 عامًا من إعلان الاحتلال الإسرائيلي تأسيس كيانه على الأراضي الفلسطينية، بعدما هجرت تنظيماته المسلحة مئات آلاف الفلسطينيين وأحلَّت نفسها مكانهم.
لكنها أيضًا تدين ما حدث في السابع من أكتوبر، لكنها لا تعتبر حركة حماس منظمة إرهابية، وتدعو للنظر إلى سياق الصراع بشكله التاريخي، لا الحدَثي الراهن، بما يشمل من انتهاكات إسرائيلية تعدت كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية.
ورغم إدانة بتلر لما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإنها تعرضت لحملات كراهية بحقها، وتضييق في كل ما تحضره من فعاليات وندوات أكاديمية وثقافية، بسبب أنها لم تؤيد حق “إسرائيل” في إبادة الشعب الفلسطيني.
يعد موقف بتلر موقفًا تقدميًا ومناصرًا للقضية الفلسطينية، لا سيما في الأوساط الثقافية الغربية التي يقف جزء من تيارها الثقافي النقدي مع بربرية الجيش الإسرائيلي، لكن نحن كعرب، ساكني الجنوب العالمي، نعتقد أن قضية احتلال فلسطين هي قضيتنا، إذ منذ بضعة عقود، كانت “إسرائيل” تقتل وتستبيح دول طوقها، مصر والأردن، وإلى الآن تستبيح سوريا ولبنان، ولم يكن الصراع في أي وقت سابق فلسطينيًا إسرائيليًا إلا بعد اتفاقيات التطبيع من أنظمة مصر والأردن، ومحاولاتهما المُستميتة في إقناع الشعوب العربية أن “إسرائيل” الآن، هي دولة مجاورة صديقة، وقضية الاحتلال، الفلسطينيون فقط هم أصحابها.
كل أشكال الاستباحة التي صنعتها، وتفننت في ممارساتها منظومة الاحتلال الإسرائيلي، جعلت من الفلسطيني لا يرضى فحسب، أن يفاوض المُحتل أو حتى القانون الدولي برجوع حريته، بل جعلت أن حتى حريته إن أُعطيت له ليست كافية
رغم أن آراء بتلر، أخذت شكلًا أكثر إنصافًا، على الأقل، فيما يخص إدانتها الواضحة لـ”إسرائيل” ووصف أفعالها بالإبادة الجماعية، فإننا نحن أصحاب القضية، يجب أن نعود إلى تنظير يأخذنا للإنصاف الكامل، لا إلى أنصاف الإنصاف.
تنظير يرسخ مفهوم السعي إلى معرفة حقنا الحقيقي في الدفاع عن أرضنا، وإنهاء الاستعمار بكل السبل الممكنة، ومن ضمن هذه السبل، وبلا أي مواربة أو انبطاح، هو تبني العنف، وبدلًا من الاستشهاد بمقولات بتلر، نستحضر فرانز فانون، هذا الطبيب والفيلسوف الذي شهد على الاستعمار الفرنسي والبربري بحق الشعب الجزائري، والذي لم يكتف برفضه، بل كان أحد منظري حق استخدام العنف تجاهه، كما شارك في جبهة التحرير الوطني الجزائري، في عملها الصحفي والإعلامي والتنظيمي والتنظيري.
العودة إلى فرانز فانون
“محو الاستعمار هو حدث عنيف دائمًا” يقول فرانز فانون، في كتابه الأشهر “معذبو الأرض” (1959)، ومع الكتاب الذي سبقه “بشرة سوداء، أقنعة بيضاء” (1952)، والذي أُخذَا دليلًا إرشاديًا حيًا إلى الآن لكل من أراد التخلص من ويلات الاستعمار والاستعباد، ويعني فانون العنف بمقولته – متأثرًا بحالة استعمار فرنسا الوحشي للجزائر التي شهدها -، أن الاستعمار هو بالأساس حدث عنيف، جاء واحتل واستوطن وأحلَّ بممارسات عنيفة تجاه الآخر، أصحاب الأرض، مثلما حدث في فلسطين. إذ جاء الانتداب البريطاني، وساعد التنظيمات الصهيونية المسلحة في الاستيلاء على الأرض، وقتل وهجَر من كان يسكنها، حتى تمكنوا فيما بعد، وخلال حرب 48 بين العصابات الصهيونية والجيوش العربية، والمجموعات الأُخرى المقاومة، من الاستيلاء على الأراضي التي تعرف الآن بالداخل الفلسطيني أو أراضي 48.
هكذا كان احتلال فلسطين حدثًا عنيفًا، فلن يزول إلا بممارسات شبيهة في العنف، حتى لو مضت مئات القرون، وما يؤكد ذلك، أن الأراضي التي استولت عليها “إسرائيل” بعد حرب يونيو 1967، وباعتراف أممي وقانوني، أنها أراض محتلة، ما زالت “إسرائيل” تُسطير عليها، وتتوسع في وجودها وسيطرتها، ونقل مستوطنيها إليها، في تعد صريح وغير آبه لحقوق الفلسطينيين والقوانين الإنسانية والدولية التي تجرم ممارسات الاستيطان.
أيضا من خلال تتبع ممارسات الفصل العنصري للاحتلال بحق الفلسطينيين، سواء في الداخل الفلسطيني أم في الضفة الغربية وغزة، يرى أي عاقل، حتى لو لم يكن فيلسوفًا مثل بتلر، أن هذه الممارسات، ما هي إلَّا ممارسات فوقية عنيفة، ترى الفلسطيني جسدًا مستباحًا آخر، لا يمتلك ذات الصفات الإنسانية التي يمتلكها الإسرائيلي، بل هو آخر، يمتلك جسدًا ووجهًا أدنى منه، حسب وصف الفيلسوف الفرنسي إيمانيويل ليفناس.
يحرص فانون على ترسيخ فعل الكرامة والمساواة في كينوتة المُستعمَر، لأنه إن أحس يومًا ما، أنه يمتلك درجة إنسانية أقل من مستعمِره فسيكون بمثابة اعتراف بموت الشعب المُستعمَر، وخنوعه لآلة الاستعمار
كل أشكال الاستباحة التي صنعتها، وتفننت في ممارساتها منظومة الاحتلال الإسرائيلي، جعلت من الفلسطيني لا يرضى فحسب، أن يفاوض المُحتل أو حتى القانون الدولي برجوع حريته، وزوال الاحتلال، بل جعلت أن حتى حريته إن أُعطيت له ليست كافية، بل الحرية يجب أن ينتزعها، أو كما يقول فانون “إن الرجل (أي الفلسطيني المُستعمَر) لا يمكن أن يكون إنسانًا، إلّا بقدر ما يحاول أن يفرض وجوده على إنسان آخر، من أجل أن يحصل منه على الاعتراف به”، وهنا يأتي هذا الاعتراف، من خلال قوة الفلسطيني التي فرضها بالعنف، وأجبرت المُحتل على الاستسلام، والخروج، واستردت حقها دون استئذان أو تفاوض متفق عليه.
كما دائمًا يحرض فانون، على عكس بتلر، التي أدانت عملية طوفان الأقصى بشكل مجرد، مع تفكيكها وتفهمها للسياق والدوافع، على عدم الاستسلام لكل منهجيات الإخضاع التي يمارسها المُستعمِر في حق أصحاب الأرض، بل يدعو إلى أقصى درجات مقاومتها، بداية بترسيخ مفاهيم الحرية والكرامة والمساواة داخل الكينونة الإنسانية، نهاية بممارسة العنف لتحقيق هذه المفاهيم، حتى لو نتج عن هذا العنف، فناء المستعمِر والمستعمَر، إذ يقول:
“إذا كانت حياتي في الواقع تساوي قيمة حياة المستعمِر، لم يعد بإمكان نظرته أن تثير الخوف فيَّ أو تثبيتي في مكاني على الفور، ولم يعد صوته يحجّرني أو (يقتلني). لم أعد أشعر بالقلق في وجوده. في الواقع، فليذهب إلى الجحيم”.
هنا تأتي تضحية المستعمَر كحل وخلاص ومنهج نحو التحرر، فالموت أفضل من حياة دونية تحت رحمة المُستوطن، بل عليه، أي المستعمَر، إدراك أنّه “منذ ولادته يجب أن يرى هذا العالم الضيق، أي الاستعمار، المزروع بأنواع المنع، لا يمكن تبديله إلا بالعنف المطلق”، كما أن العنف لا يكون مخلصًا، أو عنفًا مضادًا للعنف الكولونيالي فحسب، بل هذا العنف بمثابة ولادة جديدة للمستعمَر، لأن حياة المستعمَرين “لا تنشأ إلَّا من جثة المستعمِر المهترئة”.
هكذا تكون أدوار مثقفي التحرر، الكفاح من أجل معرفة وتطبيق مفاهيم الحرية والكرامة والمساواة، لا تكون تضامنًا باهتًا مفككًا، أو حتى منصف بدرجة ناقصة، فالمُثقف يصفه فانون أنه “ليس من الضروري فقط أن تُقاتل من أجل حرية شعبك. عليك أن تُعلّم الشعب مرةً أخرى، وأن تُعلّم نفسك أولًا، معنى المكانة الكاملة لإنسان ما؛ وهذا ما يجب أن تفعله ما دام القتال مستمرًا”.
إذ يحرص فانون على ترسيخ فعل الكرامة والمساواة في كينوتة المُستعمَر، لأنه إن أحس يومًا ما، بسبب ممارسات الإخضاع الواقعة عليه، أنه يمتلك درجة إنسانية أقل من مستعمِره، جسدًا، وجهًا، روحًا، أدنى منه، فسيكون بمثابة اعتراف بموت الشعب المُستعمَر، وخنوعه لآلة الاستعمار.
لكن ما فعلته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومع اختلافنا في تقدير مكاسبه ومآلاته السياسية والإستراتيجية، إلَّا أنه يتموضع ضمن فعل مقاومة، حرب تحرير، والتي يعرفها فانون على أنّها “جهد فخم يبذله شعب كان قد تحنّط، كي يُعيد اكتشاف عبقريته هو، ويُعيد الاستيلاء على تاريخه الخاص، ويؤكد سيادته”.