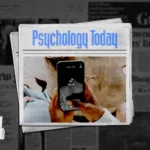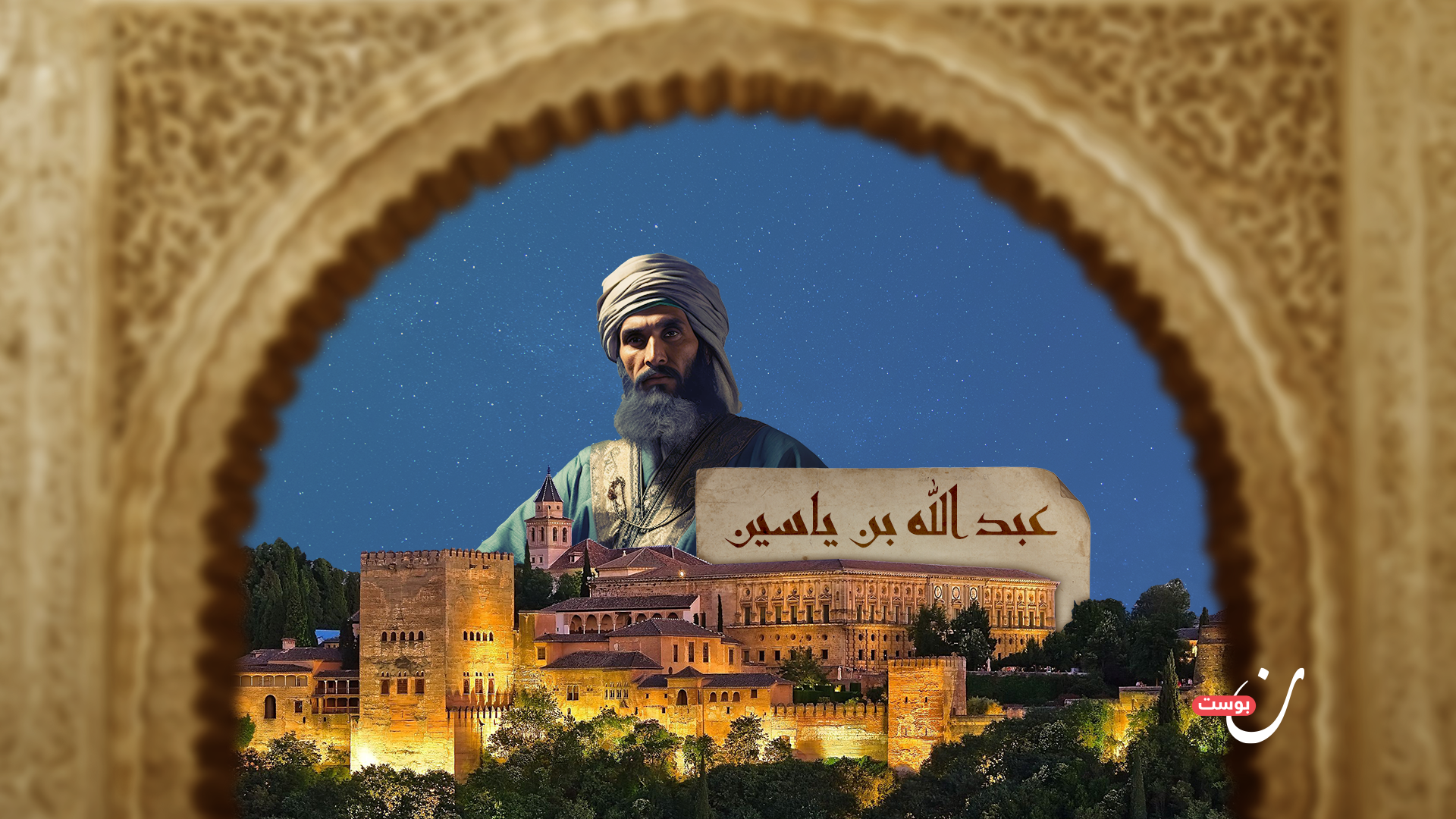على بُعد نحو 40 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة المغربية الرباط، ينتصب فوق سفح جبلي بمنطقة كريفلة مسجد شبه مهجور لم يكتمل بناؤه إلى غاية اليوم، وبجانبه بناء تاريخي أصابه النسيان، ضريح الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي، فقيه المرابطين وناشر الإسلام في الأصقاع الصحراوية.
أهملت السلطات المغربية ضريح المعلم والفقيه ابن ياسين الذي ارتبط اسمه بنشأة دولة المرابطين التي وحّدت المغرب الإسلامي وحكمت حوالي 90 سنة، لكن كُتب التاريخ حفظت مكانته وتناولت سيرته بإطناب، وخصصت له حيزًا كبيرًا حتى لا يطاله النسيان، وتتعرف الناشئة إلى علم من أعلام الأمة الإسلامية في منطقة المغرب.
ضمن ملف “الأمراء التسعة” نتعرف إلى الأمير عبد الله بن ياسين ومواقفه التاريخية وأدواره البارزة في نشأة دولة المرابطين ودفاعه عن دين الإسلام وتصديه للمذاهب الضالة في بلاد المغرب.
عبد الله بن ياسين
يعود نسب الشيخ عبد الله بن ياسين إلى قبيلة جزولة الواقعة في أقصى المغرب قرب جبال درن ضمن بلاد السوس، وهي قبيلة أمازيغية عاشت على طول ساحل المحيط الأطلسي في المغرب وموريتانيا حاليًّا، وشاركت في التجارة الصحراوية خاصة مادة الملح المستخرجة من نهر السينغال.
لا يُعرف بالتحديد تاريخ ولادة الشيخ بن ياسين، لكن بعض المراجع اتفقت أن مولده كان في أوائل القرن الخامس الهجري، من أب ملثم صنهاجي يدعى مكوك بن مسير بن علي وأمّ تسمّى تين يزامارن في تخوم صحراء سوس بالمغرب، في منطقة تتبع اليوم إقليم طاطا، وبالضبط من تمنارت.
عند ولادة ابن ياسين كان الإسلام هو الدين المنتشر بين القبائل الأمازيغية في المنطقة، فاجتهد في تحصيل العلوم الإسلامية ومعرفة تعاليم الدين السمحة والتفقّه أكثر، رغم أنه يعيش في منطقة نائية لا يصلها غير التجار الباحثين عن الربح الوفير.
اضطر الشاب اليافع إلى الرحيل مبكرًا عن خيمة والديه وخوض غمار معركة البحث عن المعرفة، وكانت الوجهة نحو بلاد الأندلس وتحديدًا مدينة قرطبة التي أقام فيها 7 سنوات (في عهد ملوك الطوائف)، وكانت قرطبة في تلك الفترة قبّة الإسلام وعاصمة الأندلس، وحاضرة العلم والعلماء العرب والعجم ومعقل خزائن المعرفة في شتى المجالات.
حصل ابن ياسين خلال سنوات إقامته في قرطبة على معارف كثيرة من أعلام الفكر وأئمة العصر آنذاك، وتمكّن من تنويع مصادره وإثراء معارفه الدينية من خلال المكتبات المتنوعة، وعُرف بين أقرانه بسرعة الحفظ والفهم ودقة الملاحظة وقوة العارضة في البحث والحجاج.
أخذ ابن ياسين على نفسه عهدًا ألا يستأثر بهذه المعارف ويساهم في نشرها بين طالبي العلم، فقد غلبت عليه الحماسة والحمية للدين والانشغال بأموره وقضاياه، عكس عامة سكان القبائل الذين امتهنوا القيام بالحرمات ونشر الرذيلة.
عند عودته إلى بلاد السوس، رأى ابن ياسين أهمية أن ينتظم إلى حلقة الشيخ وجاج بن زلو اللمطي، الذي أسّس مدرسة علمية سمّاها “دار المرابطين” لطلبة العلم والقرآن، وكان هدفه من وراء ذلك هو استكمال نشر الإسلام بين القبائل، وتطهير المنطقة من تأثيرات ونفوذ برغواطة، ومحاربة الشيعة البجلية بتارودانت.
تنوع شيوخ ابن ياسين وازدادت علومه، حتى أصبح فقيهًا في أمور الدين والدنيا، ومن أفضل رواد حلقة الشيخ وجاج بن زلو، وكانت له مكانة كبيرة في حلقة الشيخ، وهو ما يفسّر اختياره له للقيام بالمهمة الصعبة في أراضي قبائل صنهاجة الصحراوية.
المهمة الصعبة
كان ابن ياسين في حلقة وجاج معدًّا لطلبة العلم وقراءة القرآن، لكن سريعًا ما أصبح داعية ذاع صيته بين الأرجاء، إذ اختاره شيخه لمهمة دقيقة خشي منها العديد من العلماء وطلاب العلم لمخاطرها وصعوبة القيام بها، حيث أرسله إلى قبائل صنهاجة بطلب من زعيم قبيلة جُدالة يحيى بن إبراهيم الجُدالي، حتى يفقّههم في الدين ويقوّم أعمالهم، بناء على رسالة وجّهها أبو عمران الفاسي (فقيه مغربي أقام في القيروان) إلى الشيخ وجاج.
وصل ابن ياسين إلى قبيلة جُدالة، فيما يعرف حاليًا بجنوب موريتانيا، صحبة أميرها يحيى بن إبراهيم الجُدالي سنة 1040 ميلادي، وقيل قبلها بسنتَين (لا يعرف التاريخ الصحيح بالتحديد)، وكان كالجبل الأشم بعزيمة المؤمن وشدة الزاهد وربانية الداعي الرحيم، وهمّه تصحيح وتعميق معرفة قبائل صنهاجة بالشرائع الإسلامية، وقد أُعجب به زعماؤها واحتفلوا من البداية بقدومه وأقبلوا عليه لتعلم الدين والفقه، فقد كان خطيبًا موهوبًا قوي التأثير والإقناع وواسع العلم والمعرفة.
في بداية الأمر، منح الأهالي وقادتهم الشيخ القادم من بلاد السوس بالمغرب الأقصى مكانة كبيرة، إذ كانت إرشاداته مقتصرة على الصلاة والزكاة، ولكن سرعان ما انفضوا من حوله ووقفوا ضده لما تحدث لهم عن الزنى والقصاص وحدّ السرقة.
الرباط الأول
ثقل أمر الشيخ ابن ياسين ونهيه على أهالي جدالة، فنفروا منه وثاروا عليه وحاولوا قتله، وقيل إنهم هدموا داره ونهبوا ما فيها، ما اضطره إلى اعتزال القوم والانحياز في رحلة تعبُّدية صحبة رفيقه في الدعوة والجهاد يحيى ابن إبراهيم الجدالي إلى جزيرة تيدرة التي تقع على بُعد 180 كيلومترًا شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط حاليا، ضمن خلجان من المحيط الأطلسي.

أقام الشيخ ابن ياسين في هذه الجزيرة المطلّة على منطقة من اليابسة في بلاد شنقيط (موريتانيا حاليا)، خيمة بسيطة للعبادة وطلب العلم ونشر الإسلام سمّاها “رباطًا”، إسوة بشيخه وجاج بن زلو اللمطي، وصحبه هناك نفر قليل (منهم الأمير يحيي بن إبراهيم)، تراوح عددهم ما بين 5 إلى 7 أشخاص، وهناك علّم الشيخ عبد الله بن ياسين أصحابه تعاليم دين الإسلام الصحيح بعيدًا عن الضلالة التي كانوا فيها، فاشتدَّ تأثيره عليهم وسمع الأهالي بهم.
ورأى الشيخ بن ياسين أن يبعث برسالة إلى أهل جُدالة يخبرهم فيها بمكان رباطه، ويطلب منهم الالتحاق به للتعلم، فبدأت الجموع تتوافد عليه، وحين ضاقت عليهم الخيمة أقاموا خيمة ثانية فثالثة فرابعة، واستمر العدد في الازدياد حتى بلغ عددهم نحو 1000 شخص، وانضم إليهم الأمير يحيى بن عمر اللمتوني زعيم قبيلة لمتونة الصنهاجية وكامل أفراد قبيلته وذلك خلال 4 سنوات من بداية دعوته.
وتمحورت وظائف رباط ابن ياسين في 3 مجالات، الأولى تربوية، والثانية تعليمية، أما الثالثة فهي دعوية وجهادية، وذلك حتى أصبح ابن ياسين أمير الرباط وتحت جناحه أتباعًا يطلق عليهم لقب “المرابطين” يقودهم بالشدة والصرامة، سعيًا لإتمام رحلة الدعوة الإسلامية وتوسيع آفاقها.
وأعلن حينها الشيخ ابن ياسين أن القَبَلية مخالفة لشرع الله تعالى، ولذلك من الواجب الديني على المسلمين أن ينحوا خلافاتهم القَبَلية جانبًا، حتى تعلوا كلمتهم ويتمكنوا من نشر دين الإسلام بين باقي الناس المنتشرين في أقاصي الصحراء.
الجهاد في سبيل الله
رغّب الشيخ ابن ياسين المرابطين القادمين من مختلف القبائل الصحراوية بالجنة وحذرهم من عذاب الله الشديد، ولما أحسَّ أن نفوس القوم قد هدأت واستقر فيها عبق الإيمان، أسرج خيل الجهاد ودعا أنصاره إلى إعادة الفتح ونشر دين الإسلام القويم بين القبائل، فدعا الشيخ ابن ياسين أتباعه المرابطين للخروج إلى قبائل صنهاجة المنتشرة في الصحراء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى التوبة النصوح.
لم ينفع الكلام الطيب ولا الوعيد، وأعرض أغلب القوم عن اتباع دعوة ابن ياسين وجماعته، فاضطر الفقيه إلى حمل السيف ضدهم، وأذن ليحيى بن إبراهيم (المسؤول العسكري عن المرابطين) بتجهيز الجيش لإقامة حد الله والجهاد.
حارب الشيخ ابن ياسين في البداية الجيوب المذهبية المضادة للمذهب المالكي، وخاض عديد الفتوحات ضد القبائل الصنهاجية التي ثارت ضد دعوتهم، كجدالة ولمتونة ومسوفة، وتمكنوا في وقت قصير من السيطرة على مناطق واسعة من الصحراء وتوحيد عديد القبائل المنتشرة هناك، ونشروا دعوتهم بين الناس وزادت قوتهم وصيتهم.
خلال دعوته مات رفيق درب الشيخ ابن ياسين الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي في حروب بلاد السودان، فقدّم الفقيه يحيى بن عمر اللمتوني أميرًا للجماعة، واختصَّ هو بالمسألة الدعوية والتوجيه الروحي والفكري، ومع ذلك لم يعتزل العمل العسكري إذ شارك في العديد من الغزوات إلى جانب أتباعه.
أبرز معارك الشيخ ابن ياسين فتح مدينة سجلماسة التي كانت تمثل بوابة أساسية في المسالك التجارية التي تربطها بأودغست عاصمة إمبراطورية غانا في الجنوب (كانت إمبراطورية غانا الممتدة على مناطق واسع جنوب الصحراء في ذلك الوقت المنافس الأكبر لدعوة الشيخ بن ياسين)، في مسعى منه للحصول على قوة مادية ثابتة يستطيع بواسطتها تحمل نفقات تحركات المرابطين العسكرية.
واصل الشيخ ابن ياسين الزحف شمالًا وقصد عاصمة السوس مدينة تارودانت، التي كانت بها طائفة من الشيعة يقال لها البجلية نسبة إلى مؤسّسها عبد اللّه البجلي، فقام بفتحها، ثم أخضعوا قبائل زناتة وانضم إليهم قبائل المصامدة، ومع اشتداد قوة المرابطين انضمت عديد القبائل إليهم دون قتال.
ترافقت فتوحات الشيخ ابن ياسين مع إقراره إصلاحات مالية مهمة، استفاد منها سكان القبائل، إذ رفع المظالم عنها واكتفى بالجباية الشرعية، وهو ما ساعده في استقطاب مزيد من المرابطين، فكثر أنصاره واستكملت قوته العسكرية حتى قادت إلى توحيد قبائل صنهاجة.
توسعت راية المرابطين وبدأوا رحلتهم الأصعب وهي القضاء على إمارة برغواطة، وشكّلت هذه الإمارة التي نشأت على يد مدّعي النبوءة صالح بن طريف في القرون الوسطى على الساحل الأطلسي للمغرب، وضمت مجموعة من قبائل مصمودة خصمًا قويًّا للشيخ ابن ياسين سياسيًّا واقتصاديًّا، لذلك خصّص جهدًا ووقتًا كبيرَين لقتالها حتى يحكم كلمة الله فيها.

ويذكر أن أمير هذه الجماعة أقام ديانته الجديدة بين أشتات متناقضة من الإسلام واليهودية ووصل به الأمر للجنوح إلى الديانات المجوسية والطقوس الوثنية وبعض أفكار مذهب الخوارج الصفرية في التكفير، واختط لأتباعه كتابًا جديدًا من 80 سورة، وقد تبعه نفر كبير لانتشار الجهل بين الأمازيغ آنذاك.
ورغم تقدمه في السنّ، اختار الشيخ ابن ياسين قيادة الحرب ضد بوغراطة حتى يقضي عليها ويطهر أرض المغرب من تقاليدها البالية التي تنشرها بين الأهالي، وقد تمكن من إضعافها وفتح الطريق لتدميرها، لكنه استشهد عشية يوم الأحد 24 جمادى الأولى سنة 451 هجري في ميدان الحرب بمنطقة تامسنا بالشمال الغربي للمغرب الأقصى، وكان قد أوصى المرابطين بعدم التراجع ومواصلة مطاردة البوغراطيين، ودفنه عند آخر نقطة يمكنهم الوصول إليها.
وصل المرابطون إلى قمة ربوة في وادي كريفله في قبيلة زعير على بُعد 50 كيلومترًا من مدينة الرباط، فقاموا بدفن جثمان الشهيد ابن ياسين هناك، وعلى ضريحه نُقشت عبارات خالدة تصف مسيرة الشيخ: “هذا ضريح الفقيه الصالح والعالم الناصح مولانا عبد الله بن ياسين الجزولي مهدي المرابطين لدولة لمتونة، توفي رحمه الله شهيدًا في حرب برغواطة سنة إحدى وخمسين وأربعمئة هجرية، وكان شديد الورع في المطعم والمشرب”.
تمكن الشيخ ابن ياسين بفضل قدراته العلمية وحكمته السياسية من تحويل الرِّباط الذي أسّسه في الصحراء من مكان للتعلم والعبادة إلى مكان لإعداد أتباع مخلصين يحملون لواء الجهاد لنشر الدين الإسلامي، فكانت لهم الكلمة العليا وشكّلوا دولة قوية حكمت بلاد المغرب وجزءًا كبيرًا من الصحراء، وحفظت كرامة الأندلس لنحو قرن من الزمن.