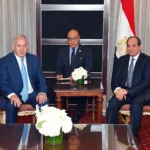ترجمة وتحرير: نون بوست
عندما كنت أبلغ من العمر 14 سنة كان يراودني حلم لن أنساه أبدا. وعلى الرغم من أنه لم يكن دراميا أو يستحق أن يتحول إلى قصة سينمائية، إلا أنه لا يزال عالقا في ذهني بعد مرور كل هذه السنين.
لقد وجدت نفسي أتجول في أروقة لامتناهية لقصر قديم وغريب. وقد أكدت بيوت العنكبوت التي زينت الأثاث الكثير في القصر، بأن المكان مهجور منذ سنين. على الرغم من أنه متروك إلا أن الكهرباء كانت تشتغل، وقد منحت تلك المصابيح الكريستالية المزخرفة والثريات توهجا قاتما إلى ملامحه الكئيبة. لم أشعر بالخوف حينها ولكن راودني شعور بالقلق. وكما تفعل شخصيات أفلام الرعب، فقد شعرت برغبة شديدة تدفعني نحو اكتشاف المكان، حتى وإن كان الرعب هو ما ينتظرني. وجدت في المرآب عربة متهالكة شبيهة بتلك العربات التي تجرها الخيول. ووجدت في غرفة الطعام وليمة منصوبة وما من شخص لتناولها. كما اعترضني أثناء تجوالي في القصر الكثير من المصابيح الكريستالية، ولا بد أن الآلاف منها قد أضاءت طريقي، ثم استيقظت.
لقد أثارت الأحلام حيرة الإنسان منذ بداية التاريخ المسجل. ففي مصر القديمة، مثلا، اعتبر الأشخاص الذين يروون الكثير من الأحلام الحية أنه قد وقع مباركتهم بنظرة خاصة، في حين سجلت العديد من أحلامهم على ورق البردي. في الحقيقة لقد آمن المصريون بأن الأحلام تعد أفضل طرق تلقي الوحي الإلهي، حتى أن البعض كان ينام على “أسرة الحلم” المقدسة بهدف تلقي الحكمة من الآلهة.
أما في القرنين التاسع عشر والعشرين، تخلى العلماء نهائيا عن هذه الأفكار الخارقة للطبيعة. وقد توصلت بعض الشخصيات البارزة على غرار سيغموند فرويد وكارل يونغ إلى نتيجة مفادها أن الأحلام توفر لمحة عامة عن عمل أدمغتنا في الداخل. ففي كتابه “تفسير الأحلام”، تحدث فرويد بشيء من التفصيل عن النظام المعقد لتحليل الأحلام. وتناولت نظريته في جوهرها إنتاج العقل اللاواعي لصور قد تمنحنا لمحة دقيقة عن أعماق أنفسنا في الوقت الذي ينام فيه عقلنا الواعي.
من المرجح أنه من بين الأسباب التي تجعلنا نخلد للنوم، السماح للدماغ بتقوية ذاكرتنا وتنظيمها
بغض النظر عما إذا كانت الأحلام قادرة على التنبؤ بالمستقبل أو السماح لنا بالتواصل مع العالم الغيبي أو بكل بساطة توفير فهم أفضل لأنفسنا، كانت عملية تحليلها رمزية للغاية. ولفهم معنى الأحلام، علينا أن نعمل تأويلها، وكأنما كتبت برموز سرية. ومن خلال إجراء عملية بحث سريعة في قاموس الأحلام على الإنترنت في “دريم مودز. كوم”، ستعلم أن المنازل المسكونة في الأحلام ترمز إلى “الأعمال العاطفية غير المكتملة” أما المصابيح الخافتة فتحيل إلى أنك “تشعر بإرهاق جراء المشاكل العاطفية”، بينما تعني رؤية الوليمة في المنام “فقدان التوازن في الحياة”، وترمز المرائب إلى الشعور “بالتوهان والابتعاد عن طريق تحقيق الأهداف”.
بالتالي، فحلمي الذي رأيته وأنا في الرابعة عشر من العمر يعني أنه كانت تنتابني العديد من المشاعر حيال عدم التوازن والتوهان الذي أعاني منهما في حياتي. لكن ماذا لو لم يكن هناك رمز سري، وأننا أضعنا برهة من الدهر في محاولة قراءة مجموعة من الصور العشوائية، تماما كما يفعل من يجد أشكالا وأشياء مخبأة في الغيوم؟ ماذا لو لم يكن للأحلام أي معنى؟
في الواقع، تعد هذه هي النتيجة التي توصل إليها البعض من علماء الأعصاب المعاصرين، من الذين يؤمنون بأن الأحلام ليست إلا مجرد تأثير جانبي لأكثر العمليات العصبية أهمية. وفي حين أنه من الشائع الاعتقاد بأن الدماغ قد يتوقف عن العمل خلال النوم ، إلا أن الباحثين يعلمون الآن أن النوم يعد فترة يتكاثف فيها النشاط العصبي. ومن المرجح أنه من بين الأسباب التي تجعلنا نخلد للنوم، السماح للدماغ بتقوية ذاكرتنا وتنظيمها، حيث يجب على أدمغتنا أن تعزز بشكل مستمر تلك الذكريات التي خزناها، ليكون بذلك أشبه بالحاسوب الذي يقوم بين الفينة والأخرى بتحسين أداء قرصه الصلب.
من هذا المنطلق، يمكن أن ننظر إلى الأمر على أنه أشبه بتنظيف منزلي عصبي، حيث يتم خلال هذه العملية التخلص من التجارب غير المهمة التي خضتها في الأيام الماضية والاحتفاظ بالتجارب المهمة وجعلها في مأمن. وقد أظهرت الدراسات، على سبيل المثال، أن تذكر الأفراد للمهام التعليمية المكتسبة حديثا يكون أفضل بعد النوم. كما أثبتت أن الأفراد قد يعانون من اضطرابات في الذاكرة في حال انقطعوا عن النوم. ومن هذا المنطلق، غالبا ما يحث الأولياء والمعلمون الأطفال على التمتع بنوم جيد قبل إجراء الاختبارات.
لم يقع التوصل إلى حد الآن إلى إجماع بين العلماء حول غياب المعنى أو الهدف في الأحلام
عموما، يعتقد الكثيرون أن الأحلام قد تكون نتيجة غير مقصودة لهذه العملية وغيرها من العمليات العصبية التابعة لها، وإن خالفهم في ذلك الكثير من الباحثين. من جانبهم، اقترح الطبيبين النفسانيين، آلان هوبسون وروبرت ماكارلي من جامعة هارفارد أن تفعيل نشاط مختلف الدارات العصبية خلال الليل، من شأنه أن يطلق العنان للأحاسيس والعواطف والذكريات العشوائية بالأساس. ونظرا لأننا مخلوقات تلاحق المعنى، تجمع أدمغتنا كل ما سبق من نشاطات عصبية لتصنع منها قصة. ولكن هذه القصة لا تحمل أي معنى، حيث تعد ببساطة محاولة لفهم النشاط العصبي الذي حدث. نتيجة لذلك، تبدو الأحلام غريبة وغير منطقية.
إذا لماذا يتمسك الناس بشدة بالقواميس المفسرة للأحلام؟
قد يكون للأمر علاقة بما وصفه الباحثون “تأثير بارنوم”، الذي اكتسب اسمه من منظم العروض بي تي بارنوم. وقد أثبت أستاذ علم النفس، بيرترام فورير هذا التأثير لأول مرة في سنة 1948، عندما عمل على إنجاز اختبار وهمي شمل 39 طالبا من طلبته، فيما يتعلق بالجانب الشخصي لكل منهم. وقد تسلم كل طالب التقييم نفسه ولكنهم لم يعلموا بذلك. وتضمن التقييم عبارات من قبيل “لديك رغبة شديدة في كسب اعتراف وإعجاب الآخرين” أو “كثيرا ما تنتقد نفسك”.
إثر ذلك، طلب من الطلاب اسناد تقييم من خمس درجات حول مدى دقة هذه النتائج. فكان معدل التقييم مثيرا للدهشة وهو 4.3 من 5، مما يشير إلى أن الجميع قد شعر بأن الاختبار قدم بيانا يكاد يكون مثاليا في توصيف عمل أدمغتهم، علما وأن الجميع تلقوا الملاحظات الوهمية ذاتها. وقد توصلت عشرات الدراسات إلى النتائج ذاتها التي توصل إليها فورير خلال العقود المنصرمة، وذلك من خلال ربطها بالأبراج وتحليل خط اليد وحتى تفسير الأحلام.
لقد كان من السهل تقبل “تصريحات بارنوم” على أنها صحيحة، لأنها يمكن أن تنطبق على قدر كبير من الأشخاص. ولئن بدت دقيقة، فهي قد تتناسب تقريبا مع أي شخص، تماما مثل التفسير الذي حظيت به فيما يتعلق بحلمي عن المنزل المسكون. ألا يبدو أن “تنتابني مشاعر مختلفة حيال عدم التوازن والتوهان في حياتي”، أمرا ينطبق عمليا على أي شخص ولو بمقدار معين؟ لذا يمكن بكل منطقية أن نطرح السؤال نفسه حول غالبية التفسيرات التي تقترحها قواميس تفسير الأحلام. ففي حال أمكن تطبيق كل تلك التفسيرات على أحلام الجميع تقريبا، فهذا يعني أنها غير دقيقة ولا تتناسب مع أي شخص.
تساعدنا الأحلام على التعامل مع تجاربنا المرهقة بشكل صحيح
في المقابل، لم يقع التوصل إلى حد الآن إلى إجماع بين العلماء حول غياب المعنى أو الهدف في الأحلام ، حيث اقترح الباحثين توري نيلسن وروس ليفن نظرية وسطية بين نظام الأحلام لفرويد الذي يستند على الرمزية السحرية والنظرية التي ترى بأن الأحلام أمر اعتباطي. وتعرف نظريتهم”بنموذج المعرفة العصبية للأحلام”، التي تعد معقدة، على أقل تقدير، ويستحيل تفسيرها بالكامل في هذا المقال.
في حين تتمسك هذه النظرية بفكرة أن الأحلام على صلة وثيقة بعمليات تعزيز الذاكرة العصبية، فذلك لا يعني أنها عشوائية. في الأثناء، يرى نيلسن وليفن أن القصص، التي ينسجها الدماغ بالاستناد إلى صور الأحلام العشوائية، يقع التحكم فيها من قبل حالاتنا العاطفية، وذلك على الأقل في جزء منها. فعلى سبيل المثال، يزيد تنامي التجارب السلبية التي نمر بها في حياتنا في اليقظة، من احتمال رؤيتنا للأحلام السلبية. ويفسر هذا الأمر السبب الذي يجعل الأشخاص الذين تعرضوا لصدمة ما أكثر عرضة للكوابيس من غيرهم. ووفقا لنظرية نيلسن وليفن، تتمثل إحدى أبرز وظائف الأحلام ت فيما اصطلحا عليه “التخلص من الخوف”.
في الحقيقة، تساعدنا الأحلام على التعامل مع تجاربنا المرهقة بشكل صحي،من خلال وضعها في حالة جمود حتى لا ترهقنا المشاعر السلبية خلال يقظتنا. وعندما تتم هذه العملية بشكل صحيح، تستخدم الأحلام الإجهاد ومشاغل اليقظة على اعتبارها مواد مرجعية، فتفككها وتجمعها في شكل قصة غريبة ولكن غير مضرة، عموما. وعادة، يسمح لنا هذا الإجراء حتما بتجاوز ذلك الإجهاد والمشاغل الحياتية.
على الرغم من أن نظرية المعرفة العصبية للأحلام ترى أن تلك الرموز الخاصة في حلمي بشأن البيت المسكون لا تحمل أي دلالة موضوعية أو عالمية قد أجدها بين طيات قاموس تفسير الأحلام، إلا أن تلك المشاعر الشاملة التي عشتها في ذلك الحلم قد تحيل إلى معنى ما. وتماما مثل أي طفل يبلغ من العمر 14 سنة، فقد كنت شابا يافعا يواجه ضغوطا تتزامن مع سن المراهقة. وقد تجسد ذلك في تلك المشاعر التي ظهرت من خلال حلمي.
على العموم، قد تخبرنا الأحلام التي لا تستشرف المستقبل ولا تعبد لنا طريق التواصل مع عالم ما وراء الطبيعة ولا تمنحنا أي لمحة دقيقة حول أعماق عقولنا اللاواعية شيئا عن مشاعرنا، نظرا لأن بعضنا قد يفقد بين الفينة والأخرى الصلة بمشاعره. وبالتالي، قد يكون هذا المؤشر مفيدا جدا. بعبارة أخرى، في حال كنت تعيش سلسلة من الأحلام السيئة، فقد يكون من الأجدر أن تتحقق من مشاعرك. في الأثناء، يمكنك القيام بأمر ما قد يساعدك في تحسين مزاجك. وكخطوة أولى، أقترح عليك أن تتخلص من قاموس تفسير الأحلام.
المصدر: سايكولوجي توادي