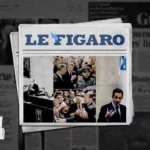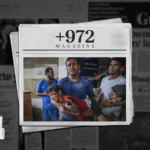رافقت المجاعة المتعمدة تاريخ الإنسان، ففرضتها أنظمة الاستعمار في الحروب والنزاعات، أو أسهمت فيها أنظمة الحكم الوطنية في الحروب الأهلية وأيديولوجيات التقشف الاجتماعية والاقتصادية. وقد عرف الفلسطيني التجويع مراتٍ عديدة بفعل الإسرائيلي أو بفعل البريطاني، كما عرفه العربي المعاصر والقديم في المشهد الأكبر، ومات الإنسان بالتجويع أكثر مما مات بالسيوف والمدافع.
والآن مع عودة شبح المجاعة في شمال القطاع ودخول حرب الإبادة الإسرائيلية شهرها التاسع، تعود ذكرى شهورٍ مضت حين أكل الناس طعام الدواب وسقطوا بين مغشي عليه وشهيد، وارتقى الأطفال من الجفاف وسوء التغذية وعانى الناس من التسمم الغذائي والأوبئة المنتشرة، وجمعوا الطحين من بين الشوك والتراب وعجنوه بالدم والمجازر.
فما ملامح المجاعة في القطاع؟ وكيف أثمرت تصريحات يوآف غالانت وإيتمار بن غفير بقطع الطعام والماء والوقود مع بداية الحرب؟ أي هدف تبتغيه المجاعة؟ وكيف مهّدت “إسرائيل” لتجويع القطاع؟ وما الذي يقوله العالم فيها بين موقف معلن وآخر مخبأ؟ يحاول هذا المقال التأطير لثقافة المجاعة ومآلاتها في القطاع.
في البدء كان الحصار
التجويع واسع النطاق الذي يُعرف اصطلاحًا بـ”Large scale starvation” يأتي نتيجة عملية طويلة هادئة وغير مكلفة، بخلاف ما يعتقده البعض من كونه أثرًا مباشرًا للأعمال العدائية، ويسعى إلى تحقيق مكاسب حربية وسياسية واقتصادية
والعملية طويلة الأمد تعتمد إضافة إلى قطع طرق وشبكة المواصلات وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الخارجية والواردات، على تدمير الاقتصاد الزراعي والمصنوعات الغذائية الداخلية بتدمير المحاصيل والبنى التحتية وآبار المياه ومنظومة الري.

وقد عمد الاحتلال الإسرائيلي لعقود سبقت الحصار المباشر الخانق على القطاع، إلى إفراغ الأخير من قدرته الإنتاجية وتحويله إلى مستهلك للمساعدات الخارجية بنسبة 90% مع التحكم الكامل بالمعابر والحدود وإطباق خانق على مقدرات الجو والبحر.
وحتى قبل السابع من أكتوبر، أشارت الإحصاءات إلى أن 1.2 مليون غزي من أصل 2.2 مليون كانوا يعانون من نوع من انعدام الأمان الغذائي بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد، أما بعد السابع من أكتوبر، فـ4 من أصل 5 من الناس الأكثر جوعًا في العالم موجودون في القطاع وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.
ورغم أن المجاعة القاتلة في القطاع اليوم تبدو عنصرًا مستجدًا ومرتبطًا بالعدوان الدموي الأخير على القطاع، فإن سياسة الاستنزاف والمحاصرة والتجويع البطيء بدأت فعليًا مع احتلال عام 1967 حين بدأت “إسرائيل” بتطبيق سياسة عاكسة لمسار التطوير تُعرَف باسم “de-development policy”.
وظّفت خلالها عدة تكتيكات لضرب الصناعة الغذائية الغزية كمكوّن رئيس لاقتصادها، فاستوردت العمالة الغزية الماهرة وشغلتها في محاصيلها الزراعية، وأغرقت السوق الغزي بالمنتج الإسرائيلي الرخيص مشكّلة منافسة غير عادلة للمحصول الغزي المكلف لارتفاع كلفة المواد الأولية، في الوقت الذي منعت فيه تصدير المحاصيل الغزية من معابرها لبقية العالم فدمرت بذلك محاصيل الذرة والفراولة والورد الغزي ومنعت حفر الآبار لتجميع مياه المطر، بينما ربطت منظومة الري كاملة بالزر الإسرائيلي وتحكمت في مضخات المياه بإحكام السيطرة على الوقود.
استولت “إسرائيل” على أكثر الأراضي خصوبة في غزة وبنت عليها مستعمراتها التي شكلت أكثر من 25% من أرض القطاع قبل أن تعلن تفكيك مستعمراتها في 2005 والاستعاضة عنها بمنطقة عازلة مسيجة بالأسوار الكهربائية حيث يتم إطلاق النار على من يقترب منها من الغزيين، لكن نقطة المقتل للاقتصاد الغزي كانت الخنق بالمعابر، وقد شرع شارون بتطويق القطاع بالسور الواقي نهاية تسعينيات القرن الماضي فعزلها عن اتصالها الوثيق بالضفة والقدس والداخل الفلسطيني، بعد أعوامٍ قليلة من توقيع اتفاقية أوسلو ومنح السلطة الفلسطينية “حق” الإدارة الذاتية في القطاع والضفة.

سيطرت “إسرائيل” على كل المعابر البرية الرابطة بين القطاع وبقية الأرض الفلسطينية ولم يتبق إلا معبر رفح الذي سلمته صوريًا للإدارة المصرية وتحت إشراف الاتحاد الأوروبي، بينما أحكمت سيطرتها الفعلية عليه بأيدٍ عربية مسلمة.
لم يبق للقطاع إلا البحر، الذي لم يسلم هو الآخر من التضييق الإسرائيلي، فحددت الأخيرة مسافة الصيد بما يترواح بين 6 و15 ميلًا بحريًا لم ترق للحد الأعلى إلا في مناطق وأوقات محدودة وعلى حدود مصر فقط، وذلك من أصل 20 ميلًا بحريًا تم تحديدها وفقًا لاتفاقيات أوسلو، كما لم تسلم مراكب الصيادين من النار الإسرائيلية بين وقت وآخر حيث تحوطهم السفن الحربية وتعلن سيادتها على البحر بما فيه.
أما مصر العربية فقد أعلنت عام 2009 بدءها العمل على تشييد جدار معدني بعمق 30 مترًا تحت الأرض وعلى امتداد 10 كيلومترات على حدودها مع قطاع غزة بحجة حماية الأمن القومي من عمليات تهريب السلاح عبر الأنفاق إلى داخل قطاع غزة، وضاعفت من بناء الأسوار الشائكة والخرسانية حول القطاع في خضم الحرب الحالية على القطاع، حائلة دون دخول نحو ألفي شاحنة متكدسة على حدودها ومشاركة في مسرحية هزلية لإنزالات جوية لا تكاد تكفي قرية صغيرة، ناهيك بمليوني لاجئ يقطنون رفح، بينما سقط أكثرها في البحر أو في تجمعات المستوطنين بالغلاف، مشاركة بذلك بشكل مباشر وفعلي بتجويع أهل القطاع.
إحكام الخناق
التضييق المتواصل والممتد على الأرض وفي الزمان مهد لظهور الدور الاحتكاري للأونروا كمصدر أساسي لإدخال الغذاء إلى القطاع، ما سهّل التحكم في لقمة الأهالي، حيث ترأس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة منظمات العمل الإغاثي التي تعمل إلى جانب القطاع الخاص ذي الأثر المحدود، بتوزيع المساعدات الغذائية القادمة إما من معبر رفح وإما معابر أخرى تتحكم فيها “إسرائيل”، لأكثر من 80% من سكان القطاع ينحدرون من لاجئين و90% يعتمدون على المساعدات الخارجية بشكل أساسي.
تكشفت آثار هذا الاحتكار في الأزمة الأخيرة المرافقة للحرب الحالية على القطاع، فـ”إسرائيل” أحكمت إطباقها على مصادر الغذاء مغلقة المعابر وسامحة بعدد قليل لا يكفي 10% من حاجة القطاع اليومية من شاحنات المساعدات الغذائية والتي وصلت في أحسن أحوالها لـ100 شاحنة من أصل 500 شاحنة يومية.
في الوقت الذي أغلقت فيه الأونروا مخازنها بحجة عدم مواءمة الظروف الميدانية للحرب لتوزيع المؤن، لتقوم “إسرائيل” علاوة على ذلك بقصف أكثر من 30 مستودعًا للغذاء منها مستودعات الأونروا وعدد غير محصور لمحلات البقالة والمخابز ومصانع الغذاء، وذلك قبل أن تشن “إسرائيل” وحلفاؤها الغربيون حربًا شعواء على تمويل الأونروا بزعم مشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر، ليتم بذلك خنق شريان رئيس لغذاء القطاع.

ولا يأتي عدد الشاحنات الشحيحة المسموح بدخولها اعتباطًا، فقد كشف تحقيق قديم لصحيفة هآرتس عمره أكثر من 10 أعوام عن وجود خطة إسرائيلية وُضِعت عام 2007 تحت قيادة إيهود أولمرت تدعى بوثيقة “الخطوط الحمراء” وقد حددت هذه الوثيقة ما يُمنع من دخول قطاع غزة بعد إطباق الحصار عليه خنقًا لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ووجودها الجماهيري في القطاع.
وكان من ضمن هذه التعليمات تحديد الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي تسمح “إسرائيل” بإدخالها دون المخاطرة بإحداث مجاعة، يعني تلك التي لا تشبع الغزي ولا تقتله جوعًا.
وقد وصل العدد النهائي لتلك الشاحنات بعد حساب المنتج الزراعي المحلي وعدد السكان البالغ آنذاك 1.4 مليون غزي إلى 100 شاحنة يوميًا، وحتى تطبيق هذه المعادلة الإجرامية أصبح هو الآخر حلمًا في ظل العدوان الحالي، حيث تتكدس الشاحنات على معبر رفح دون السماح لها بالدخول، ويقف المستوطنون على معبر كرم أبو سالم لمنعها من دخول المعبر في ظل قطاع زراعي مدمر وعدد سكان فاق 2.2 مليون غزي.
تسعى “إسرائيل” خلال العدوان القائم إلى تثبيت أركان الجوع الذي تفرضه على القطاع لتضمن هجرة دائمةً للسكان وتضييقًا شديدًا على من بقي بانتهاج سياسات تحيل القطاع إلى أرض غير قابلة للحياة.
تتنوع هذه السياسات بين سياسات بيئية تستهدف الأرض مثل ضخ ماء البحر في عدد من أنفاق المقاومة واستخدام أسلحة كيميائية وغازات سامة، فضحها نمو فطريات قاتلة أودت بحياة جنود إسرائيليين تواجدوا على أرض القطاع، وسياسة الأرض المحروقة التي أعطبت التربة وتكوينها العضوي.
وهناك أيضًا سياسات استهدفت الصناعة الغذائية مثل تدمير المحاصيل والمزارع وبيوت الدفيئة والمعدات الزراعية وتخريب شبكات الري والآبار ومضخات المياه من ناحية، وقصف المصانع الغذائية والمخابز ومخازن الطعام والحبوب من ناحية أخرى، محيلة أرض القطاع إلى أرض جدبٍ يصعب بغير استصلاح مكلف ومعتمد بصورة حتمية على مقدرات ودعم خارجي، ممنوع هو الآخر، الوقوف على قدميه والبدء من جديد.
بينما تكمن الخطورة المتوقعة على المدى البعيد بضم أراضي القطاع، خاصة تلك الخصبة في الشمال بعد إفراغ أهلها منها وحشرهم باتجاه الجنوب على الحدود المصرية، حيث يزيد الاكتظاظ وتقل فرص الزراعة والإنتاج الغذائي.

تدمر قطاع الزراعة في القطاع بسبب القصف المتواصل وندرة المياه وعدم وجود وقود لضخها وعدم القدرة على الاقتراب من المحاصيل المحاذية للحدود مع “إسرائيل”، وقد قدر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء خسائر قطاع الزراعة في غزة بما لا يقل عن 1.6 مليون دولار يوميًا.
بينما صرح قسم الأمن الغذائي الفلسطيني التابع لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الزراعة والغذاء، بأن أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في الشمال تم تدميرها بحلول نوفمبر/تشرين الثاني فقط، بينما أشارت منظمة العمل ضد الجوع بأن أكثر من 60% من محاصيل المزارعين في الجنوب قد تم تدميرها بينما لا يستطيع أكثر المزارعين الوصول إلى ما نجا من المحاصيل، في مشهد سريالي يمهّد لعقود قادمة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في القطاع.
لماذا الجوع؟
تتعدد أهداف المجاعات المفروضة على الشعوب في معرض النزاعات والحروب وحتى في أوقات السلم المموّه، حيث تطبخ السياسات الاستعمارية على مهل، فبينما تهدف المجاعة أحيانًا لتهجير السكان الأصليين تمهيدًا لضم الأرض واستعمارها، تهدف أحيانًا أخرى للتخلص الكلي منهم في عملية إبادة جماعية تستهدف تدمير الجماعة العرقية أو الإثنية أو الدينية تدميرًا جزئيًا أو كليًا كما عرفتها اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948.
وقد تهدف المجاعة إلى فرض شروط محسّنة في التفاوض وانتزاع مواقف في مصلحة المستعمر أو المحتل، وإلا فضرب حاضنة المقاومة وتجفيف منابعها بفرض عقوبة جماعية على المدنيين، وقد اجتمعت هذه الأهداف في التجويع الإسرائيلي القائم في القطاع.
كما أن للتجويع أثرًا مهمًا في مسارات الحروب والنزاعات لا بأثره المباشر بالقتل وحسب، لكن أيضًا بقدرته على تهجير السكان والتحكم بتحركهم وتجمعهم وما يخلقه ذلك من مشكلات الأوبئة والاكتظاظ وتهتك النسيج الاجتماعي مثلما حدث في مجاعة دارفور ثمانينيات القرن الماضي التي لم تكتف بقتل آلاف الناس جوعًا، لكنها أيضًا دمرت الاقتصاد والنسيج الاجتماعي وأوجدت مشكلات عديدة رافقت الاكتظاظ في مخيمات النزوح الداخلية.

ويعد التجويع المتعمد أحد العناصر المشكّلة للنزاع الداخلي التي تفرق الجماعات عادة، وتعمل عليها القوى المعادية بالتوازي مع تحركاتها العسكرية والسياسية لخلق نوع من التفكك الاجتماعي المسهل والمسرّع للسيطرة على السكان وسهولة تحريكهم والتحكم بقراراتهم، كما أثبت التجويع واسع النطاق قدرته على خلق فئة منتفعة يتم تمرير المساعدات الغذائية المدروسة والشحيحة من خلالها، لخلق فئات موالية تعمل كواجهة اجتماعية وتفت في عضد الجماعة في مواصلة للجهود الحربية للقوى المعادية من الداخل.
وبالنظر للصورة الأوسع، فقد خلق الاستعمار الأوروبي أساسًا على امتداد القرنين السابقين خللًا عميقًا في صناعة الغذاء واستغلال الأرض في المناطق التي بسط سيطرته عليها، وقد امتد أثر هذا الخلل إلى يومنا الحاضر حتى بعد أن خرجت جيوش المستعمِر وأعلنت المستعمرات استقلالها واحتفلت بذكراه السنوية.
تبدو هذه المستعمرات غير قادرة على النهوض باقتصادها الوطني وترسيخ ثقافة الأمن الغذائي التي تجعلها قادرة على حماية مواطنيها والاستقلال بقرارها السياسي الوطني دون ضغط النظام العالمي الذي تربطها به علاقة تبعية تشبه الاستعمار الصامت. وقد فتّت هذه السياسة في عضد الدول العربية حتى يومنا هذا وأثرت على قدرتها على النهوض والتعاضد والتكاتف، ملهية إياها بالبحث عن لقمة العيش وتأمين الحد الأدنى من المعيشة.
في ميزان القانون
يعتبر التجويع جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح لعام 1949، التي حظرت تجويع السكان كوسيلة للحرب أو استهداف مرافق عيشهم الأساسية مثل المحاصيل الزراعية والأراضي وقنوات الري والمياه الصالحة للشرب ومصادر المنتجات الغذائية.
وكذلك فعل كل من البروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف 1977 وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998 الذي اعتبر تجويع المدنيين كوسيلة حرب جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، فقد اعتبر الميثاق التجويع المتعمد للسكان بغية تحقيق غايات حربية جريمة حرب وفق المادة الثامنة فقرة (٢)، وجريمة ضد الإنسانية إذا تم على نطاق واسع وممنهج وفقًا للمادة (7) من ذات الميثاق.
ظل تجويع أهل القطاع محل نظر للدول الحليفة لـ”إسرائيل” وسياسة غير مقصودة بذاتها وعرضًا جانبيًا لـ”محاربة الإرهاب”!
من ناحية أخرى يعد التجويع، في معرض تدمير الجماعة جزئيًا أو كليًا بالتسبب بقتل أعضائها أو التسبب بضرر جسدي أو معنوي خطير أو تصعيب ظروف الحياة والذي يعاني منه سكان القطاع الآن، مكونًا أساسيًا لجريمة الإبادة الجماعية التي تعد أم الجرائم في ميثاق روما وفي اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، فعلى امتداد التاريخ تم توظيف التجويع كوسيلة ناجعة في معرض الإبادة الجماعية للسكان الأصليين.
ويأتي مثالها المعاصر الأبرز في مجاعة الهيريرو والناما 1904 فيما يعرف اليوم بناميبيا التي راح ضحيتها 75 ألف قتيل، بعد أن دفعهم الاستعمار الألماني إلى حدود صحراء كالاهاري وحاصرهم بعيدًا عن الماء وسمّم آبارهم وحرمهم الطعام.
وعلى الصعيد التطبيقي، تكمن خطورة التجويع في الفشل في تكييفه كجريمة قائمة بذاتها واعتباره بدلًا من ذلك أثرًا غير مباشر وضررًا جانبيًا للمعارك السائدة، بينما تشير الحقيقة إلى أنه يُعد أشد أدوات الحرب فتكًا وأنه يحقق أهدافًا تعجز عنها الأسلحة الفتاكة، ومع هذا لا يتم التعامل معه عادة على هذا الأساس، وبالتالي لا يخضع المسؤولون عنه للمحاسبة والعقاب لاعبين على وتر صعوبة إثبات النية الواجبة التحقق لتكتمل أركان الجريمة وفق القانون.
موقف عالمي منافق
الأمثلة على سياسة التجويع إبان النزاعات المسلحة في التاريخ المعاصر وحده لا تحصى، فبينما تقف مجاعات لينيغراد والبوسنة وخطة الجوع النازية كأمثلة على مجاعات مشهودة في صراعات القرن العشرين، تأتي مجاعات سوريا واليمن وجنوب السودان أمثلة قائمة على السياسات التدميرية في بلداننا في العمر القصير للقرن الحالي.
ورغم التقدم الظاهري في نُظُمِ حقوق الإنسان ومؤسساته الدولية، ما زال النظام العالمي يستخدم ورقة التجويع بصورة سياسية، حيث تشير الولايات المتحدة مثلًا بعين السخط إلى تجويع النظام السوري للمدنيين منذ الثورة، بينما تتغاضى عمدًا عن تجويع اليمنيين الذي يقوم عليه محور الحصار الحليف لها وترأسه الإمارات والسعودية، وتشارك بشكل فعّال ومقصود في تجويع أهالي القطاع.
توافق مجاعة غزة الذكرى الثانية عشرة لإطلاق خطة الأمم المتحدة “تحدي الجوع الصفري” التي أطلقتها الجمعية العامة عام 2012 للقضاء على الجوع في العالم خلال جيل واحد، وقد خصصت الأمم المتحدة برامج ووكالات وخططًا متعددة لمواجهة شبح الجوع والتجويع العالميين، وكان على رأس القائمة برنامج الغذاء العالمي الذي أخذ على عاتقه إنقاذ أكثر من 80 مليون إنسان من المجاعة، والبنك الدولي الذي يستثمر في قطاعات الزراعة وتطوير الأمن والصناعة الغذائية حول العالم، وكذلك منظمة الزراعة والغذاء الأممية التي تضطلع بمسؤولية توفير الغذاء بشكل دائم ومستقر للسكان، وأخيرًا الصندوق العالمي للتطوير الزراعي الذي يسعى لتقليل الفقر ومحاربة سوء التغذية.
باستثناء التحذيرات النارية التي أطلقها كل من برنامج الغذاء العالمي (WFP) و منظمة الزراعة والغذاء (FAO) التابعتين للأمم المتحدة، لم تتخذ المنظمة الأممية خطوات فعلية لوقف المجاعة وإنقاذ مليونين ونصف إنسان محاصرين بمساحة 360 كيلومترًا بلا منفذ ولا مكان آمن.

وينطبق هذا التعميم لا على الأشهر الـ8 السابقة التي رافقت العدوان الإسرائيلي على القطاع، لكن على السنوات الـ18 التي حكمت على القطاع بجوع بطيء وصامت ظهر أثره جليًا بانهيار المنظومة الغذائية والتخزينية سريعًا ومنذ الأسابيع الأولى للحرب الطاحنة الدائرة وأتقنت “إسرائيل” إمساك خيوطها والتحكم بمساراتها المتعددة قبل وفي أثناء الحرب، وتعد بإحكام لمواصلة سياسة التجويع القاتلة في اليوم التالي لانتهاء الحرب.
وقفت المنظومة الأممية عاجزة أمام التجويع المتعمد لسكان القطاع واكتفت بتصريحات للاستهلاك الإعلامي دون وضع خطة أو تقديم مشروع قرار يدين التجويع المتعمد للسكان ويطالب باتخاذ إجراءات عقابية بحق “إسرائيل”، فقد صرح المقرر الخاص المعني بحق الغذاء والعامل تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مايكل فخري، بأن “إسرائيل” تجوّع عمدًا سكان القطاع كجزء من حربها الدائرة هناك، كما يحافظ برنامج الغذاء العالمي على تحديث إحصاءاته بشأن عدد البيوت الغزية الجائعة وكم يومًا وليلة بقيت دون وجبة تسد الرمق، خارجًا علينا كل أسبوع بتوصيف جديد للوضع القائم بين تجويع ومجاعة ومستويات شديدة من الجوع.
غير أن إجراءً بتشكيل لجنة تحقيق مثلًا أو تقديم تقرير للجمعية العامة أو مجلس الأمن لاتخاذ إدانة رسمية مباشرة للجريمة النكراء لم يحدث حتى اللحظة، وعلى العكس فقد رفض برنامج الغذاء العالمي إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع بحجة تواصل الأعمال القتالية وعدم وجود بيئة آمنة للتوزيع!
يتم اليوم استدعاء مجاعة هولومودر التي فرضها الاتحاد السوفيتي بقيادة ستالين على أوكرانيا بين عامي 1932 و1934 ومعها خطة التجويع النازية التي فرضتها ألمانيا على كل من أسرى الحرب السوفييت والأوكرانيين بين عامي 1941-1945 كمثالين مستهجنين ومُدرّين للدموع على استخدام التجويع في معرض الإبادة الجماعية.
كما يوضعان في معرض المقارنة والتقريب مع التدمير الروسي الحالي لخطوط الإمداد والمحاصيل والبنية الزراعية التحتية في أوكرانيا، فيما اعتبره الاتحاد الأوروبي تجويعًا متعمدًا وجريمة حرب، وفتحت دول أوروبية تحقيقات خاصة بها في الجرائم التي يرتكبها بوتين في أوكرانيا ومن ضمنها جريمة التجويع، واستهجنها القاصي والداني في الغرب المتحضر، بينما ظل تجويع أهل القطاع محل نظر للدول الحليفة لـ”إسرائيل” وسياسة غير مقصودة بذاتها وعرضًا جانبيًا لـ”محاربة الإرهاب”!