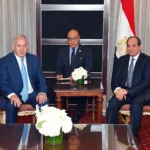تتفق الأدبيات السياسية الحديثة على جملة من الخطوط العريضة لوصف وظيفة الدولة وحيّز عملها وحدودها في علاقتها الجدلية مع المجتمع. فمن “احتكار” القدر الأكبر من ممارسة العنف المشروع وأدوات تنفيذه، إلى “ضمان” الحد الأساسي الذي لا غنى عنه من مساواة العناصر الاجتماعية أمام القانون امتثالًا، ونحو الفرص تنافسًا، وصولًا إلى دورها المفترض رسوخه بقوة التاريخ السياسي والدستور والعقد الاجتماعي وملابسات مسيرة التحديث لكل دولة، المتمثّل بـ”الحفاظ” على حد أدنى من التوازن بينها وبين المجتمع.
وتتأرجح هذه العلاقة الجدلية بقوة الشد والجذب المتبادل إلى الأمام وإلى الوراء، غير أن المتفق عليه إلى حد كبير هو ضرورة الحفاظ على “التوازن” النسبي بين الطرفَين، كل على حدة.
ولا يستند هذا الإطار الحاكم للعلاقة بين الطرفَين إلى تأويل أخلاقي وحسب، بل ربما يكون هذا التأويل الأخلاقي -في الواقع- شديد الهامشية، وإنما يستند إلى غاية مصلحية عقلانية، وهي تفادي مآلات اختلال هذا التوازن بطغيان أحد الطرفين جذريًا، أو بانفصام العلاقة كليًا، بما قد يؤدي إلى تهديد سلامة الطرفين وجوديًا والنكوص بهما إلى عصر ما قبل الدولة الحديثة.
لمَ هذه المقدمة النظرية؟ ببساطة لأن هذا التصور الراسخ لضمان الحالة الجدلية الصحية بين كل من الدولة والمجتمع، قد جرى ضربه في مقتل يوم 26 يوليو/ تموز 2013، كتاريخ تأسيسي فاصل في مسار التجربة السياسية المصرية، وكمحدّد لنمط التفاعلات بين الدولة والمجتمع خلال ما يزيد على عقد، فيما عُرف بـ”جمعة التفويض”.
التفويض: ما وراء المعنى
في هذا التاريخ من الشهر نفسه الذي وقع فيه الانقلاب العسكري، استطاعت الدولة العميقة، بالترغيب والترهيب، إقناع شريحة معتبرة من المصريين بأن الحل الوحيد لضمان “النجاة” بسفينة الوطن الذي يألفونه، سياسيًا واجتماعيًا، هو التخلي “الطوعي” عن صلاحيات المجتمع ودوره في علاقته الجدلية مع الدولة، وإيكال الإدارة والتشريع والنفوذ والثروة للدولة وحدها.
طرفان في علاقة تعاقدية: الدولة، ويمثلها بطل الانقلاب، ضابط المخابرات القادم من المؤسسة الأقوى والأكثر تنظيمًا في البلاد، السيسي في ناحية؛ والسواد الأعظم من المصريين في ناحية.
وإزاء ما تقول الدولة إنها تهديدات وجودية تهدد مستقبل الوطن، وتتطلب تدخلًا حاسمًا وعاجلًا، يعرض الطرف الأول (الدولة) حلًّا على الطرف الثاني، وهو منحه صلاحيات مفتوحة لإدارة الأمور استنادًا إلى رصيد الثقة المتراكمة، على أن يكون العائد من هذا التنازل العبور بسفينة الوطن إلى برّ الأمان ودرء التهديدات.
فجوهر مشهد التفويض العالق في الذاكرة، كما أراده من طلبه، هو استعراض “الاستجابة” الشعبية العلنية للصيغة التي عرضتها الدولة، باعتبارها حلًّا أخيرًا وحيدًا لإنقاذ الوطن وتلافي الندم الذي خيّم على شعوب مجاورة لم تحظَ بمثل هذا العرض السخي.
وما إن تحقق المطلوب -حشد “صورة الاستجابة” وتكثيفها أمام الرأي العام العالمي والتاريخ-، تبدأ الدولة-السيسي فورًا الوفاء بوعدها في سحق العدو الداخلي: الإسلام السياسي الذي كان قد تبوّأ مقعده في الحكم وفقًا للصيغة التقليدية في الاجتماع السياسي الحديث: الانتخاب الديمقراطي.
مع اتفاق ضمني بين الطرفين، المفوِّض والمفوَّض، بألا يكون النجاح في سحق الإسلام السياسي، والذي تكثف لحظة 14 أغسطس/ آب من العام نفسه في أحداث فضّ الاعتصامات بالقوة المجردة من أي كوابح قانونية، إلا مجرد بداية لتفعيل سياسة الحلول الجذرية في معالجة الأزمات الاقتصادية، والتصدي للأخطار الخارجية المحيطة بالوطن.
التفويض.. اختبار الفاعلية خارجيًا
سياسيًا، بالنسبة إلى الشريحة المستجيبة لصيغة الدولة في الإدارة، والتي تنحّي المجتمع كليًا عن المعادلة وتفترض فيه عدم الأهلية، فقد آتى التفويض أكله في تبديد مخاطر الداخل، عقب سحق الدولة كليًا للإسلام السياسي، ثم سحق التمرد القَبَلي في شبه جزيرة سيناء.
من أخطار الداخل إلى الأزمات السياسية العرضية مع الخارج، جرى تفعيل “التفويض” عمليًا في هيئة تصدي السيسي صاحب التفويض مباشرةً بنفسه لإدارة هذه الأزمات، دون أدنى مشاركة اجتماعية حقيقية كما يحدث تقليديًا في المجتمعات الطبيعية.
ففي قصر الإليزيه عام 2020، انبرى السيسي منتقدًا بنوع من الشدة الظاهرية التطاول على المقدسات الإسلامية، وهو ما تغاضت عنه الرئاسة الفرنسية حينها، نظير رفع الحصار الدبلوماسي المفروض عليها من العالم الإسلامي آنذاك، وذلك بموجب زيارة السيسي التي تضمّنت -للمفارقة- الاتفاق على مزيد من التعاون الأمني لمكافحة “الإسلاموية” والإرهاب.
بالنسبة إلى المفوضين، أثبتت الدولة خلال هذا التحدي جدارتها بالتفويض.
فبينما كان ممكنًا فيما مضى التعاطي مع مثل هذه الأزمة بالأدوات المدنية كالصحافة والدبلوماسية الشعبية والتصعيد البرلماني والمظاهرات والمقاطعة، كتفًا بكتف مع المواقف الرسمية؛ فقد تكفل صاحب التفويض والأهلية الحصري بإدارة الغضب على نحو ما يراه آمنًا.
وفي مايو/ أيار 2021، إبّان الحرب الإسرائيلية على غزة “سيف القدس”، والتي مثلت تاريخًا إيجابيًا فاصلًا في مسيرة أداء المقاومة وإحياء القضية الفلسطينية، بل التمهيد لـ”طوفان الأقصى”، تجلت فاعلية التفويض مجددًا -بنجاح- في التحركات الرئاسية الدولية لاحتواء الأزمة، والدور شديد الوضوح لجهاز المخابرات العامة في الانحياز لغزة.
حيث باتت الطريقة التقليدية في حشد المنظمات “الشعبية” المدنية، بصيغها الإسلامية واليسارية والنقابية، قوافل الإغاثة إلى بوابة المعبر، مرفوضة كليًا من جانب الدولة لما تمثله عليها من خطورة مستقبلية في تعزيز الهياكل والبنى الاجتماعية المدنية، ومن ثم منازعتها على السلطة والثروة.
أبرم السيسي اتفاقًا ثلاثيًا مع كل من فرنسا والأردن لإيقاف الحرب وتمويل إعادة الإعمار بمبلغ 500 مليون دولار، وتكفّل جهاز المخابرات العامة بإدارة تدفق حركة المساعدات والدعم المعنوي إلى القطاع، وهو ما تجلى في اللقاء الأيقوني المفعم بالحفاوة بين اللواء عباس كامل، محاطًا بقوات النخبة المصرية، ويحيى السنوار عند بوابة المعبر من الجهة الفلسطينية.
الطوفان والتفويض.. فشل الاختبار
خلال العقد الأخير، لم تكتفِ الدولة في مصر، بقيادة السيسي، بالتعاطي مع كل المستجدات وفقًا لمعطى حيازتها تفويضًا بالولاية الشاملة، دون منازع، على مقاليد الأمور وحسب.
حيث استغلت أيضًا الصورة المبتورة للجماهير المفوِّضة باعتبارها صكًّا شعبيًا جمعيًا يخوّل لها القضاء على “الهياكل الاجتماعية” الأساسية، مثل النقابات العمالية والحركة الطلابية والأحزاب المستقلة ورجال الأعمال الطموحين، بغرض قطع الطريق أبديًا على أي محاولة لانتزاع الأهلية السياسية منها وإعادة التوازن بينها وبين المجتمع.
وبالتالي صار الوضع على هذا النحو: دولة شمولية على رأسها ديكتاتور عسكري، تتحكم في كل كبيرة وصغيرة، بموجب ما تدّعي أنه تفويض شعبي عامّ لقيامها بهذا الدور نيابةً عن المجتمع الذي أقرَّ بعجزه عن المشاركة في الإدارة، بما تطور لاحقًا إلى تفكيك الأُسُس القاعدية للمجتمع، بحيث يصبح الوضع غير قابل للتغيير مستقبلًا.
وبالتزامن، ترفض الدولة وتضرب بقوة أي محاولة عفوية من المجتمع لاكتشاف نفسه تنظيميًا، حتى لو كان المراد تنظيمه إفطارًا رمضانيًا شعبيًا.
فلا بدَّ أن يُخطر جهاز الأمن الوطني مسبقًا بالقائمين على الفاعلية ومصدر التمويل وأعداد الحضور وخلفياتهم، وهو وحده من يملك البتّ في مصير الحدث، فما بالنا بمحاولة تنظيم مظاهرة عفوية ضد الاحتلال؟
ولما جاء الرد الإسرائيلي على الطوفان الذي اندلع صبيحة السابع من أكتوبر، منفلتًا من أي عقال سياسي، محطمًا كل الأسقف والاعتبارات الأخلاقية بدءًا من الحملة الجوية الكاسحة التي استمرت حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
ثم الحملة البرية، مرورًا بمجازر المعمداني ومستشفى الشفاء وخيام رفح ومخيم النصيرات، بما يقتضي ردًّا، ولو شكليًا لحفظ ماء الوجه، من الدولة المفوضة بالتصدي للتحديات الخارجية، والتي فكّكت القواعد الاجتماعية من جذورها لتحتكر لنفسها الفاعلية.
بدا -ربما لأول مرة على هذا النحو- أن تلك الدولة عاجزة كليًا عن الفعل، غير قادرة حتى على التحرك ضمن سقف العقد الاجتماعي للبلاد في زمن ما قبل التفويض.
وإمعانًا في الاستعلان بالانسلاخ من أي ضوابط سياسية كانت سارية قبل الطوفان، حيث يتجاوز العدوان الإسرائيلي حدود غزة ويتحرك جنوبًا باضطراد نحو القاهرة، ودون اعتبار لما كان يصنَّف سابقًا تحت بند “تجنّب إحراج الأصدقاء في مصر”، أقدم الاحتلال عامدًا على سلسلة من الإجراءات المستفزة للرأي العام في مصر، فيما فسّر بأنه اختبار -بالنار- للإرادة والقدرات المصرية. بدءًا من غزو رفح بريًا آخر المعاقل الآمنة المتاحة للمدنيين في غزة، مرورًا باحتلال محور فيلادلفيا بالمخالفة لاتفاقية السلام.
ثم تدمير معبر رفح البري من الجهة الفلسطينية، والذي كان نافذة مصر الرسمية على عالم القطاع، وصولًا إلى تكرار الاستهداف المباشر للجنود المصريين، قتلًا وإصابة وتخريبًا، داخل رفح المصرية.
لنصل إلى وضع لا تكون فيه الدولة عاجزة عن كبح العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في الجوار وحسب، بل تعجز حتى عن حماية مصالحها وحدودها.. أين الدولة؟
تحلُّل الدولة
“لقد فوض بعض المصريين الدولة -بناءً على طلبها- لدرء المخاطر عن البلاد، ولكن نفس الدولة عند أول اختبار حقيقي تبرّأت من التفويض وكل واجباتها الأساسية، وفوضت أمرها لله!”.
بهذه التغريدة الساخرة على موقع إكس، لخّص أحد المواطنين ذلك العجز المشهود الذي يخيّم على أداء الدولة في تعاطيها مع التهديدات الخارجية، وعلى رأسها التهديد القادم من الاتجاه الشمالي الشرقي.
فعلى غير عادته، اختفى صاحب التفويض الذي انبرى خطابيًا من قبل في مواجهة أعداء الداخل صارخًا: “اللي هيقرب لمصر هشيله من على وش الأرض”، ولم ينبس جادًّا ببنت شفة إزاء الإصرار الإسرائيلي المتعمّد على انتهاك المقدرات والمصالح المصرية، كأن الأمر لا يخصه.
كما طرأ على حالة التخبُّط والانسحاق السيادية من جانب الدولة نمط جديد من التفاعل، تقوم خلاله الدولة نفسها بـ”تفويض” كيانات وأجسام شبه رسمية، بمهمتها في التواصل مع المجتمع.
إذ عوضًا عن التصريحات الرسمية المباشرة ذات الموقف الواضح من المستجدات، بات ما يعرف بـ”المصدر المسؤول”، وهو شخص مجهول يطلق تصريحات عائمة متعارضة لمنصة “القاهرة الإخبارية” المقربة من الدولة، مهيمنًا على صوت الدولة ورسائلها المنتظرة للرأي العام.
وفي وقت متأخر من الأزمة، تصدّر كيان مقنّن حديثًا، وهو ميليشيا نشطت في سيناء خلال حقبة الحرب على التمرد، ارتبطت باسم رجل الأعمال المقرب من الدولة إبراهيم العرجاني، تحت عنوان “اتحاد قبائل سيناء”؛ الرأي العام الرسمي، لا كوكيل عن الدولة في إدارة “بيزنس” التهجير النظامي لمنكوبي غزة من القطاع إلى مصر -قبل إعطاب المعبر- وحسب.
ليضطلع هذا الكيان بمهمة التصدي لأي محاولات إسرائيلية -أو فلسطينية- مستقبلية لانتهاك السيادة المصرية، وفقًا لما أدلى به المتحدث الرسمي النائب في البرلمان مصطفى بكري، وتتجلى الهزلية بكامل ثقلها في اختيار السيسي “رئيسًا شرفيًا” لهذا الكيان، خلف الرئيس الرسمي إبراهيم العرجاني.
وفي إقصاء للخارجية عن مهمتها الأساسية في الاشتباك الدبلوماسي الممثل للبلاد لصالح نفوذ الهيئة العامة للاستعلامات، رصد باحثون تشابهًا كليًا، بالحرف، في بيانَيها المتباعدَين زمنيًا تعليقًا على جزرتَي المعمداني ورفح، دون أي تغيير، ليبدو الأمر كما لو كانت تلك البيانات عبارة عن “قوالب جاهزة” مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، دون أي حضور حقيقي للكادر البشري في الوزارة.
أما الجيش فقد تنصل بدوره ممّا نُسب إليه من التدرّب على استهداف الميركافا الإسرائيلية، حيث حُذفت لاحقًا تلك المشاهد من المقاطع الرسمية، كما تنصّل في واقعة مهينة من الجندي الذي استشهد خلال اشتباكه مع الإسرائيليين بوصفه رسميًا بـ“أحد العناصر” كأنه مرتزق مجهَّل، إضافة إلى حرمانه من الحق في تشييع جثمانه بمراسم عسكرية.
توارٍ كامل للمؤسسات الرسمية السيادية عن الأنظار. تنصل كلي من عبء ومقتضيات “التفويض” الذي طلبته الدولة نفسها، ليحل “المصدر المسؤول” محل السيسي، ويحل اتحاد القبائل محل الجيش، ويزداد حضور هيئة الاستعلامات على حساب الخارجية، ويخبو صوت الدولة والمجتمع معًا لأول مرة لصالح الميليشيا والأذرع غير الرسمية.
موت التفويض
هذا العجز ليس بالجديد، فقد تكرر بدرجات متفاوتة وتمظهرات مختلفة في تحديات خارجية سابقة، فشلت الدولة خلالها أو تنصلت فيها من الاضطلاع بالحدّ الأدنى من مسؤولياتها في الدفاع عن كرامة البلاد ومقومات وجودها، على غرار الاستسلام لإثيوبيا في ملف منابع النيل، والتردد في اتخاذ موقف حاسم ضد الميليشيات التي تحصل على دعم إقليمي لحرق الحديقة الخلفية للبلاد في السودان.
ليصبح التفويض “امتيازًا” مطلقًا حصلت عليه الدولة للقضاء الجذري غير المقيَّد على خصومها في الداخل، من الذوات والكيانات والتنظيمات السياسية والاجتماعية، دون عائد على المفوضين.
بل وصل الأمر حد “تفويض” الدولة نفسها صلاحياتها “التمثيلية”، منزوعة الفاعلية، لواجهات عصبوية وقَبَلية ضيقة ضمن اعتبارات آنية، بما يهدد بـ”تحلُّل” الدولة والمجتمع بالكامل مستقبلًا.
وكردّ فعل عفوي على عجز الدولة الكلي عن القيام بأي حراك شكلي تضامنًا مع الجيران في غزة، فضلًا عن التصدي للممارسات الإسرائيلية المهينة للسيادة المصرية، بدا أن هناك محاولات عامة لانتزاع الفاعلية المهدورة بموجب التفويض، على هيئة تحركات متشظية تكثّف الغليان القاعدي لدى طبقات المجتمع الأقل تمثيلًا والأكثر تضررًا وإحساسًا بالامتهان.
ومنها تحرك تنظيم صغير يقول إن الجندي المصري محمد صلاح الذي قضى في اشتباك حدودي أدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين قبل عام، مصدر إلهام له، لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي ناشط في الإسكندرية، إلى انفلات عقال أحد صغار الأمنيين في جهاز الشرطة باعتلائه إحدى اللافتات الإعلانية في ميدان حيوي والجهر بسبّ السيسي، وذلك بعد قيام زميل له بفتح النار على مجموعة من السياح الإسرائيليين كان مكلفًا بحمايتهم وإردائهم قتلى.
شعبيًا، نكّلت الدولة بعدة شرائح فئوية حاولت انتزاع حقها المسلوب في الفاعلية السياسية، كاعتقال المظاهرات النسائية المنددة بالاحتلال في وسط البلاد، والقبض على مجموعات من مراهقي الأولتراس لهتافها لغزة في ملاعب الكرة الرسمية ورفعها أعلام فلسطين عشية عيد الأضحى.
وفي المحصلة، بعد عقد من التفويض، تتجرد الدولة في مصر من أي وعد تاريخي أو دور أصيل في بذل الجهد لخدمة المجتمع وصيانة كرامته، إذ يبدو أن هدفها هو سلطة وامتيازات، وفي المقابل تقدم شرائح غاضبة أنفسها قرابين لاستعادة حقوق العموم وتصحيح المسار.. ويزداد الوضع قتامة والمستقبل غموضًا.