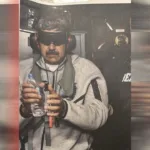لا تُطلق حرب في الكوكب دون حجّة لها، ولا يحدث صراع دون خطاب يوجّهه، فكيف يسير الأمر بتلك البساطة؟ وكيف لحرب عالمية يروَّج لها على أنها “حدثت عن غير قصد”؟ وكيف لدولة أن تغزو دولة أخرى أن تسوِّق لدعاية تقول إنها أتت لتحميها؟ وكيف لمحتل أن يبيد عائلات بأكملها بحجّة الدفاع عن النفس؟ وكيف لحاكم ظالم أن يقول إنه يحارب الفساد؟ وكيف لأحزاب متناحرة أن تقنع المواطنين بانتخابها؟
بينما يصدح العالم بنداءات السلام من على منصات الأمم المتحدة والمحافل الدولية، وخاصة الدعوات الصادرة خلال الأشهر الماضية بعقد مؤتمر للسلام لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط بعد حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” في غزة، يستمر قادة سياسيون في تبني سياسات توسعية وحملات عسكرية بحجج وذرائع مختلفة.
في هذا الملف نسلط الضوء ونحاول استكشاف عقول السياسيين والقادة، ونتناول الحديث عن مبررات الحروب التي يتبناها هؤلاء، رغم تكلفتها الكبيرة التي لا تقتصر على إزهاق الأرواح، بل تمتد لتشمل الإصابات الجسدية والنفسية، وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة.
شرعنة الحروب
“ليست الغاية الملائمة لممارسة التدريب العسكري أن يستعبد رجالٌ رجالًا لا يستحقون الاستعباد، بل أن يتجنّبوا أنفسهم استعباد الآخرين لهم”، بهذه الكلمات عبّر أرسطو عمّا سُمي لاحقًا بـ”نظرية الحرب العادلة“، وهي مفهوم يركز على تبرير استخدام القوة واللجوء إلى الحرب استنادًا إلى أُسُس ومبررات أخلاقية معيّنة، أي أن استخدام الدولة للعنف يعدّ هدفًا مشروعًا لمواجهة الخصوم ودفاعًا عن قضية عادلة، تتمثل في صدّ عدوان أو مواجهة الظلم والإرهاب والتطرف، شريطة أن تكون الوسائل المستخدمة في الحرب مقيّدة.
منذ آلاف السنين، أغرت وعود الحرب الزعماء السياسيين والعسكريين، واعتبر البشر الحرب شرًّا لا بدَّ منه، فكل دولة أو كيان قد تتعرض للغزو أو تنشب فيها حرب ما لكنها قد تشنّ هي الأخرى حربًا، وحينها يجب أن تكون لديها المبررات اللازمة لتلك الحرب، أولًا لتقنع شعبها بها، وثانيًا لتكون حربًا شرعية، ولتكون تلك الحرب باختصار صراعًا يمكن أن يتفهّمه العقل البشري.
ووفقًا للباحثين، هناك جانبان لهذه النظرية: جانب نظري يتعلق بالتبرير الأخلاقي للحرب، والأشكال المختلفة التي قد تتخذها أو لا تتخذها، وجانب تاريخي يُعرف أيضًا باسم “تقليد الحرب العادلة”، ويتعامل مع مجموعة القواعد أو الاتفاقيات الدولية -مثل اتفاقيات جنيف ولاهاي- التي يتم تطبيقها في حروب مختلفة عبر العصور، وتحدد أنواع الحرب، لكنها تجيزها في ظل ظروف معيّنة شريطة أن تكون الأهداف عادلة.

ومع ذلك، لا تبرر أهداف الحرب التي يضعها البعض استخدامهم للوسائل العنيفة لتحقيقها، لأن العنف يولّد دائمًا المزيد من العنف، وعبّر مارتن لوثر كينج الابن عن ذلك على أفضل وجه عندما قال: “إن ردّ الكراهية بالكراهية يضاعف الكراهية، ويضيف ظلامًا أعمق إلى ليل خالٍ بالفعل من النجوم، لا يمكن للظلام أن يطرد الظلام، فقط الضوء يمكنه القيام بذلك، لا يمكن للكراهية أن تطرد الكراهية، فقط الحب يمكنه القيام بذلك، الكراهية تضاعف الكراهية، والعنف يضاعف العنف، والصلابة تضاعف الصلابة في دوامة من الدمار”.
يعني ذلك أنه لا توجد “حرب عادلة” يتخفّى وراءها القادة والحكام المستبدون، فأولئك الذين يسعون إلى تبرير الحرب يتجاهلون دروس التاريخ، وعلى مرّ تاريخ البشرية لم يؤدِّ العنف إلا إلى المزيد من العنف، وجيل بعد جيل يترك الأطفال ليأكلوا ثمرة عنف آبائهم ويعانون من آثاره السامة.
وكما قال الفيلسوف برتراند راسل بشكل واضح: “نتيجة الحرب لا تحدد مَن هو على حق، فقط تحدد مَن يبقى”، فالمعارك لا تبرز أفضل ما في الناس، بل تطلق العنان للوحوش الكامنة داخلهم.
ولعلّ ما هو أكثر وحشية في الحرب هو أن الناس الذين لا يخوضون أي نزاعات شخصية يتم تشجيعهم على قتل بعضهم بعضًا بدم بارد، وكل شيء تقريبًا يتم القيام به في الحرب يُعتبر جريمة في زمن السلم.
لماذا الحرب؟
لاحظ الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط أن “حالة الطبيعة لدى البشر ليست حالة السلم، بل حالة الحرب”، فهل الحرب إذًا هي فترة استراحة أثناء السلام، أم أن السلام هو فترة استراحة أثناء الحرب؟ في الواقع، غالبًا ما يمثل السلام فترة قصيرة تكافح خلالها الدول لدفع تكاليف الحروب الماضية والمستقبلية، وقد تستمر عواقب الحرب لقرون قادمة.
ويثبت التاريخ أنه رغم الحروب التي لا تنتهي، فإن العالم لا يزال منقسمًا كما كان دائمًا، كما أن بناء الحضارة على أكوام من الجثث ليس السبيل إلى تقدُّم الحضارة، فلماذا إذًا يبدأ القادة الحروب وهم يدركون تمام الإدراك العواقب المدمرة المترتبة عن ذلك؟ وما الذي يجعل الحرب تستحق هذه المخاطر التي لا مفرّ منها؟
في كثير من الأحيان، يبدأ القادة الحروب والنزاعات على حدود غامضة وقيم مادية واهية، ويعتبر كثير منهم الحرب شرًّا ضروريًا، بل إن بعضهم يقترح حتمية الحرب عندما يسعى إلى تحقيق السلام، ولكن نظرًا إلى الدمار الذي خلفته هذه الحروب، يتعيّن علينا أن نتساءل: أي نوع من السلام يسعى هؤلاء إلى تحقيقه بهذه الطريقة؟
تتلخّص إحدى الطرق لفهم هذا السؤال في فحص عقول أصحاب السلطة، حيث يميل الأفراد ذوي أنماط شخصية معيّنة أكثر إلى السعي إلى مناصب قيادية، وعندما يحققون ما كانوا يسعون إليه دائمًا، ترفع الغطرسة رأسها القبيح، وينفصل هؤلاء القادة عن الواقع، ونتيجة لهذا يميل الأشخاص الذين يقدّمون لهم التقارير إلى إخبارهم بما يحبّون سماعه فقط.
الطريقة الجذابة التي يستخدمها هؤلاء لتعزيز قبضتهم على رعاياهم هي خلق عدو مشترك، فعندما يشعر الناس بالتهديد يقعون في موقف التبعية، ويطالبون بزعيم يظهر لهم الطريق، وبطبيعة الحال لا يدرك الناس في كثير من الأحيان الثمن الذي سيدفعونه مقابل هذا الوهم المؤقت بالحماية.
ووفقًا لأستاذ تنمية القيادة والتغيير التنظيمي في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال في فرنسا مانفريد كيتس، فإن القادة السامّين الذين يضعون احتياجاتهم الشخصية في المقام الأول، ويتصرفون بطريقة متعسفة ويصنعون قرارات سيّئة، قادرون على حشد الناس لقضيتهم، وذلك لأنهم على دراية جيدة بالعناصر الثلاثة للقيادة التي تستغل التحيزات الشعبية والمزاعم والوعود الكاذبة من أجل اكتساب السلطة: الشعبوية والاستقطاب والدعاية.
أولًا، يخلق القادة الشعبويون حقائق خيالية لرعاياهم، ويخبرونهم بما يحبون سماعه مهما كان هذا غير واقعي. ثانيًا، هؤلاء الحكام ماهرون في خلق عالم من “نحن” (الأخيار) مقابل “هم” (الأشرار)، ويسارعون إلى إلقاء اللوم على الآخرين عندما تسوء الأمور، وأخيرًا يبنون عالمًا قائمًا على حقائق بديلة تهدئ ضمائر الناس، وتستبدل الحقيقة بالدعاية، وكما قال الكاتب المسرحي اليوناني القديم إسخيلوس: “في الحرب، الحقيقة هي الضحية الأولى”.

في هذا الصدد، كتب الصحفي الأمريكي إتش إل مينكين، قبل عقود من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أن “الهدف الكامل لممارسة السياسة هو إبقاء عامة الناس في حالة من الذعر المستمر، ومن ثم المطالبة بإنقاذهم من خلال تهديدهم بسلسلة لا نهاية لها من الأحداث الخيالية”، ورغم أن وصفه لا يزال صالحًا، فإن هذه الأحداث لم تعد خيالية.
هؤلاء الحكام، الذين يفرضون أنفسهم من خلال الأجهزة العسكرية مثل الجيش والشرطة والمخابرات وغير ذلك، يطبّقون هذه المبادئ، ويعرفون بالضبط كيف يغرسون الخوف ويحملون الناس على الالتزام بنهجهم، ويجعلون رعاياهم يعتقدون أنهم يخوضون حربًا عادلة.
وفي الوقت نفسه، تتلاشى حرية التعبير أمام إجبار رعاياهم على الاقتناع بما يريدون، وكأن لسان حالهم يقول: “تلك الحرب هي حربك، ومن يُقتل اليوم هم أخوتك، وعليك أن تحمل السلاح وتدافع عن وطنك، يجب أن تموت من أجل الخطاب الذي سمعته، ويجب أن تعيش حياتك بانتظار كلمة القائد الأعلى لتسير معه”، وهنا تتحول الحقيقة المطلقة إلى حقيقة عمياء، ويُعتبر كل من يشكّك في الحرب خائنًا.
وربما تنطبق هذه الأوصاف على أولئك القادة الذين يحكمون بطرق استبدادية في الداخل، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو حليفه البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وحتى في الديمقراطيات الغربية ثمة قادة شعبويون ممّن يفضلون الصراع على السلام، كما أن المنافسة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين تثير القلق أحيانًا من اندلاع صراع من نوع آخر.
لكل حرب مبرراتها
في الصراعات السياسية، من الشائع أن يسمّي كل طرف الطرف الآخر بالشرّ، ومع ذلك إن ما هو شر في نظر أحد الطرفين قد يكون خيرًا في نظر الطرف الآخر، الأمر الذي يكشف عن وجود الشر في صورة مصغّرة في كل صراع.
وينشأ الشر أحيانًا من إلقاء القادة والحكام المستبدين اللوم على الآخرين عن الأذى الذي لحق بهم، ما يسمح لهم بإخراج مخاوفهم إلى العلن، والتنفيس عن غضبهم، ومعاقبة أعدائهم أو إرغامهم على فعل ما يريدونه، وأخذ ما يخصهم، وتجاهُل نفيهم ارتكاب أي أخطاء.
وتمثل كل حرب موافقة على نهاية الدبلوماسية ولغة الحوار لصالح الدمار والموت، وتكشف عن القدرات الشريرة والضعف في النفوس البشرية، وغالبًا ما تكون نتيجة للجشع وصراعات القوة وعدم احترام الآخرين، وليس ثمة ما يدلل على ذلك أكثر من الحروب العالمية.
في أكتوبر/ تشرين الأول 1914، كانت أوروبا على شفا كارثة كان الجميع يريدون تجنّبها، وخصوصًا في منطقة البلقان، التي سُمّيت حينها بـ”نقطة التوتر المرعبة”، ولم يكن الأوروبيون بحاجة إلى الكثير ليقيموا حربًا عالمية، فأي حادثة وخصوصًا بين الشعوب السلافية قادرة على أن تطلق تلك الحرب.
في يوم 28 يونيو/ حزيران من ذلك العام، وهو اليوم الأسود الذي يوافق ذكرى انتصار تركيا على صربيا في معركة كوسوفو عام 1389، كان الطالب الصربي غافريلو برينسيب البالغ من العمر 19 عامًا يشاهد موكب ولي عهد النمسا فرانز فرديناند، وهو يتجول في مدينة سراييفو البوسنية (كانت تابعة آنذاك لإمبراطورية النمسا والمجر)، ليسرع بإخراج مسدسه وإطلاق النار على عربة الأمير وزوجته.
اغتيال من طالب صغير يتبع لمنظمة “اليد السوداء” التي تسعى لانفصال صربيا، أشعل حربًا عالمية، وهذا حقًّا ما حدث، فبعد شهر من الحداد أعلنت النمسا الحرب على صربيا، لتبدأ أوروبا بالانقسام، حيث وقفت روسيا إلى جانب صربيا، وتحالفت ألمانيا مع النمسا، وانقسمت القارة إلى قسمين: الأول قوات الحلفاء (الوفاق الثلاثي) بقيادة بريطانيا، والثاني دول الوسط (المركز) بقيادة ألمانيا.
خلال 4 سنوات من الحرب التي بدأت بأوروبا، واجتاحت كل العالم، خلفت ملايين القتلى وخسائر بالمليارات، وانهارت إمبراطوريات، وقامت دول جديدة، وظهر نظام عالمي جديد. لكن كيف اقتنع العالم كله بأن الحرب هي الحل حقًّا؟
في الواقع، كانت المهمة صعبة في البداية لكنها جرت تدريجيًا، فكانت النمسا ترى نفسها القوة الكبرى في القارة، وأن صربيا “ابنة عاقة” للإمبراطورية، وبعد الحادثة أرسلت 10 مطالب إليها، وافقت صربيا على 8 منها، لكن النمسا وجدت أن عدم الموافقة على كل المطالب سبب منطقي لإعلان الحرب، لتصدر للشعب رواية أن ولي عهدهم قُتل بدافع إهانة الإمبراطورية.
من جانبها، أصدرت روسيا رواية تقول فيها إن النمسا إذا انتصرت على صربيا فحتمًا ستتقدم نحو أراضيها، وكانت ألمانيا من جهتها تطمح في السيطرة على أوروبا سياسيًا واقتصاديًا، ووجدت في الحرب فرصة مناسبة لضرب القارة بالكامل، وكان الشعب الألماني حينها على قناعة تامة بأن النصر سيكون لهم، والسبب هو الدعاية القوية من القادة العسكريين والسياسيين فيها.
ورغم إعلان ألمانيا الحرب على روسيا -التي اعتبرت نفسها حامية لصربيا- لكنها هاجمت فرنسا أولًا، ووجدت بريطانيا من جهتها حلفاءها الأهم مثل فرنسا يخسرون سريعًا، وفي الوقت نفسه كانت ترى ألمانيا تتقدم أكثر وأكثر نحوها، وكان الخطاب يقول إن على المملكة المتحدة التصدي لتلك الحرب.
فعليًا، وفي خضمّ هذا الصراع، نجحت الدول في إقناع العالم كله بأن تلك الحرب هي مسألة حياة أو موت، وإما أن تكون أو لا تكون، وكان لها ما أرادت، لكن كيف بُرِّر ذلك بعد الموت والدمار؟
في مذكراته عن الحرب في ثلاثينيات القرن العشرين، وصف ديفيد لويد جورج اندلاع الحرب في عام 1914 بأنه “حادث مأساوي”، وكتب الرجل الذي كان رئيسًا للوزراء أثناء النصف الأخير من الحرب العالمية الأولى أن أي قوة لم تكن تريد الصراع، لكن الحكومات انتهت إلى الدخول في الحرب التي وُصفت بأنها “الحرب التي ستنهي كل الحروب”.
هذه النظرة السلطوية على ما يبدو تتناقض مع ما يُسمّى “شرط ذنب الحرب” في “معاهدة فرساي” لعام 1919، والتي نصّت على أن “عدوان ألمانيا وحلفائها” كان مسؤولًا عن الحرب، وأن عليها تقديم تعويضات للدول التي تضررت منها.
بعد سنوات من الحرب، قال المؤرخون الأوروبيون إن الحرب نشبت “عن غير قصد”، وأن حوادث معقدة كانت السبب في اندلاعها، ليقتنع العالم بما صاغه القادة والسياسيون من حجج لتبرير تلك الحرب بالتحديد التي كانت الدول الأوروبية تجهّز لها منذ أواسط القرن التاسع عشر، ولم تكن أبدًا بمحض الصدفة.
ومع ذلك، بقيت تُسمّى بـ”الحرب العظمى”، ولا تزال بعض الدول الأوروبية تحيي ذكرى انتصارها فيها رغم أنها لم تكن حتمية أو عرضية، بل بدأت نتيجة لأفعال وقرارات بشرية، فقد تطوع أكثر من 65 مليون رجل أو جُنّدوا للقتال في جيوش شعبية.
بتلك البساطة برر القادة واحدة من أشد الحروب دمويةً وفتكًا ودمارًا، فكيف سار الأمر في بقية الحروب؟ في الحرب العالمية الثانية كانت وسيلة الإقناع أسهل: راديو وتلفاز يتوجّهان إلى الشعب، وحديث عن الوطن والانتصار للعرق، فقد نجح الزعيم النازي أدولف هتلر الطامح في إقناع شعب كان فقيرًا بالكامل بالدخول في حرب ضد أوروبا كلها.
في ذلك الوقت، بلغت الدعاية مرحلة النضج، ووفّر تطور وسائل الإعلام الجماهيرية والمتعددة أرضًا خصبة للدعاية والحرب الشاملة ما وفر الزخم اللازم لنموها، وعلى مدى الـ 100 عام الماضية، أصبحت إدارة الرأي العام الشغل الشاغل للدول في أوقات الحرب والسلام.
استمرت الحرب التي انطلقت مطلع سبتمبر/ أيلول 1939 نحو 6 سنوات، حصدت خلالها حياة أكثر من 60 مليون إنسان بين عسكري ومدني، أي نحو 3% من تعداد سكان العالم في أربعينيات القرن الماضي، وبلغ عدد الجنود المشاركين في الحرب العالمية الثانية، سواء من دول المحور أو الحلفاء، أكثر من 70 مليون، لتكون الحرب الأكثر حصدًا للأرواح في تاريخ الإنسانية.

الحرب التي قتلت الملايين كان لها تبريرها أيضًا في قاموس القادة، ففي مقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذكرى الحرب العالمية الثانية، قال: “أود أن أذكر مرة أخرى الحقيقة الواضحة، تنبع الأسباب الجذرية للحرب العالمية الثانية بشكل أساسي من القرارات التي اتخذت بعد الحرب العالمية الأولى، فقد أصبحت معاهدة فرساي رمزًا للظلم الذي تعرضت له ألمانيا، وهذا يعني ضمنًا أن البلاد سيتم سلبها، وتجبر على دفع تعويضات هائلة للحلفاء الغربيين الذين استنزفوا اقتصادها”.
كانت الدول الأوروبية ومعها روسيا على قناعة تامة بأن ألمانيا ظُلمت بعد الحرب العالمية الأولى، ومع ذلك لم يكونوا على استعداد لتخفيف ذلك الظلم، بل استعدوا للحرب الجديدة سريعًا، وحوّلوا الحرب الأعنف في القرن العشرين إلى صراع عقلاني بين الخير والشر، وأنهم كانوا على حق بقتال هتلر وموسوليني.
الأكاذيب الأمريكية الكبرى
كان العالم العربي كذلك شاهدًا على الكثير من تلك الحروب، ففي عام 1991 دفع صدام حسين بالجيش العراقي نحو الكويت ليحتلها خلال أيام قليلة، ومن ثم يعلن ضمّها إلى العراق رسميًا في حادثة هي الأولى من نوعها في التاريخ التي تحتل فيها دول عربية دولة أخرى، وذلك من خلال الحرب والدمار والموت.
لطالما اعتبر العرب تلك الفكرة صعبة التنفيذ خوفًا من الغضب الشعبي، لكن صدام أقنع الشعب العراقي، ففي البداية قال إن الكويت تعدّت على الحقوق النفطية للعراق، ثم قال إنها تتبع تاريخيًا للأراضي العراقية، وأن بغداد من حقها استعادة أرضها.
بعد سنوات طويلة، كُسر جيش صدام حسين في حرب الكويت، وخرج مهزومًا منها أمام تحالف دولي حشد مئات الآلاف، ومع ذلك بقيَ على أقواله بأنه محق في تلك الحرب.
مرّت السنوات، وشهد القرن الحادي والعشرين واحدة من أشهر الحروب، والتي حملت نهاية صدام حسين ونظامه في العراق للأبد، وذلك عندما غزت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق عام 2003، الغزو الذي قالت واشنطن إنه بهدف نزع سلاح الدمار الشامل من العراق.

لكن بعد الغزو اتضح أن بغداد لا تملك ذلك السلاح، وأن كل توقعات واشنطن كانت خاطئة رغم كونها دمرت بلدًا بالكامل، وتركت خلفها حالة من الانقسام الطائفي والنزاع العرقي، بالإضافة إلى التدخل الإيراني الكبير الذي حدث مع سقوط نظام صدام حسين.
ويمكن القول إن غزو العراق كان واحدًا من أكبر الأمثلة على عقلنة الصراعات في العصر الحديث، فالحجّة التي دخلت بها الولايات المتحدة العراق كانت واهية، وفي الواقع كان بالداخل الأمريكي رفض كبير لتلك الحرب، وشعارات حملت عبارات “لماذا نرسل أبناءنا للقتال في حرب عبثية؟”.
ومع ذلك، دخل الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الحرب دون تردُّد، واتضح سريعًا أن تلك الرواية ليست صحيحة أبدًا، فبعد سقوط بغداد بأيام قام مكتب الاستخبارات والتحقيق في وزارة الخارجية الأمريكية بعملية رصد موسّعة لـ 132 افتتاحية ومقال رأي في 45 دولة، وُثّق فيها استخدام عبارة “كذب” 41 مرة، واستخدام عبارات مثل “تزييف وتلفيق” 20 مرة، وكلها كانت تشير إلى رواية وجود أسلحة دمار شامل.
مع ذلك، لم تعترف واشنطن بتلك الرواية رسميًا إلا بعد سنوات، لكنها لم تقل ذلك بشكل رسمي بل على لسان مسؤولين سابقين فقط، وجاءت أخيرًا ما سُمّيت “ذلة لسان” جورج بوش الذي قال إن “غزو العراق عملية وحشية وهمجية جاءت بقرار رجل واحد”، مع العلم أنه هو نفسه مَن أطلق تلك الحرب عام 2003، وكأنه يناقض قرار حرب غيّر وجه بلد إلى الأبد.
وتسبّبت حرب العراق وحدها في خسارة كبيرة في الأرواح، حيث تراوحت التقديرات من 150 ألف إلى مليون قتيل في السنوات القليلة الأولى من الصراع، وبلغ عدد الضحايا بين المدنيين حوالي 61% من إجمالي عدد الضحايا، أو ما لا يقل عن 100 ألف قتيل، إلى جانب عشرات الآلاف من الضحايا العسكريين.
وعلاوة على ذلك، أسفرت الحرب بين عامي 2013 و2017 عن مقتل ما لا يقلّ عن 155 ألف شخص، وتشريد أكثر من 3.3 ملايين شخص داخل البلاد، وأشعلت حربًا أهلية وتمرُّدات وعدم استقرار إقليمي جعل العالم أكثر خطورة مّما كان عليه قبل الغزو الأمريكي الذي أمطر هذه الأراضي بالنار والغضب.
ومع ذلك، مرّت حرب العراق، واقتنع العالم كله في البداية بفكرة سلاح الدمار الشامل، ثم عاد ليقول إن هذه الحرب ليست محقة أبدًا، رغم الاعتراف بأن صدام حسين كان ديكتاتورًا لا يقاوَم في البلد، ما حوّل حرب العراق إلى صراع عقلاني بالكامل بين فئة تقول إن صدام حسين رجل مقاوم، وفئة تقول إنه ديكتاتور ويملك سلاحًا فتاكًا، وعلى العالم أن يتصدى له بأي طريقة.
بالإضافة إلى ذلك، أدّى الغضب الأعمى الذي انتاب الولايات المتحدة واندفاعها نحو الانتقام من أولئك الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر إلى حرب أخرى في العراق وأفغانستان، والعنف في العديد من الأماكن الأخرى في جميع أنحاء العالم تحت ستار الدعاية لما يُسمّى “الحرب العالمية ضد الإرهاب”.
وبرر الرئيس جورج بوش هذه الحرب بقوله: “لقد وقع الهجوم على الأراضي الأمريكية، لكنه كان هجومًا على قلب وروح العالم المتحضر، وقد اجتمع العالم لخوض حرب جديدة ومختلفة نأمل أن تكون الوحيدة في القرن الحادي والعشرين، حرب ضد كل أولئك الذين يسعون إلى تصدير الإرهاب، وحرب ضد الحكومات التي تدعمهم أو تأويهم. إن حربنا ضد الإرهاب تبدأ بتنظيم القاعدة، لكنها لا تنتهي هناك، ولن تنتهي الحرب حتى يتم العثور على كل جماعة إرهابية ووقفها وهزيمتها”.
كانت التكاليف البشرية لهذه الحرب غير معقولة، وفشلت في تحقيق هدف إنهاء الإرهاب، وجمع “مشروع تكاليف الحرب” أدلة دامغة تثبت مدى فظاعة التكاليف البشرية لهذه الحرب، وتشمل بعض النتائج الرئيسية للمشروع فقدان ما لا يقلّ عن 940 ألف شخص حياتهم بسبب العنف الحربي المباشر، ومقتل أكثر من 432 ألف مدني في “الحرب على الإرهاب” التي امتدت إلى 85 دولة.
وتشير التقديرات إلى أن 3.6 ملايين إلى 3.8 ملايين شخص لقوا حتفهم بشكل غير مباشر في مناطق الحرب بعد الحادي عشر من سبتمبر، وأدت الحروب التي اندلعت منذ ذلك الحين في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال والفلبين إلى تشريد 38 مليون شخص.
كما لقي أكثر من 7 آلاف و50 جنديًا أمريكيًا حتفهم في هذه الحروب، ومات ما لا يقل عن 4 أضعاف عدد الأفراد العاملين في الخدمة الفعلية والمحاربين القدامى في صراعات ما بعد الحادي عشر من سبتمبر منتحرين مقارنة بمن ماتوا في القتال.
ومن عجيب المفارقات أن دراسة أجراها الجيش الأمريكي في عام 2019، خلصت إلى أن إيران كانت “المنتصر الوحيد” في الحرب على الإرهاب في العراق، وهي الآن الدولة التي تزوّد روسيا بالأسلحة في أوكرانيا، فضلًا عن تمويل هجمات “حزب الله” على “إسرائيل”.
ولم يحقق العثور على صدام حسين وأسامة بن لادن وقتلهما الأهداف المعلنة المتمثلة في نزع أسلحة الدمار الشامل من العراق، وإنهاء ما قيل إنه دعم صدام للإرهاب، وتحرير الشعب العراقي، بل اتضح أن الإرهاب ازدهر من دون صدام.
ويمكن القول إن الشعب العراقي أصبح تحت وطأة القمع والحصار أكثر ممّا كان عليه قبل الإطاحة بصدام، وحتى حلفاء الولايات المتحدة لم يتمكنوا في نهاية المطاف من تبرير جهود الحرب.
وفي عام 2016، وجد تقرير تشيلكوت، وهو تحقيق بريطاني حول قرار المملكة المتحدة بخوض الحرب، أن هناك بدائل سلمية أخرى كان من الممكن استكشافها، وذكرَ التقرير أن عملية تحديد الأساس القانوني للحرب كانت غير مُرضية، وأنه بالنظر إلى كل هذه العوامل فإن الحرب كانت غير ضرورية.
في فلك مبررات الحروب الحديثة
مع تطور التكنولوجيا، أصبحت الحروب مدمِّرة بشكل متزايد، ومع زيادة التهديد بالحرب النووية والكوارث البيئية، لم تعد تتألف من بضعة أشخاص يرمون بعضهم بعضًا بالحجارة، وبمجرد أن تبدأ الحروب تبدأ الدول المتحاربة، من أجل تعبئة الرأي العام بسرعة، في نشر روايات عن كيفية اندلاع الحرب.
وفي أحدث الحروب والصراعات العالمية، تأتي الحرب الروسية الأوكرانية، والتي حملت معها منذ انطلاقها الحديث عن كل الحروب والنزاعات السابقة.
بدأت الحرب في مشهد مشابه لحرب العراق، وذلك عندما أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقرار مباشر منه، “للحفاظ على الأمن القومي لروسيا” كما قال، ويزعم آخرون أن بوتين رأى فرصة لإحياء النفوذ السوفيتي في الحرب الباردة في أوروبا الشرقية، وسريعًا قرر حلف الناتو الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا، وذلك في مشهد يمكن أن يوصف بـ”الحرب بالوكالة”، إذ وجد الحلف فرصة لإضعاف روسيا بأكبر قدر ممكن، وفي الوقت نفسه خلق نقطة توتر جديدة معها.
وتدور الحرب الروسية الأوكرانية هي الأخرى في فلك روايتَين: الأولى تقول روسيا إنها تستجيب لتوسع حلف الناتو الذي يحاول يومًا بعد يوم الاقتراب من الأراضي الروسية، ويسعى لإرضاخ موسكو بأي طريقة ممكنة، والثانية تقول إن من حق أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، وأن روسيا لا تملك أي رأي أو قرار في هذا الخصوص بأي شكل كان، فيما يروّج الغرب لرواية أكبر بكثير تقول إن بوتين هو “هتلر الجديد” في القارة الأوروبية، وإن أوكرانيا تمثل المقاومة العالمية في وجه روسيا التي تحاول التمدد في كل العالم.

واليوم، تتجلى الأهوال المروعة التي تصاحب الحروب بوضوح في الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتوضح جرائم الحرب التي يرتكبها في القطاع المحاصر كيف تبرر “إسرائيل” القتل والدمار الشامل.
في البداية، أصرّت “إسرائيل” وحلفاؤها على أن القصف مبرر لأن لها الحق في الدفاع عن النفس ردًّا على هجمات حماس في السابع من أكتوبر، لكن حجّة “إسرائيل” تبدو ضعيفة لأن غزة كانت في الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية منذ تولي حماس السلطة عام 2007.
وعبر التعمق في الماضي لإضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، قارن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحرب على غزة بالحرب العالمية الثانية، وأطلق مسؤولوه على هجوم السابع من أكتوبر “هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإسرائيلية”، لكن الخبراء يقولون إن هذه الرواية تتجاهل جذور الصراع وتجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتبرر العنف الإسرائيلي المستمر منذ عقود -والذي وصفته العديد من جماعات حقوق الإنسان الدولية بأنه أشبه بالفصل العنصري- ضد الفلسطينيين.
لكن مثل هذا العنف لا يزال شرًّا لأنه لا يتناسب مع التهديد أو الضرر، ويؤدي دائمًا إلى فقدان الأرواح البريئة، وكثيرًا ما تكون الحرب التي تشنّ تحت ستار “الدفاع عن النفس” مجرد مبرر للانتقام من الفئات الضعيفة.
توضح جرائم الحرب في قطاع غزة المحاصر كيف تبرر “إسرائيل” القتل والدمار.
من ناحية أخرى، فإن الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تدفعها الرغبة في الانتقام للأذى الذي لحق بها وبمواطنيها تسعى إلى إلحاق أذى كارثي بأعدائها، وبذلك تبرر كل إصابة وقتل بالإشارة إلى الأضرار المادية والبشرية التي تسبّب فيها أفراد أو جماعات سياسية أو دول أخرى عنيفة.
لذلك، الدفاع عن النفس ليس مبررًا دائمًا، ونادرًا ما يؤدي إلى السلام والأمن الذي تسعى إليه الدول عند الانخراط في مثل هذه الحروب، وإذا كان هناك أي شك في أن الحرب والعنف غير فعّالَين في إرساء السلام، فإن التاريخ الحديث مليء بالأمثلة.
على سبيل المثال، لم تنهِ ما تُسمّى “الحرب لإنهاء كل الحروب” كل الحروب، رغم جدّية وشجاعة المشاركين في الحرب العالمية الأولى في مواجهة شرور عصرهم.
هل الحرب هي الحل؟
في حين انخفض عدد الضحايا الناجم عن الصراعات المسلحة في التاريخ الحديث، فإن الثورات العنيفة والحروب الأهلية والتمردات، مهما كانت نبيلة، على مدى المئة عام الماضية، لم تسفر إلا عن نتائج عكسية، ولم تولد سوى المزيد من العنف والموت.
وأصبح التضليل ونزع الصفة الإنسانية عن الضحايا وحماية الجناة عمليات مهمة تستخدم في بناء الروايات في وسائل الإعلام، وخلال أوقات الحرب بشكل خاص تعدّ الدعاية في وسائل الإعلام ممارسة سائدة، ومن خلال استخدام وسائل الإعلام الغربية كمكبّر صوت وبيادق لتكرار كلماتهم وتنفيذ توجيهاتهم، والأهم من ذلك الانخراط في التشهير والترهيب وتزيين الأكاذيب، شرعن الساسة التحيز باعتباره الحقيقة.
ومع تعدد الروايات يبني كل شخص في هذا الكوكب الرواية التي تناسبه ليصطف مع أحد الطرفين، ويهاجم الطرف الآخر، واليوم يختلف الاصطفاف عن أي وقت آخر، حيث نمتلك مواقع التواصل الاجتماعي القادرة ببساطة على توجيه الرأي العام، وتحويل أي صراع عسكري إلى صراع سياسي واجتماعي بصورة أخرى، أو عقلاني بين من يؤيد تلك الرواية ومن يخالفها.
باختصار، الحروب والصراعات ليست بالضرورة أن تكون دائمًا بين الخير والشر أو بين الظالم والمظلوم، بل يمكن أن تكون عبثية أو بالصدفة كما وصف المؤرخون الحرب العالمية الأولى، لكنها دائمًا ما تدفع بخطاب سياسي رصين يوجّه الرأي العالم، ويحول أي حرب إلى صراع عقلاني بوجود الحجج والبراهين أو حتى بنسج بعض من الأكاذيب.
على سبيل المثال، الصراعات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والهنود والباكستانيين، والكاثوليك والبروتستانت، والأتراك والأكراد، والهوتو والتوتسي، لا تنتهي على ما يبدو، بل تُضاف إليها صراعات لا حصر لها في مختلف أنحاء العالم بين الأغنياء والفقراء، والمستبدين والديمقراطيين، واليساريين واليمينيين، والعمال والإدارة، والسكان الأصليين والمستوطنين، والأغلبيات العرقية والأقليات، والمدافعين عن البيئة والمطوّرين، حيث يتهم كل طرف الآخر بالشر.
ولم تعد أعمق وأخطر هذه الصراعات محصورة في حدود الدول القومية، بل إنها تؤثر على الجميع في كل مكان، وحتى النزاعات البسيطة ظاهريًا بين المجتمعات المتنافسة قد تتفاقم بسرعة إلى أزمات عالمية، فتؤدي إلى قتل الأبرياء والاغتصاب والتطهير العرقي والانهيار الاقتصادي وتدمير النظم البيئية والكراهية التي لا يمكن تبديدها، حتى بعد أجيال.
وكل من هذه الأفعال تؤثر بشكل مباشر على نوعية حياتنا، بغض النظر عن مدى شعورنا بالابتعاد عن القتال الفعلي، لكن هؤلاء القادة الذين يشنون الحروب لا يبالون بأنهم يلحقون ضررًا كبيرًا بالمدنيين، بل إن رغبتهم في القتال لا بدَّ وأن ينظر إليها باعتبارها عرضًا لحالة ذهنية مضطربة، وكما لاحظ الكاتب الأمريكي جون شتاينبك، فإن “كل الحروب هي عرض لفشل الإنسان كحيوان مفكر”.