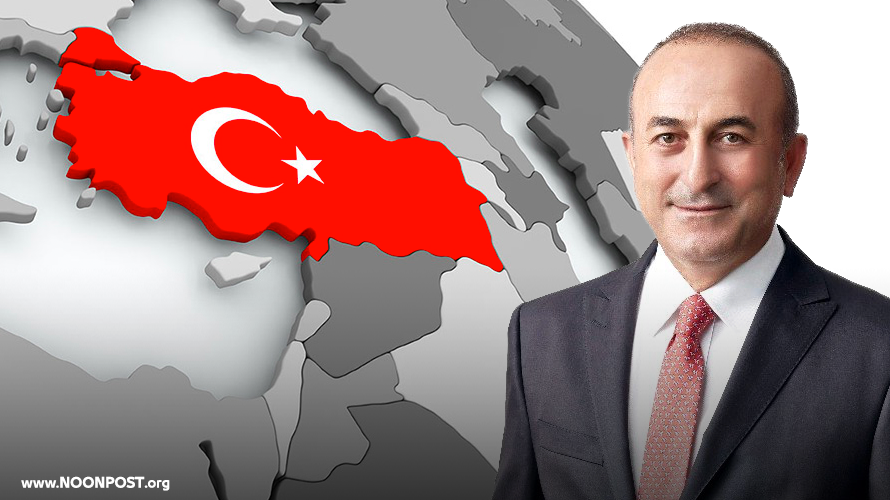يعتبر فيلم The sunset limited عبارة عن مشهد مسرحي طويل، وهذا قبل أن أنتبه وأنا أعيد مشاهدته إلى ملاحظة تقول إنه مبني فعلًا على مسرحية للكاتب كورماك مكارثي، ومن إخراج تومي لي جونز.
لا أعتقد أنه من المناسب القول إن الفيلم كله عبارة عن حوار بين شخصين في غرفة مغلقة، ذلك أن حوارهما يحطم تلك الغرفة الصغيرة ليتخذ من العالم كله، بل الوجود برمته، مسرحًا له، والكلام لا يعود مجرد كلام بل أشبه ما يكون بصدمات كهربائية عنيفة تقذف بك في قلب صراع أفكار محتدم.
وخلال الحوار لا تستطيع التزام جانب الحياد مطلقًا، فأنت طرف ثالث رغمًا عنك، والتحديد هنا مهم، لأنه يشعرك بأنك طرف فعلًا في الحوار، فليس هناك مشاهد متعددة ولا شخوصًا كثيرين لا تعرف عددهم ولا تعرف إن كان هناك المزيد ولا أماكن مختلفة، فالمكان واحد وليس فيه سوى شخصين وأنت ثالثهما.
وهذا الإحساس يدفعك لخوض غمار الحوار، فأنت لا إراديًا تندفع لتقول شيئًا أو لترد على أحدهما، إن لم تقله بصوت مسموع فإنه يدور داخلك حتمًا، ومن المهم ملاحظة أن الشخصين لا يُعرف اسميهما خلال الفيلم، وفي البدء لم أجد سببًا لذلك وفكرت أن كل ما في الأمر أن المتحاورين لم يكونا بحاجة لذكر اسم كل منهما للآخر، لكني وجدت تفسيرًا أعمق من هذا التفسير الذي لا يفسر شيئًا! وأعتقد أن السبب لمزيد من التجريد، ذلك أن موضوع الحوار على درجة عالية من التجريد، فهو الوجود، الغاية من الوجود، الخالق أو الإله، الهدف، الخير والشر، الفضيلة، إنه المعنى!
وعلى الرغم من هذا التجريد الذي يكتنف الموضوع فإنه أشد ما يكون قربًا للإنسان، وهل هناك أقرب من أن تفكر أنك موجود؟ لذا فإن عدم كون المتحاورون معروفين هو أنهما قد يكونا أي شخص آخر: أنا، أنت، هو، هم، كلنا نشكل أطراف هذا الحوار الوجودي الذي لا يفلت منه أحد.
يحاول صديقنا الأسود أن يرمي بذرة الأمل أو الإيمان، في هذا القلب الذي أكله العدم، فيحدث رفيقه عن ذلك الإحساس السحري الذي يراودك أحيانًا عن جمال العالم والشعور بأن كل شيء سينتهي بخير
الطرفان هما فقط شخص أبيض وآخر أسود (سأحاول لاحقًا أن أوضح مسألة الألوان كما فهمتها)، الأبيض تومي لي جونز وهو أستاذ فلسفة، ربما ليس مناسبًا أن نقول عنه إنه يائس ولكنه ممتلئ بالعدم، فهو يفتقد لرؤية المعنى في أي شيء في الوجود، لذلك حاول الانتحار برمي نفسه أمام قطار منطلق بأقصى سرعته، أما الأسود فهو سامويل جاكسون، ويعمل في مصحة تعتني بالأفراد الذين يعانون من اليأس وفقدان الأمل والاضطراب، وفي ذلك اليوم الذي حاول فيه الأبيض الانتحار كان هو هناك فأنقذه وأتى به إلى منزله الصغير الذي دار الحوار بين جدرانه.
منذ انطلاق الحوار يواجهنا الأبيض بعدميته، فحين يسأله رفيقه عما يفترض به فعله معه يرد عليه بأنه لماذا يفترض فعل شيء ما؟ فليس هناك معنى لأي شيء، وكونه كان هناك وأنقذه لا يعني شيئًا كما أنه لو لم يكن هناك ولم ينقذه لم يعنِ ذلك شيئًا أيضًا! ويمضي الحوار فنجد أنفسنا أمام شخصية “المثقف الحديث” فصديقنا الأبيض عندما يسأله رفيقه: هل قرأت الكتاب المقدس (وكان يمسك الكتاب المقدس بيده) يجيبه بأنه قرأ بعضًا منه، ويعيد السؤال فيجيبه بأنه قرأ سفر أيوب (وهو أحد أسفار العهد القديم)، ويكرر السؤال فيجيبه بالنفي، رغم أنه قد قرأ ما يقارب 4000 كتاب خلال حياته!
وهذه إشارة بليغة إلى أن الكتب المقدسة لم تعد تدخل ضمن اهتمامات “المثقف الحديث” فهو لا يرى فيها سوى خرافات وأوهام قديمة ذبحها العقل تحت مقصلة العلم، ولكن مالذي يؤمن به إذا لم يكن يؤمن بما تقوله الكتب المقدسة؟ إنه يؤمن بالثقافة: الكتب والفن والموسيقى.. إلخ.
ولنلاحظ هنا أننا أمام أعمدة الحضارة الحديثة، فهذه الحضارة قامت على أساس تحرير قوى الإنسان العقلية والحسية، فأنتجت الكتب في شتى العلوم والمضامين، والفن بمختلف اتجاهاته، والموسيقى الكلاسيكية العظيمة.
ولكن حتى هذا الإيمان قد فقده صديقنا الأبيض، فهذه الأشياء التي يؤمن بها قد فقدت مضامينها، أو لم يعد أحد يهتم بهذه المضامين، تحولت من مصدر للإيمان إلى شيء فاقد للمعنى بحد ذاته، وما يفتقد للمعنى لا يمكن أن يكون مصدرًا له، وهي لا تمتلك الجاذبية الكافية لتبقيه ملتصقًا بالرصيف دون أن يهوي أسفل القطار عندما يمر، وهو يقول لرفيقه: ((ربما لا أملك أي إيمان، ولكنني أومن بالقطار، الأشياء التي آمنت بها لم تعد موجودة، ومن الحماقة التي التظاهر بأنها لا تزال موجودة، أخيرًا تدمرت الحضارة الغربية وتحولت لدخان، وكنت مفتونًا جدًا لأرى ذلك)).
يحاول صديقنا الأسود أن يرمي بذرة الأمل أو الإيمان، في هذا القلب الذي أكله العدم، فيحدث رفيقه عن ذلك الإحساس السحري الذي يراودك أحيانًا عن جمال العالم والشعور بأن كل شيء سينتهي بخير، لكن لا تبدو هذه الفكرة مقنعة لصاحبه! ثم يلقي صديقنا الآخر الأبيض سؤالاً على رفيقه: لماذا لا تتقبلون ببساطة فكرة أن هناك من لا يؤمن بالله؟! فيجيبه بارتياح بأنه يتقبل ذلك! فيرد عليه قائلاً لماذا إذًا لا تتركوا لكل شخص أن يفعل ما يشاء، حتى لو كان الانتحار؟! فيجيبه بأن الله أمرنا بذلك.
هذه الأحاسيس العميقة التي تتجاوز الفوارق الدينية والاجتماعية الظاهرة لتنزل إلى عمق الإنسانية جمعاء، هذا ما كان يحاول صديقنا الأسود توضيحه لرفيقه
إنه الحب الذي يدفع الإله للاهتمام بك، وهذا الحب هو ما يريد أن يعلمنا إياه لننقذ أنفسنا ومن حولنا، يريد صديقنا الأسود أن يخبر رفيقه أنه أنقذه بدافع الحب ورغبة الناس بالأبدية، ذلك التوق الذي يجعلهم يتمسكون بخيط الأمل، الذي يجعلهم يلتصقون بالرصيف ولا يرمون أنفسهم تحت القطارات.
هذه الأحاسيس العميقة التي تتجاوز الفوارق الدينية والاجتماعية الظاهرة لتنزل إلى عمق الإنسانية جمعاء، هذا ما كان يحاول صديقنا الأسود توضيحه لرفيقه، لكن كل جواب كان يحصل عليه من رفيقه هو أن في كلامه بعض الحقيقة! وهو يتوسله ليجد ذلك الشيء الذي لن يتخلى عنه أي إنسان، ذلك الذي يتمسك به كل فرد حتى آخر رمق، كان يحاول أن ينفذ إلى أعماق رفيقه لكن لم تكن بين شفتيه الكلمات المناسبة! ثم يسأل المضيف ضيفه عن عالمه هذا الخالي من الحب والمعنى والإيمان، وهو لا يعلم أنه يسأل عن العدم! وكان الجواب قاسيًا قسوة العدم نفسه.
ويجد نفسه ليس أمام شخص مرعوب من العدم وإنما أمام شخص يعيش العدم ويرغب به ولا يرى في العالم غيره! فأشياؤه التي كانت تبث فيه الإيمان قد فقدت هي نفسها معناها، وكل شيء يمشي باتجاه واحد هو الموت والعدم، ليس هناك حياة أبدية قادمة، فقط ظلام وهدوء وصمت، على الموتى أن يظلوا موتى، إنه سلام الاستسلام للعدم.
وكل بهاء العلم الذي يجلل الحضارة الحديثة، وهذا التطور المجنون، كله سائر في طريق واحد، وفي نهاية هذا الطريق سيكتشف الجواب الوحيد، عدم معنى أي شيء!
هنا، أخيرًا، يسمح المضيف لضيفه بالانصراف، بعد أن ألح عليه كثيرًا وكان يرفض، لقد فقد الأمل بقدرته على المساعدة، ويجلس وحيدًا على أريكته ويبكي، ويعاتب الله، وكأنه المسيح وهو يعاتب الله من على صليبه: لماذا تخليت عني؟! ولكن صديقنا يسأل: لماذا لم تعطني الكلمات المناسبة؟ فقد شعر أن كلماته التي يقولها هي ذاتها كأنها تفقد قوتها ومعناها وهي تلج ذلك القلب المعتم، لكن ربما لم تكن القوة في الكلمات بقدر ما هي في القلب وليست الكلمات سوى محفز، فإذا فقد القلب قوة الإيمان حينها لا يعود لأي كلمات من معنى.
آخر صورة نراها هي الشمس وقد بانت لنا من نافذة الغرفة، وتظل الصورة بيضاء حتى النهاية
أشرت سابقًا إلى مسألة الأبيض والأسود، وأنا أعتقد أن تقسيم الأدوار بهذا الشكل هنا له دلالته، فكون الرجل الأبيض هو الذي يمثل الشخص العدمي الساخط على الحضارة يشير، برأيي، وإن كان بشكل غير مباشر، إلى الإيمان بأن هذه الحضارة قامت بجهود الرجل الأبيض، الأوربي خاصة، وعلى هذا الرجل أن يكتشف قبل الجميع فراغ الحضارة التي بناها، ومدى هشاشة أركانها.
ثمة نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها، فشخصية الرجل العدمي تقول لنا شيئًا مهما رغم أنها لا تقوله صراحة، وهو أن عدم وجود الله يساوي انعدام المعنى، ذلك أن الله يمثل القوة الجاذبة التي تلتف حولها جميع القيم، وهي أشبه ما تكون بقوة الشمس التي تمسك الكوكب التي من حولها، لأن عدم وجود الله يعني أنه لا شيء في الحياة يحمل معنى خارج الحياة ذاتها، وبما أن نهاية الحياة هي الموت فكل شيء، إذن، ينتهي بالموت والعدم، وتنهار حينها القيم والأخلاق (أقصد قيم المفاهيم، والأخلاق أقصد بها تعاملات الإنسان بالإنسان أي المجتمع ذاته).
وهذا يذكرنا بقول لدستويفسكي: إذا لم يوجود هناك إله فكل شيءٍ مباح، وأيضًا بقول للفيلسوف والأديب التنويري الفرنسي فولتير: إذا لم يوجد إله فينبغي علينا اختراعه”!