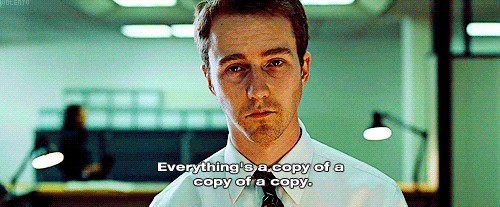يبدو أنّنا لا نحتاج كثيرًا من الوقت حتى ترجع مواقع التواصل الاجتماعي لتذكّرنا أنّنا أصبحنا نعيش، بشكلٍ مخيف، في عالمٍ يفتقد للأصالة والفرادة بحيث بات معظم الأفراد نسخًا متشابهة يسعون لتقليد السلوك ذاته أو الإيمان بالفكرة نفسها والانسياق وراء “التريند” هذا أو ذلك، بطريقةٍ تجعلنا نتساءل أينَ دور العقل من كلّ هذا.
وعلى الرغم من ظنّنا في مرحلة ما أننا نتحكّم فيما نشاهده وما نتابعه، إلا أنّنا سنجد أنفسنا فجأة، بصورةٍ غير مفهومة، جزءًا من “التريند” الذي أصبح في غضون يومٍ أو اثنين منتشرًا بطريقةٍ واسعة جدًا استطاعت اختراق جميع الأعمار والجنسيات والخلفيات الدينية، فلا أذكر كيف ومتى أصبحت حساباتي تعجّ بذلك المحتوى عن ما يُعرف بتحدي “كيكي” هذه الأيام، سواء منساقٍ مع التحدي، أو ذلك الذي ينتقده وينتقد خائضيه.
تحاول مواقع التواصل الاجتماعي تحويلنا جميعًا إلى نسخٍ متشابهة تحمل نفس الأفكار وتسلك السلوكيات ذاتها
قد يكون من الصعب جدًا تحديد السبب الدقيق لسلوك معين. ومع ذلك، يتفق علماء النفس على أنّ البشر عادة ما يميلون إلى تقليد الآخرين ومحاكاتهم دون وعي. باختصار، نحنُ لا ندرك أننا نفعل ذلك. ولعلّ التفسير العلمي الأكثر منطقيةً لهذا التقليد غير الواعي واللاشعوريّ هو الكيفية التي تعمل بها العصبونات المرآتية في أدمغتنا والتي تختص بمحاكاة سلوكيات وعواطف الآخرين من حولنا، بدءًا من مرحلة الطفولة وحتى المراحل المتقدّمة جميعها. تساعد الخلايا العصبية المرآتية في شرح كل شيء من اكتساب اللغة إلى الوعي الذاتي، لما لها من أهمية في فهم تصرفات الآخرين من حولنا، ولتعلم مهارات جديدة عن طريق التقليد والمحاكاة.
ربّما أخذ وقتًا طويلًا مع علماء الأعصاب لاكتشاف هذه العصبونات وطريقة عملها ووظيفتها، لكنّ عصر السوشيال ميديا عزّز من وظيفتها بشكلٍ مثيرٍ للعديد من التساؤلات، فلم تعد الأفكار تستغرق وقتًا طويلًا للانتشار، ولم تعد السلوكيات تحتاج الكثير من الزمان ليتمّ نسخها وتقليدها والإتيان بها. وبكلماتٍ أخرى، يمكننا القول أنّ مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي باتت تستطيع الوصول إلى تلك العصبونات في أدمغة الجميع في وقتٍ واحدٍ تقريبًا في غضون ساعاتٍ أو أقل. لكنّ السؤال هنا لم يعد حول عملية التقليد ذاتها؛ وإنما حول دور الوعي والشعور فيه.
كثيرٌ بات ينساق مع هذه العوالم بوعيٍ تام لكونه يقلّد ويحاكي الآخرين من حوله، لكنّ المشكلة تكمن في ذلك شعور الوهم بالقرار الشخصيّ والفردانية والأصالة التي يدّعيها الجميع. فإنْ كان الجميع يقلّد ويحاكي فأينْ تكمن الأصالة؟ وكيف يمكن للمرء أنْ يعرف ذاته الحقيقية والأصيلة من ذاته المزيّفة وسط كلّ هذه الحشود والقطعان؟
الأصالة عند سارتر تتطلب تحمل المسؤولية الكاملة عن حياتنا وخياراتنا وقراراتنا ومشاعرنا وأفكارنا وسلوكياتنا
فقد عرّف الفيلسوف الوجودي “مارتن هايدغر” الأصالةَ على أنها اختيار طبيعة وجود المرء وهويته، والأصالة عنده هي نقيض الزيف ومطابقة حقيقة الوجود بالانتساب إلى الأعمال الداخلية. أمّا الفرد الأصيل فهو الذي يطابق فعله طبيعته الأنطولوجية، أي أنه لا يحيا حياةً مسطحة ًفارغةً، بمعنى أنه لا يترك حياته تحددها الأعراف الروتينية والآخرون فى انقياد لهم واستسلام. فهل يمكن تحقيق ذلك ضمن عوالم التواصل الاجتماعي؟
أما “جان بول سارتر” فقد أشار إلى أنه لا يوجد جوهر ثابت للذات، إنّما لدينا إرادة حرة تتيح لنا الحرية الكاملة في تحديد خيارات حياتنا المتاحة. لذلك فالأصالة عنده تتطلب تحمل المسؤولية الكاملة عن حياتنا وخياراتنا وقراراتنا ومشاعرنا وأفكارنا. وفي الوقت نفسه، أكّد سارتر على أنّ حرية الفرد مقيّدة بالطبيعة والمجتمع، فضلًا عن قيوده الخاصة به، وهو ما أسماه سارتر بـِ “الواقعية”.
خوفنا من الاستبعاد والخروج عن المألوف هو ما قد يدفعنا في كثير من الأحيان للانسياق وراء التريندات والتحديات المنتشرة بين الفينة والأخرى
وبكلماتٍ أخرى، يقوم المجتمع من خلال العديد من الأساليب والطرق بعرقلة وصولنا لأصالتنا الذاتية؛ من خلال محاولة برمجة المرء مسبقًا كي يصبح خاضعًا له والضغوطات التي تسعى لجعله يتطابق مع القطيع، الأمر الذي قد يشكّل خوفًا لدى الفرد من الرفض أو الاستبعاد في حال فكّر بمخالفته أو الخروج عن نمطه، فيحاول إظهار أفضل وجوهه والتعبير عن ما هو متوقّع منه بحيث يتمّ قبوله والنظر إليه والتعامل معه بصورة جيّدة. وهذا تمامًا ما تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي مع مرتاديها ومستخدميها، فخوفنا من الاستبعاد والخروج عن المألوف هو ما قد يدفعنا في كثير من الأحيان للانسياق وراء التريندات والتحديات المنتشرة بين الفينة والأخرى.
كيف تحافظ على أصالة ذاتك في عصر السوشيال ميديا؟
على أنّ الجواب قد يطول كثيرًا، إلا أنّ السر قد يكون بالأساس في معرفة الذات ومراقبتها. حاول أنّ تخصص وقتًا مناسبًا للمراقبة الذاتية، بحيث تكون واعيًا لأفكارك الداخلية التي تنتابك أولًا بأول محاولًا ألا تبقي لها مجالًا لأنْ تتراكم أو تتجمّع في الخلفية دون أن تُفهم أو تُحلّل أو تُصنّف. والأمر ذاته ينطبق على مشاعرك وعواطفك وسلوكياتك؛ فكّر كثيرًا قبل أنْ تنشر ما تنشره، وحاول فهم السبب الذي يدفعك لذلك أو السبب الذي يجعلك تصبح جزءًا من القطيع في هذا التريند أو فردًا ضمن الحشد في ذلك التحدي.
تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على محاولة طمس إعمال العقل وقمعه بجعلنا جميعًا نسخًا متشابهة نحمل نفس الأفكار ونسلك ذات السلوكيات.
ففي عام 1784، كتب الفيلسوف “إمانويل كانط” أنّ القصور هو عدم قدرة المرء على استخدام فهمه دون قيادة الغير، إذ يكون هذا القصور راجعًا إلى الذات إذا كان سببه لا يكمن في غياب الفهم، بل في غياب العزم والجرأة على استخدامه دون قيادة الغير. والخروج من ذلك القصور يتطلّب حرية إعمال العقل في كلّ الميادين، الأمر الذي تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على محاولة طمسه وقمعه بجعلنا جميعًا نسخًا متشابهة نحمل نفس الأفكار ونسلك ذات السلوكيات.
في العصر الحديث، أصبح تحدّي الخروج من القصور ذلك أثقل وأثقل، فضغط الامتثال والإمّعية هو ما يسيطر على الأفراد والمجموعات. لكن ومرة أخرى؛ نحنُ بالنهاية مخلوقات اجتماعية، وتجربة العالم “سولومون أش” في خمسينات القرن الماضي لهي دليلٌ قويّ على أنّنا قد لا نستطيع في كثيرٍ من الأحيان التخلص من قيود موافقة المجموعة والانسياق نحوها، فالآخرون بالنهاية جزء من تكويننا وامتداد لشخصياتنا وذواتنا.
فكر كثيرًا قبل أنْ تنشر ما تنشره، وحاول فهم السبب الذي يدفعك لذلك أو السبب الذي يجعلك تصبح جزءًا من القطيع في هذا التريند أو ذاك
لكن بالنهاية يجب أنْ نعي أنّ معرفة الذات ومدّها بالإمكانيات المعرفية اللازمة لتحقيق أصالتها المتفرّدة هي شيء قابل للتنفيذ وليست مستحيلة أبدًا، ونستطيع من خلالها حماية أنفسنا من الآثار السلبية للقطيع، خاصة في نطاق عوالم التواصل الاجتماعيّ. فقد أشارت دراسة نُشرت في دورية “تنمية الطفل” في عام 2011 إلى أن الأطفال في عمر أربع سنوات يطوّرون ميلًا طبيعيًا للتوافق مع المجموعة المحيطة بهم، حتى في حال اعتقادهم أنّ تلك المجموعة على خطأ. لكنّ الأهمّ من ذلك أنّ أولئك الأطفال إذا أُعطوا استقلاليةً أكثر من آبائهم وقدرةً على اتخاذ القرار تبعًا لما تريده الذات والنفس، فإنّهم سيطورون مهارات معرفية أفضل تحميهم من التوافق السلبيّ والانجرار مع القطيع، أيْ تعطيهم قدرةً أكبر على معرفة الذات التي تمكّنهم من السباحة ضد التيار أو “التريند”.
تعليمك لطفلك الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار تحميه من الإمّعية وتقيه من الامتثال للقطيع
لكن بالنهاية يجب أنْ نعي أنّ معرفة الذات ومدّها بالإمكانيات المعرفية اللازمة لتحقيق أصالتها المتفرّدة هي شيء قابل للتنفيذ وليست مستحيلة أبدًا، ونستطيع من خلالها حماية أنفسنا من الآثار السلبية للقطيع، خاصة في نطاق عوالم التواصل الاجتماعيّ. فقد أشارت دراسة نُشرت في دورية “تنمية الطفل” في عام 2011 إلى أن الأطفال في عمر أربع سنوات يطوّرون ميلًا طبيعيًا للتوافق مع المجموعة المحيطة بهم، حتى في حال اعتقادهم أنّ تلك المجموعة على خطأ. لكنّ الأهمّ من ذلك أنّ أولئك الأطفال إذا أُعطوا استقلاليةً أكثر من آبائهم وقدرةً على اتخاذ القرار تبعًا لما تريده الذات والنفس، فإنّهم سيطورون مهارات معرفية أفضل تحميهم من التوافق السلبيّ والانجرار مع القطيع، أيْ تعطيهم قدرةً أكبر على معرفة الذات التي تمكّنهم من السباحة ضد التيار أو “التريند”.