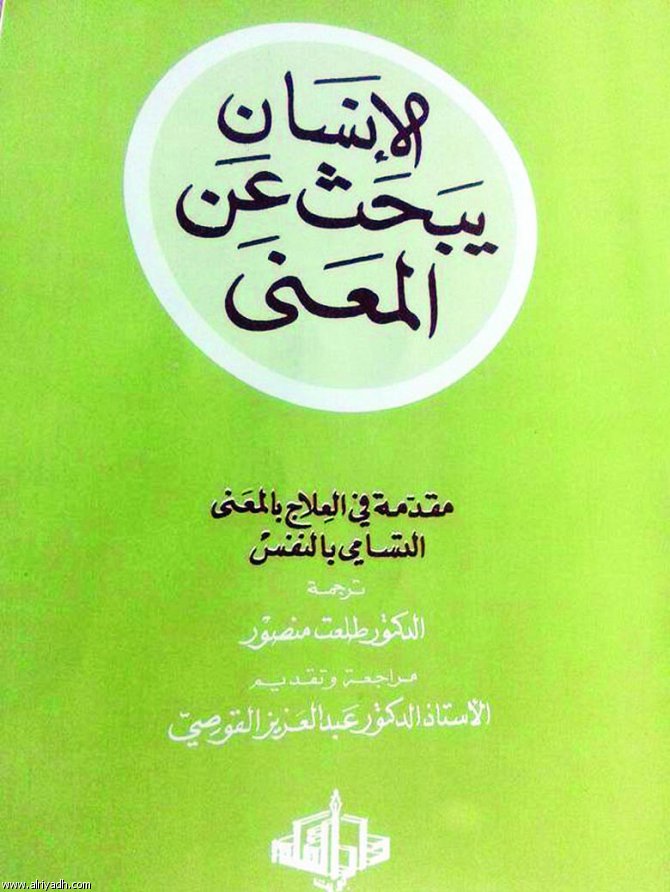شكّلت الحربان العالميّتان، الأولى والثانية، نقطة انعطافٍ مهمٍّ في تاريخ علم النفس من جهةٍ والطبّ النفسيّ من جهةٍ أخرى. إذ كان قبل تلك الفترة تخصصًا أكاديميًا مشبعًا بالنظريات الأيديولوجية العلمية إلى حدٍ كبير. ثمّ جاءت الحربان اللتان عملتا على إضفاء الطابع المهنيّ والوجوديّ إليه، وحاول علماء النفس جعل علومهم ونظريّاهم صالحة وذات صلة لاحتياجات الأفراد والمؤسسات والحكومات.
وقد تحوّلت جهود الكثير منهم إلى الأبحاث والدراسات التي تخدم الحكومات في زمن الحرب. ودخلوا في مجالات العمل العسكريّ والاقتصاديّ والمؤسساتيّ وعملوا على تحليل الدعاية أو “البروباغندا” والأثر الاقتصاديّ على سلوكيات الأفراد. وإضافةً لذلك، فقد شهد الطبّ النفسيّ تطورًا واضحًا وملحوظًا لا سيّما مع كلّ تلك الاضطرابات والاختلالات العقلية والنفسية التي لحقت بالأفراد إثر الحربين.
صدمة الحرب: الجنود الذين غيّروا من علم النفس
في أعقاب الحرب العالمية الأولى، عاد الكثير من الجنود دون أنْ يُظهروا أية إصابات جسدية واضحة. بدلًا من ذلك، كانت أعراضهم شبيهة بتلك التي كانت ترتبط سابقًا بحالات الهستيريا عند النساء كما كان مألوفًا آنذاك؛ حالات فقدان للذاكرة، نوع من الشلل، وعدم القدرة على التواصل مع العالم الخارجيّ وتباطؤ زمن ردات الفعل وحالات الخوف المتكررة وعدم القدرة على النوم أو التركيز، وغيرها الكثير.
لفترة طويلة، ظلّ تلك الأعراض دون أيّ تفسيرٍ واضح. وفي عام 1915، قدّم عالم النفس الإنجليزي “تشارلز مايرز” الورقة الأولى التي وصفت تلك الأعراض وأطلقت عليها اسم “صدمة القصف” أو “Shell-Shock“، مفترضًا أنّ كلّ تلك الأعراض قد نشأت فعلًا عن إصابةٍ جسديةٍ ما وأنّ التعرّض المتكرّر للقصف والانفجارات أدّى إلى ارتجاجٍ في المخ والذي بدوره أدّى إلى تلك المجموعة من الأعراض الغريبة.

أعراض “صدمة القصف” التي أُصيب بها الجنود البريطانيّون خلال العرب العالمية الأولى
وعلى الرغم من أنّ نظرية مايرز تلك لم تصمد أمام الاختبارات الطبية لاحقًا، خاصة وأنّ ثمة عدد من الجنود لم يتعرّضوا لأيّ قصفٍ أو انفجار لكنّهم أبدوا الأعراض ذاتها، إلّا أنّ النظرية كانت بداية الطريق للعديد من مدارس العلاج النفسيّ التي تطوّرت فعليًا على أعقاب الحرب العالمية الثانية وما حملته من اضطرابات نفسية وعقلية في المجتمعات في أوروبا وأمريكا.
لاحقًا، ومع بدء الحرب العالمية الثانية تحديدًا، تمّ استبدال مصطلح “صدمة القصف” بمصطلح “تفاعل كرب القتال” أو “Combat stress reaction“، وهو استجابة مشابهة للأولى ولكنها تختلف في بعض التفاصيل خاصّة قصر مدّتها. وقد انتبه الجيش البريطانيّ لهذا الاضطراب مبكّرًا، بعكس غيره من الجيوش، فقام بتوظيف عددٍ من الأطباء النفسيين ممّن لديهم تصور عن الانهيار النفسي الناجم عن الحرب وكيفية علاجه. وعلى إثر ذلك، تمّ افتتاح أول مشفى لعلاج الأمراض النفسية الناجمة عن الحرب في بريطانيا عام 1942.
سعى علم النفس خلال الحرب العالمية لتفسير الأعراض التي تصيب الجنود والتي تُعرف اليوم بمصطلح “اضطراب ما بعد الصدمة”
علم النفس كصنيعةٍ للحكومة أثناء الحرب
لم تكتفِ الحكومة البريطانية أنْ تقتصر مهمّات علماء وأطبّاء النفس على علاج اضطرابات الصدمة، فقدت جنّدت إضافةً إلى ذلك الآلاف من علماء النفس لأداء البحوث والاختبارات والدراسات التي تهدف إلى اختيار وتعيين الجنود ودراسة دوافعهم ومخاوفهم وتدريبهم وتقوية قدراتهم الحربيّة والنفسية لتعزيز قوّة الجيش، ومن هنا ظهر “علم النفس العسكريّ“.
قامت الحكومات بتوظيف علماء النفس بشكل نشط للمشاركة في عمليات التخطيط والاختبار التي تخدم الحكومة داخليًا وفي حروبها مع الأعداء
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، الجانب القويّ الآخر لعلم النفس آنذاك، فقد كان “علم النفس الاجتماعيّ” آخذٌ باللمعان شيئًا فشيئًا والذي وصل عصره الذهبيّ مع نهايات الحرب العالمية الثانية. إذ سعت الحكومة الأمريكية وقيادات الجيش من خلاله إلى دراسة “البروباغندا” و”الإقناع” و”الخضوع”، عوضًا عن تدخّل الاقتصاد مع السياسية لغايات تحسين الوضع الاقتصاديّ للدولة بعد الحرب من خلال دراسة الأفراد وسلوكيّاتهم الاستهلاكية.
وهكذا، قامت الحكومات بتوظيف علماء النفس بشكل نشط للمشاركة في عمليات التخطيط والاختبار التي تخدم الحكومة داخليًا وفي حروبها مع الأعداء، وقد ظهر على إثر ذلك نمط جديد من الأبحاث الميدانية المنهجية التي هدفت إلى دراسة سلوكيات الأفراد، لا سيّما وأنّ السؤال الرئيسي لعلم النفس الاجتماعيّ آنذاك كان “كيف تحوّل أفراد الشعب الألماني إلى قطيعٍ من الجنود الوحشيين خلف نازية هتلر؟”.
كما تُعتبر الحرب العالمية الثانية بكونها الشعلة الأساسية التي أخذت بمدرسة التحليل النفسيّ إلى التوسّع العالميّ، لا سيّما في ظل الاضطهاد النازيّ الذي لحق باليهود ما أجبر المحلّلين النفسيين اليهود على الهجرة إلى بريطانيا وأمريكا، اللتين كانتا آنذاك أكثر انفتاحًا على أفكار المدرسة، فظهرت حركة أوسع تُسمى “علم النفس الجديد”، عملت على تطبيق أفكار كلٍ من سيغموند فرويد وكارل يونغ وغيرهم من المحلّلين النفسيّين في العلاج. جديرٌ بالذكر أنّ فرويد نفسه هرب من فيينا بعد بضعة أشهر من الغزو النازيّ للمدينة.
العلاج بالمعنى: لماذا لا تنتحر بعد الحرب؟
على الرغم من أنّ نجم مدرسة التحليل النفسيّ كان في أوج ظهوره تلك الفترة، وعلى الرغم من توفّقها إلى حدٍ بعيد في التغلغل بين الأوساط العلمية والنفسية تمامًا كما تغلغلت بين أوساط الأفراد ولاقت قبولًا واسعًا، إلّا أنّ ثمّة مدرسةَ علاجٍ نفسيّ، خرجت من النمسا أيضًا، كانت تشقّ طريقها من بين أنقاض الحرب العالمية الثانية بنجاحٍ ملحوظ، أخذت اسم “العلاج بالمعنى” أو “Logotherapy“.
فقد أسّس عالم النفس وطبيب الأعصاب النمساوي “فيكتور فرانكل”، المدرسة الثالثة النمساويّة في العلاج النفسيّ، بعد مدرسة التحليل النفس لفرويد وعلم النفس الفردي لإدلر. أمّا جوهر “العلاج بالمعنى” وأساسه فكان يعتمد على التحليل الوجودي الذي يبحث عن الدافع المحرّك لحياة الفرد.
من خلال الإجابة على سؤال “لماذا لا تنتحر؟”، سعى “فرانكل” مع مرضاه إلى البحث عن إمكانيات الحياة المدفونة في نفوسهم
انطلق “فرانكل” بعلاجه من سؤال بسيطٍ يوجّهه لمرضاه: “لماذا لا تنتحر؟”. السؤال الذي لازمه بعد انتهاء الحرب وخروجه من معسكرات الاعتقال النازيّة. فمثله مثل غيره من يهود فيينا، تعرّض “فرانكل” لتجربةٍ قاسية إبان الاحتلال النازيّ للنمسا، أدّت به إلى التفكير بطريقةٍ للتعامل مع بؤس الحياة وموجة العدمية التي انتشرت آنذاك حاملةً معها الأفكار والرغبات الانتحارية التي راودت العديد من الأفراد.
نشر فرانكل كتابه في خمسينات القرن الماضي، وسعى فيه إلى إحياء دوافع الحياة في نفوس الناجين من معسكرات النازية
ومن خلال الإجابة على سؤال “لماذا لا تنتحر؟”، سعى “فرانكل” مع مرضاه إلى البحث عن إمكانيات الحياة المدفونة في نفوسهم، والتي قد تكون حبًّا أو عائلةً أو شغفًا أو موهبةً أو أيّ ذكرى أو مشاعر قد تعطي معنى للحياة. وقد دوّن نظريته هذه في كتابه الأشهر “الإنسان يبحث عن معنى”، والذي ينظّر للفكرة القائلة أنّ النفس البشرية تستطيع مواجهة الإحباط الوجوديّ من خلال البحث داخل النفس عن دوافعها وغاياتها في الحياة.
وهكذا، نستطيع القول أنّ الحرب العالمية الثانية كانت بمثابة شعلة الانطلاق التي حفّزت علم النفس ومدارسه المختلفة للظهور والتطوّر، سواء عن طريق الحكومات ولأهدافها في السيطرة والتحكّم، أو للجهود الفرديّة التي هدفت إلى فهم الإنسان وعلاج اضطراباته الناتجة عن الحرب أو إلى تقديم معنىً لحياته بعد كلّ ما مرّ به من بؤسٍ وتجارب قاسية.