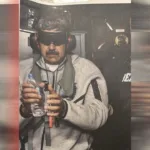لطالما كان السؤال عن علاقة اللغة المحكية بالطريقة التي نفكّر بها وندرك بها الأشياء مطروحًا منذ زمنٍ. في الواقع، فقد شغل هذا السؤال علماء النفس واللغة منذ أربعينات القرن العشرين وحتى اللحظة، وهو فعليًا أشبه بسؤال البيضة والدجاجة، من يأتي قبل من، هل تأتي اللغة قبل الإدراك أمْ أنّ الإدراك هو ما يأتي باللغة؟
لنتفق أولًا أنْ لا ثمّة إجابة محددة يمكن الوصول إليها في هذا السياق. فاللغة والإدراك يشكّلان جزئين اثنين من طبيعة الإنسان المعقدة، فهناك من جانبٍ آخر الثقافة التي تشكّلنا وتشكّل سلوكياتنا وأيضًا إدراكنا. والثقافة لا تحدّد الطريقة التي نفكّر بها أو تسيّر تفكيرنا، إلا أنها تلعب دورًا كبيرًا في الطريقة التي ننظر فيها إلى الأشياء من حولنا، كالزمن واللون والنوع وغيرها من الأمور الإدراكية، لكنّ الزمن هو ما يهمّنا الآن.
وعلى أننا كبشرٍ نتشابه في أنّنا نتعامل مع الزمن بلا توقف وننشئ له مفاهيمَ خاصة وأفكارًا تسمح لنا بوضع الخطط والتفكير واتّباع الخطوات ومشاركة ذكريات الماضي ورسم الأحلام والآمال المستقبلية، إلا أنه مما لا شكّ فيه ثمّة اختلاف أو فروقات في الطريقة التي نتعامل بها مع الأزمنة المختلفة.
نبني مفاهيمنا للزمن تبعًا لمفاهيم مجازية أخرى، كالمكان والحجم والحركة والموقع.
تكشف الأبحاث الحديثة في العلوم المعرفيّة والإدراكية أنّ مفاهيم الزمن عند البشر تختلف عبر الثقافات وتعتمد في جزءٍ كبيرٍ منها على الاستعارة والمجاز، وهو ما يسمّيه علماء الإدرااك “استعارة مفاهيمية”، وهي الطريقة التي نفكّر فيها بشيءٍ ما من وجهةِ نظرٍ شيءٍ آخر. وهكذا، فإنّنا نبني مفاهيمنا للزمن تبعًا لمفاهيم مجازية أخرى، كالمكان والحجم والحركة والموقع.
هذا يعني أنّ الناس من مختلف الثقافات يختلفون في طريقة نظرهم للزمن تبعًا لأنماط الاستعارة والمجاز في اللغة التي يتحدثون بها. فعلى سبيل المثال، تُستخدم كلمة “Framtid” في اللغة السويدية للإشارة إلى المستقبل، ولو جئنا إلى معناها الحرفيّ لوجدناه “الزمن الأماميّ”. وفي اللغة العربية، فكلمة “مستقبل” نفسها هي اسم مفعول مشتقة من الفعل “قبل” أو “أقبل”، ما يعني “قدِمَ” أو “أتى”، و”استقبل الشيء” فتعني “وجّه وجهه نحوها”، ولهذا غالبًا ما نقول أنّ المستقبل يمتدّ أمامنا أما الماضي فيضحي بالخلف.
أمّا في لغة سكّان البيرو، فإنّ كلمة “Qhipuru” هي اللفظة التي تدلّ على المستقبل، وتعني حرفيًا “الزمن بالخلف”، فكيف يمكن للمستقبل أنْ يكونَ بالخلف؟
يدرك أولئك السكّان من وجهة نظرهم المختلفة، أنّنا كأفرادٍ لا نستطيع رؤية المُستقبل، وبالتالي فالأكثر منطقيةً بالنسبة لهم أنْ يكون خلفنا نظرًا لأنّنا لا نستطيع رؤية ما هو خلف ظهورنا. أمّا الماضي، أيْ كلّ ما مررنا به ورأيناه أمام أعيننا، فيُمكن وصفه بالزمن الأمامي. ومن هذه النقطة، نستطيع القول أنّ ثمّة تداخلٍ كبير ما بين التعابير المكانية التي نستخدمها في لغتنا، وما بين مصطلحاتنا الزمنية.
يمكن الاستدلال على تلك العلاقة أيضًا من خلال النظر إلى أحد الشعوب في غينيا، حيث يمتلك شعب الـ Yupnoإدراكًا مختلفًا لمفاهيم الماضي والحاضر والمستقبل، لا سيّما في استخدامهم للإشارات والإيماءات للدلالة عليها. فهم يوجّهون اليد إلى ما وراء الكتف عند الإشارة إلى الماضي، وإلى الأمام عند الإشارة إلى المستقبل. وتكشف هذه الإشارات الضمنية طريقةً أساسية للتفكير في الماضي كشيءٍ نتركه وراء ظهرنا، والمستقبل كشيءٍ أمامنا نتطلّع إليه.
يشير سكان شعب الـYupno بأيديهم إلى ما وراء أكتافهم أثناء الحديث عن الماضي وإلى الأمام أثناء الحديث عن المستقبل
وتعدّ المسافات والكمّيات أحد أنواع الاستعارات التي يمكن استخدامها لوصف الوقت. كأنْ نقول “إجازة طويلة” أو “رحلة قصيرة” كما في العربية أو الإنجليزية، فيما يستخدم آخرون الكمّيات بديلًا عن المسافات، فتصبح الإجازة صغيرة والرحلة كبيرة كما في الإسبانية واليونانية. أما السبب فيرجع إلى أنّ المسافات تُستخدم في اللغات التي تنظر للزمن على أنه خطًا أفقيًا متصلًا، أما المجموعة الثانية فتنظر إليه على أنه كمّية أو حجم.
تعدّ المسافات والكمّيات أحد أنواع الاستعارات التي يمكن استخدامها لوصف الوقت. كأنْ نقول “إجازة طويلة” أو “إجازة صغيرة”
ولو سألنا أنفسنا كيف يمكننا فهم كلّ هذا في ضوء سلوكيّاتنا وأفعالنا، فالإجابة تكمن في الطريقة التي نتعامل بها مع مرور الزمن، والطريقة التي ننظر بها للماضي ونتعامل مع ذكرياته، كأنْ نمرّ عنه ونتركه وراءنا فعلًا ونركّز على المستقبل أو أنْ نعلق فيه ونحمله معنا للأمام فيصبح هو والحاضر والمستقبل أزمنةً متداخلة لا فواصل بينها.
وبكلماتٍ أخرى، ينظر متحدّثو العربية والإنجليزية للزمن كمسطرة متصلة يجب أن نقطعها، أما الإسبانيون واليونانيون فينظرون إليه وكأنه وعاءٌ يمتلئ بالماء وينقص. وتنعكس هذه الرؤية أو هذه الطريقة من الإدراك على الكثير من الجوانب النفسية، مثل تعاملنا مع أحاسيسنا وعواطفنا وتجاربنا، فإمّا أنْ ننظر إليها على أنها متصلة ومتواصلة كالمسطرة مثلًا، أو ننظر إليها كوعاء يمتلئ وينقص تبعًا للعديد من العوامل.
وعلى صعيدٍ آخر، فقد وجدت إحدى الدراسات أنّ التباين اللغوي في الزمن يُظهر عدة اختلافات في النشاط الاقتصاديّ أيضًا، وأنّ قدرة الفرد على الادّخار والتوفير تتأثر بلغته واستخدامات الزمن فيها. فعلى سبيل المثال، فإنّ متحدثي اللغات التي لا تحدد الفروقات بين أزمنة الوقت بدقة مثل الصينيين يميلون إلى تحقيق ادخارات أعلى من أولئك الذين يتحدثون اللغات التي تميّز بين عدة أزمنة كالماضي والحاضر والمستقبل.
ولعلّ الدراسات القادمة ستخبرنا الكثير عن علاقة اللغة والاستعارات المكانية بالوقت والزمن، وتوضّح لنا بشكلٍ أكبر أثر ذلك على سلوكياتنا وتصرفاتنا سواءً الفردية أو المجتمعية. ومع ذلك، يجب أنْ نعي تمامًا أنّ الاستعارات الخاصة التي نتكئ عليها في إدراكنا للوقت وفهمنا له هي نتاج للثقافة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل فعلًا عن الطريقة التي سنصبح نرى فيها الزمن مع تطوّر ثقافاتنا بفعل عوامل التكنولوجيا والحداثة والعولمة وغيرها.