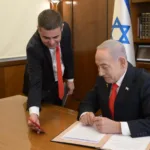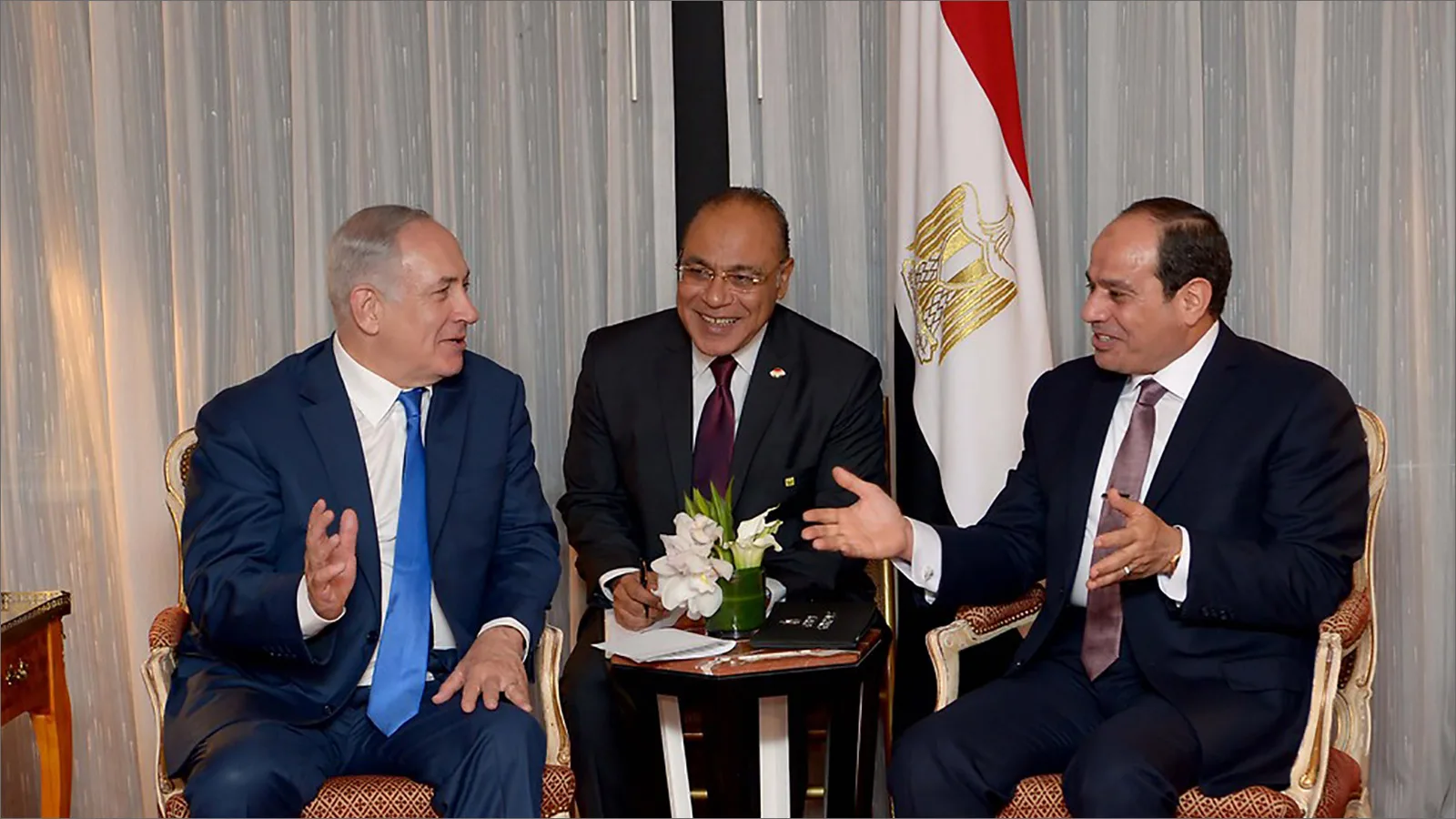تنمي المدارس جزءًا لا يستهان به من أفكارنا ومعتقداتنا وحتى سلوكياتنا، فهي البيئة الأولى التي يواجه فيها الطفل العالم الخارجي ويبدأ من خلالها بالتفاعل مع محيطه ومجتمعه، ولا شك أن جميع القيم والمعلومات التي يتلقاها شيئًا فشيئًا خلال سنوات الدراسة، بقصدٍ ومن دون قصد، تحمل رسائل مختلفة الأهداف ولها أبعاد ودوافع محددة، أهمها السياسة.
في عام 1968، ظهر مصطلح “المنهج الخفي” الذي صاغه فيليب جاكسون في كتابه “الحياة في الفصول الدراسية”، ويقصد به جميع السلوكيات ووجهات النظر والقيم الاجتماعية والثقافية التي تعلمها المدرسة للطالب بشكل غير مكتوب أو علني، فعلى سبيل المثال، إن طريقة تعامل الطلاب مع أقرانهم من العرقيات والأديان المختلفة تبين لنا طبيعة المعلومات التي تلقوها خلال سنوات الدراسة عن العنصرية والمساواة.
في هذا التقرير نحاول التعرف على دور السياسة في نظام التعليم وكيف تحاول التلاعب بوعي الطالب وسلوكياته سرًا من خلال المقررات الدراسية واللغات الأجنبية أو حتى تصاميم المباني الدراسية وتأثيرها في نفسية الطالب.
المنهج الدراسي
توفر المدرسة مصدرًا أساسيًا للعلوم العلمية والإنسانية، ولكنها في الوقت ذاته تتبع ثلاثة أنواع من المناهج الدراسية وهي العلنية والخفية والمستبعدة، والأولى هي كل المقررات الوزارية الرسمية، والثانية تعني بكل القواعد والقناعات التي ترغب الجهات العليا بإرضاعها للتلاميذ منذ الصغر، أما الأخيرة فتشير إلى المواضيع التي تتجنب السلطات ذكرها أو عرضها للطالب.
تبين لنا هذه الأنواع الثلاث أن الطالب في المدرسة لا يتم فقط تعليمه وإثراء تفكيره بمعلومات مختلفة، وإنما يتم تجهيله أيضًا وتعتيم فكره عن بعض الأمور التي لا تلائم التطلعات الحكومية أو تهدد وجودها بشكل ما، فبجانب دروس الرياضيات والجغرافيا يتعلم الطالب أيضًا ممارسة القبول السلبي والطاعة، بهدف تجميد أفكار الأجيال وقولبتها بأنماط مقبولة بمعايير السياسة والمجتمع، وبهذا تكون قادرة على خلق شباب غير قادر على التشكيك بما حوله من قضايا محلية أو دولية.
تعد المواد الدينية والتاريخية، أكثر المواضيع جدلية وحساسية بالنسبة للدولة، لذلك يتم غالبًا تلقينها للطالب بأسلوب جامد وبعيدًا عن النقاشات النقدية
وبالتالي، تتصادم جهوده العقلية وانتقاداته بقوانين الإدارة وتعليمات المعلم التي تجبره على قبول كل ما يسمعه أو يملى عليه دون جدال أو نقاش، فالمدرسة وطواقمها رمز من رموز السلطة التي تشكل توجهات الطالب من خلال تزويده بلائحة من الضوابط والقوانين التي تزرع الخوف في نفسه والبرود في عقله حتى لا يتمكن من كسر هذه الحواجز الاجتماعية وتعويده على الاستسلام لجميع أشكال السلطة الأخرى.
فتعد المواد الدينية والتاريخية، أكثر المواضيع جدلية وحساسية بالنسبة للدولة، لذلك يتم غالبًا تلقينها للطالب بأسلوب جامد وبعيدًا عن النقاشات النقدية، على سبيل المثال، يختلف سرد المواضيع الدينية بحسب موقف الدولة من الدين، فإذا كانت الدولة علمانية متشددة مثل فرنسا نرى أن المواد الدينية تكاد تكون معدومة، أما إذا كانت محايدة مثل أمريكا فهي تستبعد التعليقات الدينية خشية أن يكون التعليق لصالح فئة معينة على حساب أخرى.
وتبعًا لذلك، يتم تعديل وتطوير المناهج لخدمة أجندات سياسية معينة توجه الفكر العام نحو موقف واحد يلائم تطلعاتها وميولها لمساعدتها على الاستمرار والاستقرار على أساس الرضا الاجتماعي النابع من قناعات مزيفة ومبنية على عقيدة احترام الأعراف والأنظمة السائدة.
على سبيل المثال، في تقرير سابقًا لـ”نون بوست” بعنوان “كيف يعيد أردوغان بناء الهوية التركية من خلال مؤسسة التعليم” أشرنا إلى دور حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تشكيل الوعي التاريخي والوطني لدى المجتمع التركي من خلال النظام التعليمي الذي تم تعديله وتحديثه مرارًا باختلاف النظام الحاكم، ففي زمن أتاتورك كان يمنع الطلبة من ارتداء أي لباس ذي رمزية دينية مثل الحجاب وألغى اللغة العربية وأبجديتها تمامًا من المؤسسات التعليمية، وبالمقابل أدرج اللغة الإنجليزية واعتمد على المصادر الثقافية الغربية في المناهج.
في المقابل وبعد انحصار الحكم العلماني، سمحت وزارة التعليم الوطني في تركيا بالحجاب داخل المدارس والجماعات، وأدخلت مادة التربية والدين والأخلاق إلى المواد المدرسية، مركزة على مواضيع الشريعة الإسلامية وهو الأمر المنافي تمامًا للتوجهات العلمانية التي تبناها أتاتورك وحاول تقليصها على قدر المستطاع.
لا يقتصر تأثير السياسة على المحتويات الدراسية المكتوبة أو المغيبة، فلقد ربطت عدة دراسات وأبحاث بين التصميم المعماري وما يحتويه في تفسير دوره على الطالب ونظرته إلى المعارك السياسية أو حتى الأحداث التاريخية والخلفيات الدينية
هذا الاختلاف الواضح في التوجهات بين التيارين العلماني والمحافظ غير بشكل واضح المحتوى التعليمي في المدارس التركية التي عملت في فترة معينة على تعظيم مجموعة دينية ووطنية على حساب أخرى، دون وجود أي موضوعية أو حيادية، وإنما انصياعًا لرغبات النظام الحاكم.
ولا يتوقف التأثير السياسي على ولاء الطلاب ووطنيتهم فقط من خلال المحتويات الدراسية، فإن أقل الأنشطة أهمية تؤثر على مواقفهم الفكرية، وذلك بدايةً من أداء تحية العلم والنشيد الوطني وغيرها من الأغاني الوطنية الحماسية التي تمجد شخوصًا ورموزًا تاريخية وتنمي مشاعر الولاء والفداء لديهم بطريقة مدروسة وملائمة لتوجهات السلطة.
في تجربة أخرى بالوطن العربي، قررت وازرة التربية السورية بأمر من النظام تدريس اللغة الروسية كلغة اختيارية ثانية ضمن المناهج التعليمية لطلاب المدارس، حيث جاء هذا القرار بعد الأزمة السورية وطرح روسيا نفسها كأكبر حليف للنظام سواء عسكريًا أم سلميًا، وما دلل لاحقًا على اتفاقيات متبادلة بين الطرفين تمنحهم متعة الاستفادة من بعضهما على مختلف الأصعدة السياسية والثقافية.
واعتبارً لذلك، فإن روسيا تستغل لغتها الوطنية كسلاح ثانٍ من أجل فرض نفوذها ووجودها على الساحة السياسية وتحديدًا فيما يخص القضية السورية، ولكنها هذه المرة توجه خطابها إلى الطلاب والنشء بأسلوب متحضر ومتأصل، فلا شك أن اللغة أداة مثالية لاستقطاب الولاء والقبول من السوريين.
منظومة المدرسة في غالبها دفعت الطالب إلى الاستكانة والاستسلام بحجة التحصيل العلمي والالتزام الأخلاقي، بدلًا من تشجيعه على التفكير والتغيير المبني على تحفيز الشك البناء
لا يقتصر تأثير السياسة وأجندتها على المحتويات الدراسية المكتوبة أو المغيبة، فلقد ربطت عدة دراسات وأبحاث بين التصميم المعماري وما يحتويه في تفسير دوره على الطالب ونظرته إلى المعارك السياسية أو حتى الأحداث التاريخية والخلفيات الدينية.
لإثبات ذلك، نعرض مثالاً آخر من تركيا التي أقرت فيها وزارة التعليم بضرورة افتتاح مصليات داخل المدارس، الأمر الذي يمنح المؤسسات التعليمية طابعًا إسلاميًا محافظًا ويعطي للدين وشعائره مساحته الخاصة واليومية من وقت الطالب وتفكيره حتى يعتقد بالنهاية أن هذه الممارسات جزء أساسي وروتيني من هويته وتنشئته الاجتماعية.
وهو الأمر الذي ألغاه أتاتورك تمامًا من حياة الطلاب اليومية، فلقد كانت المدارس خالية تمامًا من أي طابع ديني أو مذهبي وبالمقابل زينت المؤسسات التعليمية بصوره وخطاباته ومقولاته، ومن هنا نستطيع فهم تقديس البعض لشخصه وآرائه.
إن منظومة المدرسة في غالبها دفعت الطالب إلى الاستكانة والاستسلام بحجة التحصيل العلمي والالتزام الأخلاقي، بدلًا من تشجيعه على التفكير والتغيير المبني على تحفيز الشك البناء والجرأة في الطرح والسؤال، والذي من شأنه أن يخلق لديه طاقة حيوية ومهارات إبداعية في تحسين الحاضر إلى الأفضل.