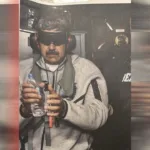في السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من المناهج والأساليب الحديثة التي أخذت على عاتقها مسؤولية إحداث تغييرات في أنظمة التعليم التي تقوم على الأساليب التقليدية الرتيبة، التي لا تعود على الطالب إلا بالملل وكره التعليم من جهة، وفصله عن الحياة الواقعية والاجتماعية والطبيعة من حوله من جهةٍ ثانية.
وتأتي هذه الأساليب تماشيًا مع نظرة الفيلسوف الفرنسيّ “ميشيل فوكو” فيما يتعلّق بالمدارس الحديثة بوصفها “ثكنات عسكرية” تعمل كوسيلةَ مراقبةٍ تهدف إلى ترويض الأفراد وجعلهم ذواتًا تخضع للسلطة وتخدمها بهدف إنشاء “مجتمع انضباطيّ” يسهل التحكّم به والسيطرة عليه. والمدرسة عند “فوكو” هي شكلٌ من أشكال السلطة الحديثة التي تعمل من خلال المراقبة والضبط والتطويع، أو من خلال التهميش والإقصاء عن طريق الامتحانات على سبيل المثال، إذ أنها بالنهاية ليست سوى وسيلة “انتقاء” تهدف إلى إقصاء فئة على حساب أخرى، لكن بطريقةٍ مشروعية يقبلها المجتمع ككلّ.
ولهذا، يسعى العديد من خبراء التعليم والتنشئة والدارسين لصحة الطفل النفسية والعقلية على دعم الأساليب غير التقليدية في التعليم، سعيًا منهم إلى استعادة قيمة التعلّم التي ضيّعتها المناهج الرتيبة والصفوف المغلقة والأنظمة الصارمة، لما يعود بالفائدة الكبيرة على نفسية الطلاب ونموّهم الفكري والعقلي من جهة وواقع المجتمعات ومستقبلها من جهةٍ ثانية.
التعليم في الهواء الطلق: الطبيعة كأكبر حافز للتعلّم
يُعتبر “التعليم في الهواء الطلق” واحدًا من التقنيات الحديثة للتعليم الذي يأتي بديلًا للطرق التقليدية والقديمة بطريقةٍ تدعم تنشئة الأطفال والطلّاب بشكلٍ يتفق مع الطبيعة بعيدًا عن جدران الصفوف والأبواب المغلقة. وتأتي الفكرة أساسًا من تناقص فرص الأطفال في العصر الحديث في قضاء الوقت الكافي في الهواء الطلق مع كلّ هذا التطوّر التقني والتكنولوجي والتغيّر في ملامح الحياة الحاصل.
فمع زيادة شواغل الآباء وأعمالهم، إضافة إلى تناقص الشعور بالأمان في المجتمعات، تضاءلت فرص الأطفال في استكشاف البيئة الطبيعية المحيطة بهم، الأمر الذي يجعل خبراء التنشئة وصحة الطفل عن التساؤل عن مدى أثر ذلك على نمو الطفل السليم، سواء الجسدي أو العاطفي، ومهاراته الاجتماعية وصحته العامة على المدى البعيد.
تعزّز الدراسة خارج أبواب المدرسة السلوك التحفيز للطلاب تجاه التعلّم وتجذب انتباههم واهتمامهم للعملية التعليمية
إذ تشير العديد من الدراسات إلى أنّ هذا النوع من التعليم، جنبًا إلى جنب مع منهجية التعليم الاستكشافي، تعمل على تعزيز السلوك التحفيزي للطفل تجاه التعلّم. وقد أظهر الأطفال الخاضعون للدراسة التي أجراها باحثون بجامعة إلينوي الأميركية، أنّ تلقيهم لدروسهم في الهواء الطلق جعلهم أكثر انتباهًا لما يقوله المدرّس، إضافةً لتحفيز مشاركتهم في أعمالهم المدرسية مشاركةً فعالة أكثر من أقرانهم الذين يدرسون داخل قاعات التدريس التقليدية، والعديد من الفوائد والإيجابيات الأخرى التي تتمثل في خلق جسدٍ صحي وعقل سليم وبناء شخصية اجتماعية وواثقة من نفسها وقادرة على الابتكار والمشاركة في المجتمع.
التلعيب: التعليم بالخبرة لا بالدرجات
تخبرنا العديد من النظريات في علم النفس أنّ اللعب يُعدّ وسيلةً للتنمية الشخصية والعقلية والعاطفية، لما فيه من أساليب عديدة تساعدنا على مواجهة العديد من مشاعر الضعف والقلق والعجز. ومن جهةٍ ثانية، تفترض بعض النظريات أنّ الأطفال، مثلهم مثل غيرهم من صغار الثدييات، يلجأون للعب كنتيجةٍ للانتقاء الطبيعيّ الذي تنصّ عليه نظرية التطوّر. أيْ أنّنا نسعى من خلال الألعاب التي نلبعبها بدءًا من تسلّق الأشجار والقفز بالحبال وصنع البيوت، ومرورًا بالألعاب الحديثة والألعاب الجماعية وغيرها، بوصفها وسيلة تعلّمنا المهارات البدنية والعقلية التي نحتاجها للبقاء والاستمرار والتكاثر.
التلعيب هو تطبيق العناصر الأولية لممارسة لعبة ما، مثل قواعد اللعب وأساليب التنافس والفوز والخسارة والتشارك مع الآخرين، في مجالات مغايرة لا ترتبط باللعبة نفسها على وجه التحديد، لإشراك الطلاب في الدرس وتعزيز انتباههم وتحفيز أساليب التعلّم والتفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات لديهم.
ومن هنا جاءت فكرة “التلعيب”، أي تطبيق العناصر الأولية لممارسة لعبة ما، مثل قواعد اللعب وأساليب التنافس والفوز والخسارة والتشارك مع الآخرين، في مجالات مغايرة لا ترتبط باللعبة نفسها على وجه التحديد، لإشراك الطلاب في الدرس وتعزيز انتباههم وتحفيز أساليب التعلّم والتفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات لديهم.وقد عُرف مصطلح ” Gamification” للمرة الأولى عام 2010 على يد “نيك بيلنج Nick Pelling“، المبرمج البريطانيّ الذي صاغ الفكرة مشتقًا اسمها من كلمة Game، أما في العربية فيمكن ترجمتها إلى تلعيب ولوعبة ولعبنة. وبدءًا من عام 2011، بدأت العديد من المجالات مثل التعليم والتسويق والصحة وغيرها. فعلى سبيل المثال، هناك العديد من التطبيقات التي تستخدم التلعيب لتشجيع مستخدميها على أداء تمارينهم بفاعلية أكبر وتحسين صحتهم بشكلٍ عام.
ولنفهم كيف يمكن دمج هذا الأسلوب بالتعليم، فمدرسة ” Quest to Learn“، إحدى مدارس المرحتلين المتوسطة والثانوية في نيويورك، التي بدأت منذ عام 2009 تطبيق أول منهاج كامل طبّق عليه مبدأ التلعيب، حيث يعدّ تفاعل الطلاب في المواد الدراسية حصريًا فقط عن طريق اللعب وإنشاء اللعب وخوضها. فعلى سبيل، يتعلّم الطلاب عن أجهزة جسم الإنسان في درس العلوم من خلال لعبةٍ يقوم فيها بمساعدة عالمٍ متقلّص يبحث عن طريقه في جسم الإنسان.
يعتمد منهج التلعيب على أنْ تكون الخبرة التي يجنيها الطالب هي مقياس تعلّمه لا الدرجات التي قد يحصل عليها في الامتحانات
وبهذه الطريقة، يدعم منهج “التلعيب” أنْ لا تكون الدرجات مقياسًا للتعلّم، وإنما الخبرة التي يمكن للطالب اكتسابها وسلوكها تمامًا فيما لو كان ضمن لعبة تتراوح مستوياتها ما بين “مبتدئ” و”متقدّم”. وتتعدد فوائد وإيجابيات التلعيب، منها شعور الطلاب بتحكّمهم بعملية التعليم ومسؤوليتهم عنها، وتحديد دوافع الطلاب في التعلّم، وبناء شعور بالإنجاز والتحقيق، وتحفيز التزام الطالب بعملية التعليم وتحفيز التعاون والتشارك والتنافس السليم بينه وبين زملائه.
التعليم المتباعد: استغلال الذاكرة لتحسين التعلّم
تخيّل ذاكرتك وكأنها أشبه غرفةٍ تُحفظ فيها المجلدات والمستندات التي تستطيع الوصول للمعلومة فيها لمقدارٍ من الوقت قبل أنْ تُضاف معلومة أخرى للغرفة. وهذا هو الحال تمامًا في دماغك، تجد معلومةً أمامك، تحفظها في ذاكرتك قصيرة المدى، ثمّ قد تنساها إنْ أهملتها ولم تعزز وجودها، أو قد تحفظها بطريقةٍ فعالة في حال عرفت كيف تنقلها إلى ذاكرتك طويلة المدى لتسترجعها على المدى البعيد.
يعتمد التعليم المتباعد على مبدأ عمل الدماغ الذي يخزّن المعلومات والإشارات التي يتلقّاها أمامه بشكلٍ يوميّ بطريقةٍ تفضيلية أوانتقائية، بحيث إنه يميل لتخزين المعلومات التي يراها مهمة أو التي يواجهها ويتعرّض لها بانتظام وبشكل متكرر
أدرك العديد من الباحثين للكيفية التي تعمل بها هذه الآلية وطبّقوها فيما بات يُعرف بمصطلح “التعليم المتباعد Spaced Learning” أو “التكرار المتباعد”، وهي آلية تُتبع في بعض مناهج التعليم بحيث يتم تعريض الطلاب للمعلومة أو الدرس على مدىً متكرّر، كثلاث مرات على سبيل المثال، بحيث يستطيع الدماغ استقبالها من خلال مجموعة متنوعة من المحفّزات البصرية والسمعية والتفاعلية وغيرها. ثمّ يُهيّأ للدماغ فتراتٍ من الراحة لإتاحة الوقت لاستيعابها، ثمّ تكرار المعلومات باستخدام أساليب مختلفة لتوسيع فهمها وتعميقه ولتحسين استعادتها لاحقًا. ثمّ تكرار الخطوات لاحقًا.
وبكلماتٍ أخرى، فيعتمد التعليم المتباعد على مبدأ عمل الدماغ الذي يخزّن المعلومات والإشارات التي يتلقّاها أمامه بشكلٍ يوميّ بطريقةٍ تفضيلية أوانتقائية، بحيث إنه يميل لتخزين المعلومات التي يراها مهمة أو التي يواجهها ويتعرّض لها بانتظام وبشكل متكرر. لذا فإن التكرار المتباعد، أو مراجعة المعلومات بانتظام على فترات زمنية محددة، يعدّ فهمًا عميقًا ومنطقيًا لآلية عمل الدماغ واستخدامها على أكمل وجه..
وهذا ما أثبتته بالفعل العديد من الأبحاث النفسية، لتحسين مستوى الدراسة وحفظ المعلومات فأفضل طريقة يمكن اتباعها هي الدراسة القصيرة ولكنْ على مراتٍ عديدة متباعدة. فبدلًا من الدراسة ليلة الامتحان، يُنصح بدراسة جزءٍ قصير من المادة وتكراره على مدى فتراتٍ متباعدة حتى يستطيع الدماغ تشرّبها بشكلٍ كامل. أمّا المدارس التي تتبع هذا الأسلوب في التلقين، فتعتمد غالبًا وقتًا قصيرًا للدرس، ومن ثمّ يقوم الطلاب ببعض الأنشطة التي يمكنها تشتيت انتباههم عن المعلومات، كالرياضة أو الأدب أو الحوارات أو الطعام، ومن ثمّ العودة إلى الدرس نفسه للمرة الثانية، وهكذا.