فولو-أنفولو: كيف غذّت مواقع التواصل الشخصية الحدّية؟

“متابعة؟ عدم متابعة.. صداقة؟ إلغاء صداقة.. كتم وأخذ استراحة”، كل هذه خيارات تحدد حضور المعارف والأصدقاء في مساحتنا الرقمية، وتحدد حضورنا كذلك في عوالمهم الافتراضية. وعلى الرغم من كون سلوكنا في تحديد الصداقات والإعجابات والتعليقات في الحيز الافتراضي هو سلوك طبيعي في غالبية الأحيان، إلا أنه قد يتخذ شكلاً سلبيًا أو حتى مرضيًا في بعض الأوقات. يظهر هذا أكثر ما يظهر حين تنعكس أعراض اضطرابات الشخصية على سلوك المستخدم داخل هذه العوالم.
أثبتت العديد من الدراسات وجود علاقةٍ متينة وواضحة بين مواقع التواصل الاجتماعي من جهة واضطرابات الشخصية من جهةٍ ثانية، بما في ذلك الشخصية الهستيرية والنرجسية والحدّية، أو اضطراب الشخصية غير المستقرّة عاطفيًا كما يُعرف أيضًا، والذي يعدّ واحدًا من أكثر اضطرابات الشخصية شيوعًا.
ينطوي اضطراب الشخصية على أنماط طويلة الأمد وثابتة في الإدراك والتفكير والسلوك. وبسبب عدم مرونة هذه الأنماط وقلة انتشارها في المجتمعات، فهي عادةً ما تسبّب مشاكل وصعوبات في حياة الشخص من وقتٍ لآخر على مختلف المستويات الفردية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية والعاطفية وغيرها. وعلى عكس الاكتئاب والقلق مثلًا، فالمُصاب باضطراب الشخصية لا يعترف عادةً بإصابته بها.
على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، تُصبح المتابعة وإلغائها “follow & unfollow” والحظر “block” هي الطرق التي تعبّر بها الشخصية الحدّية عن مشاعرها وعواطفها غير المستقرة في الحيّز الإلكتروني
وفي حين أنّ معظم الناس قد يجدون في أنفسهم سمة أو أكثر من السمات التي تميّز اضطرابات الشخصية؛ إلا أنّ الشخص الذي يمكن تشخيصه بالمضطرب هو الذي يُعاني من معظم أعراض وسمات ذلك الاضطراب التي تستمرّ معه بدءًا من مرحلة البلوغ وحتى المراحل اللاحقة. ولهذا قد تتصرّف أحيانًا بشكلٍ حدّي أو غير مستقرّ عاطفيًا دون أنْ يعني ذلك أنّك مُصاب باضطراب الشخصية الحدّية.
أنفريند-فريند/هايد-أنهايد: تقلّب في بناء العلاقات والصداقات
قد تكون لاحظتَ يومًا أنّ هناك في قائمة أصدقائك مَن يرسل لك طلب صداقة أو مَن يصلك منه إشعار متابعة، مرارًا وتكرارًا بين الفترة وأختها، مع أنك تكون قد قبلت طلبه سابقًا، أو أنك تكون متأكدًا من أنه يتابعك بالفعل، فتسأل نفسك: لماذا يستمرّ هذا الشخص بمتابعتي وإلغائها بهذا الشكل المتقلّب جدًا؟
غالبًا ما تكون العلاقات والصداقات وحتى الحياة الأسرية للشخصية الحدّية حادة للغاية وغير مستقرة، وكأنّها تتأرجح بين قطبين متناقضين تمامًا، أحدهما أبيضَ اللون والآخر أسود، ولا وجود للرمادي بينهما أبدًا. فقد تحبّ تلك الشخصية صديقًا لها الآن لتكرهه بعد ساعة وقد تعبّر عن رغبتها بعدم التواصل معه على الرغم من حاجتها إليه. والشخص الذي تراه صديقًا اليوم قد يصبح كريهًا غدًا، والشخص الذي تراه مثاليًا الآن قد يصبح بعد ساعات قليلة شخصًا عاديًا لا يستحق أيّ تقدير أو احترام. وهكذا دواليك.
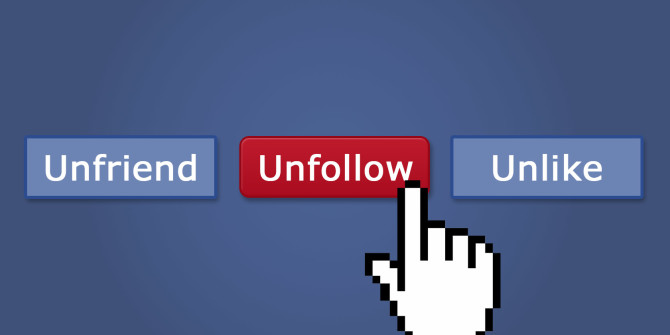
تفتقر الشخصية الحدّية للقدرة على تنظيم الانفعالات والمشاعر، لهذا فكثيرًا ما تقوم تكرّر متابعة وإلغاء متابعة نفس الشخص لاضطراب مزاجها
على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، تُصبح المتابعة وإلغائها “follow & unfollow” والحظر “block” هي الطرق التي تعبّر بها تلك الشخصية عن مشاعرها وعواطفها غير المستقرة في الحيّز الإلكتروني. ففي الوضع الطبيعي، قد تكون قادرًا على تحديد قائمة مَن ترغب في متابعتهم، حتى وإنْ وجدتَ نفسك غير معنيّ بشخصٍ ما وما يشاركه على حساباته، فستقوم بإلغاء المتابعة لأنكَ قادرٌ على تحديد مشاعرك ووجهات نظرك بالآخرين ممّن تتابعهم.
بينما لا يحدث الأمر بهذا الشكل مع الشخصية الحدّية، والتي تتّسم أساسًا بعدم قدرتها على الاستقرار في المشاعر والانفعالات، فقد تلغي متابعتها لشخصٍ ما لاختلافها معه أو لغضبها من رأيه، وبمجرد زوال الغضب وهدوء الانفعال ستقوم فورًا بإعادة إرسال طلب الصداقة أو المتابعة. أو قد تغضب من صديقٍ لها فتقوم بإزالة كافة الإعجابات التي وضعتها له مسبقًا، واحدًا تلو الآخر. كما يظهر الأمر جليًّا أيضًا مع خاصّية إخفاء قصص انستجرام أو سناب شات اللحظية “hide story” أكثر من مرة خلال فترةٍ قصيرةٍ جدًا، أو حذف الرسائل الإلكترونية والتعليقات نتيجة انفعالٍ أو غضب.
نحن هنا لا نتحدث عن مَن يُخفي قصصه ومنشوراته لرغبةٍ منه بإخفاء بعض تفاصيله اليومية عن أشخاص بعينهم، فالشخصية الحدية تفعل هذا مع أقرب الأشخاص إليها، صديق أو حبيب أو فردٍ من العائلة، دون سببٍ وجيه أو منطقي سوى لتقلّب مشاعرها وعواطفها تجاههم. وبتعبيرٍ آخر، لا يكون سلوك الشخصية الحدّية مفهومًا لمن حولها لانعدام الأسباب المنطقية المتعلقة به.
آكتيفيشن-ديآكتيفيشن: خلل في صورة الذات وسعي نحو الاهتمام
تعاني الشخصية الحدّية من قدرة عالية على تطوير صورة سلبية للذات واضطراب في الهوية، إضافةً إلى انخفاضٍ كبير في استحقاق الذات. وبالتالي، تعمل وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها بيئةً تعتمد أكثر ما تعتمد على عدد الإعجابات والتعليقات والتفاعلات، على تغذية الخلل الهويّاتي وانعدام الاستقرار الذاتي عند الأفراد المصابين باضطراب الشخصية الحدية.
فهي تبحث بشكلٍ دائم عن طرق وأساليب خارجية لتحسين صورة ذاتها ونفسها، عوضًا عن أنها كثيرًا ما تقارن نفسها بغيرها كنتاجٍ لعدم الاستقرار هذا. لذا، قد تدخل الشخصية الحدية في اكتئابٍ أو مشاعر حزن من خلال مقارنة النفس بالغير عن طريق ما يُنشر على مواقع التواصل. كما يؤدي الشعور الدائم بالفراغ واضطراب الهوية إلى قيام الأشخاص بنشر تفاصيل حياتهم كل دقيقة على تلك المواقع، وتوقّع تفاعل المتابعين واستجاباتهم، الأمر الذي قد يصل إلى نقطة تطوير الهواجس والعيش في عالمٍ مبنيّ على الإعجاب والشعور بالأهمية المتخيّلين.
تعمل وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها بيئةً تعتمد أكثر ما تعتمد على عدد الإعجابات والتعليقات والتفاعلات، على تغذية الخلل الهويّاتي وانعدام الاستقرار الذاتي عند الأفراد المصابين باضطراب الشخصية الحدية
وبحثًا عن الاهتمام والانتباه أيضًا، قد تسعى الشخصية الحدية للاختفاء عن مواقع التواصل الاجتماعي أو تعطيلها لا لشيءٍ سوى للفت الانتباه وجذب الاهتمام وتحصيل السؤال. فالذات لديها في عطشِ دائم لصورةٍ إيجابية وحسنة يمكن تحصيلها من خلال اهتمام الآخرين بها وسؤالهم عنها وجعلها محطّ النقاش والحديث.
يرافق اضطراب صورة الذات عند المصابين بهذا الاضطراب، شعورهم بالشكّ والخوف الدائمين من التخلّي والترك والهجران، ولهذا فتراهم يتفحّصون الرسائل التي أرسلوها ليروا فيما إذا كانت قُرئت أم لا. وبفضل الخاصية التي تُري المرسِل أنّ رسالته قد قُرأت بالفعل، يتغذّى شعور الشخص الحدّي بالاضطراب واهتزاز صورة ذاته في حال تأخر الردّ أو عدم تلقّيه. تمامًا كما قد يتجنّب الرد على الرسائل والتعليقات لا لشيءٍ سوى لعدم وجود تصور ثابت للشخص المصاب عن نفسه، حيث يوجد تحول سريع في ما يحب ويكره، ولتقلّب مزاجه السريع جدًا.
قد نكون جميعنا متّفقين على أنّ وسائل ومنصّات التواصل الاجتماعيّ تحمل معها العديد من الأساليب والجوانب الإيجابية والسلبية على حدٍ سواء. ومهما كانت مشكلتنا معها، فلا بدّ أنْ نعترفَ أنها باتت تشكّل جزءًا لا ينفصل من واقع الحياة التي نحياها، ما يعني أنّ تركها أو هجرها يعدّ أمرًا صعبًا يُنظر إليه بمثابة عزلة اجتماعية أو حتى انتحار إلكترونيّ.
ولذلك، يمكننا من خلال فهم آليات تأثير تلك المواقع على عقولنا ونفوسنا ووعينا بها، أنْ نحاول بناء طرق صحية للتعامل معها والاستفادة منها بحيث تقينا من أية أعراض مُحتملة لأيّ اضطراب في الشخصية، كالهستيرية والنرجسية والحدّية، وغيرها الكثير، خاصة وأنّ تلك المواقع تعدّ بيئة ممتازة لزرع تلك الأعراض والسلوكيات المتعلّقة بها حتى وإنْ كان مستخدمها لا يعاني من أيّ اضطرابٍ نفسيّ أو عقليّ.