زعمت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة على مر تاريخها أنها دائمًا ما سعت إلى إقامة علاقات سلمية مع الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، كما روجت مرارًا أن فرص التسوية كانت دائمًا متاحة، لكن الفلسطينيين وحركة حماس تحديدًا، أهدروا كل الاحتمالات المطروحة، ولم تحصد إلا العداء من جميع الجهات والتعنت في كل المنعطفات، ولذلك لم يكن أمامها خيار سوى اللجوء إلى العنف، بذريعة “الدفاع عن النفس”.
لكن بالنظر إلى الوراء، فمنذ عام 1949 وحتى اليوم اقترح الفلسطينيون والزعماء العرب العديد من مبادرات السلام والتسوية، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يتنازل أبدًا عن عرقلة وتقويض كل خطة سلام عربية وفلسطينية ودولية، فسُدت كل السبل، خاصةً أن كل الحلول المقترحة والمماطلات المتكررة لم تزد حياة الفلسطينيين سوى تعقيدًا وتدهورًا، إذ كانت جميعها مجحفة ومقصرة بحقهم.
نقدم في هذا المقال قراءة لكتاب “الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربي” للمؤرخ الإسرائيلي، آفي شلايم، وهو بريطاني من أصول عراقية، تناول في كتابه مبادئ الدبلوماسية الإسرائيلية حيال العرب عمومًا وحيال الشعب الفلسطيني خصوصًا، موضحًا أدوات المراوغة والمماطلة التي تبنتها حكومات الاحتلال بمختلف توجهاتها وألوانها الإيدلوجية، لإبقاء القضية الفلسطينية رهينة الشروط والمصالح الإسرائيلية.
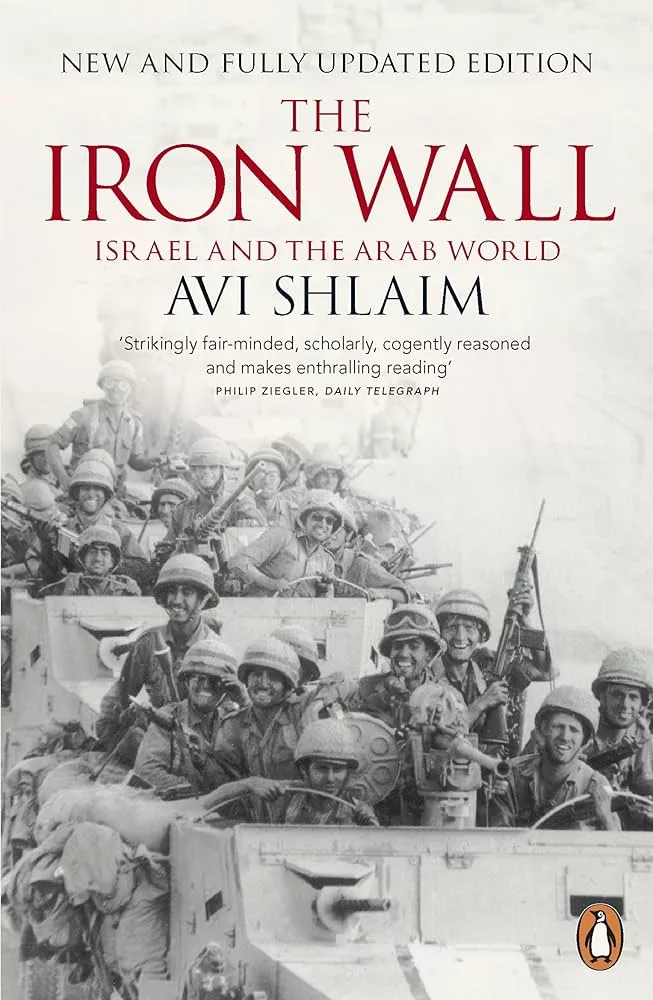
مبدأ “جابوتنسكي”: دبلوماسية الصهاينة الأوائل
يمكن تلخيص المشكلات التي واجهتها الحركة الصهيونية في بداياتها حين صدر بيان عن بعثة تقصي الحقائق التي أرسلها حاخامات فيينا إلى فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر لاستكشاف إمكانية إنشاء مستعمرة يهودية في فلسطين، وجاء في مذكرة الوفد: “البلد عروس جميلة، لكنها متزوجة من رجل آخر”.
أدرك حينها زعيم الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل أن فلسطين مأهولة بعدد كبير من السكان الأصليين، لكنه مثل العديد من الصهاينة الأوائل، فضل نهج الاتكاء على القوى الكبرى، فكانت جهوده الدبلوماسية موجهة لإقناع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بمنحه ميثاقًا للاستيطان اليهودي في فلسطين، كما كانت موجهة أيضًا إلى العديد من زعماء العالم وكبار الشخصيات المؤثرة في أوائل القرن العشرين طلبًا للمساعدة في الترويج لمشروعه الصهيوني.
من بين أولئك الذين منحوا هرتزل فرصة اللقاء، ملك إيطاليا فيكتور الثالث والقيصر الألماني فيلهام الثاني ووزير المستعمرات البريطاني جوزيف تشامبرلين، وفي كل مرة عرض فيها هرتزل مشروعه، كان يحاول استعطاف السامعين وتقديم الإغراءات لهم، فلما وعد السلطان العثماني بالأموال والاستثمارات، ألمح إلى القيصر بأن تكون “الأراضي اليهودية” بؤرة استيطانية تابعة لبرلين، وعرض الأمر ذاته كذلك على تشامبرلين بأن تكون “الأراضي اليهودية” مستعمرة تابعة للإمبراطورية البريطانية.
وأيًا ما كانت الحجج المستخدمة، فإن المبدأ الأساسي الذي تبناه الصهاينة الأوائل ظل مركزيًا وثابتًا في الدبلوماسية الصهيونية حتى اليوم، وهو: الحصول على دعم القوى العظمى، وهي السمة التي اقترنت كذلك بعدم الاعتراف بالفلسطينيين، وذلك بحسب المؤرخ اليهودي آفي شلايم في كتابه “الجدار الحديدي”.
كان المهندس الرئيسي للتحالف بين الحركة الصهيونية وبريطانيا القوة العظمى في ذلك الوقت، هو حاييم وايزمان (1874-1952)، فقد توجت جهوده بالنجاح عندما حصل على الميثاق الذي سعى هرتزل للحصول عليه من العثمانيين في شكل إعلان بلفور، فصار التحالف مع بريطانيا حجر الزاوية للدبلوماسية الصهيونية على مدار النصف الأول من القرن العشرين.
ووفقًا لشلايم، استند الآباء المؤسسين لـ”إسرائيل” في سياساتهم الدبلوماسية مع العرب والفلسطينيين على استراتيجية “الجدار الحديدي” لزئيف جابوتنسكي الأب الروحي لحزب الليكود الحالي ومؤسس الصهيونية التصحيحية.
تتلخص استراتيجية جابوتنسكي التي صاغها في عشرينيات القرن العشرين في مرحلتين: الأولى بناء قوة عسكرية تلحق بالعرب والفلسطينيين سلسلة من الهزائم المدمرة وترغمهم على التخلي عن أي أمل في مواصلة القتال، إلى أن يدركوا أن الجدار الصهيوني منيع والقتال عبثي.
والمرحلة الثانية تأتي من خلال التفاوض على السلام والتسوية انطلاقًا من عجز العرب أمام القوة الإسرائيلية الساحقة، وفي النهاية يقبل العرب والفلسطينيون بتحقيق سلام بناء على شروط خصمهم والحقائق التي فرضها على الأرض، وليس على ما يطمحون إليه من حقوق ومطالب مستقلة.
محاولات التسوية الأولى (1948-1956)
عندما قامت دولة الاحتلال الإسرائيلية في خضم حرب مع الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، كانت هذه الحرب التي أطلق عليها الإسرائيليون حرب “الاستقلال” وسماها العرب “النكبة”، تتألف من مرحلتين: استمرت الأولى من 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 عندما أقرت الأمم المتحدة قرار التقسيم حتى 14 مايو/أيار 1948 حين أعلن قيام دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.
واستمرت المرحلة الثانية من 15 مايو/أيار 1948 حتى انتهاء القتال في 7 يناير/كانون الثاني 1949، وانتهت كلا المرحلتين بانتصار للإسرائيليين وهزيمة للجيوش العربية، ومأساة للفلسطينيين مستمرة حتى اليوم.
حسب الرواية الإسرائيلية الرسمية التي يرويها شلايم في كتابه “الجدار الحديدي”، سعى زعماء “إسرائيل” بلا كلل إلى التوصل إلى تسوية سلمية بعد عام 1948، ولكن كل جهودهم باءت بالفشل على صخرة التعنت العربي، ولم يكن هناك من يتحدثون إليه على الجانب الآخر، ما وضع “إسرائيل” أمام موقف لا خيار فيه.
لكن المؤرخ شلايم يرى عكس ذلك، فقد اطلع على أرشيفات دولة الاحتلال ومكتب السجلات العامة في لندن وأجرى مقابلات مع العديد من اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك الملك حسين بن طلال ثالث ملوك المملكة الأردنية الهاشمية، وإسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيلي راحل، وشمعون بيريز أحد أبرز زعماء دولة الاحتلال، ورأى أن ملفات وزارة الخارجية الإسرائيلية مليئة بالأدلة على محاولات استعداد العرب للتفاوض مع “إسرائيل” بعد مرور شهور معدودة على النكبة.
يذكر شلايم أنه في أواخر سبتمبر/أيلول 1948 رفض الإسرائيليون مبادرة السلام التي عرضها الملك فاروق الأول، ثم في ربيع عام 1949 رفض الإسرائيليون مبادرة السلام التي قدمها حسني زعيم رئيس الجمهورية السورية الأولى، الذي اقترح أن توطن سوريا ربع مليون لاجئ فلسطيني في مقابل تنازل “إسرائيل” عن النصف الشرقي من بحيرة طبريا، ولكن ديفيد بن غوريون أحد مؤسسي دولة الاحتلال رفض كل دعواته للتفاوض.
رأى شلايم أن الزعيم خلال فترة ولايته القصيرة أعطى “إسرائيل” كل الفرص لدفن الأحقاد وإرساء أسس التعايش السلمي، ولكن “إسرائيل” المتصلبة بمواقفها وأهدافها رفضت عرض الزعيم وبددت فرصة تاريخية للسلام.
لاحقًا في ديسمبر/كانون الأول 1950 اقترح الملك الأردني عبد الله الأول استئناف المفاوضات مع “إسرائيل”، فأراد تنفيذ اتفاقية الهدنة بالكامل، ووعد بتنفيذ المادة الثامنة كخطوة أولى نحو السلام، والتي أعطت “إسرائيل” الحق في الوصول إلى المؤسسات الإنسانية والدينية في القدس.
لكن بن غوريون رفض التفاوض والتسوية السلمية مع الأردن رغم إصرار الملك على المضي قدمًا نحو التوصل إلى تسوية مع “إسرائيل”، ورغم عرض الملك مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصيًا، لكن لم يُظهِر بن غوريون أي قدر من المرونة في تعامله مع الأردن، فكل ما وافق عليه، تغييرات طفيفة في الحدود، في حين أراد الملك صفقة من شأنها أن تبرر موقفه المؤيد لقبول “إسرائيل”.
رغم كل ذلك، لم يغلق العرب قناة التواصل مع “إسرائيل”، إذ كانت كل دولة عربية قد بدأت اجتماعات سرية مع المسؤولين الإسرائيليين للتفاوض بشأن الحدود وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وطالبت كل الدول العربية إعطاء اللاجئين الخيار بين العودة إلى ديارهم أو تلقي تعويضات، لكن رفضت “إسرائيل” التفاوض بشأن هاتين المسألتين.
عقب اغتيال الملك الأردني عبد الله في يوليو/تموز 1951، واصل ابنه طلال وحفيده حسين التقليد الهاشمي القديم المتمثل في تفضيل التعايش السلمي مع “إسرائيل”، ففي فبراير/شباط 1952، وقع الأردن اتفاقية مع “إسرائيل” لمنع دخول الفلسطينيين إلى حدوده، والحفاظ على حدود سلمية مع “إسرائيل”.
بعد ذلك، تحولت الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية نحو مصر، لكونها المفتاح الرئيسي في التوصل إلى تسوية مع كل العالم العربي، وأشارت المحادثات الأولى بين ممثلي الاحتلال ومصر في رودس ولوزان، إلى أن مصر لن تعتدي على “إسرائيل” في مقابل تنازلات في النقب وعودة اللاجئين الفلسطينيين، لكن لم يكن أي سياسي في “إسرائيل” على استعداد لدفع هذا الثمن. ومثلها كمثل الأردن، كان الملك فاروق يريد ثمنًا يبرر به السلام أمام الجماهير المصرية.
عندما أطاحت حركة الضباط الأحرار بالملكية في انقلاب 23 يوليو/تموز 1952، استبشر الصهاينة بها، وقال موشيه شاريت رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك: “إن الإطاحة بفاروق أزالت عقبة في طريق السلام”.
أعلن الضباط الأحرار نيتهم في التركيز على الإصلاح الداخلي وتحركوا للحد من الاحتكاك الحدودي مع “إسرائيل”، في المقابل نظر ساسة الصهاينة إلى الضباط باعتبارهم قوميين مصريين من المرجح أن يستنتجوا أن الصراع مع “إسرائيل” لا يخدم مصالح بلادهم، ففي 18 من أغسطس/آب 1952، وفي خطاب ألقاه في الكنيست، هنأ بن غوريون الضباط الأحرار على ثورتهم وأعرب عن أمله في بداية جديدة للعلاقات المصرية الإسرائيلية، وقال: “لا يوجد أي سبب للصراع السياسي أو الاقتصادي أو الإقليمي بين مصر وإسرائيل… إن دولة إسرائيل ترغب في رؤية مصر حرة ومستقلة وتقدمية”.
تبع هذا العرض العلني رسالة خاصة إلى مجلس قيادة الثورة، ففي 22 من أغسطس/آب، ذهب شموئيل ديفون السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية بباريس آنذاك، إلى مقر إقامة علي شوقي القائم بالأعمال في السفارة المصرية بباريس حينها، ونقل إليه اقتراحًا من الحكومة الإسرائيلية، وكان يتلخص في عقد اجتماع سري لمناقشة السلام بين البلدين والتوصل إلى تسوية سلمية.
أرسل الدبلوماسيون المصريون عدة رسائل حسن نية إلى نظرائهم الإسرائيليين، ومقابل السلام، طالبوا دعم “إسرائيل” في الحصول على الأسلحة والمساعدات الاقتصادية من أمريكا، واستمرت الاتصالات بين الدبلوماسيين المصريين والإسرائيليين، وفي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول 1952، أجرى شموئيل ديفون محادثات مع عبد الرحمن صادق الذي أرسله مجلس قيادة الثورة إلى باريس من أجل التفاوض مع الإسرائيليين، وبذلك اكتسبت “إسرائيل” قناة مهمة للتفاوض مع الضباط الأحرار.
ظلت قناة باريس مفتوحة لأكثر من عامين، وتم تبادل رسائل مثيرة للاهتمام من خلال هذه القناة في النصف الأول من عام 1953، وكان أحد المؤيدين الرئيسيين لمواصلة الاتصالات والتحرك نحو التفاهم مع “إسرائيل” داخل مجلس قيادة الثورة هو العقيد جمال عبد الناصر، الذي خدم برتبة رائد في حرب فلسطين وكان على اتصال بضباط إسرائيليين عندما كان محاصرًا في الفالوجة.
راقب عبد الناصر بنفسه الاتصالات مع الإسرائيليين، وكان صادق يقدم إليه التقارير ومنه يتلقى التعليمات، وأكد ناصر على رغبته في إبقاء هذا الاتصال سرًا، وحذر من أن مصر لا تستطيع في الوقت الحالي أن تحيد عن الموقف العربي العام بشأن القضية الفلسطينية، فمن الأهمية بمكان أن نميز بين الشعوب العربية وحكامها، فقد كانت مشاعر العداء الشعبي تجاه “إسرائيل” في أعلى مستوياتها عقب خسارة فلسطين والهزيمة العسكرية العربية.
لكن من ناحية أخرى، أظهر الحكام العرب قدرًا ملحوظًا من البراغماتية في أعقاب نفس الأحداث، فقد كانوا مستعدين للاعتراف بـ”إسرائيل” والتفاوض معها بشكل مباشر، بل وحتى عقد السلام معها مقابل ثمن إقليمي، ولم يرفض أي منهم التحدث إلى الإسرائيليين مثلما أوضح شلايم باستفاضة.
عودة إلى 13 مايو/أيار 1953 بفندق رينولدز في باريس، التقى صادق مع ديفون وأظهر له رسالة رسمية من مجلس قيادة الثورة وموقعة من ناصر، وفيها وعد ناصر مرة أخرى بأن مجلس قيادة الثورة لا يضمر أي نوايا عدائية تجاه “إسرائيل”، وكان سعيدًا لأن “إسرائيل” قبلت كلمته على أساس الثقة المتبادلة.
وحث ناصر “إسرائيل” على تعبئة نفوذها في أمريكا لدعم مطلب مصر بانسحاب القوات البريطانية، وقال إن هذا من شأنه أن يسهل على مجلس قيادة الثورة التوصل إلى تسوية نهائية مع “إسرائيل”، كما أوضح في رسالته أن الرأي العام في مصر والعالم العربي يجعل من الحكمة أن يبني مجلس قيادة الثورة سياسته تجاه “إسرائيل” تدريجيًا.
على الجانب الآخر، رحبت “إسرائيل” بإقامة المحادثات وأعربت عن استعدادها لمساعدة مصر في المجال الاقتصادي من خلال شراء ما قيمته 5 ملايين دولار من القطن ومنتجات أخرى مقابل أن ترفع مصر القيود المفروضة على مرور ناقلات النفط الإسرائيلية عبر قناة السويس وخليج العقبة.
يُنظَر إلى رسالة ناصر هذه بأهمية بالغة لأنها كانت المرة الأولى التي يخطر فيها مجلس قيادة الثورة حكومة “إسرائيل” برغبته في اتخاذ سلسلة من الخطوات لتحسين العلاقات بين البلدين وتمهيد الطريق إلى تسوية نهائية، لكن لم يكن هذا ما رآه بن غوريون.
يوضح شلايم في كتابه أن السلام والتفاوض مع العرب لم يكن من أولويات بن غوريون في ذلك الوقت، وإنما بناء الدولة، وتشجيع الهجرة، وتعزيز استقلال “إسرائيل” الذي اكتسبته حديثًا، وكان يعتقد أن اتفاقيات الهدنة دون سلام مع الدول العربية ودون حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، تلبي احتياجات “إسرائيل” الأساسية للاعتراف الدولي والأمن والاستقرار، والأهم أنه لم يكن مستعدًا لدفع ثمن اتفاقية سلام بالتنازل عن الأراضي والموافقة على عودة عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.
كما يضيف شلايم أن دبلوماسية “إسرائيل” تجاه مصر في السنوات الثلاثة التي سبقت حرب السويس 1956، كانت نتاجًا لصراع بين مدرستين، الأولى تُفضل إظهار العدوان والقسوة، والأخرى تفضل التفاوض دون التنازل عن الأرض وعودة اللاجئين. وقد تجسدت هاتان المدرستان في بن غوريون وموشيه شاريت اللذين تناوبا على منصب رئيس الوزراء خلال هذه الفترة الحافلة بالأحداث.
ظل موقف ناصر تجاه “إسرائيل” قبل حرب السويس براغماتيًا وعمليًا، وفي محادثاته الخاصة مع غير العرب بدا وكأنه قبل فكرة إمكانية تحقيق السلام، كما تعاون ممثلوه مع “إسرائيل” من خلال لجنة الشؤون العسكرية بهدف الحد من التوترات على طول الحدود، ودارت محادثات سرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي شاريت وناصر، والأهم أنه أبقى قناة “ديفون-صادق” مفتوحة حتى بعد أن زرعت “إسرائيل” شبكة تجسس داخل مصر وكلفتها بالقيام بعمليات تخريبية في القاهرة والإسكندرية.
قُطعت هذه المحادثات في أعقاب عودة بن غوريون إلى السلطة، وبسبب الهجوم الإسرائيلي الشرس على غزة في عام 1955، الذي أودى بحياة 38 جنديًا مصريًا وجرح 33 آخرين، وهو ما زعمت “إسرائيل” حدوثه بسبب فتح مصر حدودها أمام الفدائيين الفلسطينيين، وبحسب شلايم، فهناك وثائق من مصادر عربية وبريطانية وأمريكية ومن الأمم المتحدة، بل وحتى إسرائيلية، تشير إلى أن الحكومات العربية منعت دخول الفلسطينيين إلى أراضيها وحاولت الحد منه.
كما تدحض سجلات الاستخبارات العسكرية المصرية والأردنية، التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي في أثناء حربي 1956 و1967، بشكل قاطع الرواية الإسرائيلية، إذ بينت هذه المستندات أن السلطات العسكرية المصرية كانت تتبنى سياسة ثابتة وحازمة للحد من دخول الفلسطينيين من قطاع غزة إلى “إسرائيل”، وتروي الوثائق الأردنية قصة مماثلة.
تعاملت كل حكومة عربية مع هذه المشكلة بطريقتها الخاصة وبدرجات متفاوتة من النجاح، فقد نقلت السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين شمالًا إلى مخيمات في بيروت وصور وصيدا، وأغلقت الحدود مع “إسرائيل”، كما مارست السلطات السورية سيطرة صارمة على حدودها مع “إسرائيل”، وكانت حوادث التسلل نادرة.
بالعموم، كانت الجبهة المصرية أكثر هدوءًا من الجبهة الأردنية، إذ كانت تورطت مصر في حرب اليمن عام 1962، ما دفعها إلى تجنب الاشتباكات الحدودية مع “إسرائيل”، وكان تقييم ناصر بأن “إسرائيل” أقوى عسكريًا من كل الدول العربية مجتمعة.
وتماشيًا مع هذا التقييم، منع ناصر الفلسطينيين في قطاع غزة من العمل ضد “إسرائيل” حتى لا يمنحها أي ذريعة للقيام بعمل عسكري ضد مصر، وكانت الجبهة الوحيدة المثيرة للمتاعب بالنسبة لدولة الاحتلال في الستينيات هي الجبهة السورية، إذ كانت هناك 3 مصادر رئيسية للتوتر بين “إسرائيل” وسوريا: المناطق منزوعة السلاح، والمياه، وأنشطة المقاومة الفلسطينية المسلحة.
يلخص شلايم الدبلوماسية الإسرائيلية التي جرت قبل حرب 1967 في دراسة بعنوان “المسكين شمشون”، وهي إشارة إلى محاولة القيادة الإسرائيلية تصوير “إسرائيل” باعتبارها داود اليهودي المسالم الذي يقاوم جالوت العربي المجنون العدواني، في حين أنها كانت تتمتع بالتفوق العسكري ورفضت مقترحات السلام والتسوية التي عرضها الحكام العرب.
الضحايا الصالحون: عبادة الغطرسة
شكل النصر الإسرائيلي في حرب 1967 بداية عصر جديد في تاريخ “إسرائيل”، وحسب ما يروي شلايم فقد كان الانتصار الساحق الذي حققته “إسرائيل” على مصر والأردن وسوريا في يونيو/حزيران 1967 بمثابة برهان دراماتيكي وحاسم لنجاح استراتيجية الجدار الحديدي.
يذكر شلايم أيضًا أن كبار الساسة في “إسرائيل” أصبحوا مفتونين بالقوة العسكرية، ما دفعهم إلى التشبث بالحرب حتى عندما طرح زعماء الدول العربية فرص التسوية والسلام، فقد وافقت مصر والأردن على السلام بعد هزيمتهما، ولكنهما أصرا على أن يكون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيهم المحتلة هو الخطوة الأولى نحو السلام.
وحين كان سلام وتسوية 1948 يتعلق بالحدود وعودة اللاجئين، إلا أن سلام ما بعد 1967 تعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة في 1967، وكرر الملك الأردني حسين استعداده لإحلال السلام الشامل مع “إسرائيل” بعد النكسة، لكن لم ترَ “إسرائيل” أي حافز تجاه ذلك، ولم يكن الملك حسين هو الوحيد الذي سعى إلى تحقيق السلام على الجانب العربي، فقد كان ناصر يعلم ويدعم الدبلوماسية السرية التي أجراها حسين، شريطة ألا تؤدي إلى سلام منفصل.
وفيما كانت الاتصالات الإسرائيلية المصرية تجري بوساطة الولايات المتحدة، كانت الاتصالات مع الأردن مباشرة وعلى أعلى مستوى، وكانت الاجتماعات مع الملك حسين تسير بالتوازي مع محادثات “إسرائيل” مع زعماء الضفة الغربية، ولكن هذه المحادثات أيضًا لم تسفر عن أي شيء، لنفس السبب، وهو رفض “إسرائيل” الانسحاب من الضفة الغربية.
استمرت “إسرائيل” في رفض مبادرات السلام العربية، ففي عامي 1967 و1968، رفضت الدخول في مفاوضات مع وجهاء فلسطينيين بهدف إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي فترة 1974-1976 رفضت الحكومة الإسرائيلية بقيادة إسحاق رابين الدخول في مفاوضات مع الأردن أو مع الفلسطينيين بشأن مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة.
رفضت كذلك في فترة من عام 1969-1971 العديد من العروض المصرية التي توسطت فيها القوى العظمى والأمم المتحدة، التي تضمنت اتفاقية سلام تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، كما رفضت جولدا مائير رئيسة الوزراء آنذاك علنًا وبشكل قاطع كل عروض الملك حسين للسلام.
وجه ناصر نفسه رسالة إلى ناحوم جولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي لزيارته في القاهرة لمناقشة آفاق السلام، ولكن رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترحات ناصر، وأدى فشل الجهود الدبلوماسية إلى دفع عبد الناصر إلى صياغة شعار “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”.
رغم ذلك، فقد أطلق الرئيس المصري الجديد أنور السادات مبادرة أخرى للتوصل إلى تسوية مع “إسرائيل” حتى لو كانت مؤقتة، وفي فبراير/شباط 1971، اقترح السادات في خطاب ألقاه أمام الجمعية الوطنية المصرية انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة كخطوة أولى في تنفيذ القرار 242.
لم يكن اقتراح السادات مفاجئًا لـ”إسرائيل”، إلا أن مائير ردت على مبادرة السادات بتعليقات غاضبة وسلبية، ولكن السادات لم يتراجع، وأرسل رسالة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية أوضح فيها أن هدفه هو نزع فتيل الخطر السائد ومناقشة جادة تتم من خلال الولايات المتحدة وليس الأمم المتحدة.
بناءً على السردية السابقة، فإن الدبلوماسية الإسرائيلية بعد عام 1969 تتلخص في عرض أحد البديلين فقط على العرب، إما السلام الكامل دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة، وإما استمرار الوضع الراهن.
سلام الجدار الحديدي: الطريق إلى اللامكان
يوضح آفي شلايم في كتابه “الجدار الحديدي” أن الهدف الرئيسي لـ”إسرائيل” في فترة 1967-1973 هو إدامة الوضع الراهن، فقد رفضت مائير أن تستبدل “إسرائيل” سيناء بالسلام مع مصر، كما رفضت اقتراح السادات بتسوية مؤقتة، وبالتالي لم تترك له أي خيار سوى الذهاب إلى الحرب من أجل تحريك الوضع.
في أثناء استعداده للحرب، بذل السادات محاولة أخيرة لإقناع أمريكا بالضغط على “إسرائيل” لقبول شروطه للتوصل إلى تسوية سياسية، فأرسل مستشاره للأمن القومي حافظ إسماعيل في مهمة سرية إلى واشنطن، وعقد هنري كيسنجر الذي حل محل وليام روجرز في منصب وزير الخارجية الأمريكي، سلسلة من الاجتماعات مع حافظ إسماعيل في الفترة ما بين نهاية فبراير/شباط 1973 ونهاية مايو/أيار 1973، مع ذلك لم يتمكن كيسنجر من الضغط على “إسرائيل”.
عقب حرب أكتوبر 1973 دعا السادات إلى سلام شامل مع “إسرائيل” يتضمن الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود ما قبل عام 1967 والاعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم، لكنه اعترف أيضًا بحق “إسرائيل” في الوجود كدولة ذات سيادة، وفي يناير/كانون الثاني 1976 صرح رابين في خطاب ألقاه أمام الكونجرس بأن “إسرائيل” مستعدة للمفاوضات مع أي دولة عربية، ولكنها ليست مستعدة للانتحار بالاجتماع مع منظمة التحرير الفلسطينية.
ثم في 17 من سبتمبر/أيلول 1978، تم توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بحفل مهيب في البيت الأبيض، وكان عنوان الاتفاقيتين إطار للسلام في الشرق الأوسط، وإطار لإبرام معاهدة سلام بين “إسرائيل” ومصر، ونصت مقدمة المعاهدتين على أنهما تشكلان خطوة لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي بكل جوانبه.
وافق السادات على سلام منفصل مع “إسرائيل”، وفي التحليل النهائي، حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن على ما أراده. وفي عام 1982 أقرت قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في فاس بالمغرب فكرة المفاوضات مع “إسرائيل”، وهُمشت القضية الفلسطينية بشكل كبير إلى أن اندلعت الانتفاضة في 1987 وأعادت تركيز اهتمام العالم إلى القضية.
في تطور مفاجئ، قبلت منظمة التحرير الفلسطينية جميع قرارات الأمم المتحدة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 1988، كما تبنت مبدأ حل الدولتين على حدود ما قبل 1967 واعترفت بحق “إسرائيل” في الوجود، ولكن كان رد الحكومة الإسرائيلية حادًا للغاية، إذ أعلنت رفضها في بيان مكتوب، جاء فيه “إن قرارات منظمة التحرير الفلسطينية تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي”.
ثم في عام 1993، قبلت منظمة التحرير الفلسطينية الصيغة الإسرائيلية لاتفاقية سلام أوسلو، التي وقعتها من موقف ضعف ملموس ودون التزامات واضحة من جانب “إسرائيل”، ودافع ياسر عرفات عن قراره بالتوقيع على الاتفاق باعتباره الخطوة الأولى نحو تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، معتقدًا أنه بتخليه عن مطالبه بـ78% من فلسطين سوف يحصل على دولة مستقلة تمتد على قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.
مع ذلك واصل الإسرائيليون توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ثم في العام التالي على اتفاق أوسلو وقع الأردن و”إسرائيل” معاهدة سلام في 1994، وكان الملك حسين ينظر إلى هذا السلام باعتباره الإنجاز الأعظم لحكمه الطويل وكان يأمل أن يرى ثماره في حياته.
وفي يناير/كانون الثاني 1994 بدأت جامعة الدول العربية في رفع المقاطعة الاقتصادية التي كانت سارية منذ إنشاء “إسرائيل”، ولم يعد العالم العربي كما كان، فقد تغيرت قواعد اللعبة بشكل جذري.
ثم في 28 سبتمبر/أيلول 1995، تم التوقيع على الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة في واشنطن، من جانب إسحاق رابين وياسر عرفات، وبحضور بيل كلينتون وحسني مبارك والملك حسين ملك الأردن، وقد أصبح هذا الاتفاق معروفًا باسم “أوسلو 2”.
وبحلول 1996، كانت “إسرائيل” قد أقامت اتصالات دبلوماسية مباشرة مع 15 دولة عربية، في مقدمتها المغرب وتونس، وفي منطقة الخليج، كانت عُمان وقطر أول من تعامل تجاريًا مع “إسرائيل”، إذ أراد المسؤولون القطريون أن يشاركوا بنشاط في دفع عملية السلام بين “إسرائيل” والفلسطينيين إلى الأمام، وتوسيع هذه العملية لتشمل سوريا ولبنان. وفي نظرهم في ذلك الوقت، فإن سياسة المقاطعة والمواجهة المسلحة مع “إسرائيل” لم تخدم المصالح العربية.
لكن الآمال المبكرة سرعان ما تحولت إلى خيبة أمل بعد شهور قليلة، لأن “إسرائيل” عرقلت عملية السلام، فجمدت بعض الدول العربية علاقاتها معها، في حين تراجعت دول أخرى بالفعل عن الاتفاقيات التي أبرمتها خلال المرحلة المتفائلة من عملية أوسلو.
وفي مارس/آذار 1993، انتخب بنيامين نتنياهو زعيمًا لحزب الليكود، وفي نفس العام نشر كتابًا بعنوان “مكان بين الأمم: إسرائيل والعالم”، وقد زعم فيه أن القضية الفلسطينية تم خلقها بشكل مصطنع وأن اليهود لم يغتصبوا الأرض من العرب، بل العرب هم الذين اغتصبوها من اليهود. ثم في عام 1996 هزم نتنياهو زعيم حزب العمل شمعون بيريز في الانتخابات، وصار رئيس وزراء “إسرائيل”.
ندد نتنياهو بفكرة الدولة الفلسطينية، وبشكل منهجي، أنفق السنوات الثلاثة الأولى التي قضاها في السلطة لتقويض اتفاقيات أوسلو، وتوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بوتيرة سريعة. كما ركز بشكل أساسي على أن تكون محادثات السلام مع الفلسطينيين قائمة على الأمن الإسرائيلي بدلًا من مبدأ الأرض مقابل السلام.
كذلك فيما يتصل بالدول العربية، كان نتنياهو مترددًا في المضي قدمًا في مسار الأرض مقابل السلام مع سوريا، فقد كان يدرك أن انهيار الاتحاد السوفييتي وهزيمة العراق في حرب الخليج تركت الدول العربية في موقف أضعف.
ورغم أن حافظ الأسد قبل المعادلة المتمثلة في السلام مقابل الأرض، فإن “إسرائيل” تمسكت باحتلال أجزاء من الجولان والاحتفاظ بمحطة إنذار مبكر، وهو الأمر الذي رفضته سوريا وأصرت في كل جولات المفاوضات التي خاضتها على الانسحاب الكامل إلى خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وفشلت كل المفاوضات في التوصل إلى أي نتائج بسبب الرفض الإسرائيلي للانسحاب الكامل.
دبلوماسية الاستنزاف: عقدين قبل طوفان 2023
في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى في عام 2000، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آرئيل شارون في عام 2001 أن اتفاقيات أوسلو أصبحت لاغية وباطلة، وطرح خطته الخاصة للتوصل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين، والتي تضمنت اللاءات الثلاثة: لا تفكيك للمستوطنات، ولا انسحاب من وادي الأردن، ولا تنازلات بشأن القدس.
ثم في عام 2002 اجتمعت قمة الجامعة العربية في بيروت واعتمدت ما أصبح يعرف بمبادرة السلام العربية، التي تتلخص في عرض السلام الشامل القائم على الشرعية الدولية وتطبيع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية مع “إسرائيل”، مقابل إقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا هو الحل الذي توحد خلفه العالم العربي والعديد من قادة العالم الغربي، ولكن مرة أخرى، رفضت “إسرائيل” مبادرة السلام العربية، وبعد أقل من شهر من إطلاقها، أعلنت أنها ستبني “جدارًا أمنيًا” يمتد 50 ميلًا في الضفة الغربية، فيما وصفته بأنه “إجراء للدفاع عن النفس لحماية مواطنيها من الانتحاريين الفلسطينيين”.
تبين أن الغرض من هذا الجدار الذي أطلق عليه الفلسطينيون “جدار الفصل العنصري” لم يكن منع أعمال المقاومة، بل إرساء حدود جديدة وترسيخ حقائق على الأرض على الطريقة الصهيونية التقليدية.
ثم في 30 من أبريل/نيسان 2003 أطلقت اللجنة الرباعية – الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي – مبادرة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، عرفت باسم “خارطة الطريق للسلام”، وتضمنت جداول زمنية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بحلول نهاية عام 2005.
تبنى الزعماء الفلسطينيون بحماس مبادرة خارطة الطريق، والتزم محمود عباس بشكل لا لبس فيه بتنفيذ بنودها، وذهب إلى غزة واقنع حماس والجهاد الإسلامي بتعليق العمليات العسكرية في مقابل موافقة إسرائيلية على وقف إطلاق النار، لكن مرة أخرى، كان الموقف الإسرائيلي رافضًا لإقامة دولة فلسطينية، ولم يكن شارون متقبلًا لفكرة الحوار والتسوية.
وفي 14 من أغسطس/آب 2003، عرقلت “إسرائيل” وقف إطلاق النار باغتيال محمد سدر رئيس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الخليل، وحث عباس المقاومة على الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم الانجرار وراء “إسرائيل”.
لاحقًا في 6 من سبتمبر/أيلول 2003، حاولت الحكومة الإسرائيلية اغتيال مؤسس حركة حماس وزعيمها الروحي الشيخ أحمد ياسين، وكانت هذه المحاولة الفاشلة لاغتيال الشيخ بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ففي حين نفد صبر المقاومة، زعمت “إسرائيل” أنها لا تستطيع أن تحقق السلام في ظل العنف.
وفي مارس/آذار 2004، قصفت طائرة إسرائيلية الشيخ ياسين على كرسيه المتحرك وقتلته مع حراسه الشخصيين في أثناء توجههم إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وكان هذا الاغتيال بمثابة تصعيد كبير، وعلى أثره تلقت مبادرة خارطة الطريق التي أُطلقت وسط ضجة كبيرة قبل عام واحد ضربة قاتلة.
وقبل شهرين من تعيينه زعيمًا للحركة، عرض الرنتيسي على “إسرائيل” هدنة لمدة 10 سنوات في مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية، ولكن في 17 أبريل/نيسان 2004 قتلته القوات الجوية الإسرائيلية بإطلاق صواريخ هيلفاير من طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي على سيارته.
وفي عام 2006، فازت حماس في انتخابات حرة، ومرة أخرى، عرضت على “إسرائيل” التفاوض بشأن هدنة طويلة الأمد، وقد أعلنت موافقتها على حل الدولتين، لكن مرة أخرى، رفضت “إسرائيل” التعامل مع حماس واستخدمت الحرب الاقتصادية لتقويضها.
وفي عام 2008 دخل أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي في مفاوضات مع محمود عباس من أجل التوصل إلى تسوية نهائية بين فلسطين و”إسرائيل”، أصر أولمرت على الاحتفاظ بالمستوطنات في الضفة الغربية، واشترط بقاء قواته المسلحة في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهو ما لم يكن مقبولًا لدى الفلسطينيين.
ورغم التزام “إسرائيل” بتخفيف الحصار عن غزة وتوقيع الهدنة التي توسطت فيها مصر بين حماس و”إسرائيل” عام 2009، فلم يتغير شيء. وأمام تعنت نتنياهو رد الفلسطينيون بتعليق مشاركتهم في محادثات السلام وأصروا على شرطين للعودة إلى طاولة المفاوضات: تجميد أنشطة البناء في الأراضي المحتلة، والانسحاب إلى خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 كأساس للمفاوضات، وهما الشرطان اللذان رفضهما نتنياهو مرارًا وتكرارًا.
كان اندلاع الربيع العربي بمثابة مفاجأة غير سارة لنتنياهو وحزبه وحكومته، وبحسب شلايم فقد دفع التغيير الذي مرت به المنطقة في 2011 إلى تشديد شروط “إسرائيل” للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، واقتنعت القيادة الإسرائيلية بضرورة السيطرة العسكرية الدائمة حتى في سياق تسوية سلمية مع الفلسطينيين.
استمر الجمود الدبلوماسي لمدة 3 سنوات أخرى، وفي يوليو/تموز 2013، أقنع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الجانبين باستئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 9 أشهر.
ورغم أن محمود عباس التزم بالتنسيق الأمني مع “إسرائيل”، رفض نتنياهو بشكل قاطع معظم الشروط الفلسطينية، ولكنه وافق على استئناف محادثات السلام دون أي شروط مسبقة. وفي نظر شلايم، فإن نتنياهو يتظاهر بالتفاوض على تقسيم البيتزا بينما يواصل أكلها.
كان الفلسطينيون يدركون أن الحكومة الإسرائيلية ليست جادة بشأن المفاوضات، ولكن في الوقت نفسه، كانوا يخشون من أن تستغل “إسرائيل” محادثات السلام التي لا تحرز أي تقدم، كما حدث في العقدين اللذين أعقبا أوسلو، من أجل استرضاء المجتمع الدولي والتوغل أكثر في أراضيهم، وتحويلها إلى جيوب معزولة لا تملك السلطة الفلسطينية أي سلطة حقيقية عليها.
ومنذ عام 2015، عاد نتنياهو إلى رفضه المعتاد للسلام والتسوية، وصرح بشكل قاطع بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في عهده، ويشير هنا شلايم إلى أن استراتيجية نتنياهو الأساسية تتمثل في المماطلة واللعب على الوقت وتوسيع مستوطنات “إسرائيل” في الضفة الغربية إلى النقطة التي يصبح عندها إنشاء دولة فلسطينية مستحيلًا تمامًا.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يؤمن أبدًا بالسلام في الشرق الأوسط#الجزيرة_مباشر #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/lT1iNjU9E6
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2024
رغم كل ذلك وقعت 4 دول عربية في عام 2020، الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، على ما يسمى “اتفاقيات أبراهام” مع “إسرائيل”، وهو ما يمثل نهاية الموقف العربي التاريخي المتمثل في السلام والتطبيع مقابل قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس.
أقدمت هذه الدول على صنع السلام مع “إسرائيل” دون أن تضطر الأخيرة إلى دفع أي ثمن للفلسطينيين، ودون أن تضطر إلى الانسحاب ودون أن توافق على دولة فلسطينية، وإنما عقدوا السلام بشروط نتنياهو، ما تسبب بخيبة أمل مريرة لدى الفلسطينيين بعدما تحلوا بالصبر الكافي، فقد خسروا كل يوم المزيد من الأرض وحقق المستوطنون انتصارات كبيرة، ولم تساعد هذه الاتفاقيات الأخيرة في تخفيف معاناتهم.
ثم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 كرر نتنياهو التصريحات القديمة بأن كيانه محاطًا بالأعداء وأنه يسعى إلى السلام، لكن لا يوجد شريك فلسطيني للسلام، فخرج وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وقال: “نحن ممثلو 57 دولة عربية وإسلامية نتعهد بضمان أمن إسرائيل في مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية”.
السيسي يقول على هامش فعالية للجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية إن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية pic.twitter.com/j80fugkKiL
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 8, 2024
حتى اللحظة، لا يزال العديد من القادة الفلسطينيين والدول العربية يدعون إلى حل الدولتين منذ سبعينيات القرن العشرين، وجدير بالذكر أنه مع كل جرائم الاحتلال الأخيرة في قطاع غزة، لم تغلق حماس ملف التفاوض، لكن لا يوجد أي دليل يشير إلى أن زعماء “إسرائيل” مهتمون بحل سلمي، ويبدو أنهم متحدون على الحفاظ على سيطرتهم العسكرية والاقتصادية على الضفة الغربية وغزة.
نهاية الأوهام
القوة العسكرية لم تكن الملاذ الأخير، بل الخيار المفضل لدى القيادة الإسرائيلية، فقد كان هناك دائمًا خيارًا سلميًا على مدار سنوات الصراع، إذ كان الفلسطينيون على استعداد للتفاوض مع “إسرائيل” على تسوية نهائية أو جزئية وقدموا كل درجات المرونة، وتفاوضوا تحت رحمة توازن غير متكافئ، ولكن “إسرائيل” اعتمدت على القوة العسكرية كعامل أساسي في صياغة الدبلوماسية.
بجانب أن رؤساء الوزراء الإسرائيليين، بداية من ديفيد بن غوريون ومناحيم بيجين ومرورًا بإسحاق رابين وإيهود باراك وصولًا لأرئيل شارون وبنيامين نتنياهو، يتمتعون جميعًا بمؤهلات عسكرية كبيرة، ويمكن رصد هذه الخلفية العسكرية في تبني نهج دبلوماسي عدواني تجاه العرب والفلسطينيين.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: النار المشتعلة الآن في الحديدة يمكن رؤيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط#الجزيرة_مباشر | #اليمن pic.twitter.com/nOQBHnRlxH
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 20, 2024
بالمحصلة، فإن “إسرائيل” لا تفاوض إلا عندما يكون عدوها في أضعف حالاته، وعلى حد تعبير وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت: “لا نجري المفاوضات إلا تحت النار”. والإشكالية أن هذه الدبلوماسية لم تحمِ “إسرائيل” فحسب، بل شكلت استجابة من قادة العالم العربي، إذ تمكنت “إسرائيل” بجدارة من اصطياد الأطراف العربية بشكل منفرد، وبما يمكن اعتباره اعترافًا ضمنيًا بالعجز والهزيمة.
بالنهاية، يلخص المؤرخ شلايم الدبلوماسية الإسرائيلية بكونها أداة لخداع العالم وإقناعه بأن “إسرائيل” تسعى بنشاط إلى التوصل إلى تسوية، في حين أنها تستخدم المفاوضات كغطاء لإخفاء عدوانها المستمر، إذ كان منطقها أقرب إلى فرض الاستسلام، حيث دخلت في المفاوضات بهدف تعزيز موقفها وتقويض الموقف الفلسطيني، وإرضاء لمصالحها الأمنية، والحقيقة أن سلامًا من هذا النوع، حتى لو تم، فلن يدوم بسبب الظلم الكامن فيه.