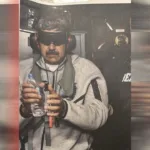صوت حياة نشيطة صاخبة يرتد صداه أصوات محنة ومعاناة، هكذا يمكن تخيُّل الفارق بين صياح الباعة في سوق الخضار الرئيسي في إدلب، وزفير المارّة الحائرة عقولهم بالتفكير: أيها أوفر.. المجدرة الفاصولياء بزيت أم الجظ مظ؟ كلها تحتاج إلى زيت زيتون وافر، الكيلوغرام الواحد منه بأكثر من 150 ليرة تركية، في بلده وفي موسمه أيضًا.
الرزق ضيّق والحيلة أيضًا، الواسع فقط هو كل هذا النشاط والازدحام، والمواجهة حتمية لا فرار منها ولا نجاة، فأنت لست وحدك، أنت وزوجتك و3 أطفال -وهذا مثال غير واقعي أبدًا-، ولو عشت وعاشوا على “الخبز الحاف” بمعدل 3 أرغفة للنسمة الواحدة منهم يوميًا، ومع كيلوغرامَين من “زيتنا” شهريًا، يعني أكثر من 1000 ليرة كل شهر، لا زعتر مع الزيت ولا نعناع ولا بصل ولا بندورة ولا محمّرة ولا حتى ملح.
وهنا نتكلم عن عائلة تعيش في الهواء، هكذا معلق أفرادها في الجو لا أرض يطأونها ولا سقف يظلهم، لا بيت لا كهرباء لا ماء ولا تدفئة، لا دواء لا علاج ولا تعليم، لا لباس لا مواصلات ولا اتصالات ولا معاملات، لكنما -والحمد لله- لم تُفرض على المعلقين في الهواء ضريبة حتى الآن.
أقسام وأشكال وأحوال همّ الناس في مدينة إدلب، والتركيز عليها هنا مثل التركيز على عاصمة تختزل أو تلخّص حالة المحيط، دولة كان أو ولاية أو إقليمًا أو كيانًا أو غير ذلك؛ وخطوط بيانات الأزمات بأنواعها لا تنخفض وترتفع تبعًا للزحام أو الكثافة السكانية فحسب، بل نتيجة لأسباب الحالة، وهي أسباب لها أسباب وأسباب.
مثل السؤال: ما سبب ضعف القوة الشرائية عند الناس؟ الفقر يا أخي، واضح، بالتأكيد الفقر، حسنًا.. وما أسباب الفقر؟ وهنا تشرع أبواب الأسئلة ولا تغلق نوافذ التحليلات والتوصيفات، ومنها أن تصف مدينة إدلب على أنها عاصمة كيان موازٍ لدولة، كيان فيه مقومات الأرض والشعب والسلطة، وتبقى مسألة القانون.
أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء الناس الذين يعيشون في مدينة إدلب الآن، ما خطر في بال أحدهم يومًا أو مرة أن يزوروها حتى زيارة، لكنه الحال الذي يعرفه السوريون جميعًا، وسبحان من يغير الأحوال.
أُجبر السوريون على الهجرة واللجوء والنزوح من بيوتهم وأحيائهم عن ذويهم وأحبائهم، وكانت إدلب في أغلب الأحوال منفىً إجباريًا وفي أحسنها مكانًا للعيش، وعلى الناس أخيرًا أن يتدبّروا لقمة هذا العيش، والواقع صعب قاسٍ يزداد صعوبة ونكدًا مع مرور الوقت وتفاقم أزمات الحياة على أشكالها، في بلد تعاني منذ سنين صارت طويلة من الآثار التي خلّفها كل هذا الإصرار الكوني على عدم حل مسألتها.
حيث هي أصلًا وفصلًا ليست سوى مسألة حرية وقضية خلاص، هذه هي حكاية السوريين، مثل حكاية بحّار في خطر أراد أن يصل بنفسه وبمجاديفه إلى شاطئ آمن، فوجد نفسه ممسكًا بتلابيب زورقه المحطم وشراعه الممزق وما بقيَ له من أمل.
في ظل الظروف السياسية والمجتمعية المستقرة، ومع الأحوال العادية والطبيعية دائمًا أو نسبيًا، تعاني كل مجتمعات العالم من التراجع الاقتصادي إن صحّ التعبير، والمقصود به حزمة من القضايا المترابطة أسبابًا كانت أو نتائج: ضعف الموارد أو سوء إدارتها، فشل الإدارة أو صعوبة استبدالها، الفقر أو انخفاض القدرة الشرائية، ضعف الإنتاج أو مقاومة تحقيقه أصلًا، البطالة والعمل غير الثابت.
ومع عدم الاستقرار السياسي والمجتمعي، وفي ظل أحوال ليست عادية ولا طبيعية، تتحول هذه القضايا -لا ريب- إلى كوارث حقيقية لا يمكن الخلاص منها، سوى بوجود حلول نهائية للمشكلات التي سبّبتها، وتبقى المحاولات محاولات إيجاد حلول.
كيف يقاوم الناس؟
“التضخم الاقتصادي”، هو شراؤك الآن لربطة خبز من 5 أرغفة بـ 10 ليرات وقد كنت تشتري سابقًا 10 أرغفة فيها بليرتين، أو مثل أن تقبض مالًا فترى أنه كافٍ، وحين تلج بعد ساعات منزلك تفكر: كيف ومن أين سأحصل على المال؟ ويا لها من معادلة.
يحاول السوريون جميعًا الآن حل معادلاتهم الاقتصادية بأشكال مختلفة، ومهما كانت أشكال الحلول وإمكانيات فرق الإنقاذ وأماكن وأعماق الغرقى، تبقى كحلول المتشبّث على أمل بالحطام وأشباهه، فلا خيارات أو مشاهد واضحة، فمن ضياع إلى ضياع ومن غرق إلى غرق.
كانت المساعدات الدولية المصنّفة تحت باب “الإنسانية” بابًا مواربًا لتغطية احتياجات الناس في إدلب، خاصة النازحين إليها أو المشردين فيها، من الأغذية والأدوية والموارد الأساسية من المياه أو الكهرباء، لكنها لم تكن تغطي سوى جزء يسير من هذه الاحتياجات المتزايدة دائمًا، مع ارتفاع أعداد من يحتاجونها وارتفاع نسب التضخم ومعدلات الغلاء.
وكان الاعتماد على دعم الأقارب والأصدقاء من الخارج بابًا أيضًا للتخفيف من الأعباء، وكانت فرص العمل في الزراعة والبناء والتجارة وغيرها توفّر جزءًا من الاحتياجات، ولم يدخر الناس هنا وسعًا أو جهدًا في توفير النفقات وتقليل التكاليف وتخفيض الاستهلاك، وبالنتيجة انكمشت المساعدات الدولية، تقلصت الإعانات العائلية، كما سيطر العجز على قدرة الناس على التكيُّف والتأقلم والتدبير، على ماذا يتكيّفون أصلًا أو يتأقلمون، وماذا يتدبّرون؟
“من سيّئ إلى أسوأ”. جُلّ أو كل الناس هنا يجيبون هكذا عن هذا السؤال: كيف الحال؟ طبيعية جدًّا هذه الإجابة وهذا الرد، فلا شيء يتغير إلى الأحسن ولا حال يتبدل إلى مآل، ولا تتحفز الأنظار إلى ما هو أفضل أبدًا، ومع استمرار حالة الصراع السوري وتلاشي آفاق أية حلول نهائية أو مؤقتة حتى أو آنية، فسيبقى الوضع الاقتصادي في إدلب هشًّا ومضطربًا.
ستزداد الأسعار وترتفع التكاليف وتقلّ فرص العمل وتخفّ القوى الشرائية ويتضخم التضخم، ستضعف بالتأكيد قدرة الناس على الصمود في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة ماحقة، والمعادلة مزعجة ومتعبة للغاية لكنها بسيطة ومن الدرجة الأولى: شحّ موارد + انسداد آفاق = الذهاب إلى الهاوية، فما هي الحلول التي يمكن على الأقل تصورها؟
تخفيف الآثار
يبدو أن محاولة تخفيف آثار هذه الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السوريون عمومًا، وسكان محافظة أو مدينة إدلب الذين أصبح بعضهم وسيصبح بعضهم الآخر من أهلها الدائمين، ليست سهلة، لكنها واجبة، فأعداد الناس واحتياجاتهم تتزايد ولا تتوقف، ولا يمكن للاقتصاد المحلي وحده تخفيف أعباء الناس وتحسين أوضاعهم المعيشية، وستبقى الحاجة ماسّة لتدخل دولي قوي ومؤثر.
وسيبقى الاعتماد على المساعدات ضرورة راهنة لتوفير الاحتياجات الأساسية، لكنما بالتركيز على توجيه الجزء الأكبر من أي دعم خارجي إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة أصحابها بتأمين الموارد التشغيلية والفنية، لخلق فرص عمل وكفاءات جديدة مؤهَّلة في مختلف أنواع المهن أو الحرف اليدوية، وفي الزراعة والصناعة والتسويق.
لكن الاعتماد الكبير على إخراج وإنجاح هذه المشاريع سيكون من داخل إدلب نفسها، فالمنظمات والمؤسسات الدولية لا تقدم حلولًا دائمة وحاسمة، وبالطبع لن تقدم الأيدي العاملة.
ثمة مسائل أخرى يمكن محاولة القيام بها أو القيام بها فعلًا، من أهمها الدفع نحو السيطرة على الأسعار، خاصة أسعار المنتجات والسلع الغذائية، بالرقابة الفاعلة على موازين الاستيراد والتصدير، وعلى الفروقات بين بيع الجملة وبيع التجزئة، وتحسين ظروف السوق المحلية وأعباء النفقات والضرائب على المحال التجارية أو المرافق الإنتاجية والخدمية، كالأفران مثلًا أو الصيدليات.
ولن يمكن تحقيق ذلك سوى بإشراك المجتمع المحلي ليس في الرقابة العامة أو الشعبية فقط، بل في تحديد أولوياته الاقتصادية على صعيد المشاريع الإنتاجية اللازمة والأسعار المناسبة للمواد الأساسية على الأقل.
ومع أن السعي لتحديد الأسعار أو السيطرة عليها سيكون صعبًا للغاية بسبب “التضخم المستورد”، لأن اقتصاد إدلب المحلي يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من تركيا، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملتها زيادة أو ارتفاعًا، أو بسبب التضخم الناجم عن انخفاض العرض بمواجهة الطلب بسبب الأوضاع الأمنية الهشة والبنى التحتية المتضررة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقليل ما يعرض من المنتجات أيضًا؛ فإن الاعتماد الكامل أو الكبير على المساعدات الخارجية غير المستقرة أو المستمرة أصلًا، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الحصول على المواد الأساسية التي كانت مدعومة في السابق، كالسكر والأرز وغيرهما.
من جهة أخرى ومن زاوية أوسع، إدلب محافظة ومدينة تعاني بشدة من “التضخم العقاري” وليس من التضخم الاقتصادي المعيشي وحده، وإن كانت الحالتان مترابطتين، لكن الأسوأ يحدث ليس على مستوى الغذاء وحده بل على مستوى المأوى، ولن يمكن ضبط أية حالة بشكل معقول سوى بحلّ نهائي.
ويمكن تلخيص مسألة مؤشر التضخم العقاري في إدلب بمثال بسيط: منزل طابق أول في حي الجامعة في مدينة إدلب كان سعره قبل شهرين 15 ألف دولار مثلًا، صار سعره منذ شهر 10 آلاف دولار ولا أحد يفكر في شرائه أصلًا، فقد ذاعت شائعات المعارك على جبهات حلب وغيرها، فاتجهت أمزجة الناس إلى النزوح وليس إلى امتلاك منازل في مدينة أو منطقة أول ما ستواجه حال نشوب المعارك صواريخ بوتين والأسد، ولا يبقى من أجل التخفيف من حدّة التضخم العقاري في إدلب سوى العمل على تخفيف إيجارات المنازل والمحال، أو الحد من زيادتها.
إن توفير الدعم النقدي المباشر للعائلات المتضررة أو الأشد ضعفًا، وكذلك احتياجاتها الغذائية الأساسية، وتوفير الموارد التشغيلية اللازمة لتشجيع المشاريع الإنتاجية وتحفيز العمالة، وإيجاد آليات لتثبيت الأسعار أو إيقاف ارتفاعها، وتشجيع الاستقرار الأمني والسياسي بل النفسي، يمكن أن يقدم مشاريع حلول لهذه الأزمة الاقتصادية الخطيرة.
المستقبل..
مع استمرار النزاع السوري وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وانعدام الاستقرار الدائم وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، يبدو أن المستقبل ليس جيدًا، وستظل إدلب معتمدة على المساعدات الإنسانية، مساعدات متقطعة وغير كافية يتحكم فيها المموّلون والداعمون والمسيطرون على سلطة القرار في المنظمات الإنسانية أو المؤسسات الرسمية.
وبسبب البيئة المضطربة لن يكون بوسع القطاع الخاص القيام بدوره الضروري في دعم الاقتصاد المحلي في إدلب وإنعاشه، بسبب غياب الاستثمار الداخلي والخارجي عنها، وبسبب شحّ الموارد وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكاليف التشغيل، وإن استمرت حالة الصراع طويلًا ستزداد معاناة الناس لا ريب، وسيستمر التضخم بأشكاله ودرجاته.
وربما أمكن للسلطات الحاكمة في إدلب الآن، ومهما كانت مواقف السوريين الأدالبة أو السوريين الذين في إدلب منها، أن تعمل على تطوير آليات اقتصادية تركز على تلبية احتياجات الجميع، بالتعاون المستقل والحيادي مع الأطراف الدولية والمحلية التي تسعى إلى ذلك، دون شروط أو أهداف أو اعتبارات سوى مصالح الناس، السوريين الذين امتلكوا أفضل أنواع النفط والفوسفات والقطن والزيتون واللحوم والألبان والمياه والخضار والقلوب الطيبة والنصيب الرهيب، والإيمان.