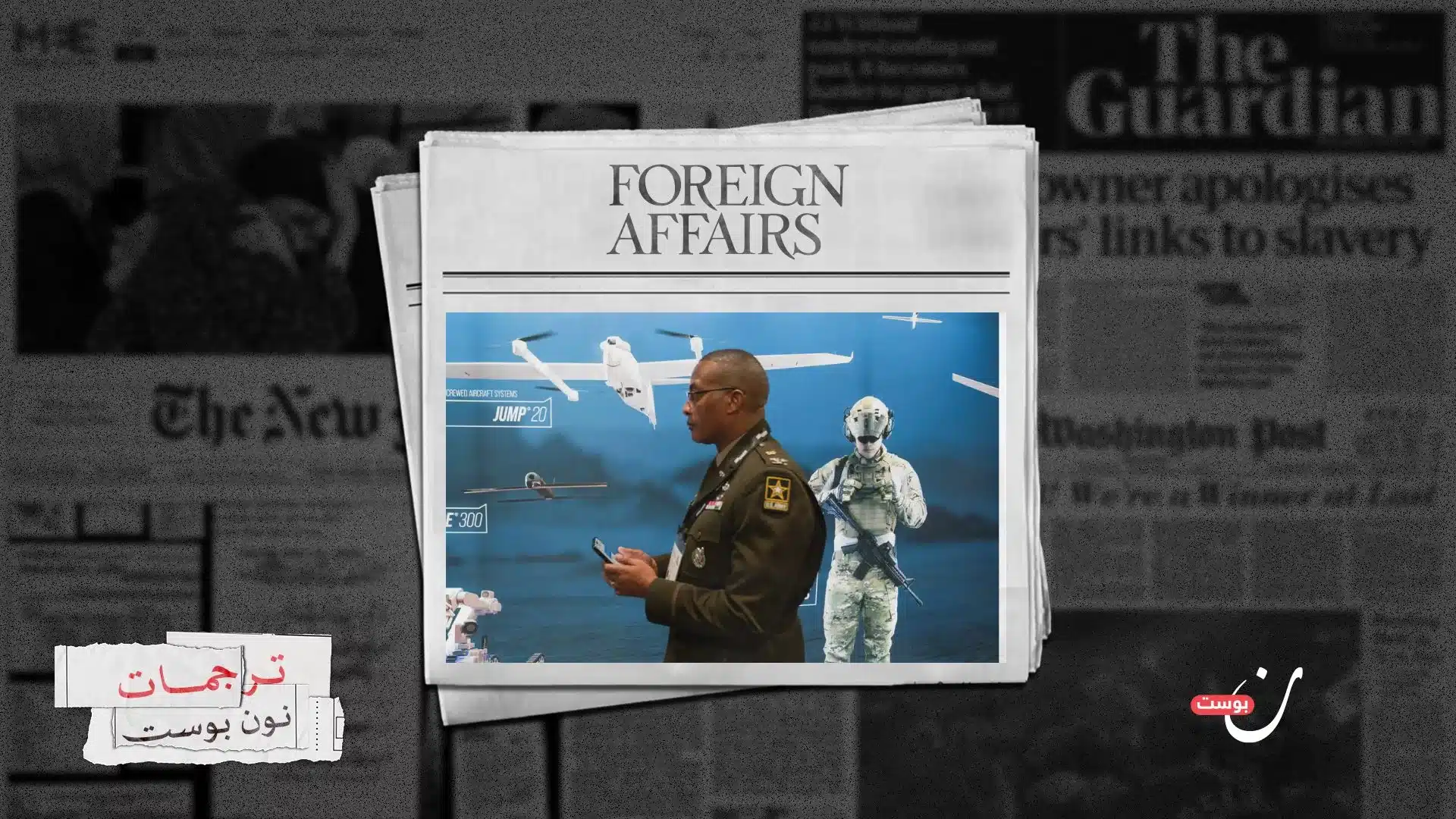ترجمة وتحرير: نون بوست
من إعادة تقويم الاستراتيجية العسكرية إلى إعادة تشكيل الدبلوماسية، سيصبح الذكاء الاصطناعي مُحدِّدًا رئيسيًا للنظام العالمي؛ حيث يقدم الذكاء الاصطناعي، المحصّن ضد الخوف والمحاباة، إمكانيات جديدة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل موضوعي.
لكن هذه الموضوعية، التي يعتمد عليها القائد العسكري وصانع السلام، يجب أن تحافظ على الطابع البشري، وهو أمر ضروري لممارسة السلطة بشكل مسؤول. سوف يكشف استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب عن أفضل وأسوأ السمات الإنسانية، وسيكون بمثابة وسيلة لإشعال الحروب وإنهائها على حد سواء.
لقد وصل كفاح البشرية الطويل لتشكيل واقعها ضمن منظومات تزداد تعقيدًا يوما بعد يوما، بهدف أن لا تكتسب أي دولة هيمنة مطلقة على الآخرين، إلى مكانة تحاكي قوانين الطبيعة المستمرة وغير المنقطعة. ففي عالم لا يزال فيه البشر الفاعل الرئيسي – حتى في ظل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتزويده بالمعلومات وتقديم المشورة – يجب أن تتمتع الدول بدرجة من الاستقرار القائم على معايير السلوك المشتركة، الخاضعة للتعديل والتكيف وفقًا لمقتضيات الزمن.
ولكن إذا تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة من الكيانات السياسية والدبلوماسية والعسكرية المستقلة عمليًا، فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير توازن القوى القديم واستبداله بتوازن جديد غير مسبوق. إن التوافق العالمي بين الدول القومية – الذي يمثل توازنًا هشًا ومتغيرًا تم تحقيقه على مدى القرون الأخيرة – قد صمد جزئيًا بسبب المساواة الجوهرية بين الأطراف الفاعلة.
أما في عالم يتسم بالتفاوت الشديد – على سبيل المثال، إذا اعتمدت بعض الدول على الذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر من غيرها ــ سيكون من الصعب التنبؤ بما ينتظرنا مستقبلا. ففي الحالات التي يواجه فيها بعض البشر تحديات عسكرية أو دبلوماسية ضد دولة مزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي على أعلى مستوى، أو في مواجهة الذكاء الاصطناعي نفسه، قد يكافح البشر من أجل البقاء، ناهيك عن المنافسة. ومثل هذا النظام الوسيط يمكن أن يؤدي إلى انهيار اجتماعي من الداخل، وصراعات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.
تتعدد الاحتمالات الأخرى، فبعيدًا عن السعي وراء الأمن، خاض البشر الحروب بحثًا عن النصر أو دفاعًا عن الشرف. أما الآلات -في الوقت الحالي- فإنها تفتقر إلى أي تصور عن النصر أو الشرف، وقد لا تخوض الحروب أبدًا، مفضلةً على سبيل المثال عمليات تبادل للأراضي بشكل فوري ودقيق استنادًا إلى حسابات معقدة.
أو قد تقوم -معتبرة النتيجة أكثر أهمية من حياة الأفراد- بأفعال تؤدي إلى حروب دموية تستنزف البشر. وفي أحد السيناريوهات، قد يتطور الجنس البشري إلى الحد الذي يجعله يتجنب تماماً وحشيته السابقة، وفي سيناريو آخر، قد نصبح خاضعين تمامًا للتكنولوجيا ونعود إلى ماضينا الهمجي.
معضلة أمن الذكاء الاصطناعي
الواقع أن العديد من الدول مهووسة بـ”الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي”، وجزء من هذا الهوس مفهوم. فقد تضافرت عوامل الثقافة والتاريخ والتواصل والتصورات لخلق واقع دبلوماسي راهن بين القوى الكبرى يعزز انعدام الأمن والشك من جميع الأطراف. ويعتقد القادة أن الميزة التكتيكية التدريجية يمكن أن تكون حاسمة في أي صراع مستقبلي، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر هذه الميزة.
إذا رغبت كل دولة في تعزيز مكانتها، فإن الظروف ستكون مهيأة لحرب نفسية بين الجيوش ووكالات الاستخبارات لم تواجه البشرية مثيلا لها في التاريخ. نحن على أبواب معضلة أمنية وجودية. ربما تكون الرغبة المنطقية الأولى لأي فاعل بشري يحصل على ذكاء اصطناعي فائق التطور -أي ذكاء اصطناعي افتراضي أكثر ذكاءً من الإنسان- هي محاولة ضمان عدم حصول أي طرف آخر على هذه النسخة المتطورة من التكنولوجيا. وقد يفترض أي طرف فاعل من هذا القبيل أيضًا بشكل معقول أن منافسه، الذي تعصف به الشكوك والمخاطر ذاتها، سوف يفكر في اتخاذ خطوة مماثلة.
وبعيدًا عن الحروب، قد يتمكن الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء من تقويض وعرقلة أي برنامج منافس. على سبيل المثال، يستطيع الذكاء الاصطناعي تقوية فيروسات الكمبيوتر التقليدية بفعالية غير مسبوقة وإخفاءها بشكل كامل.
وعلى غرار الدودة الحاسوبية “ستوكسنت” – السلاح السيبراني الذي تم الكشف عنه في عام 2010 والذي كان يُعتقد أنه دمر خمسة من أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم في إيران – قد يتمكن الذكاء الاصطناعي من تخريب تقدم المنافسين بطرق فعالة وإجبار الأعداء على مطاردة الأوهام.
وبفضل قدرته الفريدة على التلاعب بنقاط الضعف في علم النفس البشري، يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا أن يختطف وسائل الإعلام في دولة منافسة، مما ينتج طوفانًا من المعلومات المضللة الاصطناعية التي تثير القلق لدرجة أنها تلهم معارضة جماهيرية ضد مزيد من التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي في تلك الدولة.
سوف يكون من الصعب على الدول تشكيل فكرة واضحة عن موقفها من الدول الأخرى في سباق الذكاء الاصطناعي. إن أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي يتم تدريبها بالفعل على شبكات آمنة منفصلة عن بقية شبكة الإنترنت. ويعتقد بعض المديرين التنفيذيين أن تطوير الذكاء الاصطناعي سوف ينتقل عاجلاً أم آجلاً إلى مخابئ لا يمكن اختراقها، حيث سيتم تشغيل أجهزة الكمبيوتر العملاقة بمفاعلات نووية، وبعض مراكز البيانات يتم بناؤها حاليا في قاع المحيط، وقد يتم قريبا عزلها في مدارات حول الأرض.
قد تتوقف الشركات أو الدول عن نشر أبحاث الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتجنب القرصنة، ولكن أيضًا لإخفاء وتيرة تطويرها. لتشويه الصورة الحقيقية لتقدمها، قد يحاول البعض الآخر نشر أبحاث مضللة عمدًا، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنشاء مبررات مقنعة.
هناك سابقة لمثل هذه الخداع العلمي، ففي عام 1942، استنتج الفيزيائي السوفييتي جورجي فليوروف بشكل صحيح أن الولايات المتحدة تصنع قنبلة نووية بعد أن لاحظ أن الأمريكيين والبريطانيين توقفوا فجأة عن نشر أوراق علمية عن الانشطار الذري.
واليوم، لا يمكن التنبؤ بمثل هذه المنافسة نظرًا لتعقيد وغموض قياس التقدم المحرز في شيء مجرد مثل الذكاء الاصطناعي. ورغم أن البعض يرى أن الأفضلية تتناسب مع حجم نماذج الذكاء الاصطناعي التي بحوزة كل دولة، إلا أن النموذج الأكبر ليس بالضرورة متفوقًا في جميع السياقات، وقد لا يتفوق دائماً على النماذج الأصغر حجماً التي يتم نشرها على نطاق واسع؛ حيث تعمل آلات الذكاء الاصطناعي الأصغر حجماً والأكثر تخصصاً مثل سرب من الطائرات المسيرة ضد حاملة طائرات، وقد لا تتمكن من تدميرها، ولكنها تستطيع تحييدها.
قد يُنظر إلى أحد الأطراف على أنه يتمتع بميزة إجمالية إذا ما أظهر إنجازًا في قدرة معينة. ومع ذلك، تكمن المشكلة في هذا النمط من التفكير في أن الذكاء الاصطناعي يشير فقط إلى عملية تعلم آلي لا تنحصر في تقنية واحدة فحسب، بل في طيف واسع من التقنيات. وبالتالي فإن القدرة في أي مجال قد تكون مدفوعة بعوامل مختلفة تمامًا عن القدرة في مجال آخر. وبهذا المعنى، فإن أي “ميزة” يتم قياسها بشكل تقليدي قد تكون ميزة وهمية.
علاوة على ذلك، وكما يتضح من الانفجار الهائل وغير المتوقع لقدرات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، فإن مسار التقدم ليس ثابتًا ولا يمكن التنبؤ به. وحتى إن كنا نستطيع القول إن أحد الأطراف الفاعلة “يتقدم” على الآخر بعدد تقريبي من السنوات أو الأشهر، فإن اختراقًا تقنيًا أو نظريًا مفاجئًا في مجال رئيسي، وفي لحظة حرجة، يمكن أن يقلب مواقف جميع الأطراف.
في مثل هذا العالم، حيث لا يمكن لأي زعيم أن يثق في قدرات ذكائه الاصطناعي الأكثر صلابة، أو غرائزه الأكثر بدائية، أو في الواقع نفسه، لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومات بسبب تصرفها في موقف ما بأقصى درجات جنون العظمة والشك.
ولا شك أن القادة يتخذون قراراتهم بالفعل على افتراض أن مساعيهم تخضع للمراقبة أو تنتج عن جهود معادية خبيثة. وإذا افترضنا أسوأ السيناريوهات، فإن الحسابات الاستراتيجية لأي جهة فاعلة على الحدود ستكون إعطاء الأولوية للسرعة والسرية على حساب السلامة. وقد يسيطر على القادة الخوف من عدم وجود شيء اسمه المركز الثاني، وتحت الضغط، قد يسرعون قبل الأوان في نشر الذكاء الاصطناعي كوسيلة ردع ضد التهديدات الخارجي.
نموذج جديد للحرب
على مدى التاريخ البشري بأكمله تقريبًا، كانت الحروب تُخاض في مساحة محددة حيث يمكن للمرء أن يعرف بشكل تقريبي قدرات ومواقع القوات المعادية. وقد أتاح الجمع بين هاتين الخاصيتين لكل طرف شعورًا بالأمن النفسي واللجوء تلقائيا إلى سلوك مشترك، مما سمح بضبط النفس فيما يتصل بالقتل خلال الحروب. فقط عندما يتفق القادة المستنيرون على فهم موحد لكيفية خوض الحروب، يمكن للجيوش المتنازعة أن تقرر ما إذا كان ينبغي لها أن تخوض الحرب أم لا.
كما كانت السرعة والقدرة على الحركة من بين أكثر العوامل التي يمكن التنبؤ بها والتي تدعم قدرات مختلف المعدات العسكرية، ومن الأمثلة المبكرة على ذلك تطوير المدافع. فعلى مدار ألف سنة بعد بنائها، استطاعت أسوار ثيودوسيان أن تحمي مدينة القسطنطينية من الغزاة الخارجيين. ثم في عام 1452، اقترح مهندس مدفعية مجري على الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر بناء مدفع عملاق يطلق النار من خلف الأسوار الدفاعية لسحق القوات المعادية. لكن الإمبراطور الواثق من نفسه، والذي لم يكن يمتلك الوسائل ولا البصيرة اللازمة لإدراك أهمية تلك التقنية، رفض تطبيق الفكرة.
لسوء حظه، تحول المهندس المجري إلى مرتزق، وغيّر تكتيكاته (وتوجهاته)، وقام بتحديث تصميمه ليكون أكثر قدرة على الحركة – كان يحتاج في البداية إلى ما لا يقل عن 60 ثورًا و400 رجل لنقله – وتحالف مع منافس الإمبراطور الروماني، السلطان العثماني محمد الثاني الذي كان يستعد لمحاصرة القلعة المنيعة.
وبعد أن حظي باهتمام السلطان الشاب عندما قال إن هذا المدفع قادر على “تحطيم أسوار بابل ذاتها”، ساعد المهندس المجري القوات التركية على اختراق الأسوار القديمة في غضون خمسة وخمسين يومًا فقط.
حدثت هذه الدراما التي تعود إلى القرن الخامس عشر مرارًا وتكرارًا عبر التاريخ. في القرن التاسع عشر، مكّنت سرعة وسائل التنقل جيش نابليون من اجتياح أوروبا، ثم استفاد جيش بروسيا بقيادة هيلموت فون مولتكه (الأكبر) وألبريشت فون رون، من السكك الحديدية المطورة حديثًا للمناورة بشكل أسرع وأكثر مرونة. وبالمثل، استُخدمت الحرب الخاطفة – وهي تطور للمبادئ العسكرية الألمانية نفسها – ضد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بشكل واسع وفظيع.

لقد اكتسبت “الحرب الخاطفة” معنى جديدًا – وانتشارا واسع النطاق – في عصر الحرب الرقمية؛ حيث أصبحت السرعة فورية، ولا يحتاج المهاجمون إلى التضحية بالقدرات القتالية للحفاظ على القدرة على الحركة، حيث لم تعد الجغرافيا تشكل أي قيود. ورغم أن هذا المزيج كان في صالح المهاجمين إلى حد كبير في العصر الرقمي، إلا أن عصر الذكاء الاصطناعي قد يشهد زيادة سرعة الاستجابة ويسمح للدفاعات بالتصدي للهجمات السيبرانية بكفاءة أكبر.
وفي الحروب الميدانية، سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى قفزة أخرى إلى الأمام. فالطائرات المسيرة، على سبيل المثال، ستكون سريعة للغاية وقادرة على الحركة بشكل لا يمكن تصوره. وبمجرد أن يتم نشر الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتوجيه طائرة مسيرة واحدة ولكن لتوجيه أساطيل منها، ستتشكل غيوم من الطائرات المسيرة وتحلق بشكل متزامن كمجموعة واحدة متماسكة ومتناسقة ومثالية في تزامنها. ستنتشر أسراب الطائرات المسيرة في المستقبل وتعيد تشكيل نفسها دون عناء في وحدات من كل الأحجام، تمامًا كما يتم بناء قوات العمليات الخاصة النخبوية من مفارز قابلة للتطوير، كل منها قادر على التحرك بشكل منفرد.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الذكاء الاصطناعي دفاعات سريعة ومرنة. ستتطور أساطيل الطائرات المسيرة إلى درجة يصبح فيها من الصعب إن لم يكن من المستحيل إسقاطها بالصواريخ التقليدية. ولكن يمكن للأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تطلق قذائف من الفوتونات والإلكترونات (بدلاً من الذخيرة) أن تحاكي في قوتها التدميرية قدرات عاصفة شمسية على إحراق الأقمار الصناعية المكشوفة.
ستصل الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى دقة غير مسبوقة في تنفيذ المهام. لطالما مثلت محدودية معرفة جغرافيا الخصم عائقاً أمام قدرات الأطراف المتحاربة. إلا أن التحالف بين العلم والحرب قد أتاح مستوى غير مسبوق من الدقة في مجال الأسلحة. ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق تطورات أكبر في هذا المجال، مما يقلص الفجوة بين النوايا والنتائج النهائية، بما في ذلك عند استخدام القوة المميتة.
سواء كانت أسراب طائرات مسيرة على الأرض، أو جيوشا آلية في البحار، أو أساطيل في الفضاء، ستتمتع الآلات بقدرات عالية على تنفيذ عمليات القتل بدقة فائقة وأثر غير محدود. في النهاية، سيعتمد مدى الدمار على إرادة كل من البشر والآلات وقدرة كل منهما على ضبط النفس.
وبناء على ذلك، فإن تطبيقات عصر الذكاء الاصطناعي في الحروب لن تنحصر في المقام الأول في تقييم قدرات الخصم، بل ستركز على نواياه وخططه الاستراتيجية. وفي العصر النووي، دخلنا بالفعل هذه المرحلة، ولكن آلياتها وأهميتها سوف تصبح أكثر وضوحا مع إثبات الذكاء الاصطناعي قيمته كسلاح في الحروب.
ومع إدخال هذه التكنولوجيا المتقدمة، قد تتغير طبيعة الحروب بشكل جوهري. فمن الممكن أن يبتعد الذكاء الاصطناعي عن إشراك البشر في ساحة المعركة، مما يقلل من الخسائر البشرية، ولكنه سيقلل أيضا من فرص حسم الصراع. بالمثل، قد لا يصبح الاستيلاء على الأراضي الهدف الرئيسي للصراعات المستقبلية، بينما ستصبح مراكز البيانات والبنى التحتية الرقمية الحيوية أهدافاً ذات أولوية قصوى.
في هذه الحروب، قد لا يكون الاستسلام نتيجة لاستنزاف القوات أو نفاد الأسلحة، بل بسبب انهيار الحواجز الرقمية وعدم قدرة الجيوش على حماية مواردها التكنولوجية ومن ثم عناصرها البشرية. قد تتحول الصراعات إلى مواجهات ميكانيكية خالصة، حيث يصبح العامل الحاسم هو القوة النفسية للبشر أو الذكاء الاصطناعي، الذي يقرر ما إذا كان سيخوض المعركة أو يتجنبها خوفا من لحظة اختراق قد تؤدي إلى دمار شامل.
كما أن دوافع الحرب في هذا السياق قد تصبح غريبة. يقول الكاتب الإنجليزي غلبرت كيث تشيسترتون “الجندي الحقيقي لا يقاتل لأنه يكره من أمامه، بل لأنه يحب من خلفه”. أما في الحروب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد لا يكون للحب أو الكراهية دور، وقد تتغير مفاهيم مثل الشجاعة العسكرية. ولكن قد تظل دوافع مثل الهوية والولاء والغرور موجودة، وإن كان من المرجح أن تأخذ أشكالاً جديدة تختلف تماماً عن المفاهيم المعروفة.
لطالما كانت معادلة الحرب تعتمد على استنزاف الطرف الآخر أولاً. في الماضي، كان وعي الأطراف بحدود قدراتها هو ما يفرض ضبط النفس، ولكن في ظل غياب هذا الوعي وانعدام الإحساس بالألم، يُطرح السؤال: ما الذي قد يدفع الذكاء الاصطناعي إلى ضبط النفس؟ وكيف ستنتهي الحروب التي يشارك فيها؟ تخيل آلة ذكاء اصطناعي تلعب الشطرنج ولم يتم تعليمها قواعد إنهاء اللعبة؛ قد تستمر في اللعب حتى آخر قطعة على اللوحة.
هيكلة جيوسياسية جديدة
على مر العصور، برزت قوى تمتلك القوة والإرادة والدافع الأخلاقي والفكري لإعادة تشكيل النظام الدولي وفقاً لرؤاها، كما وصف ذلك هنري كيسنجر. أحد أبرز النماذج التي تجسد هذه الظاهرة هو نظام “وستفاليا”، الذي رسخ مفهوم الدولة القومية ذات السيادة. ورغم أن هذا النظام لم يتجاوز بضعة قرون منذ ظهوره ضمن ما يُعرف بـ”صلح وستفاليا” في القرن السابع عشر، فإنه لم يكن أبداً النموذج الوحيد لتنظيم المجتمعات البشرية. واليوم، في ظل العصر الرقمي، قد يثبت هذا النظام القديم أنه غير ملائم لعصر الذكاء الاصطناعي.
التوسع السريع للمعلومات المضللة والتمييز الآلي يهدد بتقويض الثقة في النظام القائم، مما يضع الذكاء الاصطناعي في مواجهة مباشرة مع سلطة الحكومات الوطنية. وفي المقابل، قد يسهم الذكاء الاصطناعي في إعادة ترتيب موازين القوى بين الدول. إذا تمكنت الدول من تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد نشهد نمطاً جديداً من الهيمنة، أو توازناً جديداً بين الدول القومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، قد يدفع الذكاء الاصطناعي نحو تحول أعمق، ويُجبر الحكومات الوطنية على التخلي عن دورها المركزي لصالح نظام سياسي جديد كلياً.
أحد السيناريوهات المحتملة هو أن الشركات المالكة لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد تكتسب قوة شاملة اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا. تواجه الحكومات اليوم تحدياً مزدوجاً: فهي من جهة تدعم هذه الشركات من خلال توفير الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي لتعزيز مكانتها، ومن جهة أخرى تحاول طمأنة مواطنيها الذين يشككون في نوايا هذه الشركات التي تفتقر إلى الشفافية. قد لا تستطيع الحكومات أن تستمر في التعامل بنجاح مع هذا التناقض.
في الأثناء، قد تسعى الشركات إلى تشكيل تحالفات لتعزيز قوتها الحالية، وقد تكون هذه التحالفات مبنية على تكامل المصالح أو على رؤية مشتركة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها. وقد تتحول هذه التحالفات إلى كيانات قادرة على أداء وظائف كانت تقتصر على الدول القومية، غير أن هدفها سيكون إدارة شبكات رقمية واسعة على غرار المجالات الجغرافية التقليدية التي تخضع لنفوذ الدول.
قد يشهد المستقبل ظهور تحدٍ جديد يتمثل في الانتشار الواسع وغير المنضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تشكيل مجموعات صغيرة أو “عصابات” تعمل في شكل “قبائل رقمية”. هذه الكيانات قد تمتلك قدرات محدودة، ولكنها قد تكون فعّالة بما يكفي لتمكينها من إدارة شؤونها وتلبية احتياجاتها والدفاع عن نفسها في إطار محدود.
في هذا السياق، قد تتبنى هذه المجتمعات نهجاً يعتمد على اللامركزية في التمويل والاتصال والإدارة، مما يؤدي إلى تشكل نموذج جديد لفوضى منظمة مدعومة بالتكنولوجيا. ومن المحتمل أن تأخذ هذه المجموعات بُعداً دينياً، حيث أظهرت الأديان، بفضل مؤسساتها وانتشارها التاريخي، قدرة على التأثير تفوق الدول من حيث الاستمرارية والقدرة على التأثير العميق. في المستقبل، قد تصبح الهوية الدينية أكثر أهمية من المواطنة، لتصبح الإطار الأساسي للانتماء والولاء.
سواء كان المستقبل تحت سيطرة تحالفات الشركات الكبرى أو ضمن مجموعات دينية مرنة، فإن “الأراضي” التي ستتنافس عليها هذه الكيانات لن تكون جغرافية، بل ستكون رقمية. سيتركز التنافس على ولاء الأفراد في الفضاء الرقمي، مما يعيد تشكيل الروابط بين المستخدمين والإدارات ويقوض المفهوم التقليدي للمواطنة. كما أن الاتفاقات بين هذه الكيانات ستكون مغايرة للتحالفات التقليدية التي اعتاد عليها العالم.
تاريخياً، كانت التحالفات تُبنى عبر جهود فردية من القادة لتعزيز قوة دولهم في أوقات الحرب. على النقيض، فإن بناء الهوية القومية والتحالفات – وربما خوض الحروب أو الحملات العسكرية – على أساس آراء ومعتقدات وهويات فردية في أوقات السلم، فيتطلب تصوّراً جديداً (أو قديماً جداً) لمفهوم الإمبراطورية. كما تفرض هذه التحولات إعادة تقييم الالتزامات المرتبطة بالولاء، إلى جانب تكاليف خيارات الانفصال، إن وُجدت تلك الخيارات أساسا في مستقبلنا المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
السلام والسلطة
على مر العصور، تشكلت السياسات الخارجية للدول من توازن دقيق بين المثالية والواقعية. وغالباً ما يُعتبر التوازن الذي يحققه القادة حلّاً مؤقتاً يتناسب مع ظروفهم الخاصة، وليس نهاية حاسمة، بل استراتيجيات مرحلية تواكب التحديات الآنية.
ومع كل عصر جديد، ظهرت صيغ مختلفة لما يُعرف بالنظام السياسي، متأرجحة بين السعي لتحقيق المصالح القومية من جهة، وتحقيق القيم الإنسانية العامة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، كانت الدول الصغيرة تركز ببساطة على البقاء في إطار دبلوماسي محدود، بينما كانت الإمبراطوريات الكبرى، بقدراتها ووسائلها الهائلة، تواجه تحديات أعمق وأكثر تعقيداً.
منذ بدايات الحضارة، ومع نمو حجم المجتمعات البشرية، نشأت مستويات جديدة من التعاون. إلا أن حجم التحديات العالمية، إلى جانب الفوارق الاقتصادية بين الدول وداخلها، قد أفرزا اليوم ردود فعل متزايدة تعارض هذا الاتجاه التعاوني. في هذا الإطار، قد يمثل الذكاء الاصطناعي أداة مثلى للتعامل مع متطلبات الحوكمة العالمية الشاملة، حيث يمتلك القدرة الفائقة على تقديم رؤية دقيقة ومتكاملة، لا تقتصر على مصالح الدول فحسب، بل تشمل العلاقات الدولية بمختلف أبعادها.
ثمة أمل في أن يُسهم الذكاء الاصطناعي في صنع السياسة الداخلية والخارجية بما هو أكثر من مجرد تقديم رؤى حول التوازنات الحالية. في أفضل السيناريوهات، قد يوفر حلولاً عالمية جديدة تصمد لوقت طويل، ودقة تتجاوز الإمكانيات البشرية، مما يعزز تقارب المصالح المتباينة. وقد يصبح الذكاء الاصطناعي، في هذا السياق، وسيطاً في إدارة النزاعات وإحلال السلام، قادراً على تسليط الضوء على المعضلات التقليدية أو حتى تجاوزها بالكامل.
لكن، قد يثير نجاح الذكاء الاصطناعي في حل القضايا التي كانت تُعتبر حكراً على البشر أزمة ثقة مزدوجة: ثقة مفرطة وأخرى متآكلة. من جهة، قد يجعلنا إدراك حدود قدرتنا على التصحيح الذاتي مترددين في منح التكنولوجيا سلطة كبيرة على القضايا الوجودية المرتبطة بالسلوك البشري.
ومن جهة أخرى، إذا اكتشفنا أن استبعاد العنصر البشري كفيل بحل أكثر مشكلاتنا تعقيدا، فقد يكشف ذلك عن قصور في التصميم البشري نفسه. وفي حال أدركنا أن السلام كان دائماً خيارا بسيطا ومتاحا لكننا لم نتمكن من تحقيقه بسبب عيوبنا، أو فشلنا في تصوره، قد يشكل ذلك صدمة قاسية لنا كبشر.
وفي مجال الأمن، على خلاف العديد من المجالات الأخرى مثل العلوم والأبحاث الأكاديمية التي قد تتأثر بإقصاء الإنسان، قد نكون أكثر تقبلاً لفكرة حيادية طرف آلي، معتبرين إياه خياراً أفضل من تحيز البشر. مثلما يعترف الناس في النزاعات الشخصية بالحاجة إلى طرف ثالث محايد، فإن بعض أسوأ سماتنا البشرية – مثل الأنانية – قد تدفعنا لتبني أحد أفضل تلك السمات : قبول تفوق الذكاء الاصطناعي في خدمة الصالح العام.
المصدر: فورين أفيرز