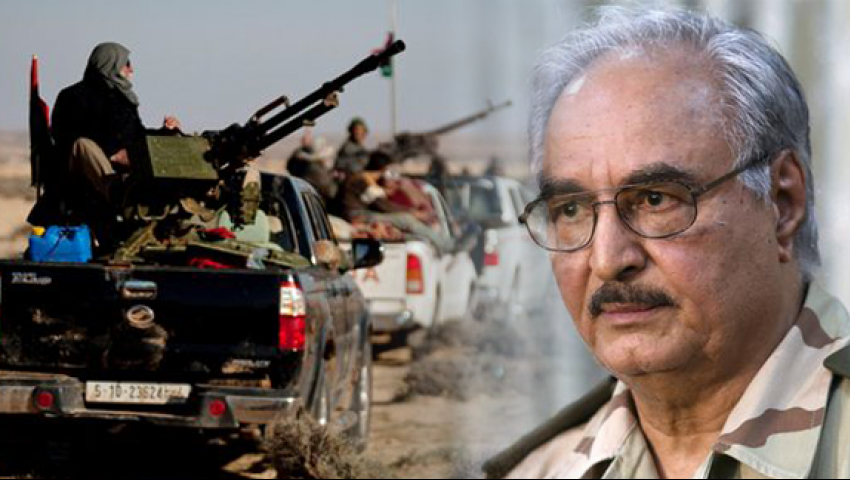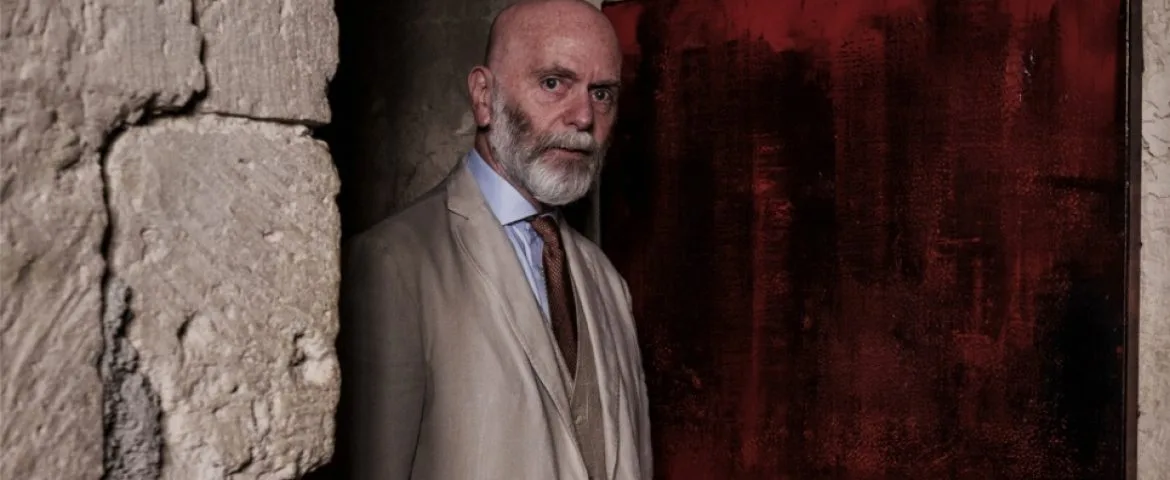لا يكاد يمرُّ يومٌ من أيّامنا دون أنْ نشكو أو نتذمّر من شيءٍ ما حولنا، فنحن نشكو من الأحوال الجوية، ومن أزمة المرور، ومن العمل، ومن تذمّر والديْنا أو أصدقائنا. ونشكو بشكلٍ موسّع أكثر حين تتوسّع دائرة اهتماماتنا أو انتباهنا لما يحدث في العالم من حروب وكوارث سياسية وطبيعية واقتصادية، وغيرها الكثير الكثير.
بشكلٍ عام، تعبّر الشكوى عن عدم الرضا والاستياء، ويتمّ التعبير عنها لفظيًّا باستخدام اللغة. وبما أنها سائدة بشكلٍ واسع وكبير، فقد جذبت اهتمام العديد من دارسي علم نفس الشخصية وعلم النفس الاجتماعيّ، نظرًا لأنها غالبًا ما تكون على مستوى الأفراد والجماعات، أو أنها تتطلّب على الأقل علاقة من شخصين اثنين يقوم أحدهما بالتعبير عن شكواه للآخر. وهذا لا يمنع من أنّ الكثيرين يميلون أيضًا للحفاظ على شكواهم وتذمّرهم لأنفسهم دون مشاركتها مع الغير. فكيف نفهم هذا السلوك من وجهة نظر علم النفس، متى يحدث ولماذا؟
لماذا نشكو ونتذمّر؟
عادةً ما تحدث الشكوى في أعقاب المواقف السلبية كأنْ تكون حركة المرور أسوأ من المتوقع، أو تكون العلامة التي حصلت عليها في الامتحان دون المستوى الذي تطمح إليه، أو أنْ يكون الفيلم الذي شاهدته مخيّبًا للآمال. ما يعني أنّ المواقف غالبًا هي ما تحدّد حدوث الشكوى أم لا. ومن جهةٍ ثانية، تلعب عوامل الشخصية دورًا كبيرًا في ذلك، ويكون دورها واضحًا بشكلٍ جلّي في أنّ بعض الأشخاص يميلون إلى الشكوى العلنية، بينما يحتفظ الآخرون بشكواهم لأنفسهم.
وفي أبسط إيجابيّاتها، تعمل الشكوى بمثابة وسيلة للتنفيس أو التفريغ. فمن خلال التعبير عن النفس وما يساورها من قلق وتوتّر وإحباط، قد يكون من الممكن جدًا التخفيف من حدّة ذلك الإحباط والتوتّر. ومن وجهة نظر روبن كوالكسي، أستاذة علم النفس في جامعة كليمسون، فيمكن أنْ تعمل الشكوى كأداة لكسر الجليد المتراكم في النفس، تمامًا كما تساعد في تكوين انطباعٍ ما عن الشخص أمام الآخرين، أو تدعوهم لمساءلة سلوكيّاتهم وتصرّفاتهم.
الشكوى الفعّالة هي تلك تخرج عندما يعتقد أصحابها أنهم سيحقّقون النتائج المرجوّة منها بصورة إكثر إنتاجية
فقد توصّلت الدراسة التي نشرتها كواكسي مع زملائها في مجلة علم النفس الاجتماعي عام 2014 إلى أنّ ثمّة فروقات مهمّة في أنواع الشكاوى التي يقوم بها الناس، لكنّ أكثرها فعالية هي تلك التي تساعدهم في التعامل مع مشاكلهم بصورة أكثر إنتاجية. وبالتالي، فالشكوى الفعّالة هي التي تخرج عندما يعتقد أصحابها أنهم سيحقّقون النتائج المرجوّة منها.
فيما تركّز الدراسة على ضرورة الاعتدال في الشكوى واختيار الجمهور أو الطرف الآخر بعناية فائقة. فبحسب وصفها فإنّ المستمع الخاطئ قد يجعل الشخص المشتكي أكثر غضبًا أو أكثر انزعاجًا. ما يعني أنّ عليك البحث دومًا عن شخصٍ تشعر بالراحة معه وتتأكد من دعمه لك في شكواك، سواء كنتَ تبحث عن فرصة للتنفيس عمّا في صدرك حتى تتمكّن من تجاوزه، أو كنت تبحث عن حلٍّ أو مشورةٍ ما. كما تلعب الشكوى دورًا جوهريًا وأساسيًّا في علاج الصدمات النفسية أو خلال الأحداث العصيبة.
تعمل الشكوى بمثابة وسيلة للتنفيس أو التفريغ. فمن خلال التعبير عن النفس وما يساورها من قلق وتوتّر وإحباط، قد يكون من الممكن جدًا التخفيف من حدّة ذلك الإحباط والتوتّر
وقد يشكو أشخاص آخرون كوسيلة لصياغة أو تعزيز هوياتهم؛ فهم يستخدمون شكواهم للتلاعب بالطريقة التي ينظر بها الآخرون إليهم، وهي ظاهرة تُسمّى في علم النفس بمصطلح “إدارة الانطباع”. فعلى سبيل المثال، قد تجد نفسك على طاولة الغداء مع عددٍ من أصدقائك فيما يقوم واحدٌ منهم بالشكوى من نوعية الطعام أو جودته. في الحقيقة، قد يكون هدفه بالنهاية هو أنْ يخبر من حوله بأنه صاحب معايير عالية في الطعام والتذوّق والمطاعم وما إلى ذلك.
على جانبٍ آخر، يتحدث الطبيب النفسيّ الأمريكيّ إريك بيرن، صاحب نظرية التحليل التفاعلاتي لفهم تركيب النفس البشرية، في كتابه “الألعاب التي يلعبها الناس” عن ما يسمّيه بنمط التواصل “نعم.. ولكن!”، حيث يقوم شخصٌ ما بالتعبير أو الحديث عن مشكلته وشكواه، ليستجيب له شخص آخر من خلال تقديم الاقتراحات حول كيفية حلّها وتجاوزها، ليقول الأول “نعم، ولكن…!”، ويستمر الثاني في تقديم الاقتراحات والحلول الممكنة فيما يستمرّ الأول باستدعاء الموانع وتصعيب الحلول من خلال استمراره في قول “ولكن!”.
يصف بيرن أنّ غرض هذا الحوار ليس حلّ المشكلات وإيجاد الحلول الممكنة واللازمة، وإنما يهدف الشخص الشاكي منه لاكتساب التعاطف في مشكلته وعدم قدرته على حلّها أو تجاوزها من الآخرين المحيطين به، وهو بذلك ينتمي إلى دائرة من الأشخاص يعرّفهم علم النفس بمصطلح “أصحاب الشكوى الذين لا يبحثون عن مساعدة”.
ماذا يحدث حينما لا نشكو؟
تقودنا تلك الفوائد الإيجابية للشكوى لطرحِ سؤالٍ مهمّ عن الأشخاص الذين يفضّلون بالاحتفاظ بالشكوى لأنفسهم؛ فهم إمّا يجدون طرقًا أخرى للتنفيس غير التعبير عن استيائهم وإحباطهم، أو أنّ قمعهم للشكوى سيؤدّي إلى نوعٍ من السلوكيّات السلبية العدوانية، وهي ذلك النوع من السلوكيات والتصرفات التي يقوم بها الأفراد كتعبير عن شعور سلبيّ لكن بأساليب عدوانية غير مباشرة؛ مثل إلقاء النكات العدائية والعناد والعبوس واللامبالاة أو تسويف إنجاز المهام أو الفشل في أدائها، وهكذا.
فعلى سبيل المثال، تخيّل أنّك تواجه مشكلةً في عملك في الوقت الذي طلب فيه مديرك منك إنجاز مهمّة ما. نظرًا لأنّك هنا عاجزٌ عن التعبير عن شكواك بخصوص مشكلتك، فإنّك قد تسلك سلوكًا سلبيًا بشكلٍ غير مباشر وغالبًا دون وعيٍ منك، كأنْ تؤجّل إتمام المهمّة حتى اللحظة الأخيرة، ظنًّا منك أنّك تعاقبك مديرك الذي كلّفك بالمهمّة أو أنّك تفرغ غضبك على العمل بمماطلتك هذه.
قد يؤدي قمعك للشكوى إلى سلوكٍ سلبيّ عدوانيّ، أي تعبيرك عن المشاعر السلبية بأساليب عدوانية غير مباشرة
أمّا عن الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا النوع من السلوكيات فيرجع بشكلٍ كبير إلى أساليب التنشئة التي ترعرع عليها الشخص والتي تكون في أغلب الأحيان مثّبطة للتعبير عن المشاعر أو لا تسمح به. وحين يشعر الشخص أنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره الحقيقية بشكل أكثر انفتاحًا، فقد يجد بعض الطرق البديلة لتوجيه غضبه أو إحباطه ولكن بشكلٍ سلبيّ وعدوانيّ. من جهةٍ ثانية، قد يلجأ آخرون لتجنّب الشكوى كنوعٍ من الكسل والرغبة في سلوك الطريق الأسهل للتعامل مع الأحداث دون الحاجة إلى مواجهة مصدر الإحباط والاستياء الذي تسبّبه.
ما يعني أنّ الشكوى بالنسبة للكثيرين هي طريقة للتعبير عن النفس على أمل التنفيس عن جزءٍ ممّا يعتريها أو أنْ يدرك شخصٌ ما مشكلتك أو معاناتك فتجد بعضًا من التعاطف والاهتمام. وبمجرّد تحقيق ذلك، يشعر المشتكي ببعض الرضا فيُنهي شكواه. بالنسبة لآخرين كثر، فإنّ شكواهم دومًا مستمرة بغض النظر عن أيّ شيءٍ آخر أو أيّ تدخل من قَبل الآخرين. إذ تصبح الشكوى عندهم طريقةً للحياة يسعون من خلالها تحقيق الرضا على الرغم من علمهم المسبق بعدم نجاحهم في أغلب الأحيان.
بالمحصلة، ربما تكون الكلمات المنسوبة إلى الباحث والراهب البوذي في القرن الثامن شانتيديفا بمثابة تلخيصٍ جيّد للفائدة المرجوّة من الشكوى: “إذا كان يمكنك تغيير شيء ما، اعمل على تغييره. إذا لم تستطع ذلك، فلماذا تقلق أو تنزعج أو تشكو؟”