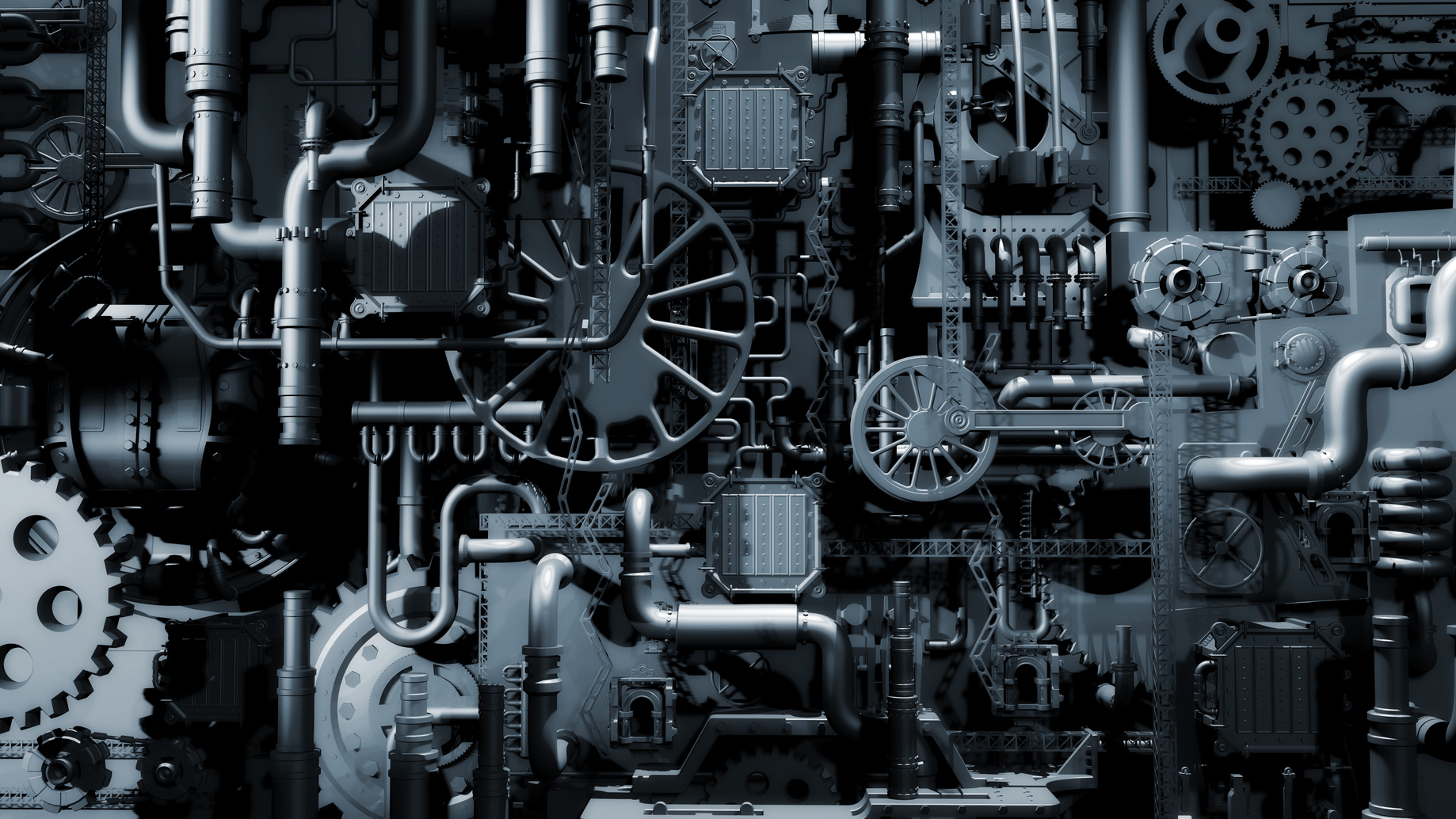لم يتغيّر مشهد العمل والقوى العاملة في الفترة الأخيرة وحسب، بل تغيّر معها الكثير من مفاهيمنا عن أنفسنا وذواتنا والحياة بمختلف مجالاتها. وما نقصده بالفترة الأخيرة هنا ليس العقود الأخيرة فقط، فالمشهد آخذٌ بالتغيّر منذ الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر وما صاحبته من توسّع أخذ بالازدياد مع الوقت في خيارات المهن والوظائف.
ولو أردنا تلخيص التغيّر في المشهد ذاك لربما وجدنا أنّه حدث باتجاهين اثنين؛ فمن جهة أصبحت الوظائف مؤتمتة أكثر فأكثر، لا سيّما بدخول الآلات والروبوتات وتوغّل الذكاء الاصطناعي بالمجالات جميعها. ومن جهةٍ ثانية، ظهرت الوظائف الإبداعية في كلّ مكان، أي تلك التي تعتمد على القدرات الفكرية والإدراكية للفرد مثل تطوير البرمجيات والتسويق والتصميم والهندسة والكتابة الصحفية وصناعة الأفلام وغيرها الكثير.
تعامل وظائف العصر الحديث الإنسان كآلةٍ محدّدة المهام يمكن من خلال زيادة عملها ووقته تحقيق الكفاءة القصوى
وفي حين يعتمد النوع الأول من الوظائف على المهامّ المتكرّرة والروتينيّة حيث زيادة العمل وجهده يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والأرباح وتحقيق الأهداف، إلّا أنّ النوع الثاني بقي معتمدًا على التفكير الإبداعيّ الذي هو منتجٌ لعقل الإنسان لا يده أو جسده، ما يجعل من مجرّد الاعتماد على الجهد وساعات العمل أمرًا غير كافٍ لزيادة الإنتاجية وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
لا نبالغ إنْ قلنا أنّ وظائف العصر الحديث تعامل الإنسان كآلةٍ محدّدة المهام يمكن من خلال زيادة عملها ووقته تحقيق الكفاءة القصوى دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ الدماغ البشريّ لم يصمّم كما الآلة ليكون قادرًا على التركيز التامّ بمهمّةٍ ما ويحقّق كفاءته القصوى فيها.
بكلماتٍ أخرى، لم يصمّم الدماغ البشريّ ليصبّ جهده وطاقته جميعها في مهمّة واحدةٍ فقط. وإنْ حدث ذلك من خلال استبعاد المهامّ الأخرى في الحياة أو إهمالها، فستكون التكاليف مرهقة نوعًا ما. ما يعني أنّ الوظيفة قد تكلّفك في جانبٍ آخر من الحياة، زواجك أو عائلتك أو تنشئتك لأطفالك أو علاقاتك الاجتماعية أو هواياتك أو بحثك عن الراحة والاسترخاء، وغيرها.
نتيجةً لذلك، أصبحت الدراسات والأبحاث النفسية في الآونة الأخيرة تركّز على مفاهيم مثل تحقيق التوازن بين العمل والحياة من باب أنّ الموظّفين الأكثر سعادةً في حياتهم هم الموظّفون الأكثر إنتاجية، أو أنّ الموظفين السعداء يميلون إلى التمسك بنفس الشركة أو الوظيفة لفترة أطول، وأيّ عناوين بحثية أخرى من هذا القبيل.
يرى البعض أنّ ما يمكن أنْ يسمّى توازنًا ليس سوى محاولات لتحديد الأولويات وترتيبها وفقًا لأهمّيتها أو أيّة عوامل أخرى تتداخل معها
ثمّ خرجت لنا المحاضرات والمقالات التي تدعو في خطواتٍ محدّدة كيف يمكن للشخص العامل أن يبرمج نفسه ويساعدها ليخلق نوعًا من التوازن، وبكلماتٍ أكثر تحديدًا فالحديث غالبًا ما يكون حول الفصل ما بين العمل وبين أيّ جانبٍ آخر في الحياة. كأنْ تكون قادرًا على التوقّف عن التفكير في يومك السيء في العمل وتغيّر من حالتك المزاجية بمجرّد خروجك من المكتب، أو أنْ تنسى مشاكلك وأمورك الشخصية والإنسانية بمجرّد ذهابك للعمل لتستطيع التركيز على مهمّتك فقط ثمّ تعود لتلك المشاكل مجدّدًا بعد انتهاء دوامك.
ولنحدّد فكرتنا بشكلٍ أوضح، فما يُسمّى بالتوازن بين العمل والحياة قد يكون أمرًا غير قابل الحدوث في معظم الأوقات والحالات. فمن جهة، يرى البعض أنّ ما يمكن أنْ يسمّى توازنًا ليس سوى محاولات لتحديد الأولويات وترتيبها وفقًا لأهمّيتها أو أيّة عوامل أخرى تتداخل معها أو وفقًا للقيم التي يبني الشخص عليها حياته مثل العائلة أو الأصدقاء أو التطوّع أو الرياضة أو السفر.
خيارات ورغبات كثيرة ووظيفة تأكل يومك
من جهةٍ ثانية، يعتمد البعض في رأيه على الفلسفة الوجودية التي ترى أنّنا سنبقى مطالبين بالاختيار واتّخاذ القرارات المُثلى ومحكومين بالخوف من الالتزام والتقيّد بها. هذه هي المعضلة التي تكمن في قلب الوجودية؛ القرار لا يعني أبدًا تحقيق الذات بل نكرانها. فعند اختيارك لقرارٍ ما فإنك ترجّح احتمالًا وترفض احتمالًا آخر. وبتعبير جون ماكوري فالقرار هو “مخاطرة حرمان المرء من ممكنات أخرى كانت معروضة أمامه. إنه رهان وتعهد بالمستقبل، تعهد محفوف بالمخاطر ومصحوب بالقلق”.
أيْ أنّنا سنبقى دومًا نعاني من اختياراتنا وقرارتنا، لا شيءٍ سوى لأنّ ذلك هو منهج الحياة بشكلٍ عام. غيرَ أنّ شكل الحياة الحديثة يُملي علينا العديد من الخيارات الكثيرة والمتعدّدة، في جميع المجالات تقريبًا، ما يجعل من الناس يجدون صعوبةً في اختيار أيّ شيءٍ.
لنفترض الآتي: أنتَ تُمضي 8 ساعات على أقلّ تقدير من يومك في العمل لتخرج بعدها وأنتَ تتساءل ما الذي يمكنك فعله في بقية يومك، هل تزور أهلك أم تخرج مع أصدقائك أم تشاهد فيلمًا أو تذهب للتسوّق أو تمارس الرياضة واليوجا. أمّا في عطلة نهاية الأسبوع فستجد نفسك واقعًا تحت وطأة خياراتٍ أكثر، هل تمضيها في البيت أم تخرج برحلةٍ قصيرة أم تمارس هوايتك المفضّلة.
مع تفكيرك الدائم بعدم امتلاكك للوقت الكافي لفعلِ أيٍّ من تلك النشاطات، يخضع دماغك تحت عبء الاختيار أو “مفارقة الاختيار” كما يُشير إليها عالم النفس الأمريكي باري شوارتز في كتابه “مفارقة الاختيار” الذي يرى فيه أنّ الناس في هذا العصر يمتلكون خياراتٍ أكثر من قبل ما يجعل منهم أقلّ رضىً من الذين عاشوا قبلهم بعقودٍ قليلة فقط. فهم يرغبون بوظيفةٍ جيدة وراتب ممتاز وجسمٍ رياضيّ وعلاقات اجتماعية صحية وفعّالة وأسرة مستقرة وسعيدة وتحصيل شهادةٍ دراسية مرموقة ومكانة اجتماعية عالية، إضافةً لوقت الفراغ والاسترخاء الذي يرغبون بقضائه مع أنفسهم أو عائلاتهم.
دائمًا ما يشعر الناس أنّهم يتخلّون عن الكثير من الخيارات مقابل خياراتٍ أخرى يتعرّضون لها بشكلٍ مستمر، وهو ما يجعلهم أقلّ تيقّنًا وتأكدًا ممّا يختارونه أو من منفعته وجدواه
يُرجع شوارتز السبب إلى أنّ الناس الآن دائمًا ما يشعرون أنّهم يتخلّون عن الكثير من الخيارات مقابل خياراتٍ أخرى يتعرّضون لها بشكلٍ مستمر، وهو ما يجعلهم أقلّ تيقّنًا وتأكدًا ممّا يختارونه أو من منفعته وجدواه. فالواحد منّا ليس متأكّدًا أساسًا من أنه اختار الوظيفة المناسبة، ولا يعرف ما يجب عليه فعله بعد انتهاء دوامه أو في عطلة نهاية أسبوعه أو في الأعياد أو فيما يقضي وقت فراغه وكيف يملؤه. عوضًا عن ذلك، يرى شوارتز أنّ إنسان العصر الحديث أصبح يمتلك أسقف توقعّاتٍ عالية ممّا يمكنه فعله وإنجازه في الحياة دون أنْ يستطيع الوصول إليها أبدًا.
ما الحلّ إذن؟
ربّما يجب علينا التوقّف عن السعي نحو حياة مثالية يحكمها التوازن بين العمل وباقي الجوانب، فجميعها تتداخل ببعضها شئنا أم أبينا. عوضًا عن أنّنا فعليًا نحيا في عالمٍ تحكمه قوانين السوق والاقتصاد والمواعيد النهائية والعمل الآليّ الذي يستخفّ بعقل الإنسان ويحاول اختزاله وقولبته ليصبح شبيهًا بعقول غيره ويشغله السؤال عن كيف أضاع يومه كما أضاع أمسه كما سيضيع غده بين جدران المكاتب الزجاجية والمفتوحة.
ومن هنا، العمل لا ينفصل عن الحياة والحياة لا تنفصل عن العمل. أمّا كيف يمكن للفرد إخراج نفسه من هذه الدوّامة الصعبة والمرهِقة للذات والنفس فيكمن في إيجاد نوعٍ من التناغم بين أوقاته تبعًا لطاقته وقدرته مع الإيمان المُطلق والكامل بطبيعة الحياة وفوضوية العالم المفروضة علينا جميعًا دون أيّ إرادةٍ منّا.
قد يكون الحلّ الأمثل والأكثر واقعيةً وصحةً في ترتيب الأولويات كما قلنا سابقًا، ومن ثمّ تقسيم الوقت بحسب ذلك الترتيب والظروف التي نحن فيها. ربّما ساعتها فقط نستطيع أنْ نحمي نفسيّاتنا وحالاتنا المزاجية من الألم النفسيّ والعقليّ الناتج عن التفكير في تحقيق التوازن وخلقه أو حتى من التفكير في سلبية وظيفتك وكيف أنّها تسلب جلّ وقتك وتسحق قدراتك الإبداعية والفكرية وتجعل منك مجرّد روبوت يقوم بعمله وحسب.