عن جانب لا نعرفه من حياة عمر الخيام
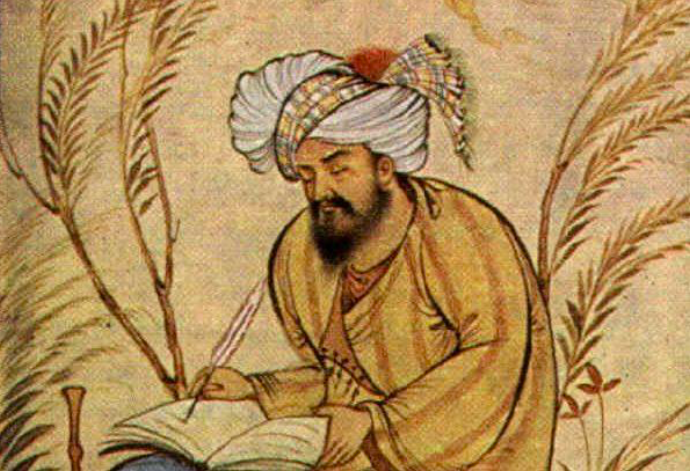
“أفق خفيف الظل هذا السحر.. نادى دع النوم وناغ الوتر.. فما أطال النوم عمرًا ولا.. قصر في الأعمار طول السهر”.. كانت هذه الأبيات التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1951 أحد النوافد الواسعة التي تعرف العرب من خلالها على الشاعر الفارسي عمر الخيام.
ورغم ما تحمله تلك الكلمات التي ترجمها الشاعر أحمد رامي من معاني الفلسفة والروحانية والتصوّف في بعض الأحيان فإن صورته الموضوعة على زجاجات النبيذ الذي سمّي باسمه، ما زالت تخيم على مخيلة شريحة أخرى ربطت بينه وبين معاني المجون والسكر.
وبين رباعياته التي خلدت اسمه كواحد من أفضل من كتب هذا النوع من الشعر في التاريخ الإسلامي ونبيذه الذي وضعه في صورة مخلة في مخيلة آخرين، هناك جانب خفي في حياة الرجل ربما لا يعرفه الكثيرون، قادر أن يعيد رسم تلك الصورة الذهنية التي أخذت عنه وحادت عن الحقيقة في كثير من مساراتها.
اليوم يحتفي مؤشر البحث العالمي “جوجل” بذكرى ميلاد الشاعر المسلم والعالم الشهير، الذي يوافق 18 من مايو عام 1048، الأمر الذي يدفع إلى تسليط الضوء على الجانب الخفي من حياة أحد أبرز من قدموا إسهامات جليلة في مجال العلوم والرياضيات، وذلك بعد ما يقرب من مرور 971 عامًا على مولده.
نشأة أرستقراطية
ولد غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام الشهير بعمر الخيام في مدينة نيسابور، شمال إيران، لوالد كان يعمل طبيبًا، تلقى تعليمه على يد عالم الرياضيات باهمانيارين مرزيان الذي تتلمذ على أعتاب الفيلسوف ابن سينا، ونجح في تقديم تعليم شامل للطالب المجتهد في العلوم والفلسفة والرياضيات في آن واحد.
والده الشغوف بالعلم لم يكتف بتلك العلوم فحسب، بل أوكل إلى العالم الخواجي الأنباري بتدريس علم الفلك لولده، الذي لقنه نظرية “مجسطي بطليموس” وهي عبارة عن أطروحة رياضية فلكية، ليشبع عمر بجرعات مكثفة من العلوم المختلفة أثقلت شخصيته خاصة أنها كانت على أيدي كبار العلماء في عصره.
تعد الرباعيات الشعرية التي ألفها الخيام واحدة من أشهر الرباعيات في التاريخ الإسلامي، تلك المقطوعات الشعرية التي حققت شهرة عالمية في مختلف أنحاء العالم، خلدت اسمه بين قوائم الأدباء والشعراء الكبار على مر العصور
عمل الخيام في سن مبكرة مع والده في الجراحة وتعلم على يديه الكثير من علوم الطب، إلا أن الموت الذي غيبه سريعًا في 1066 كان نقطة تحول في حياة عمر الذي كان عمره في هذا الوقت 18 عامًا، ليواجه العالم الصغير مصاعب الحياة مبكرًا قبل أن يكمل مراحل تعليمه المختلفة.
نشأته الأرستقراطية المرفهة بعض الشيء دفعته لتكوين صداقات قوية بشخصيات ذات أهمية ومكانة كبيرة في هذا الوقت، إذ قضى معظم أيامه بين بلاطي السلطان القراخاني والسلجوقي، وكان له اثنين من الأصدقاء اللذين لعبا دورًا محوريًا في التاريخ الإسلامي، نظام الملك والحسن الصباح، لكنه نأى بنفسه عن صراعاتهما وآثر التفرغ لعمله وشعره.
وفي الـ4 من ديسمبر 1131 توفي عمر الخيام عن عمر ناهز الـ83 عامًا، ودفن في إحدى المقابر القابعة بمحيط بستان وفق ما طلبه هو قبل وفاته، مخلدًا خلفه سيرة حافلة عرفها الأوروبيون قبل العرب، ممن بادورا بترجمة أعماله وإبداعاته منهم السير إدوارد فيتزجيرالد الذي ترجم رباعياته إلى الإنجليزية.

أعمال الخيام الشعرية دفعت الأوروبيين لترجمتها
الرباعيات الأشهر في التاريخ الإسلامي
تعد الرباعيات الشعرية التي ألفها الخيام واحدة من أشهر الرباعيات في التاريخ الإسلامي، تلك المقطوعات الشعرية التي حققت شهرة عالمية في مختلف أنحاء العالم، خلدت اسمه بين قوائم الأدباء والشعراء الكبار على مر العصور، وكانت سببًا رئيسيًا في ولع الكثير من المستشرقين بالعرب وتاريخهم الأدبي.
وتشير الرباعية إلى مجموعة من المقطوعات الشعرية المترابطة التي تعكس حالة شعرية محددة، تميز بها الخيام، وكانت سببًا في شهرته رغم إسهاماته في العديد من المجالات الأخرى كما سير ذكره في موضع آخر، غير أن العديد من علامات الاستفهام أحيطت بشأن عدد الرباعيات المنسوبة له.
فبعض المصادر تذهب إلى أن عدد الرباعيات الفعلية التي كتبها الشاعر الفارسي لا تتجاوز مئتي رباعية، فيما ذهب آخرون إلى أن العدد يتخطى حاجز الألفين، وهو ما دفع بعض خبراء الشعر وعلماء التاريخ إلى تقديم بعض الشواهد والأدلة التي استطاعوا من خلالها تقسيم الرباعيات التي نسبت للخيام إلى 3 أنواع.
الأول: الرباعيات التي تتحدث عن الزهد والحاجة وتجسيد معاناة العوز، وهي النوعية التي استبعدها الكثير من النقاد نظرًا لما كان يتمتع به الشاعر من منزلة اجتماعية مرموقة في عصره، فالحياة المرفهة التي عاشها الرجل يستحيل معها كتابة هذا النوع من الشعر الذي يخرج من رحم الحاجة والفقر.
الثاني: الرباعيات التي تستخف بالكائنات والقدر وتحث على اللجوء للحانات وغيرها، ومثلها مثل النوع الأولى استثناه دارسو حياة الخيام ومسيرته الشعرية، إذ عرف عنه الأخلاقيات العالية وحصوله على العديد من الألقاب آنذاك مثل حجة الحق وهو لقب يعادل حجة الإسلام، وكانوا يطلقون على الخيام أيضًا لقب الإمام وهو لقب كان يطلق على من يتصدر الملأ في العلم والحكمة، ومن ثم من الصعب لرجل يحمل هذه الشيم أن يكتب شعرًا يدعو للمجون ويسخر من القدر.
أما النوع الثالث فهو الذي يحاول الإجابة عن أسئلة الكينونة والوجود، ويتسم بالبعد الفلسفي، ويحث على الصدق والعدل والصبر وخدمة الإنسان، وهو النوع الذي يرجح المؤرخون نسبته إلى الخيام الذي طغت سماته الفلسفية على كثير من مراحل حياته، فأثرت تربته الشعرية وامتزجت بمكنونه العاطفي.
عالم الجبر والهندسة والفلك
بعد أشهر قليلة من وفاة والده انتقل عمر إلى مدينة سمرقند في أوزبكستان، وهناك بدأ في دراسة علم الجبر بعد أن اكتشف صديق والده الذي كان يعمل حاكمًا للمدينة وقتها، موهبته في هذا العلم، فأوكل إليه وظيفة خزانة الملك ليكون مسؤولًا عن حسابات الدولة المالية.
حقق الخيام نجاحات كبيرة في دراسته للجبر، منها استنتاجه أنه غير ممكن حل المعادلات التكعيبية باستخدام الأدوات الهندسية اليونانية القديمة المعتادة في ذاك الوقت، وأكد أن هناك طرقًا أخرى قد تكون أكثر فعالية، وفي عام 1070 وحين كان عمره لم يتجاوز 22 عامًا ألف كتابه الذي حمل عنوان “دراسة حول مظاهر مشاكل الجبر والموازنة”.
طوّر الخيام التقويم الذي كان معمولاً به في هذا التوقيت، حينما وجد أن طول السنة الاستوائية 365.2422 يومًا، الأمر الذي دفع السلطان لاعتماده واستمر حتى القرن العشرين
يعد هذا الكتاب واحدًا من أهم المراجع في علم الجبر حتى الآن، وفيه قدم الخيام شرحًا وافيًا لكيفية حل المعادلات التكعيبية، وأثبت أنها من الممكن أن يكون لها أكثر من حل واحد، كما شرح في الكتاب الطرق التي يمكن من خلالها إعطاء حلول هندسية للمعادلات التكعيبية.
وفي الـ26 من عمره، كلفه حاكم أصفهان بإدارة المرصد الفلكي للمدينة وذلك عقب زياته التي دُعي إليها لبلاط ملك شاه حاكم السلجوقيين، وكان عمر ضمن حاشيته المقربة وتمتع بشهرة كبيرة في ذاك الكون بكونه على دارية كبيرة بعلم الفلك والتنجيم.
ظل الخيام في وظيفته الجديد قرابة 30 عامًا كاملة، استطاع خلالها أن يحقق بعض الإسهامات المحورية في علم الفلك، حيث طوّر التقويم الذي كان معمولا به في هذا التوقيت، حينما وجد أن طول السنة الاستوائية 365.2422 يومًا، الأمر الذي دفع السلطان لاعتماده واستمر حتى القرن العشرين.
لم تقف إسهامات شاعر الرباعيات عند هذا الحد وفقط، بل نجح بفضل جهوده في علم الهندسة ومحاولة التطوير في المسلمات الهندسية الخمسة الشهيرة حينها، في تأسيسه لفرع جديد بعلم الرياضيات يُطلق عليه “الهندسة اللاإقليدية” وهي المقابل للهندسة الإقليدية.
وفي المجمل.. لم يكن عمر الخيام شاعرًا وفقط كما يظن البعض، كما أنه لم يكن صاحب دعوات المجون والانفلات والسكر كما استقر في أذهان الكثير، إذ إن جل حياة الرجل قضاها مترجلاً من علم لآخر، ومن مدينة لأخرى، طالبًا المزيد من التعلم، وهو ما تثبته إسهاماته المتعددة في شتى فروع العلم.