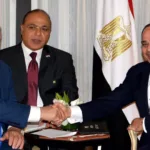لم يمضِ وقت طويل على بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى تعرض المجتمع الفلسطيني المسيحي في قلب القطاع لأول استهداف مباشر، إثر قصف إسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس فجر 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متسبّبًا في استشهاد 20 شخصًا، بينهم 18 مسيحيًا، كانوا جميعًا يحتمون بالظلال الدينية للمكان وما بدا لهم من حرمة استهدافه.
سبق ذلك استهداف آخر للمستشفى العربي المعمداني المجاور قبل يومين، والذي يتبع للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس، فيما اُعتبر المجزرة الأولى في الحرب حيث خلف الهجوم الإسرائيلي 471 شهيدًا.
على مدى أشهر الحرب التي تجاوزت الـ 14 شهرًا، واصل الاحتلال سرًّا وجهرًا استهداف المسيحيين في قطاع غزة، في محاولة لانتزاع ما تبقى منهم، وإنهاء أي علاقة لهم بأرض فلسطين، والسيطرة الكاملة على المكان وتاريخه ومستقبله، بما يخدم رؤيته لدولة “يهودية خالصة”.
تسلط السطور التالية الضوء على العلاقة المتشابكة بين مسيحيي الأرض المقدسة والقضية الفلسطينية، والتي استدعت في أحد أوجهها تماهيًا بين الاحتلال والكنائس المسيحية الغربية على حساب المجتمع المسيحي الفلسطيني، أما في وجهها الآخر فقد شهدت إبادة تدريجية عبر التطهير العرقي أو التهجير القسري، وهو ما بدأت معالمه بالظهور مع نهاية العام المنصرم.
“أحجار الأرض الحية”
تكتسي العلاقة بين اليهودية والمسيحية على أرض فلسطين طابعًا مختلفًا تمامًا عن تلك العلاقة بين المسيحية واليهودية في الغرب، ففي الأخيرة تتيح المسيحية مساحات واسعة ومشتركة لدعم الصهيونية، ما أدّى إلى ظهور ما يُعرف بـ”المسيحية الصهيونية” التي تدمج بين العهدَين القديم والجديد.
يؤمن أتباعها بأن قيام دولة “إسرائيل” هو بشرى لا بدَّ من السعي لتحقيقها، كما ترى أن اليهود هم شعب الله المختار، وأن فلسطين هي أرض الميعاد التي عادوا إليها بعد شتاتهم في أنحاء العالم، بناءً على وعد الله لهم في العهد القديم.
أما المسيحية الفلسطينية فترى أن وجود “إسرائيل” على أرض فلسطين احتلالًا صرفًا لا بدَّ من مقاومته، وتتبنى خطابًا مقاومًا منفتحًا على جميع الجهود الفلسطينية نحو التحرر والانعتاق، ينافس في انتمائه الوطني أشد التيارات الفلسطينية إيمانًا بالمقاومة.

يتسم هذا الخطاب بالوضوح الشديد في موقفه الرافض للصهيونية، حيث يتصدى لها لاهوتيًا، منكرًا فكرة “شعب الله المختار”، كما يدعو إلى إعادة قراءة الكتاب المقدس بطريقة تجعله أكثر توافقًا مع واقع المجتمعات وقضاياها، ويعتبر أن العدالة والتحرر هما ضرورة أساسية وقضية مركزية بالنسبة إلى الفلسطينيين، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين.
ونتيجةً لهذه الرؤية نشأ منذ بداية الحركة الصهيونية وتوجهها نحو احتلال فلسطين، حراك مسيحي فلسطيني رافض لهذا الوجود، كان منسجمًا مع الفعل الفلسطيني ومشتركًا فيه، وقد اتّسع في مراحل عديدة ليغدو حراكًا مسيحيًا مشرقيًا قادرًا على اختراق العقل الغربي لصالح الرواية الفلسطينية بأحقية الأرض وتقرير المصير.
في هذا السياق، يذكر المؤرخ عارف العارف أن المسيحيين قادوا الحراك السياسي خلال فترة الانتداب البريطاني، وأن 25-30% من النخبة السياسية آنذاك كانت منهم، بل إن بعضهم تصدر العمل العسكري، مثل أميل الغوري الذي كان أحد مؤسسي كتائب الجهاد المقدس إلى جانب آخرين مثل يوسف صهيون وفؤاد سابا، وأنطوان داوود الذي نفّذ عملية نسف مقر الوكالة اليهودية في القدس، ورجا ميشيل عيسى قائد فوج الإنقاذ.
كما تصدر المسيحيون مجالات الثقافة والإعلام والموسيقى،حيث كان من بينهم نجيب نصار مؤسس جريدة “الكرمل”، وخليل بيدس الروائي الفلسطيني، بالإضافة إلى مي زيادة وسميرة عزام وجبرا جبرا، والموسيقار سلفادور عرنيطة، والسينمائيان إبراهيم وبدر لاما، كما كانوا روادًا في العمل النقابي وتأسيس الجمعيات والمشافي والمدارس والكليات التعليمية، ولا تزال مؤسساتهم حاضرة وفعالة على الأرض الفلسطينية حتى اليوم.

جدير بالذكر أيضًا أن أماكن وجودهم انتشرت في مختلف أنحاء فلسطين، من الناصرة والجليل وصولًا إلى حيفا ويافا، مرورًا بالقدس وبيت لحم، وانتهاءً بغزة، كما أن تنوع طوائفهم كان يشمل الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك واللاتين والبروتستانت، بالإضافة إلى طوائف أصغر مثل السريان والأرمن، ما أضاف بُعدًا حيويًا وديناميكيًا متوازنًا لأنشطتهم.
ونتيجة لهذا الدور الكبير، تعرض المجتمع المسيحي في فلسطين لهجمة شرسة خلال النكبة، تسبّبت في تهجير نحو 35% من مسيحيي فلسطين، فقد قدرت أعدادهم قبل عام 1948 بحوالي 143-160 ألف نسمة، وكانوا يشكلون ما نسبته 7-11% من إجمالي السكان الفلسطينيين.
وبعد النكبة تراجعت أعدادهم بنسب كبيرة، حيث هُجّر حوالي 40 ألفًا منهم إلى الدول العربية المجاورة، خاصةً لبنان وسوريا، كما شهد توزيعهم الديموغرافي داخل فلسطين تغييرات كبيرة، فانحصروا في مناطق محدودة مثل الناصرة وحيفا ويافا، إضافة إلى بعض القرى الجبلية مثل كفر كنا وعبلين.
ومع استمرار التمييز العنصري والقيود الإسرائيلية على حرية العبادة وحقوق المسيحيين في التنقل والعمل، انخفض عددهم بشكل مضطرد، حتى وصل نهاية عام 2022 إلى 1% فقط من عموم سكان فلسطين، حيث بلغ عدد المسيحيين في فلسطين المحتلة 180 ألف مسيحي، ثلاثة من كل أربعة منهم عرب، بينما البقية هم من اليونانيين والرومان.
وبينما بقيَ منهم 50 ألفًا فقط في الضفة الغربية، انخفض عدد مسيحي قطاع غزة من 3 آلاف نسمة في بداية الحصار الإسرائيلي عام 2007 إلى 1200 نسمة فقط في منتصف عام 2023، قبل أن ينخفض عددهم إلى 750 نسمة مع بداية الحرب.
وفي الواقع، لم يعنِ التقلص المتواصل في وجود المسيحيين في الأرض المقدسة تراجعهم عن ممارسة دورهم السياسي والاجتماعي في دعم القضية الفلسطينية، لا سيما أن عمق مساهمتهم مستوحى بشكل أساسي من الكتاب المقدس، الذي يصف وجودهم وصمودهم بـ”الحجارة الحية”، ففي رسالة بطرس الأولى إلى مسيحي الأرض المقدس، يقول لهم: “كونوا أنتم أيضًا كحجارة حية تبني بيتًا روحيًا”.
هذا المفهوم المحبّب لدى المسيحيين في الشرق يتم تكراره للإشارة إلى صمودهم وعطائهم، من خلال المؤسسات التعليمية والخدماتية والثقافية والصحية، وكذلك من خلال الكنائس ومجالسها التي تقدم الدعم المجتمعي وتعزز الصمود والبقاء، وتساهم في تمتين الوجود المسيحي والدفاع عنه.
وفي كثير من الأحيان، يتجاوز هذا المفهوم الحدود الفلسطينية ليشمل المساحات المشرقية الواسعة، حيث يتم استعارته من جميع كنائس الشرق الأوسط في مصر والأردن وسوريا ولبنان، ليعبّر عن أهمية التضامن في تعزيز الوجود المسيحي المقاوم للاحتلال في الأرض المقدسة.
الوحدة الجغرافية لهذا المصطلح يعبّر عنها رئيس مجلس الطائفة الأرثوذكسية فؤاد فرح، في كتابه “الحجارة الحية”، حيث يذكر أن الهوية العربية تسبق المسيحية كهوية في قلوب أصحابها، ولهذا كان لمسيحيي الأرض المقدسة دور رائد في مواجهة أي احتلال للأرض.
كما يشير الكاتب إلى دور مسيحي مؤيد للإسلام في معركة اليرموك وفي مقاومة الجحافل الصليبية، وكذلك في دعم النسيج الاجتماعي للأمة العربية، وذلك بناءً على أصولهم التي تعود إلى قبائل غسان وتغلب وجذام، حيث يربط التاريخ بالحاضر من خلال الإشارة إلى دور المسيحيين في تأسيس لاهوت محلي متحرر، كان داعمًا ومؤيدًا للقضية الفلسطينية.
أنتجت هذه الهوية لاحقًا نَفَسًا مسيحيًا في الدفاع عن فلسطين، عبّر عن نفسه من خلال شخصيات مسيحية بارزة، مثل المطران هيلاريون كابوتشي، الذي هو من أصل سوري، وعمل لسنوات طويلة على تهريب الأسلحة بسيارته الخاصة إلى الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك حتى اكتشف الاحتلال أمره، فتمَّ سجنه ثم نفيه إلى إيطاليا، التي انطلق منها ليقود أساطيل كسر الحصار بين عامي 2009 و2010، حتى توفي في عام 2017.
ومن الشخصيات البارزة أيضًا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، الذي يواصل صراعه المستمر ضد الاحتلال والاستيطان، وله العديد من المواقف المؤيدة للمقاومة، حيث يسعى دائمًا إلى تعزيز الحق الفلسطيني في الأرض والمقدسات.
والأب مانويل مسلم، رجل الدين المسيحي الذي وقف إلى جانب المقاومة، عُرف بمواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014، بمقولته الشهيرة: “إن هدموا مساجدكم ارفعوا الأذان من كنائسنا”، كما دافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال عضويته في الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، وفتح مدارس الكنائس المسيحية لاستقبال العائلات المسلمة النازحة، كما لعب دورًا مهمًّا في الوساطة بين حركتي فتح وحماس.
وفي ميدان العمل العسكري، واصل مسيحيو الأرض المقدسة نضالهم ضد الاحتلال، حيث كان كل من جورج حبش ووديع حداد، مؤسِّسا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونايف حواتمة، مؤسس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مقدمة المشهد المقاوم.
وعلى مدار تاريخهما، شهدت كلا الجبهتين تنوعًا دينيًا وعرقيًا واسعًا من المقاومين الذين رفضوا الاحتلال واستمروا في مقاومتهم، وتواصل الجبهتان حتى اليوم مشاركتهما في النضال الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
“كايروس فلسطين”: نقطة تحول
رغم التفاعل المسيحي الفلسطيني والمشرقي الوطني والتحرري مع قضية فلسطين، والمواقف التاريخية لعدد من رجال الدين المسيحيين الذين دعموا نضال الفلسطينيين، ومن بينهم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلى للطائفة الأرثوذكسية المصرية الراحل، شنودة الثالث، الذي رفض كل محاولات الزج بالمسيحيين الأقباط في مسار التطبيع مع دولة الاحتلال، لدرجة أوصلته إلى تحدي الرئيس المصري الراحل أنور السادات، حيث رفض مباركة هرولته نحو تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، وقال إن زيارة كنيسة القيامة بوجود الاحتلال تعدّ خيانة ليسوع المسيح.
وما ينسجم مع الموقف المسيحي تجاه فلسطين، كان موقف الكرسي الرسولي (الفاتيكان) الذي تعاطى بحذر مع القضية الفلسطينية، ففي البداية أثناء النكبة اتخذ موقفًا حياديًا، لكن مع مرور الوقت أظهر اهتمامًا متزايدًا بحماية الأماكن المقدسة، خاصة بعد الدعوة التي أطلقها البابا بيوس الثاني عشر في نهاية عام 1948 لحماية هذه الأماكن.
علّق ديفيد بن غوريون، رئيس وزراء “إسرائيل” حينها، على موقف الفاتيكان قائلًا: “هناك دين رئيسي في العالم، يجب عليه أن يسوي معنا حسابًا تاريخيًا”، في إشارة إلى رفض الفاتيكان الذي اعتبره حجر عثرة أمام قبول “إسرائيل” كعضو في الأمم المتحدة، فقد طالبت حملة الفاتيكان حينها بربط عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة بضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، بالإضافة إلى الالتزام بحماية الأماكن المقدسة.
فيما رفضت السلطات الإسرائيلية طلب الكنائس بتوفير الحماية لرعاياها، صرح عدد من القادة المتطرفين، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، بأن “البصق على المسيحيين هو تقليد يهودي عتيق ومحمود”.
ظهرت على الواجهة أيضًا شخصيات تجاوزت المواقف الرسمية للتعبير عن انسجامها العميق مع القضية الفلسطينية، مثل البابا يوحنا بولس الثاني وعلاقته الوثيقة مع ياسر عرفات التي شهدت تعيينه أول بطريرك لاتيني من أصل فلسطيني وهو ميشيل صباح عام 1987، إلى جانب دعمه الصريح لجهود إقامة دولة فلسطينية وإحلال السلام في المنطقة.
وعلى خلاف العديد من الدول والأنظمة العربية، حافظ الفاتيكان على موقف متصلب وبارد تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلية، حتى توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
فقد شهدت تلك الفترة تحولًا في سياسة الفاتيكان، حيث وقّع الكرسي الرسولي عقب ذلك اتفاقية تبادل السفراء وإقامة علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، وتضمنت بنودًا تتعلق بحقوق الملكية للكنيسة الكاثوليكية والكيانات التابعة لها في الأراضي الفلسطينية، والتي لم تحظَ أبدًا بموافقة الكنيست الإسرائيلي.
بينما أبرم الكرسي الرسولي اتفاقًا مشابهًا مع السلطة الفلسطينية في منتصف فبراير/ شباط 2000، وفي الشهر التالي زار البابا يوحنا بولس الثاني الأراضي المقدسة، حيث تنقل بين القدس وبيت لحم والأردن، وتوقف مطولًا أمام حائط البراق ومتحف ياد فاشيم للناجين من الهولوكوست، وهي زيارة اُعتبرت نقلة نوعية في العلاقات بين الفاتيكان ودولة الاحتلال، مع ذلك لم تؤدِّ إلى تصديق أو اعتراف إسرائيلي بالشخصية القانونية وسلطة القانون الكنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورغم أن انتفاضة الأقصى التي اندلعت في نهاية عام 2000 أدّت إلى توتر العلاقات بين الجانبَين، حيث تم إيقاف المشاريع المشتركة الخاصة بالتاريخ اليهودي في متاحف الفاتيكان، كما أُلغيت المؤتمرات العلمية المشتركة بين الباباوية والحاخامية، إلا أن الاتجاه الرسولي الذي ساد بعد تلك الفترة كان لصالح الرواية الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية، حيث بدا الفاتيكان مفضِّلًا، في أحسن الحالات، التأكيد على موقف الحياد السلمي، بدلًا من اتخاذ موقف أكثر صرامة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
في عهد البابا بنديكت السادس عشر، هنّأ الكرسي الرسولي دولة الاحتلال بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيسها، مشيرًا إلى أن “الكرسي الرسولي ينضم إليكم في تقديم الشكر للرب على أن تطلعات الشعب اليهودي إلى وطن في أرض آبائهم قد تحققت”، كما أقدم البابا راتزينجر، عقب زيارته للأراضي المقدسة عام 2009، على إلقاء خطبة على جبل نيبو داخل الأراضي الأردنية، حيث أشار إلى “الأرض الموعودة” للشعب اليهودي، مؤكدًا الروابط المشتركة بين المسيحية والشعب اليهودي.
بسبب هذه المواقف، التي تزايدت وتيرتها في الكنيسة الغربية الكاثوليكية أو اليونانية وتماهيها مع الاحتلال الإسرائيلي، وجد مسيحيو الأراضي المحتلة أنفسهم أمام تحدٍّ كبير، إذ أصبحوا مضطرين لاتخاذ موقف حاسم يميزهم عن كنائسهم الغربية ويفصلهم عن الواقع السياسي الذي يعيشونه، سواء تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في إطار إدارة السلطة الفلسطينية.
في نهاية عام 2009، أطلق مسيحيو فلسطين وثيقة “كايروس فلسطين”، التي دعت مسيحيي العالم إلى دعم نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث أشرف على تنقيح وإعداد هذه الوثيقة مجموعة من رجال الدين المسيحي البارزين، مثل الأب عطا الله حنا، والقس متري الراهب، والقس نعيم عتيق، والأب جمال خضر، في حين برز رفعت قسيس منسقًا وناطقًا باسم الوثيقة، وقد حظيت الوثيقة بتوقيع أكثر من 3 آلاف شخصية مسيحية فلسطينية.
الوثيقة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المسيحية، حيث دعت الكنائس الغربية إلى الدفاع عن القدس، وأعلنت عن ضرورة حماية المدينة المقدسة، كما وصفت “إسرائيل” بالاحتلال العسكري والخطيئة التي لا تغتفر إلا بتحقيق سلام عادل والمساواة بين جميع الشعوب، وعبّرت الوثيقة عن دعمها للمقاومة الفلسطينية، معتبرة إياها واجبًا وحقًّا لجميع الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.
كما طرحت الوثيقة حلًّا يركز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كشرط أساسي لإنهاء المقاومة، معتبرةً أن إنهاء الاحتلال يجب أن يكون الخطوة الأولى وليس العكس، كما رفضت الوثيقة اللاهوت التوراتي المؤيد للصهيونية، خصوصًا فكرة “شعب الله المختار”، معتبرةً إياها تحريفًا لمفهوم “حب الله وعنايته” التي يجب أن تشمل جميع الشعوب والأفراد دون استثناء.
كذلك أعلنت الوثيقة تأييدها الكامل للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، داعية إلى العصيان المدني وضرورة الدفاع عن الحياة والحرية والأرض، بالإضافة إلى دعمها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS)، واستنكارها لفكرة “الدولة اليهودية أو الدينية” في فلسطين.
رغم رفض مجلس الكنائس العالمي تبني الوثيقة، فقد لاقت تأييدًا من عدة كيانات مسيحية بارزة، مثل تجمع قادة الكنائس في جنوب إفريقيا، ورؤساء كنيسة المسيح المتحدة (UCC) والكنيسة المسيحية (تلاميذ المسيح)، وزمالة السلام الأسقفية، وهو ما اعتبر دعمًا قويًا للفلسطينيين داخل الدوائر المسيحية، ما منحهم قوة أخلاقية وشرعية لاهوتية أكبر في مواجهة الاحتلال.

ثم في عام 2012 أعاد المنظمون تحديث الوثيقة، ونشروا نصها على موقع مجلس الكنائس العالمي، حيث وصفوا “إسرائيل” بأنها “نظام غير شرعي”، ودعوا إلى “حملات مقاطعة دولية وسحب استثمارات وفرض عقوبات” ضد الدولة اليهودية، كما صنفت الوثيقة، التي وقع عليها 60 ممثلًا من أكثر من 15 دولة، الكنائس المؤيدة لـ”إسرائيل” على أنها “متواطئة في جرائم ضد الإنسانية”، واعتبرت الصهيونية المسيحية “جريمة وخطيئة تتحدى جوهر الإنجيل”.
منذ ذلك الحين، استمر مسيحيو الأرض المقدسة في كشف الرواية الصهيونية والتصدي لها، من خلال سلسلة من المؤسسات والفعاليات التي تسعى إلى توعية المجتمع الدولي بحقيقة أوضاع الفلسطينيين بشكل عام، والمسيحيين منهم بشكل خاص، بما في ذلك التمييز العنصري، ومصادرة الأملاك واحتجازها، والاعتداءات والتضييقات التي يتعرضون لها في مواسمهم الدينية، كل ذلك في مواجهة كنائس عظمى تفضّل أن تسوي الحقوق مع الاحتلال على قاعدة القوي يربح دائمًا.
إبادة الأجراس المقدسة
رغم التأثير العميق للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والهجمات العسكرية المتواصلة على القدس والضفة الغربية التي لم تميز بين مسلم أو مسيحي، واستغلال هذه الحرب كوسيلة لتقليص الوجود المسيحي في فلسطين حتى الوصول إلى إنهائه، إلا أن هذا الجهد قد تصاعد بشكل ملحوظ قبيل اندلاع الحرب.
يوثّق القس متري الراهب سلسلة من الهجمات العنيفة التي شنّها المستوطنون ضد الطائفة المسيحية خلال العام الذي سبق الحرب، والتي شملت هجوم الشرطة الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين، حيث تم تقييد وصولهم إلى كنيسة القيامة ومنعهم من دخولها.
كما تعرضوا للتنكيل على يد المستوطنين، الذين قاموا بالبصق عليهم وضربهم وكتابة عبارات مناهضة على جدران كنائسهم وأديرتهم، بالإضافة إلى ذلك شهدت الفترة توسعًا استيطانيًا في عدد من المواقع المسيحية الأثرية، حيث تم الاستيلاء على هذه المواقع.
خلال النصف الأول من عام 2023 ارتفعت وتيرة الاعتداءات، حيث تجاوزت الحوادث 2-3 اعتداءات أسبوعيًا، وشملت هذه الهجمات اقتحام المستوطنين لعدد من الأماكن المقدسة، بما في ذلك كنيسة حبس المسيح وبطريركية الأرمن والمقبرة البروتستانتية، حيث قاموا بتحطيم محتويات أثرية، والأضرار بالصلبان وشواهد القبور، بالإضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية على الرهبان.
وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شهدت القدس وحيفا سلسلة من حوادث “البصق” التي مارسها متطرفون ومتدينون يهود ضد رجال الدين المسيحيين، أثناء مشاركتهم في الطقوس المسيحية في عدد من الكنائس والأديرة، وبلغ عدد هذه الحوادث أكثر من 21 حادثة.
وفي الوقت الذي رفضت فيه السلطات الإسرائيلية طلب الكنائس بتوفير الحماية لرعاياها، صرّح عدد من القادة المتطرفين، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأن “البصق على المسيحيين هو تقليد يهودي عتيق ومحمود”.
في تجاهل لمطالب مجلس الكنائس العالمي التي سبقت السابع من أكتوبر بـ 4 أيام فقط، والتي دعت إلى حماية المسيحيين في الأراضي المقدسة، صرّح منسق مكتب مجلس الكنائس العالمي في القدس يوسف ضاهر، قائلًا: “نشعر بالاضطهاد كمسيحيين وللمسيحية كدين في هذا البلد. هناك اضطهاد يهودي إسرائيلي يتم تشجيعه سواء من خلال إهمال الشرطة أو بالكلام الذي يصدر عن وزراء الحكومة الإسرائيلية”.
ومع هذا التصاعد في الحشد اليهودي ضد مسيحيي الأرض المقدسة، مثلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فرصة لإتمام الهدف الذي طالما سعى إليه الاحتلال: إنهاء الوجود المسيحي في منطقة من مناطق الصراع، فلجأت قوات الاحتلال إلى استهداف المسيحيين بشكل مباشر، سواء عبر ارتكاب مجازر أو من خلال قصف ناري مكثف على المحميات والكنائس في القطاع، في محاولة لإسكات آخر الأجراس المقدسة هناك وإبادتها بالكامل.
دفع ذلك جميع السكان المسيحيين في القطاع للنزوح إلى كل من كنيسة سانت بورفيريوس وكنيسة العائلة المقدسة القريبة، وهي جزء من آخر أبرشية كاثوليكية متبقية في مدينة غزة، حيث تواصل 340 عائلة غزية مسيحية الاحتماء في الكنيستَين بحثًا عن الأمان النسبي، رغم البرد والجوع والخوف.
على صعيد آخر، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها عبر صفقات مع حكومات أجنبية، وكان من أبرزها الاتفاق مع الحكومة الأسترالية التي وافقت على استقبال 1000 عائلة مسيحية من قطاع غزة، وهو ما يمكن اعتباره بداية لمخطط أكبر يهدف إلى جذب دول غربية أخرى، منها فرنسا وروسيا واليونان وإيطاليا، لاستقبال الطائفة المسيحية بحجة حمايتها.
وفي المقابل، تستمر الصهيونية في تنفيذ جزء من مشروعها الأكبر في محو الهوية الدينية المتنوعة لفلسطين، بما في ذلك إفراغ الأرض من مكوناتها المسيحية الأصيلة.
على الخط نفسه، تستمر السلطات الإسرائيلية في محاولاتها العبثية مع المسيحيين الفلسطينيين، حيث تجمع القساوسة في لقاء “ودّي” مع رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وفي الوقت ذاته تهاجم خطابات البابا فرانسيس الذي استطاع أخيرًا بعد عام وأكثر أن يعبّر عن رأيه في ما يجري بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ما يحدث يعدّ “إرهابًا” وربما “إبادة جماعية”.
وفي ظل هذا الوضع، يظلّ مسيحيو فلسطين ثابتين في موقفهم، رافضين العبث الإسرائيلي والتساوق الكنسي مع الاحتلال، فقد تنازلوا عن فرحة الميلاد التي تضاءلت أنوارها تحت وطأة العدوان، وأعلنوا استنكارهم للتهاون المسيحي العالمي في حماية المقدسات من الهجمات الإسرائيلية، رافضين حصر القضية الفلسطينية في إطار “الحرب الدينية بين الإسلام واليهودية”.
يقول القس متري الراهب في حديثه عن “حجارة الأرض الأخيرة”: “لم تنشأ المسيحية لا في روما ولا في غيرها، هي نبتة فلسطينية. وأول كنيسة شُيّدت كانت في القدس عام 30 ميلادي. وعندما تتحدث عن المسيحيين الفلسطينيين، فأنت تتحدث عن المسيحيين الذين يعيشون هنا منذ 2000 عام… في الواقع، المسيحية لم تغادر هذا البلد قط”.