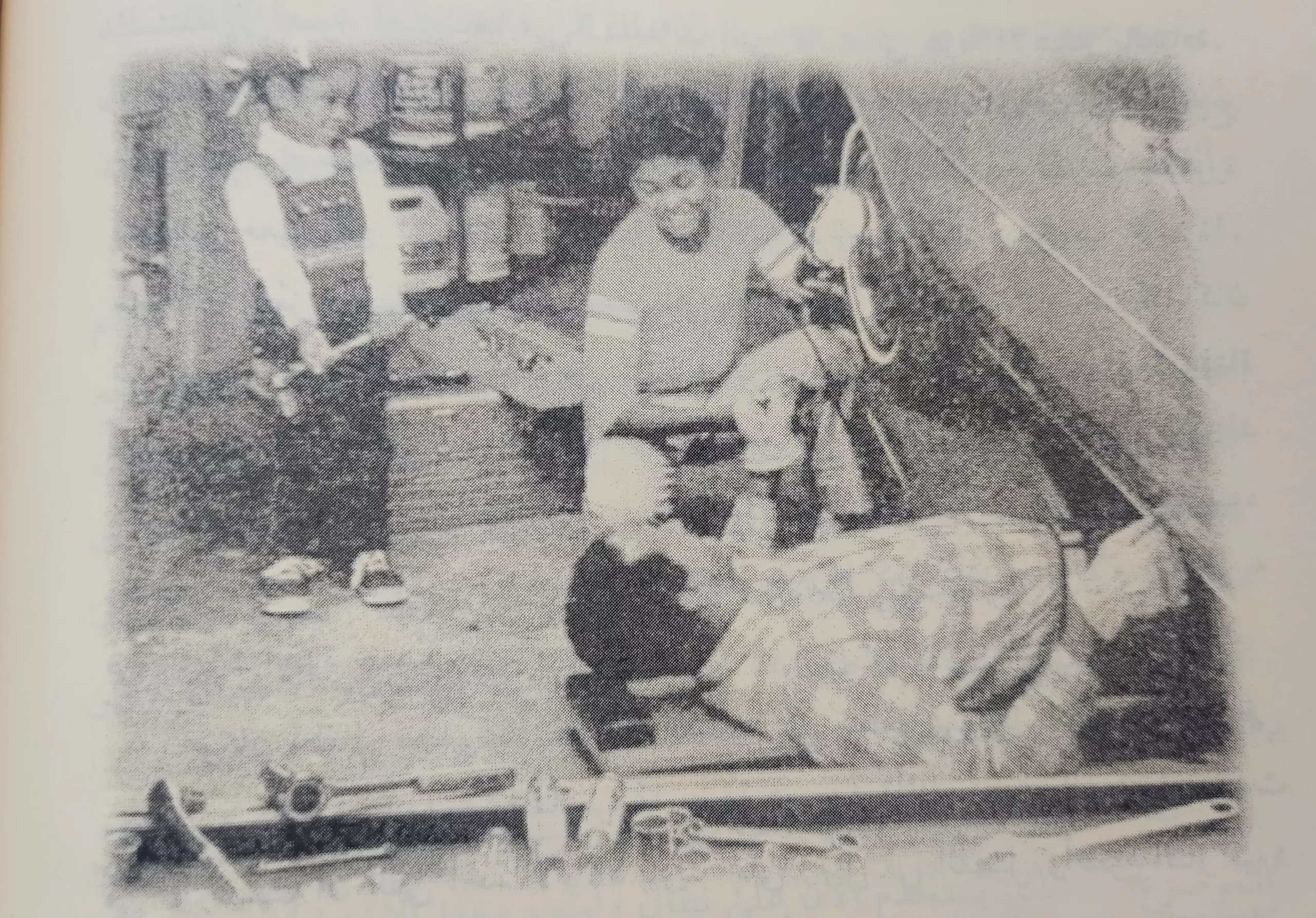حين انطلقت ثورة الكرامة في سوريا قام النظام باعتقال الأطفال، ولم تفلح كل الشفاعات لإطلاق سراحهم، وحين اشتدّت الأحداث كان يقتلهم تحت التعذيب ويعيدهم جثثًا لذويهم، ليرسل رسالة بأصعب الطرق أن لا حصانة لأحد.
وحين سقط النظام شاهدنا جميعًا كاميرا الثوار صوّرت طفلًا كأنه ذو 3 أعوام، مذهولًا يقف أمام باب الزنزانة، في أفضل السيناريوهات دخل هذا الطفل مع أمه، أي أن النظام انتهج سياسة اعتقال الأطفال، فما هو حصاد هذه الجريمة المنظمة؟ وماذا تركت للمجتمع؟
علّقت صورة الطفل المذهول أمام باب الزنزانة في ذهني لأيام، وكنت أراه كلما نظرت إلى طفلي وأعجز عن تخيل كيف رعته أمه في زنزانة؟ ماذا تفعل حين يبكي ويمرض ويغضب ويملّ ويجوع ويتسخ؟ والأهم كيف شعر وكيف كبر وهو يرى الأهوال؟ وكيف هو اليوم؟
نضال وأخوته
أسميته في عقلي نضال، ورأيتني ألتقي به، كيف سيكون؟ في محاولة لرسم صورة أقرب إلى الواقع، تحدثت مع استشاري الطب النفسي الدكتور ملهم الحراكي، المختص بعلاج الأطفال والمراهقين، وسألته كيف سيكون حال طفل قضى سنوات من أول عمره بين جدران السجن؟ أو في مركز رعاية قاسٍ بعد فصله عن أمه المعتقلة؟
بعد حديثنا تعرفت إلى ما يمكن أن يصبح عليه نضال، وقد كبر في غياهب السجن.
حرائرنا الصابرات تم تحريرهم من سجون نظام الإجرام الأسدي. pic.twitter.com/X7ACjDVy39
— ضياء قدور dyaa kaddoor (@dyaakaddoor) December 8, 2024
سيكون نضال في ظاهره طفلًا عاديًا، وما أن نتعرّفه أكثر حتى نلحظ في سلوكه تعلقًا مفرطًا بأحد والديه أو الشخص المسؤول عن رعايته، وهذا التعلق قد يصل حد الالتصاق التام، سيكون من الصعب علينا الحديث مع نضال، فسيطلب دائمًا من والدته أن تحمله ويجلس في حجرها، وقد يمسك بعنقها فترات طويلة، أو يحضن ساقها وهي تتحرك دون أن يكون له طلب أو سبب.
نضال، ومن عاش ذات التجربة من الأطفال، قد يرفضون الذهاب للمدرسة أو الابتعاد عن من يرعاهم، سيشعرون بقلق مفرط وخوف من الانفصال عن مصدر الأمان، قلق الطفل يظهر بحركة مفرطة متعبة غير مبررة، وقد يبكي لفترات طويله دون سبب، وتنتابه أحيانًا نوبات غضب شديد يصبح معها عدوانينًا في التعامل، أو ربما سيعزل كثيرًا ويرفض التواصل مع أي طرف.
حين يبدأ تحصيله العلمي قد يظهر على نضال تأخُّر في تعلم مهارات لغوية ضرورية، حتى قدرته على التعلم قد تكون أضعف من ذويه، سيكون ربط المعلومات والأفكار متعِبًا ومرهِقًا وصعبًا عليه، وهذا نتاج نموه في بيئة متعبة مرهقة له ولمن يرعاه، ولا يكون الليل أحنَّ على نضال من نهاره، قد تزوره الكوابيس وقد يمشي أثناء نومه وربما يعاني أيضًا من تبول لا إرادي.
نضال والأطفال الذين عاشوا في السجون السورية في ظروف قاسية في السنوات الأولى من عمرهم قد لا يتذكرون الأحداث والأشخاص، لكن التجربة القاسية تبقى جاثمة في عقولهم وأنفسهم، حتى الأطفال الذين نقلوا إلى مراكز رعاية فترة اعتقال أمهاتهم سيعيشون سلوكيات قريبة، وتختلف نسبة ظهور هذه الأعراض من طفل لآخر تبعًا لشخصياتهم.

الزمن لا يكفي
إذا عبر نضال السنوات الأولى من خروجه دون عناية نفسية ورعاية تناسب وضعه، فإن سنواته القادمة لن تكون أسهل، فالتجربة السيّئة ستعبّر عن نفسها بأشكال أخرى، وفي مرحلة ما من حياته ستظهر عليه نوبات ذعر مفاجأة، وردود فعل مبالغ فيها تجاه مواقف بسيطة، لكنه رأى فيها تهديدًا.
وهذه الذكريات ستطارده وتأثّر في قدرته على بناء علاقة آمنة، سيميل إلى الحذر الزائد ولن يثق بالآخرين بسهولة، وأسوأ ظهور للتجربة القديمة يكون في علاقته مع زوجته وأطفاله مستقبلًا.
وكلما تقدم في العمر أظهر سلوكيات مختلفة، قد يكره التواجد في الأماكن المزدحمة كالتجمعات العائلية أو المناسبات، وكل ما كانت التجربة أقسى وأسوأ فإن أعراضها تكون أكثر وأصعب، قد يواجه نضال وأمثاله مشاكل صحية وجسدية، كضعف في المناعة ومشاكل هضمية نتيجة للقلق الممتد لسنوات.
وأحيانًا قد يلجأ الأطفال الذين عاشوا تجربة السجن الصعب لآليات تأقلم سلبية مثل إيذاء النفس، كل ذلك قد يعاني منه نضال، رغم أنه قد لا يتذكر بشكل واضح الأحداث في السجن إذا كان قد خرج في عمر صغير قبل سنوات الوعي الكامل، فلماذا ستظهر كل هذه الأعراض وهو لا يتذكر؟
الجسد لا ينسى
قرأت قبل شهور من رؤيتي للطفل أمام باب الزنزانة كتابًا يتحدث عن الصدمات النفسية تحت عنوان “الجسد لا ينسى”، قال الكاتب في مقدمته: “لا يشترط أن يقاتل المرء في حرب أو يزور مخيمًا للاجئين في سوريا أو الكونغو كي يمرّ بصدمة نفسية”، أذكر يومها انزعاجي من زجّ سوريا بهذه الطريقة الفجّة في خضمّ الحديث عن الصدمات النفسية، قبل أن استوعب أننا فعلًا في سوريا مخزن لكل أنواع الصدمات التي قد يمرّ به البشر، وما عاشه السوريون خلال عقد ونيف يختصر كل المآسي.
عدت إلى الكتاب للمؤلف بيسل فان در كولك، علّني أجد فيه سبيلًا لفهم هؤلاء الأطفال بعد التجربة المأساوية التي عاشوها، لا يتحدث الكاتب عنهم بشكل مباشر، لكنه يقدم نتائج عقود من الدراسات أجراها على أطفال عاشوا ظروفًا قاسية وتعرضوا لتعنيف وتعذيب في بيئات سيّئة، واستوقفتني فيه عدة أمور يجب أن ندركها حين نتعامل مع المعتقل الطفل والبالغ ربما على حد سواء.
يقول الكاتب أن الطفل يخزّن الصدمات التي تعرض لها في جسده حتى لو لم يتذكرها، وتظهر في تصرفاته وعلاقاته وعمله ودراسته.
قام الكاتب بتطبيق تجربة أسماها “الاختبار الإسقاطي”، لاكتشاف نفوس الأطفال المعنّفين ومن نشأوا في بيئة قاسية، ورؤيتهم للعالم وكيف يفكرون، الاختبار بسيط جدًّا ويمكن أن تجرّبوه مع أطفالكم، عرض الطبيب صورة لعائلة من أب وطفليه، الأب مستلقٍ تحت السيارة يصلحها والطفلان يلتفّان حوله يحملان أدوات تساعده في عمله، وطلب منهم تخيل ما حدث بعد التقاط الصورة.
تخيل الأطفال المعنّفون نهايات كارثية للصورة، كأن يسحب الطفل الرافعة لتطحن جسد والده ويتناثر الدم في كل مكان، أو تسقط المطرقة من يد الطفلة على رأسه فيموت، بينما تخيل الأطفال الطبيعيون أن الأب انتهى من إصلاح السيارة ودخلوا لمشاهدة التلفاز أو تناول الغداء، أو ذهبوا بها في نزهة.
بعد تجارب لصور عديدة طبيعية أخرى على الفئتين، كاستعراض صورة امرأة حامل، كرر الأطفال الذين تعرضوا لإساءة جسدية أو نفسية تقديم توقعات سيئة أو مؤلمة، ولم يكن بإمكانهم تخيل نتائج طبيعية، إن تصورهم عن الحياة العادية تضرر بالكامل، وأي سلوك ولو كان طبيعيًا حولهم يرونه نذيرًا لكارثة.
وإذا قارناهم بطفل عادي فهم يتصرفون بعنف أو خوف تجاه حدث طبيعي، فيخافون من تحطم زجاج أو من صوت سيارة عالٍ أو من ركوب المصعد، وغيرها من الأحداث اليومية العادية، فخبرتهم عن الحياة القاسية أصبحت هي النموذج الأول لخوض الحياة والتعامل مع الآخرين والمحيط.
أورد الكاتب أيضًا دراسة تتحدث عن تأثير التجارب القاسية والإهمال في اضطراب سلوك الطفل، فالإنسان يتعلم تدريجيًا رعاية نفسه جسديًا وعاطفيًا، وأهم درس وأولهم يتعلمه من رعاية الآخرين له، فحين يتلقى رعاية سيئة وقاسية لن يتعلم رعاية نفسه وفهم مشاعره واحتياجاته، وبالتالي إن سلوكه لن يكون سليمًا.
وبالنظر إلى هذه الدراسة، يمكننا أن نتصور كيف سيكون حال طفل مثل نضال، كبر في سجن يعيش من فيه ظروفًا إنسانية وحشية، بالكاد يلتقط الواحد منهم أملًا، ويشهد أسوأ شكل للمعاناة النفسية والجسدية، كيف سيبني تصورًا صحيحًا عن رعاية نفسه؟
ولا يتوقف الأمر على الأثر النفسي، فالأثر الأسوأ هو ما يحصده الجسد من هذه التجربة القاسية، يقول الدكتور أحمد شيخاني في كتابة “الأطفال والحرب”، إن أثر الصدمات الطويلة والقصيرة على الجسم يشبه إعلان حالة طوارئ داخله، فيستجيب متأهّبًا على 3 مراحل، الأولى تسمّى الإنذار، بعد تعرض الإنسان للصدمة تستفز منطقة المهاد في الدماغ مع الجهاز المناعي والجهاز العصبي الودّي، لتهيئة الجسم للردّ على مصدر الضغط وإفراز الهرمونات المناسبة.
المرحلة الثانية هي المقاومة، فيسعى الجسم لاسترجاع حالة التوازن الداخلي، فتخفّ الأعراض المباشرة كخفقان القلب والتنفس السريع، لكن الجسم يبقى في حالة إنذار تدوم لفترات طويلة تكون على حساب إضعاف الموارد الجسدية الداخلية للجسم كجهاز المناعة، ومن أهم الأمراض التي تتعلق بالتعرض للضغط الحاد هي الأمراض الالتهابية والحساسيات والقرحة والأورام السرطانية وآلام المفاصل، فالضغط يؤثر على قدرة الجهاز المناعي على الدفاع عن الجسم.
ثم تأتي الحالة الثالثة هي الإنهاك، فيؤثر الضغط المستمر على وظيفة القلب، وقد تؤدي للذبحة القلبية، فتجربة السجن الطويلة المرّة لن تنتهي آثارها بخروج السجين، فجسده يحصد آثار صموده داخل المعتقل لسنوات طوال.
كما أن تعرُّض الأطفال خصوصًا في العمر المبكر جدًّا، لخوف وذعر لفترات طويلة، يعيق عملية النمو للقشرة الدماغية، والتي من المفترض أنها تساعده على اكتساب اللغة والنطق والقدرات الأساسية التي يتعلمون من خلالها لاحقًا القراءة والرياضيات وأخذ المبادرة وضبط الانفعالات، كما تؤثر الضغوط المبكرة على المنطقة التي تسمّى “قرون آمون” في الدماغ، المسؤولة عن الذاكرة قصيرة المدى التي يحتاجها الطفل في عملية التعلم.
وهذه القاعدة تنطبق على الأطفال الذين عاشوا في المخيمات ضمن ظروف صعبة، أو تحت القصف لشهور طويلة، أو حصار امتد لسنوات، فنحن في سوريا أمام أعداد كبيرة من الأطفال كبرت دون “تشغيل كامل للدماغ”، ومهما حاول الطفل وحاول ذووه لاحقًا لتعويضه، فإنه سيبقى بحاجة لمراعاة ظروفه وتقدير حدوده، وعلينا ألّا نحمله فوق طاقته بعد كل ما مرَّ به، والخطوة الأولى لذلك هي الوعي بنتائج ما عاشه وعاناه.
إنهم فتية آمنوا بربّهم
نضال لم يكن الوحيد الذي رأيته في السجن، كنت أتابع تقريرًا مصورًا أنجزه الصحفي السوري عمر أدلبي لقناة “الجزيرة”، التقى فتيان لا يبدو أنهم تجاوزا الـ 15 بتجولون في السجن الذي عُذبوا فيه.
عدد الفتيان الذين مرّوا بتجربة الاعتقال يتجاوز الآلاف، قبل سقوط النظام بأشهر كانت الأرقام المؤكدة تتحدث عن أكثر من 2300 طفل لا يزالون مخفيين قسريًا و3700 طفل اُعتقلوا تعسفيًا وانقطعت أخبارهم وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، لكن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك، فالسوريون خلال عقد ونيف لم يوثّقوا كل حالات الاختفاء بسبب القبضة الأمنية، ولا تشمل الأرقام كذلك الأطفال والفتيان الذين دخلوا وخرجوا.
تبقى ذكريات السجن لهؤلاء جاثمة تنغص عليهم حياتهم اليومية، يختلف أثرها من شخص لآخر، قد يعاني بعضهم من نوبات غضب وعدوانية يؤذي بها الآخرين ومن يحاول مساعدتهم ورعايتهم، فهم يعيشون ألمًا نفسيًا قد لا يستطيعون إخراجه، لكن جسدهم سيلفظه كوابيس وأحلام متكررة بالسقوط، وأحيانًا تصل إلى تبول لا إرادي حتى في عمر متقدم.
قد يلاحظ المقربون منهم دخولهم في صمت طويل ورفض بناء علاقات متينة، والتشكيك في نوايا الآخرين تجاههم، وشعور عارم بعدم الانتماء للمكان أو الأسرة والغربة عن المحيط، كل ذلك أعراض لنقص في تقدير الذات والشعور بالعار والخجل والضعف وصعوبة فهم أنفسهم والتعبير عنها.
قد يُظهر بعضهم ميلًا إلى الإفراط في السيطرة، ومحاولة التحكم في البيئة لتعويض شعورهم بالعجز في الماضي.
تصبح الذكريات عدوًّا شرسًا وتضرب دون سابق إنذار، ولن يدرك ذوو المعتقل أو المحيطون بهم ما حدث، لكن يمكن قراءة آثار ذلك في سلوكهم وتخمينه، قد تعود الذكريات من خلال محفزات خارجية، شيء من البيئة الطبيعية توقظ مشاعر سيئة، كالظلام أو رجل أمن أو أماكن ضيقة مغلقة أو صوت، أو حتى رائحة بعينها كرائحة الكهرباء أو الاحتراق، فعلينا أن نراقب محيط الطفل والفتى إذا ظهرت عليه نوبات هلع أو قلق أو سلوك فجائي غير مفهوم.
وتعود المشاعر السلبية كالخوف والعجز في الكوابيس وأحلام اليقظة أو بشكل مفاجئ دون وعي واضح، بسبب تأثير الخبرات المبكرة في تشكيل الجهاز العصبي والمعتقدات.
هل يمكننا إعادة الزمن وإصلاح كل شيء؟
مساعدة أبناء السجون واجب أخلاقي، ودعم ذويهم وإرشادهم لرأب الصدع مسؤولية جماعية، وحين يتعذر تقديم مساعدة متخصصة فإن الحد الأدنى المطلوب هو الوعي بحجم الألم والمأساة التي يعيشها المعتقل وذويه، وتقديم الإسعافات الأولية النفسية.
إذا عدنا إلى نضال، فإن سنواته الأولى بعد السجن مهمة جدًّا ليستعيد عافيته، قبل كل شيء يجب أن نتأكد من سلامته الجسدية، وإجراء فحوصات عضوية للسمع والبصر والمعادن في الجسم، والتأكد من تلافي فقر دم ونقص المعادن.
بعدها علينا أن نستجيب للاحتياجات الأساسية لإعادة الاستقرار النفسي، نوفر بيئة آمنة ومستقرة فيها نمط هادئ، فالاستقرار في نمط الحياة سيساعده على إعادة النظر إليها، ولا نفرط في تدليله وتقديم كل ما يرغب له لتعوضيه عمّا فات، بل تعزيز السلوكيات الحسنة كالطلب بأدب والحديث اللبق والرفض المهذب والتعبير بوضوح عن رغباته، وغيرها من المهارات الاجتماعية ليفهم ويشعر بالقواعد الجديدة للحياة، ليستطيع الخروج من قالب السجن الذي يسيطر على ذهنه.
أما من الناحية العلمية، فعلينا تقديم تأهيل معرفي وسلوكي ولغوي جديد والاهتمام بتعليمه بشكل خاص، تعليم لا يركّز على اللغة والحساب والعلامات في المدرسة، بل تعليم قوامه عودة الاستقرار النفسي للطفل، من خلال التعاطي مع البيئة كالزراعة والاقتراب من الحيوانات والطبيعة والألعاب.
حتى الفتيان والفتيات الذين خرجوا من السجن يحتاجون دعمًا عاطفيًا مستمرًّا، دون إجبارهم على الحديث عن التجارب المؤلمة أو تذكيرهم بها بشكل مباشر أو غير مباشر، كأن نقول لهم أنت لست في السجن، أو لا يوجد سجّان هنا وما إلى ذلك، بل نشجّعهم على اللعب والرياضة والتلوين ومشاركتهم هذه النشاطات.
علينا تقدير مشاعرهم دون تقديم وعود كاذبة بأن ما يشعرون به سيختفي، وبالتأكيد لا يمكننا أن نستخدم تصرفاتهم أو ما يروُونه لنا كقصة نرويها للآخرين، أو مادة للضحك والسخرية.
لن يكون سهلًا على نضال وعلى الفتيان والفتيات تجاوز الاعتقال، لكنه ليس مستحيلًا، ويمكن لأمور بسيطة أن يكون لها أثر كبير في تغير معاناة يومية، ومن الوصايا التي يقدمها الدكتور ملهم لعب الرياضة والانخراط في الأعمال الجماعية والفنية، وتثقيف الفتيان والفتيات بمعلومات بسيطة عن أثر الصدمات في سلوكهم وتفكيرهم، والابتعاد عن معاقبتهم حال التصرف بعدائية وغضب، بل محاولة فهم الدوافع والتحدث عنها بهدوء وأريحية معهم.
البداية السهلة وحدود المأساة
الخروج من السجن هو الخطوة الأولى السهلة في نفوس الأطفال والفتيان، ما أسلفته في الأعلى هو نقطة في بحر عميق من الآلام التي يسبح فيها أبناء السجون، لا يمكن علاج المشكلة دون العودة لمختصين، لكن الوعي بآثار المعاناة ونتائجها التي ستظهر تباعًا يخفف من هول الحدث عن الضحية وذويه.
ضحايا سجون الأسد ليسوا فقط من دخلها، أطفال كثر سينالهم شرّها بكل حال، أولهم أبناء المعتقلين والمعتقلات، فالأثر الذي يتركه التعذيب والمعاناة لا يختفي بانتهائهما، وأثرهما غُرس في نفوسهم ويحبسهم داخل عوالم يصعب الخروج منها.
سيؤثر هذا على قدرتهم في التعاطي مع الأطفال، وبناء اتصال آمن وسهل معهم، ما سينعكس بدوره على قدرة الطفل في فهم العالم وبناء علاقات مع المحيطين به، وقد يتوحّد كثير منهم مع آلام أمهاتهم وآبائهم ليعيشوا معهم معاناة جديدة، وكل ما كانت أطفال المعتقلين والمعتقلات أصغر كان الأثر أكبر وأشد وطأة.
لا يمكن لمقال أو اثنين أو عشرة أن توجز المأساة القادمة، فالرعاية المختصة والمكثفة لأبناء السجون ضرورة لا رفاهية، وهي واجب اجتماعي يشمل كل من له صلة بهم وبذويهم، فالكارثة كبيرة ونحن أمام حالة فريدة ستتكشف فصولها تباعًا، ومراقبة نتائجها أول السبل لاحتوائها وتجاوزها.