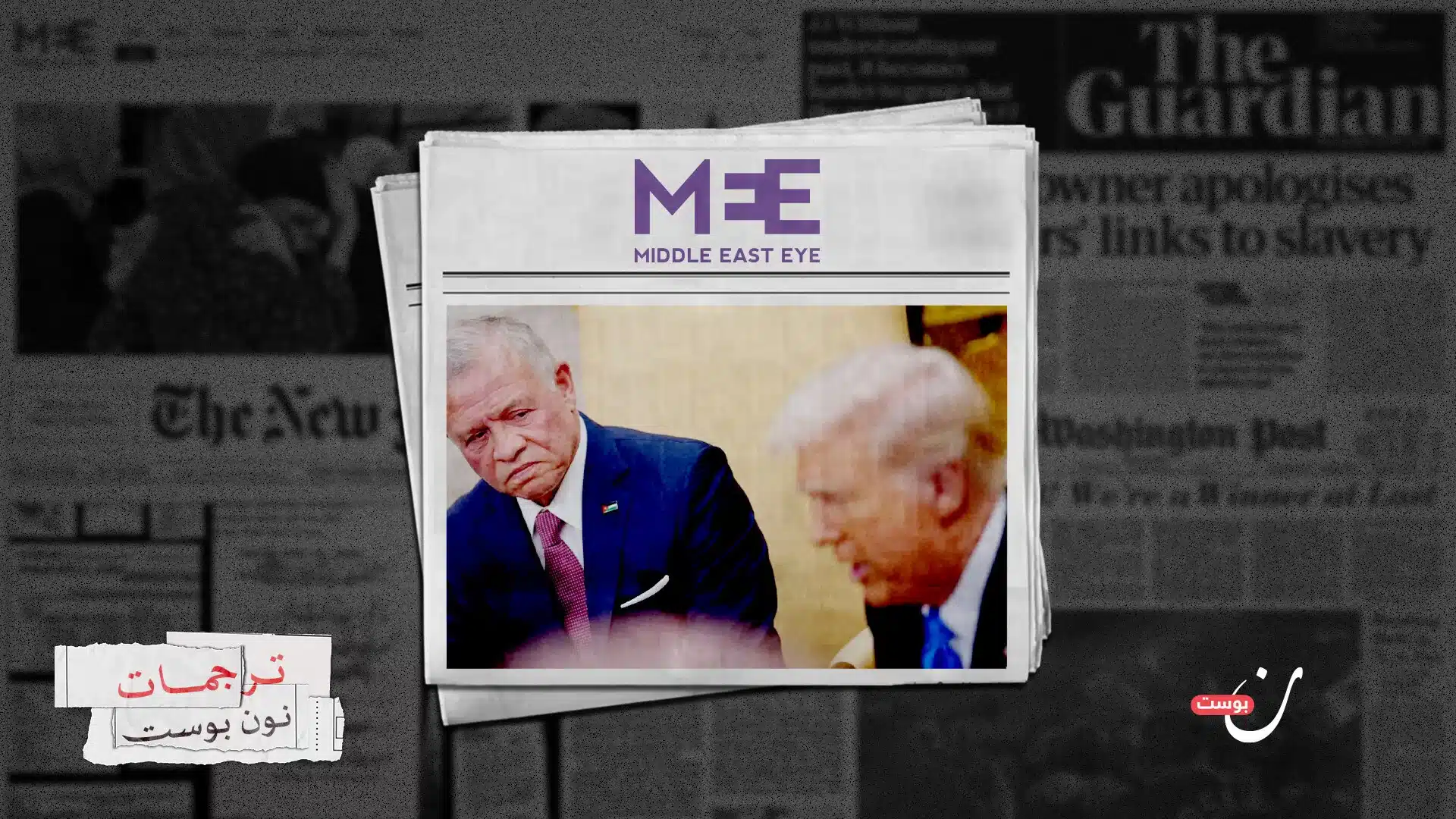ترجمة وتحرير نون بوست
كانت الديمقراطية الأمريكية على مدى السنوات القليلة الماضية تتحرك ببطء نحو نوع من حكم الأقلية المالية الإقطاعية التقنية. ويمثّل فوز ترامب بولاية ثانية قفزةً هائلة في هذا الاتجاه، لتصبح البلاد بشكل متزايد أقرب إلى كونها نظامًا ملكيًا دستوريًا بينما بات أحد أعمدة النظام السياسي الأمريكي – الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية – غير واضح أكثر من أي وقت مضى.
فالرئيس دونالد ترامب يصفّي موظفي الحكومة الفيدرالية الأمريكية بإشراف ولي عهده، الملياردير إيلون ماسك. كما أنه يسيطر أيضًا على مجلسي الكونغرس ومن المتوقع أن تكون المحكمة العليا مذعنةً ومتعاطفة مع إصلاحه الشامل للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأمريكي. وتأتي المعارضة الضعيفة الوحيدة من بعض القضاة الذين يطعنون في بعض أوامر ترامب التنفيذية.
إنه وضع يشبه وضع بعض الأنظمة الملكية العربية، ومن هذا المنطلق، فإنه من المثير للاهتمام مراقبة الديناميكيات السياسية بين الولايات المتحدة والدول العربية في إطار الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، الذي يبقى على المحك في ظل اتفاقين هشين لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة تُتهم إسرائيل بانتهاكهما. وبالطبع، لم يقل ترامب شيئًا عن هذه الانتهاكات، ولكن عندما ماطلت حماس في إطلاق سراح بعض الرهائن بسبب عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، رد الرئيس الأمريكي بإنذار خطير وعنيف تنتهي صلاحيته يوم السبت القادم.
زيارة محرجة
لا بد أن أي مواطن عربي لديه ذرة من الكرامة الشخصية قد شعر بالحرج الشديد عند مشاهدته للتفاعل الذي حدث في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء، عندما استقبل ترامب العاهل الأردني الملك عبد الله. لم ينطق الملك الهاشمي بكلمة واحدة بينما كان الرئيس الأمريكي يعرض رؤيته لغزة التي تتطلب تحديثًا لجميع كتيبات الدبلوماسية لتعكس هذا النظام الجديد من “السياسة الخارجية الواقعية”.
كرر ترامب مرتين أو ثلاث مرات ضرورة إجراء تطهير عرقي للسكان الفلسطينيين في غزة وإعادة توطينهم في البلدان المجاورة (باستثناء إسرائيل)، ويهدد هذا الاقتراح بقلب المنطقة رأسًا على عقب وزعزعة استقرار الدولتين الهشّ اللتين من المفترض أن تكونا أهم المستقبِلين لمليوني فلسطيني: مصر والأردن.
من غير الواضح ما إذا كان الملك عبد الله قد قال أي شيء لترامب بعد مغادرة وسائل الإعلام المكتب البيضاوي. ولكن من غير المستغرب أن يتم الإعلان عن تأجيل زيارة وشيكة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن إذ ربما لم يكن السيسي حريصًا على أن يتلقى نفس المعاملة المهينة التي تلقاها الملك الأردني.
هناك قاعدة ذهبية يجب اتباعها عندما يتحدث ترامب: لا تأخذوا كلامه على محمل الجد، فكل شيء ونقيضه يمكن أن يكون صحيحًا بالنسبة له، نحن في عصر ما بعد الحقيقة، وبالتالي هناك بصيص أمل في أنه لا يعني حقًا ما يقوله وأن نهجه هو محض مقاربة تفاوضية. الجميع يشعر بالحيرة في التوفيق بين تأكيد ترامب بأنه سيمتلك غزة وبين التزامه بعدم نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان حديث ترامب يعكس تفكيره الشخصي، أم أنه نتاج ثانوي للعديد من المستشارين الصهاينة الذين اختارهم لفريق السياسة الخارجية.
يمكن العثور على دليل مقنع في التعليقات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. حتى لا يتفوق على صديقه الأمريكي، قال نتنياهو إنه يمكن إنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية، التي تملك الكثير من الأراضي المجانية تحت تصرفها. وعلى أقل تقدير، لم يبدُ الديوان الملكي في الرياض مسرورًا بهذا الاقتراح. فقد صبّ القصر الملكي الماء البارد على نتنياهو وترامب في رده الصريح على كليهما يوم الأحد الماضي: “أكد صاحب السمو الملكي أن المملكة العربية السعودية ستواصل جهودها الحثيثة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولن تقيم علاقات مع إسرائيل دون ذلك”.
وفي الواقع، قد تكون سنوات من الدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية تجاه المملكة العربية السعودية والسعي لتوسيع اتفاقات إبراهيم عرضة للخطر بسبب التصريحات الخرقاء لترامب ونتنياهو، والوقت كفيل بإثبات ذلك.
معضلة معقدة
إذا كانت الأنظمة الملكية العربية تريد حقًا التأثير على عملية صنع القرار الأمريكي فيما يتعلق بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، فيجب أن تتحدث معًا بطريقة منسقة. وقد تكون القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في 27 فبراير/شباط إحدى الفرص الأخيرة لذلك. لسوء الحظ، أظهر التاريخ مرارًا أن مثل هذه التجمعات تتسم بالأداء الخطابي الرنان الذي لا يعقبه سوى القليل من العمل الملموس. ولكي نكون منصفين، فإن المرة الأخيرة التي اقترحت فيها الجامعة العربية شيئًا ذا مغزى كان مبادرة السلام العربية لسنة 2002، والتي تم تجاهلها عمليًا من قبل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
أما قطر والإمارات، وهما دولتان ملكيتان ذكيتان وجريئتان، فقد أظهرتا قدرتهما على التفاعل بكفاءة مع الولايات المتحدة والتحدث عن الحقائق المزعجة لواشنطن وتل أبيب. في الوقت نفسه، تواجه السعودية معضلة معقدة: كيف يمكنها تعزيز أجندتها الإصلاحية، التي تتطلب دعمًا أمريكيًا ومحيطًا إقليميًا سلميًا، مع الحفاظ على شرعيتها كخادم للحرمين الشريفين؟
بعبارة أخرى، كيف يمكن لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن ينضم إلى اتفاقات إبراهيم بينما تقوم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بخطابهما التحريضي وأفعالهما الوحشية على أرض الواقع، بتقويض منهجي للحد الأدنى من متطلبات الاستقرار والسلام في المنطقة ؟
لم يعفِ ترامب ولي العهد السعودي من جرعة الإذلال عندما قال إنه سيحتاج إلى 500 مليار دولار من المملكة في شكل مشتريات لإكرام المملكة بزيارته الأولى. وعندما التزمت المملكة بمبلغ 600 مليار دولار، رفع ترامب المبلغ إلى تريليون دولار.
يعتمد النظام الملكي الأردني الهش، مثل مصر، على الدعم الاقتصادي والعسكري والاستخباراتي الغربي. وبالنسبة للعديد من الباحثين المهتمين بالدبلوماسية في الشرق الأوسط، فإن سلوكيات الولايات المتحدة وإسرائيل تتحدى المنطق والحكمة التقليدية، وهي سلع أصبحت نادرة جدًا للأسف.
إن الانطباع السائد هو أن ترامب يسعى إلى مساعدة نتنياهو على تحقيق هدفه المتمثل في إعادة إطلاق الحرب في غزة، ويبدو أنهم لم يتعلموا شيئًا من الفشل الذي شهدوه على مدار الأشهر الخمسة عشر السابقة، لكن الأسوأ قد يكون قادمًا: فلن يكون مفاجئًا إذا ما اعترفت الإدارة الأمريكية الجديدة رسميًا بالمزيد من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، خارج القدس الشرقية، إلى جانب عمليات ضم جديدة للأراضي السورية.
جاء الرد السعودي على هذا الدعم العلني للتوسع الإسرائيلي في بيان آخر من القصر الملكي، منتقدًا التصريحات التي “تهدف إلى صرف الأنظار عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك التطهير العرقي الذي يتعرضون له”. وذهب البيان إلى أبعد من ذلك: “إن هذه العقلية المتطرفة والمحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض”.
في ظل هذه اللهجة القاسية الجديدة في الدبلوماسية السعودية، هل ستواصل الممالك العربية الالتزام باتفاقيات إبراهيم؟ وهل ستستمر مصر والأردن في الالتزام بمعاهدات السلام مع إسرائيل، في حين تبدو نوايا الأخيرة بعيدة كل البعد عن السلمية؟
المصدر: ميدل إيست آي