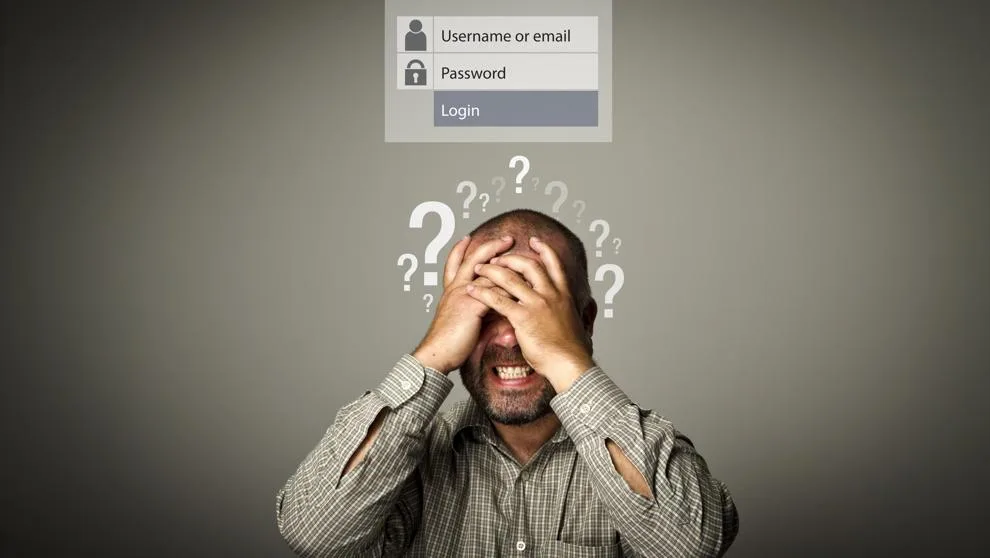لم يتغير جوهر السياسة الغربية في الشرق الأوسط منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، عندما طُلب من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر هذا الأسبوع تأكيد ما صرح به الرئيس دونالد ترامب من أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبا بكر البغدادي مات “وهو يئن وينتحب” بينما كان يفر باتجاه النفق، قال إنه ليس بإمكانه تأكيد ذلك، وأضاف: “ليست لدي هذه التفاصيل”.
نظراً لأنه لم يشارك في حياته في عمليات حربية، وشاهد فيلماً رديئاً تم إنتاجه من مقاطع صورتها المروحيات عن بعد، لا بد أن ترامب شعر بضرورة أن يقوم بتزويق حكاية ما حصل فعلاً تحت الأرض، أو لعل القائد الأعلى حصل على هذه المعلومات الحصرية من الكلب “الرائع” الذي أطلقه رجال البحرية ليطارد البغدادي.
ما تم من استعراض هنا كان أمراً مألوفاً، فكلما قتل زعيم من زعماء القاعدة أو داعش يرتكب الغرب خطأ الادعاء بأن المشكلة قد انتهت دون الأخذ بالاعتبار أو الإقرار بالسياق وبالظروف التي سمحت لشخصيات مغمورة بالارتقاء إلى مواقع السلطة والشهرة والنفوذ.
هل فعلاً أنجزت المهمة؟
لم يكن ترامب أول زعيم يحلم بنهاية القاعدة أو الدولة الإسلامية ويتخيل وقائعها من خلال أصداء ما ورد ذكره في العهد القديم من صفات الرب المنتقم.
فقد شهدنا كيف أن جورج بوش وطوني بلير وفلاديمير بوتين ونيكولا ساركوزي ودافيد كاميرون جميعهم زعموا أنهم “أنجزوا المهمة” بعد تدخلهم في الشرق الأوسط. ويمكن لكل ذي بصيرة أن يرى اليوم ثمار ما أقدموا عليه: فسوريا مدمرة وتعيش في ظل احتلال تام ودائم، وأما اليمن وليبيا فتعصف بهما الحرب الأهلية بينما يصاب العراق بالشلل التام.
فالبغدادي نفسه كان نتيجة مباشرة لقرار بوش وبلير غزو العراق في عام 2003.
حينما انسحبت الولايات المتحدة من العراق في عام 2011، كانت الدولة الإسلامية تعتبر تافهة لدرجة أن الجائزة التي خصصت لمن يدل على أحد زعمائها أو يقتله خُفضت من خمسة ملايين دولار إلى مائة ألف دولار
فمثله مثل كثير من العراقيين الذي ينحدرون من سامراء، انضم البغدادي إلى السنة العراقيين الذين قاتلوا ضد الغزو الأمريكي، وأسس جماعة أهل السنة والجماعة ثم وقع في الأسر في الفلوجة واعتقل في “أبو غريب” وفي معسكر بوكا – الذي وُصف فيما بعد بأنه كان “جامعة الجهاديين” – وأطلق سراحه بعد أقل من عشرة شهور. بعدها اختفى من المشهد. كان مجرد رجل دين قصير النظر يستمتع بممارسة رياضة كرة القدم، كان رجلاً لا يأبه له أحد.
وحينما انسحبت الولايات المتحدة من العراق في عام 2011، كانت الدولة الإسلامية تعتبر تافهة لدرجة أن الجائزة التي خصصت لمن يدل على أحد زعمائها أو يقتله خُفضت من خمسة ملايين دولار إلى مائة ألف دولار. وحينها قال جون برينان، مدير المخابرات الأمريكية في ذلك الوقت، إن تنظيم الدولة الإسلامية “قد تحطم تماماً” وأن أتباعه لا يزيدون عن سبعمائة. كان برينان محقاً، فقد نجحت حركة “الصحوات” في خنق الدولة الإسلامية ثم جاء الربيع العربي ليعزلها تماماً إذ لفظها المجتمع السني في العراق بينما تبرأ منها تنظيم القاعدة.
سحق الربيع العربي
لم تلبث المساعدة أن وصلت إلى البغدادي، مرة أخرى، من طرف حلفاء الولايات المتحدة الذين تآمروا على إسقاط محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، من خلال انقلاب عسكري مازالت الولايات المتحدة لا تراه انقلاباً. كان سحق الربيع العربي عام 2013– على يد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة – ومعه سحق آمال ملايين المواطنين العرب في إمكانية أن يحدث التغيير سلمياً وديمقراطياً، أكبر حقنة منشطة في الذراع يتلقاها تنظيم الدولة الإسلامية بشكل عام والبغدادي بشكل خاص.
فقد أفضى ذلك إلى بعث الرجل والتنظيم من جديد، وذلك بعد أن كان تنظيم الدولة جاثماً على ركبتيه وبعد أن كان الناس قد انفضوا عن الفكرة التي يمثلها. حصل التنظيم على دعم لم يكن يحلم به في العراق الذي مزقته الأحقاد الطائفية وفي سوريا التي تحولت إلى ساحة وغى بفضل سيل لا ينقطع من المقاتلين الأجانب الذين وردوا عليها من كل حدب وصوب. تُرتكب اليوم نفس الغلطة إذ يدعونا ترامب إلى اعتبار موت البغدادي نقطة تحول في مسار تنظيم الدولة، بينما يتم تجاهل السياق والظروف التي منحت الحياة لأناس مثل البغدادي وجماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية، ويجري كنسها جانباً من قبل زعماء بات كل همهم التفاخر بإنجازاتهم.
جل بنظرك، وسدد الرؤية إلى أبعد من ذلك، وسوف ترى حالة من الغليان المدني في لبنان، وستكتشف أن سوريا قد تم تقطيعها إلى ثلاث محميات، وكذا حال اليمن الذي قطعت أوصاله على الأقل بنفس العدد من الطرق بفضل “الهجوم الخاطف” الذي شنه محمد بن سلمان قبل أربعة أعوام
ومن هذه الأحوال التي يتم تجاهلها تلك الثقة الغربية التي لا تتزعزع في الطواغيت واعتبار أنظمة حكمهم نماذج للسيطرة لا ينبغي التخلي عنها. ومنها أيضاً العجز التام لهؤلاء الطواغيت في تقديم نماذج حكم تسمح لبلدانهم بالنهضة والتقدم، ومنها أيضاً ما يعيش فيه ملايين الناس في مختلف أرجاء العالم العربي من بؤس اقتصادي واجتماعي. يمكن اليوم رؤية نفس الأحوال التي أفضت إلى انطلاق الربيع العربي قبل ثمانية أعوام وقد عادت إلى شوارع بغداد، حيث يغلي العراقيون سخطاً على الحكومة الطائفية التي تجثم على صدورهم في أجواء من انقطاع الكهرباء وشح المياه النظيفة وانهيار العملية التعليمية وتدهور الأوضاع الصحية والأمنية.
بينما النخبة السياسية تتحالف إما مع الولايات المتحدة أو مع إيران، وتنهمك في قتال بعضها البعض. وفي نفس الوقت تعكف هذه النخب على سرقة مقدرات البلد. وعلى الرغم من ثروة العراق النفطية الهائلة إلا أنه لم تقم فيه أي مشاريع بنية تحتية تستحق الذكر.
هذه هي الأرض التي أوجدتها الولايات المتحدة في العراق.
جل بنظرك، وسدد الرؤية إلى أبعد من ذلك، وسوف ترى حالة من الغليان المدني في لبنان، وستكتشف أن سوريا قد تم تقطيعها إلى ثلاث محميات، وكذا حال اليمن الذي قطعت أوصاله على الأقل بنفس العدد من الطرق بفضل “الهجوم الخاطف” الذي شنه محمد بن سلمان قبل أربعة أعوام. وسترى حفتر متربصاً بطرابلس في ليبيا، بينما تشهد الجزائر مظاهرات أسبوعية حاشدة في معركة محتدمة بين العسكر والشعب. لم يطرأ أي تغير على السياسات الغربية التي نجمت عنها كل هذه النكبات.
يتنافس قصر النظر مع الغباء أيهما يهيمن على المكان ما الذي يضمن لهم أن الانفجار الذي نشهده حالياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط لن تصلهم شظاياه؟
فترامب، كما كان حال أوباما من قبله، لم يتوقف عن التصريح بأنه بصدد سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، ومع ذلك، وفي اليوم التالي لإعلان انسحابه من سوريا، قام بإرسال ألفي مقاتل إلى المملكة العربية السعودية. وبعد أن لقي البغدادي حتفه بدأت الولايات المتحدة بتعزيز مواقعها حول حقول النفط شرقي سوريا. فقد تراجع ترامب عن كل كلامه المتعلق بسحب القوات من سوريا، وراح يعلن: “سنحتفظ بالنفط. لطالما قلت ذلك. لقد قمنا بتأمين النفط.” فهدفه حسبما قال هو ضمان حصة الولايات المتحدة في عائدات النفط السورية. على الأقل في حالة ترامب، لم يعد ثمة ما يستدعي التستر خلف الزعم بأن الولايات المتحدة تسعى من وراء تدخلها تحقيق أهداف سامية. إلا أن جوهر السياسية الغربية في الشرق الأوسط لم يتغير منذ عام 2003، حيث تقوم هذه السياسة على شيء قريب مما يلي: تجاهل الجزائر واليمن وليبيا وسوريا – فهي قضايا خاسرة ولا تعنينا على أية حال، بينما يتم التركيز على عاصمتين – القدس والقاهرة – وإذا ما بدتا مؤمنتين، فما المشكلة في ذلك؟
ولكن هنا أيضاً، يتنافس قصر النظر مع الغباء أيهما يهيمن على المكان ما الذي يضمن لهم أن الانفجار الذي نشهده حالياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط لن تصلهم شظاياه؟
خذ على سبيل المثال الاستقرار المزعوم الذي تحقق في ظل نظام الحكم المتعفن للدكتاتور المفضل لدى ترامب: “القاتل” عبد الفتاح السيسي.
سوء إدارة مصر
أولاً، ساءت علاقات السيسي بمموله الأساسي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ولم تعد مصر تحصل على النفط المجاني من دول الخليج بحسب ما أخبرني به مصدر عال المستوى في المملكة العربية السعودية. ولعل هذا ما يفسر رؤية الرئيس المصري وهي يشتم محمد بن سلمان خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى بغداد، والتي ربما توجه إليها أملاً في الحصول على نفط عراقي مجاني. ما لبث دين مصر الخارجي في ارتفاع مستمر، حيث زاد من 106.2 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس إلى 108.7 مليار بنهاية حزيران/ يونيو، وذلك بحسب ما صدر عن بنك مصر المركزي من بيانات.
زاد الدين الخارجي في عام واحد بما قدره 16 مليار دولار. بلغ سوء إدارة الاقتصاد مستويات مهولة، وكل ذلك بهدف الإبقاء على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري، وأصبحت مصر في عهد السيسي ثقباً أسود بالنسبة للاستثمار الخارجي. يشعر المصريون محلياً بأنهم يزدادون فقراً كل شهر، وهذا ما يحصل لهم فعلياً.
وبلغ بهم الحال أن يكفيهم بأن ينطق واش واحد مثل محمد علي لكي يدفع بهم للانطلاق في مظاهرات حاشدة في شوارع البلاد بطولها وعرضها، مما نجم عنه اعتقال المئات من الأفراد من مختلف مكونات الطيف السياسي. ويكشف ذلك عن حالة الانكشاف التي يعيشها السيسي، وما كل ذلك إلا بعض مما هو آت مقارنة بالمشاكل التي تنتظر الرئيس بسبب الأزمة المتوقعة في موارد المياه المصرية، والتي تعتبر بحق مسألة وجود بالنسبة للبلاد. سد العار
لم تكن فكرة المشروع الإثيوبي لتشييد سد عظيم لتوليد الكهرباء فكرة جديدة، بل كانت موجودة منذ مدة. وهي الفكرة التي عارضها محمد مرسي خلال سنة حكمه الوحيدة في عام 2012. ثم انطلق مشروع السد بشكل متسارع بعد أن وقع السيسي على اتفاق أولي مع كل من إثيوبيا والسودان.
زعم الخبير أن مصر لا تحصل على كثير من الأمطار سنوياً، ولذلك فإن المياه الجوفية تأتي من النيل ذاته، وإذا ما انخفض مستوى مياه النيل فلن تعوض المياه الجوفية. بالإضافة إلى ذلك يخشى المصريون من أن مياه السد لن تستخدم فقط لتوليد الكهرباء.
في ذلك الوقت، قيل للمفاوضين المصريين إن إثيوبيا تنوي وقف تزويد النيل بالمياه مؤقتاً نظراً لأن ملء البحيرة التي تقام خلف السد سيستغرق ثلاثة أعوام، ثم بعد ذلك تعود الأمور إلى سابق عهدها ويستأنف تزويد مصر بالمياه كالمعتاد. إلا أن خبراء الري في مصر انتابهم شعور بالقلق إزاء هذه المزاعم حتى في عام 2015. أحد هؤلاء الخبراء، وهو مطلع بشكل جيد على تفاصيل المفاوضات التي جرت بين مصر وإثيوبيا، صرح لموقع ميدل إيست آي بما يلي
“لئن جرى تعبئة السد خلال ثلاثة أعوام كما يرغب الإثيوبيون فإن مستوى المياه في النيل داخل مصر سينخفض لدرجة أن كثيراً من أنابيب المضخات سوف تنكشف لانحسار المياه عنها. وعندما ينخفض مستوى المياه إلى هذا الحد فإن الدلتا، وهي أكثر مناطق مصر خصوبة، وعلى إثر تراجع مستوى النيل، فإن مياه البحر ستدخل، مما يعني أن تربة الدلتا ستصبح مالحة وغير صالحة لكثير من المحاصيل الزراعية.”
زعم الخبير أن مصر لا تحصل على كثير من الأمطار سنوياً، ولذلك فإن المياه الجوفية تأتي من النيل ذاته، وإذا ما انخفض مستوى مياه النيل فلن تعوض المياه الجوفية. بالإضافة إلى ذلك يخشى المصريون من أن مياه السد لن تستخدم فقط لتوليد الكهرباء.
وقال الخبير “يزعم الإثيوبيون في العلن أنهم لن يستخدموا المياه في الزراعة، وأنه بعد مرور ثلاثة أعوام، كما يزعمون، ستعود مستويات المياه في مصر إلى ما هي عليه الآن. ولكن هذا الكلام غير صحيح، حيث أن الإثيوبيين يمنحون الأراضي لمستثمرين أجانب، وها هم الآن يقسمونها ويوزعونها على مستثمرين محليين وأجانب. وسوف يستخدمون بشكل دائم ما بين عشرين إلى ثلاثين بالمائة من المياه التي عادة ما تذهب إلى مصر، مما سيكون له كبير الأثر على مصر، التي لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه.” ولئن كان أي انهيار في مصر قابلاً لأن يدفع ولو بجزء ضئيل من السكان شمالاً باتجاه أوروبا، فمن المؤكد أن مثل هذا التطور كفيل بذلك.
الفوضى العارمة
وفي فلسطين أيضاً بإمكاننا أن نرى الغرب يفاقم من قيمة فاتورة سيكون عليه دفعها، حيث تتنافس مكونات معسكر اليمين في “إسرائيل” على الهيمنة، وحيث أصبح التطهير العرقي في فلسطين الآن جزءاً من الخطاب الشعبي المشروع، يعبر عنه المتدينون والعلمانيون على حد سواء دون خجل أو وجل وعن ثقة راسخة، وبشكل خاص أفيغدور ليبرمان.
توجد لدى إدارة ترامب خطة مازالت تنتظر الإعلان عنها لا وجود فيها للدولة الفلسطينية الأمر الذي يعزز من ثقة معسكر اليمين الإسرائيلي بأنه يقف على أرض صلبة.
وهذا أيضاً لا يبشر بحالة من الاستقرار. فما مدى سلامة الفرضية التي تصدر عن الغرب بأن استثماراته الكبرى في كل من “إسرائيل” ومصر والمملكة العربية السعودية محصنة ضد الفوضى العارمة التي تجتاح المنطقة؟
تكشف الهجمات الأخيرة على اثنين من أهم المرافق النفطية في المملكة العربية السعودية عن حالة الضعف والانكشاف التي باتت فيها هذه المرافق والتي صارت عرضة لهجمات قد يقوم بها الجيران في منطقة الخليج.
لن يغير كثيراً قتل رجل واحد. مازال النفوذ الخارجي داخل المنطقة بمثابة الورم الخبيث الذي مازالت أعراضه من غزو وتدخل ودعم للطغاة وللطائفية على حالها. لن يسلم أحد من تفاقم الفوضى. فإلى متى سيستمر الغرب في تأجيج هذه النيران بدلاً من المبادرة إلى إطفائها؟
المصدر: ميديل إيست آي
ترجمة وتحرير: عربي21