ترجمة وتحرير: نون بوست
بدأ كل شيء بسؤال بسيط: كيف كان رد فعل المسؤولين البريطانيين بعد أن قتلت المملكة العربية السعودية 155 شخصًا وأصابت مئات آخرين في جنازة في اليمن عام 2016؟ في ذلك الوقت، كانت حرب السعودية ضد الحوثيين في أوجها ولم يكن ذلك ممكنًا لولا الأسلحة البريطانية.
تجمّع المئات من المشيعين يوم السبت 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في القاعة الكبرى في صنعاء لتقديم واجب العزاء في والد جلال الرويشان، وزير الداخلية في حكومة المتمردين. قال أحد الشهود: “أطلقت طائرة صاروخًا وبعد دقائق قصفت طائرة أخرى المبنى”.
يُعرف هذا الهجوم بـ”الضربة المزدوجة” حيث تعقب الضربة الأولى ضربة ثانية تقتل المزيد من المدنيين وعمال الطوارئ الذين هرعوا لمساعدة القتلى والمصابين. وقد أفاد شهود عيان أيضًا بوقوع ضربة ثالثة بعد ظهر ذلك اليوم. تحدثت التقارير في ذلك الوقت عن تناثر أشلاء الجثث والبقايا المتفحمة في القاعة، وبُترت أطراف الناجين، وقال أحد المنقذين للصحفيين: “لقد تحول المكان إلى بحيرة من الدماء”.
لقي الهجوم على القاعة الكبرى، وهو أكبر خسارة فردية في الأرواح خلال الحرب، إدانة واسعة على الصعيد الدولي من قبل الأمم المتحدة وجهات أخرى. وقالت السعودية في النهاية إنها نفذت الغارة الجوية بناءً على معلومات غير صحيحة، بينما دفعت المجزرة الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما إلى مراجعة مشاركتها في النزاع. وبعد شهرين، منعت واشنطن صفقة بيع أسلحة كبيرة للسعودية واستند المسؤولون في ذلك تحديدًا إلى هجوم الجنازة.
لكن ماذا عن المملكة المتحدة؟ ماذا حدث عندما عاد موظفو الخدمة المدنية والسياسيون البريطانيون إلى مكاتبهم في لندن في بداية الأسبوع التالي؟ هل فكّروا فيما إذا كانت هذه هي اللحظة التي ينبغي فيها وقف ترخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية؟
في فبراير/ شباط 2016، أي قبل ثمانية أشهر من الهجوم، أخبر إدوارد بيل، المسؤول البريطاني الرفيع المشرف على ضوابط تصدير الأسلحة، وزير الأعمال آنذاك ساجد جاويد بأنه سيكون من “الحكمة والحذر” أن توقف المملكة المتحدة صادرات الأسلحة إلى السعودية، وكتب بيل في رسالة بالبريد الإلكتروني: “أشعر بأنه يجب علينا تعليقها”. لكن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أي بعد أسابيع فقط من هجوم القاعة الكبرى، حثّ بوريس جونسون، وزير الخارجية في ذلك الوقت، جاويد على مواصلة بيع الأسلحة كما سيظهر طلب حرية الوصول للمعلومات لاحقًا.

ما الذي حدث في وايتهول في أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام؟ هذه هي قصة ما حدث على مدى ثلاثة أعوام حيث جمعنا خبرتنا المشتركة كصحفية استقصائية وأكاديمية تبحث في صادرات الأسلحة في محاولة للإجابة على هذا السؤال.
على طول الطريق، جعل الهجوم الإسرائيلي على غزة – واستمرار منح تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل شهرًا بعد شهر مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين – إيجاد إجابة لهذا السؤال أمرًا أكثر إلحاحًا. إذا ما تمكنا من تسليط الضوء على ما حدث مع صادرات الأسلحة البريطانية خلال حرب اليمن، فهل يمكن أن يساعد ذلك في منع حدوث ذلك مرة أخرى؟
لعبة طويلة
بدأ هذا البحث يوم ثلاثاء من شهر مارس/ آذار عام 2022. فكّرتُ في أنه لا بد من وجود أثر ورقي في مكان ما، ربما رسائل بين موظفي الخدمة المدنية، أو محاضر اجتماعات، أو وثائق أخرى تُلمّح إلى ما حدث في وايتهول في خريف عام 2016. لم يكن هذا أسهل أو أسرع لغز يمكن حله، لكنه أيضًا لن يكون خطيرًا مثل عمل منظمة حقوق الإنسان اليمنية “مواطنة” التي وثقت انتهاكات القانون الدولي الإنساني على الأرض، بما في ذلك الهجوم على القاعة الكبرى.
من مكاتبنا في لندن، كان بإمكاننا الوصول إلى القرارات التي أزهقت الأرواح في اليمن، وكان ذلك مهمًا. كان من المهم بالنسبة للشعب البريطاني أن يعرف بالضبط ما يُرتكب باسمه، وقبل كل شيء، كان ذلك لأجل اليمنيين الذين تم استهدافهم بأسلحة صُنعت في المملكة المتحدة. كنت أعرف أن آنا ستافرياناكيس قد نجحت في هذا الأمر من قبل: فبصفتها أستاذة العلاقات الدولية في جامعة ساسكس، قامت بالبحث والتدريس على نطاق واسع حول تجارة الأسلحة الدولية وضوابط نقل الأسلحة، وتواصلت مع صانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية حول صادرات الأسلحة البريطانية.
والأهم من ذلك، حسب ما رأيت، كانت آنا على دراية تامة بكيفية التعامل مع طلبات حرية المعلومات، التي يمكن لأي شخص في المملكة المتحدة تقديمها إلى السلطات العامة في المملكة المتحدة للحصول على المعلومات التي بحوزتها.
بعد معركة استمرت 20 شهرًا مع مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، كشف طلب حرية الوصول للمعلومات الذي قدمته آنا في عام 2017 عن مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي أظهرت كيف أوصى بوريس جونسون المملكة المتحدة بمواصلة بيع قطع غيار القنابل إلى السعودية – بعد أيام فقط من غارة جوية على مصنع لرقائق البطاطا في صنعاء أسفرت عن مقتل 14 شخصًا في أغسطس/ آب 2016.

راسلتُ آنا عبر البريد الإلكتروني لأسألها عما إذا كانت هناك طريقة لمعرفة ما حدث في شهر أكتوبر/ تشرين الأول أثناء اتخاذ الحكومة للقرار الحكومي بشأن صادرات الأسلحة، ولماذا يبدو أن هناك ثغرة في السجل الرسمي. ردت آنا على رسالتي بعد أقل من نصف ساعة قائلة: “هذا مثير للاهتمام. سأكون سعيدة جدًا بالتحدث معك. امنحيني بعض الوقت للنظر في ملفات حرية المعلومات وما إلى ذلك – هل يناسبنك يوم الخميس، لنقل في الساعة العاشرة صباحًا؟”. وبعد مرور أسبوع ومكالمة عبر تطبيق “سيغنال“، كنا نتقدم بطلبات حرية الوصول للمعلومات.
وعود على ورق: صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة
كثيرًا ما تقول حكومة المملكة المتحدة إن لديها واحدًا من أقوى أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة في العالم، وهذا صحيح على الورق. فالسياسة واضحة: لن تسمح الحكومة بتصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح من إمكانية استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. ولكن السياسة الجيدة على الورق ليست جيدة بنفس القدر في الممارسة العملية ويقول خبراء مثل آنا إن مصطلحي “واضح” و”ربما” قد أسيء استخدامهما بما يتجاوز أي منطق سليم للسماح باستمرار الصادرات.
تُنتج الأسلحة من قبل شركات خاصة – شركة بي إيه إي سيستمز هي أكبر شركة أسلحة في المملكة المتحدة – ولكن يجب أن تحصل على ترخيص من الحكومة للتصدير، وعملية الترخيص مبهمة للغاية وغالبًا ما تؤدي إلى نتائج محيرة. فعلى سبيل المثال، خلال الربيع العربي في عام 2011، سمحت الحكومة بتصدير بنادق القنص إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط تحت مسمى “سلع السيطرة على الحشود”. ومع أن التفاصيل المعقدة لسياسة ترخيص صادرات الأسلحة قد لا تجذب انتباه الجمهور، إلا أن أعضاء البرلمان ليسوا أكثر اطلاعًا عليها من أولئك الذين يمثلونهم.
ما بين 1999 و2024، خضعت صادرات الأسلحة البريطانية للتدقيق من قِبل “لجنة عليا” تُسمى لجان ضوابط تصدير الأسلحة التي كانت مكونة من أعضاء من أربع لجان مختارة: الأعمال والتجارة، والدفاع، والشؤون الخارجية، والتنمية الدولية. ولكن غالبًا ما كانت لجان ضوابط تصدير الأسلحة تعاني من مشاكل، بما في ذلك عدم وجود عدد كافٍ من الأعضاء، وغياب العضو والرئيس المختص، وعدم القدرة على إقناع الوزراء المعنيين بالحضور والإدلاء بشهاداتهم.
في عام 2016، أجرت اللجان تحقيقًا في استخدام الأسلحة بريطانية الصنع خلال الحرب في اليمن. لكن التحقيق انتهى بمهزلة عندما انقسم الأعضاء بين من أراد التوصية بتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية وبين من لم يرغب في ذلك. تم تسريب مسودة التقرير وانتهى الأمر بثلاث من اللجان المنفصلة بنشر تقاريرها الفردية (اختارت وزارة الدفاع فقط عدم نشر تقاريرها). وفي نهاية المطاف، قال أعضاء اللجنة أنفسهم إن إدارة الهيئة لم تكن ملائمة للتدقيق في تراخيص الحكومة ومراقبة صادرات الأسلحة. وفي يناير/ كانون الثاني 2023، ضغط رؤساء اللجان المختارة الأربع من أجل تكوين لجنة خاصة بمناقشة صادرات الأسلحة.
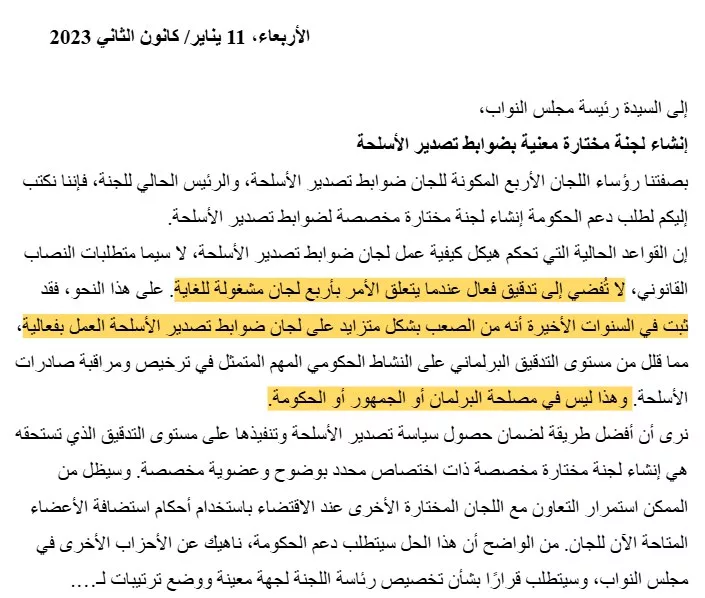
لكن النائب المحافظة بيني موردونت، رئيسة مجلس العموم آنذاك والعضوة السابقة في نفس اللجنة، قالت لهم: “أُقدّر أهمية التدقيق البرلماني الفعّال في صادرات الأسلحة، إلا أنني لست مقتنعة حاليًا بضرورة التغيير الذي طلبتموه”.
لم تُشكَّل لجنة مختارة معنية بالأمر بل سارت الأمور في الاتجاه المعاكس: تم حلّ لجان ضوابط تصدير الأسلحة التي كانت ضعيفة الأداء في يناير/ كانون الثاني 2024 تاركةً مهمة التدقيق في ضبط الأسلحة للجنة الأعمال والتجارة. والنتيجة؟ بعد بداية قوية تحدّت فيها اللجنة الحكومة بشأن أدائها في التدقيق، أدى نجاح حزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو/ تموز 2024 إلى تحجيم أداء اللجنة.
لا تظهر تفاصيل سياسة تصدير الأسلحة إلا عندما يتغلب أعضاء البرلمان والناشطون والصحفيون والباحثون على مماطلة الحكومة وعرقلتها ويسعون للحصول عليها أو عندما تُجبر الطعون القانونية الحكومة على الكشف عن تورطها. وفي الواقع، جاءت معظم التفاصيل العلنية حول قرارات الحكومة البريطانية المتعلقة بمبيعات الأسلحة إلى السعودية خلال حرب اليمن فقط من المذكرات الحكومية المقدمة إلى المحكمة العليا في عام 2017، عندما قدمت حملة مكافحة تجارة الأسلحة طعنًا قانونيًا.
ولكن حتى في ذلك الوقت، لم يتم نشر العديد من المذكرات التي قدمتها الحكومة علنًا. وبدلاً من ذلك، لم يتم مشاركتها إلا خلال جلسات الاستماع المغلقة التي لم يُسمح بحضورها إلا لمحاميي حملة مكافحة تجارة الأسلحة المعينين خصيصًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي. حتى “حملة مكافحة تجارة الأسلحة” لم تكن متأكدة مما هو عام وما هو خاص: بل اضطرت إلى مراجعة محاميها عندما سألتُ أنا وآنا عما إذا كانت المجموعة تمتلك أي سجلات أخرى تتعلق بهجوم القاعة الكبرى لم تنشرها على موقعها الإلكتروني.
كانت هناك أيضًا مشكلة في معرفة ما طلبه الآخرون بالفعل من خلال طلبات حرية النفاذ للمعلومات التي قدموها؛ حيث تنشر بعض الإدارات والسلطات الحكومية هذه السجلات على الإنترنت – ولكن ليس جميعها. ولا توجد مجموعة شاملة واحدة لطلبات حرية النفاذ للمعلومات في المملكة المتحدة، على الرغم من أن مجموعات مثل “أنريداكتد“، وهي وحدة بحثية في جامعة وستمنستر، تحاول تنسيق الجهود وسدّ الفجوة.
سيتم إطلاق مشروع حرب اليمن التابع للوحدة، الذي يضم أكبر مجموعة من المواد المتاحة للجمهور والمتعلقة بتورط المملكة المتحدة في الحرب في اليمن منذ عام 2015، ويمكن الآن الاطلاع على جميع وثائق حرية النفاذ المعلومات التي ذكرناها في هذه القصة في أرشيف المشروع.
والآن، لنعد إلى بحثنا. بحثت آنا في الوثائق التي تلقتها بالفعل ردًا على طلباتها، وبحثتُ في موقع “وات دو ذاي نو“، وهو موقع إلكتروني ينشر فيه العديد من الأشخاص طواعيةً طلباتهم وإجاباتهم المتعلقة بحرية النفاذ للمعلومات في محاولة لإبقاء المعلومات متاحة للعامة. لكن لم يظهر أي شيء يسد ثغرات بحثنا. وكانت الجهات الحكومية ترفض طلباتنا، رسالة بريد إلكتروني تلو الأخرى.
اتخاذ القرار بشأن السعودية
ما الذي كنا نبحث عنه بالضبط؟ كان من الواضح للجميع تقريبًا أن التحالف، بقيادة السعودية، قد انتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن. فقد تعرّضت المواقع المدنية من المدارس إلى المستشفيات إلى الأسواق وغيرها للقصف قبل وقت طويل من قصف قاعة العزاء. تتولى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية مسؤولية تلك الأجزاء من عملية ترخيص الأسلحة التي تتعلق بالقانون الدولي الإنساني. ولكن كيف قام مسؤولو الوزارة ومحاموها بقياس قدرة السعودية والتزامها باتباع القانون الدولي؟ وماذا فعل السياسيون بالمشورة التي تم تقديمها إليهم؟

للتعمق في التفاصيل: هل قرّر الوزراء البريطانيون ومستشاروهم أن هجوم أكتوبر/ تشرين الأول 2016 كان القشة التي قصمت ظهر البعير فيما يتعلق بوجود خطر واضح من استخدام الأسلحة البريطانية الموردة للسعودية في انتهاك القانون الدولي الإنساني؟ إذا كان الأمر كذلك، فكان ينبغي على الحكومة البريطانية، وفقًا لمعاييرها الخاصة، وقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية. كنّا نشك في أننا قد نجد بين الوثائق الحكومية التي ستعود إلينا دليلًا دامغًا مجازيًا مخفيًا في مكان ما بين جميع التعديلات.
سيكشف هذا الدليل، كما افترضنا، كيف اعتقد المسؤولون أن عتبة الخطر الواضحة قد استُوفيت – لكن الحكومة تجاهلت النصيحة حتى لا تضطر إلى تقييد صادرات الأسلحة. في جوهر الأمر، كنا نحاول العودة إلى الوراء وإثبات خطأ الحكومة علنًا، معتقدين أنه إذا تمكنا من فضح ما كنا نشتبه في حدوثه، فقد يمنع ذلك حدوثه مرة أخرى. لكن حرب إسرائيل على غزة ستقلب منطقنا رأسًا على عقب.
الطلبات والتعديلات والتأخير
حتى قبل هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي عجّلت بحرب إسرائيل على غزة – والتي أثارت مجددًا تساؤلاتٍ جوهرية حول سياسة صادرات الأسلحة البريطانية – جعلتنا الردود التي تلقيناها على طلبات حرية المعلومات ندرك أن هذا اللغز لن يُحلّ بسرعة أو بوضوح. في هذه المرحلة، تزداد هذه القصة تعقيدًا – لكنني أعدكم بأنها ستُفضي إلى نتيجة.
إليكم لمحة عامة: بين مارس/ أذار 2022 وأبريل/ نيسان 2024، قدّمتُ أنا وآنا 15 طلبًا منفصلًا لحرية النفاذ للمعلومات إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ووزارة التجارة الدولية، كما كانت تُسمى آنذاك. أردنا الحصول على مراسلات بين مسؤولين حكوميين رئيسيين حول صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية بعد هجوم القاعة الكبرى. نجحت آنا بالفعل، وإن كان ذلك صعبًا، في استخدام طلبات حرية النفاذ للمعلومات للعثور على معلومات حول النصائح التي قدّمها المسؤولون للسياسيين في الأشهر الثلاثة التي سبقت الغارة الجوية، استغرق الأمر منها عشرين شهرًا، بالإضافة إلى تقديم التماس إلى مكتب مفوض المعلومات لإجبار وزارة الخارجية على نشر المعلومات.
لذا، اتبعنا نهجها المُجرّب والمُختبر حيث طلبنا في البداية معلومات من وزارتي الخارجية والتجارة حول فترة التقارير الفصلية من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2016، بالإضافة إلى محاولة تجربة طرق أخرى. رُفضت بعض طلباتنا بحجة أنها “واسعة النطاق” أو “مكلفة للغاية”: بمعنى آخر، سيكلفنا ذلك أكثر من 24 ساعة من وقت الموظفين، بقيمة 600 جنيه إسترليني (حوالي 780 دولارًا أمريكيًا) للحصول على ما نريد.
حسنًا، لم نكن نهدف إلى إفلاس الحكومة البريطانية أو إرهاقها، كل ما أردناه هو المعلومات. لكن جهود آنا السابقة لم تُرفض في البداية لكونها واسعة النطاق أو مكلفة للغاية – بل رفضت وزارة الخارجية والكومنولث الإفصاح عن المعلومات بحجة أنها ستؤثر سلبًا على سير الشؤون العامة أو قد تضر بعلاقة المملكة المتحدة مع السعودية. ومع ذلك، أعدنا تقديم تلك الطلبات مع تحديد فترات زمنية أضيق على أمل أن ننجح في ذلك. وفي المرة الثالثة التي رُفض فيها أحد طلباتي الأضيق نطاقًا المقدمة من وزارة الخارجية، أوضحت وحدة حرية النفاذ للمعلومات التابعة للوزارة أن المواد التي أردتها “موجودة ضمن كمية كبيرة من المجلدات الورقية والأوراق المنفصلة التي قد تحتوي أيضًا على معلومات لا علاقة لها بطلبكم”.
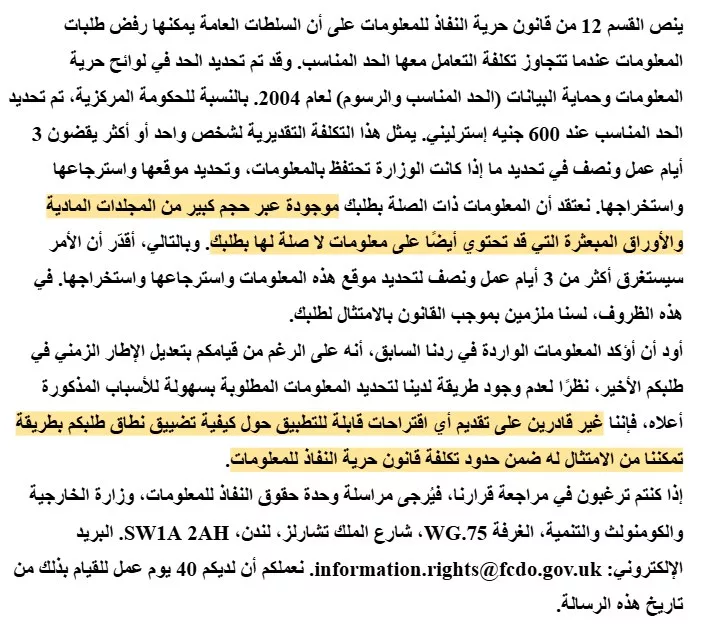
لقد أقروا بأنني كنت أقوم بتقصير الأطر الزمنية، وهو ما كان يعني نظريًا أن هذا سيقلل من جهدهم، لكنهم قالوا مع ذلك إنهم “لا يستطيعون تحديد المعلومات بسهولة” بسبب هذا الوضع الورقي المتهالك. واختتموا كلامهم بقول: “إننا غير قادرين على تقديم أي اقتراحات قابلة للتطبيق حول كيفية تضييق نطاق طلبك بطريقة تمكننا من الامتثال له”. لذلك تقدمت بطلب مراجعة داخلية بعد هذا الطلب الثالث: وهذا في قانون حرية النفاذ للمعلومات يعادل طلب شريحة لحم مستوية في مطعم ثم الاتصال بالمدير للشكوى من أنها غير مطهيوة جيدًا.
في يناير/ كانون الثاني 2023، تم إخباري أن مدير وزارة الخارجية والتنمية، في هذه الحالة، اتفق مع الموظفين: ما طلبتُه كان مكلفًا للغاية بحيث لا يمكن معالجته. كان هذا رد وزارة الخارجية، لكن رد فريق وزارة التجارة كان مختلفًا بعض الشيء. بعد رفض طلبي الأول بسبب التكلفة، صرحت وزارة التجارة الدولية في أغسطس/ آب 2022 بأن طلبي الثاني قد فعّل ما يُسمى “اختبار المصلحة العامة”، وهو ردّ شائع، خاصةً في أي شيء يتعلق بالسياسة الخارجية أو الأمن.
ما هو الأهم بالنسبة للمصلحة العامة: الكشف عن المعلومات التي أريدها أم حجبها؟ مهما كان الأمر، فسيحتاجون إلى مزيد من الوقت للنظر في ذلك. مرّ شهر آخر، ومدّدت الوزارة موعدها النهائي مرة أخرى وطلبتُ مراجعة داخلية. في الشهر التالي، رفضت الوزارة طلب حرية المعلومات، متذرعةً بثلاثة استثناءات. في حال نشرها، قد تؤدي المعلومات التي أريدها إلى:
- الإضرار بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة.
- الكشف عن كيفية وضع السياسات الحكومية.
- الإضرار بمصالح فرد أو شركة أو الحكومة.
ولكن بعد ستة أشهر، أشارت المراجعة الداخلية للوزارة نفسها إلى أنهم ارتكبوا خطأ. لم يكن الأمر يتعلق بالاستثناءات السابق ذكرها: في الواقع، كما هو الحال مع وزارة الخارجية، كنت أطلب الكثير وكان الأمر مكلفًا للغاية. قالت وزارة التجارة الدولية إن بإمكاني المحاولة مرة أخرى – وعلى عكس وزارة الخارجية، فقد قدموا بعض الاقتراحات. ولكن، بالمناسبة، قد يستمرون في رفض هذا الطلب بناءً على بعض الاستثناءات التي ذكروها في البداية. وأضافوا: “قد تنطبق استثناءات أخرى”.
حاولت مرة أخرى. والآن، لدى الحكومة نظام تراخيص تصدير على شبكة الإنترنت يسمى “سباير”. ومن بين الاقتراحات الأخرى، تساءلوا: هل ستكون المعلومات المحددة التي أحتاجها متعلقة بذلك؟ أم أنها ذات طبيعة أكثر عمومية، مثل المراسلات خارج سباير؟ لذلك، بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2023، قدمتُ ثلاثة طلبات أخرى بموجب قانون حرية الوصول للمعلومات إلى وزارة التجارة الدولية بناءً على توجيهاتهم.
كان أول طلبين يتعلقان بأي مراسلات خارج سباير ثم على وجه التحديد للمراسلات المحفوظة في شكل إلكتروني خارج سباير. وفي كلا الحالتين، قالت الوزارة إنها لا تملك شيئا. أما الطلب الثالث فكان يتعلق بوثائق سباير، وقد وجدوا بالفعل شيئًا يندرج تحت طلبي، لكنهم رفضوا الكشف عنه مجددًا قائلين إنه قد:
- يضر بفعالية سير الشؤون العامة والمصالح التجارية
- يكشف معلومات شخصية أو معلومات سرية
بعد ذلك، وبينما بدا أن كل شيء قد ضاع هباءً، بدا أن استفسارًا منفصلًا قدمته آنا لوزارة التجارة بموجب قانون حرية الوصول للمعلومات سيحقق الاختراق المطلوب.
أربعة أشهر لقول إن الأمر سيستغرق ثلاثة أيام.
عندما يتعلق الأمر بترخيص صادرات الأسلحة، تدرس حكومة المملكة المتحدة قائمة من ثمانية معايير. المعيار الثاني، كما هو معروف، ينظر تحديدًا إلى مدى احترام المشتري – السعودية في هذه الحالة – للقانون الإنساني الدولي. لذلك طلبت آنا معلومات عن مناسبات أثار فيها مسؤولو التجارة أو الخارجية مخاوف تتعلق بالمعيار الثاني بشأن صادرات الأسلحة إلى الرياض. أسفر طلبها عن عدد قليل من التواريخ، ظننا أن هذه بداية جيدة، لكن لم يتطابق أي من هذه التواريخ مع هجوم القاعة الكبرى أو الأيام التي تلته مباشرة. ذكّرتها وزارة التجارة بأن وزارة الخارجية والتنمية هي التي تقدم المشورة بشأن المعيار الثاني، وقالوا لها: “قد ترغبين في الاتصال بهم“.
لكن الوزارة رفضت الإفصاح عن أي معلومات حول طبيعة المخاوف أو عن سلسلة رسائل البريد الإلكتروني بين سكرتير وزارة التجارة آنذاك ليام فوكس ووزير التجارة آنذاك مارك غارنييه في ديسمبر/ كانون الأول 2016، والتي أخبرت وزارة التجارة الدولية آنا بوجودها. لذلك طلبت آنا مراجعة داخلية لرفض الإفصاح عن المعلومات، ثم توجµهت إلى مكتب مفوض المعلوماتK وهو الحَكم النهائي في جميع النزاعات المتعلقة بحرية المعلومات. في كلتا المرتين، تم تأييد حجب المعلومات.
بعد ذلك: العودة إلى وزارة الخارجية (نحن الآن في فبراير/ شباط 2023). بعد رفض طلبين سابقين بسبب التكلفة، اقترحت آنا في طلبها الثالث “النظر في طلب المعلومات المحفوظة في شكل إلكتروني على نظام تكنولوجيا المعلومات المدار مركزيًا التابع لوزارة الخارجية والكومنولث”. وهذا ما فعلته آنا. في نهاية المطاف، أفرجت الوزارة عن بعض المعلومات الأساسية حول عدد التقييمات التي أجرتها للسعودية. وتضمنت أن المسؤولين قد أجروا تقييمات للمعيار الثاني في عدة تواريخ بما في ذلك، وبشكل حاسم، 12 أكتوبر/ تشرين الأول، أي بعد أربعة أيام فقط من هجوم القاعة الكبرى. لكن الوزارة قالت إنها لا تملك أي سجلات تشير إلى أن وزارة الخارجية والكومنولث قد أثارت مخاوف بشأن المعيار الثاني مع إدارات أخرى.
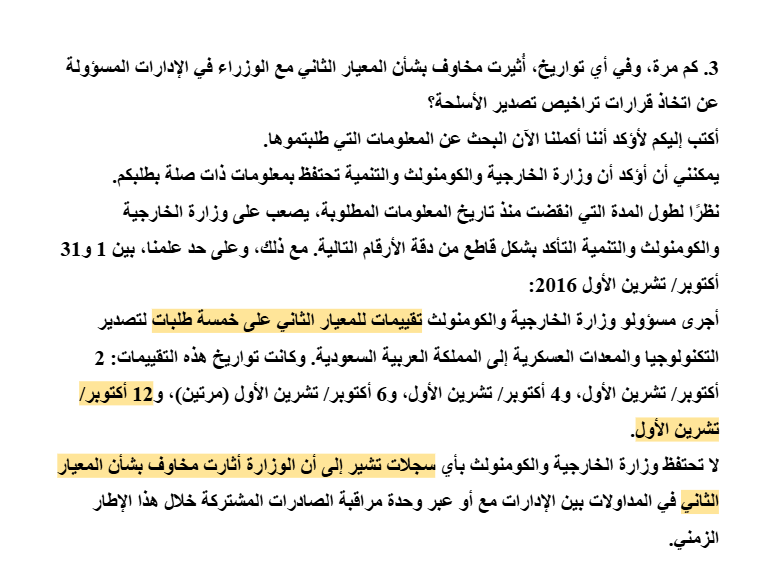
لم تفعل ذلك أيضًا عبر وحدة مراقبة الصادرات المشتركة بين الإدارات، وهي هيئة مشتركة بين الإدارات تُشرف على ضوابط التصدير البريطانية وتراخيص المواد العسكرية وذات الاستخدام المزدوج. ولم يُستشر الوزراء إلا مرة واحدة، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016. ثم تطرقت آنا إلى تفاصيل أكثر. ففي يونيو/ حزيران 2023، طلبت وثائق ومعلومات حول قصف القاعة الكبرى التي أُشير إليها في تقارير إعلامية ووثائق قضائية، ولكن لم تُنشر بالكامل.
شملت هذه الوثائق رسالة من بوريس جونسون إلى ليام فوكس بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016؛ وتحديثًا للقانون الدولي الإنساني تلقاه جونسون، والذي ذكر في تلك الرسالة أنه تلقاه مؤخرًا؛ ومواد أخرى، بما في ذلك طلبات المملكة المتحدة إلى السعودية لإجراء تغييرات على الاستهداف بعد قصف القاعة الكبرى. كانت هناك أيضًا ورقة قرار من عام 2019 تُقدم المشورة للحكومة بشأن قضايا القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تقييم شامل لإجراءات السعودية فيما يتعلق بالمعيار الثاني.
لم تردّ وزارة الخارجية والكومنولث لمدة أربعة أشهر رغم سعي آنا الدائم للحصول على رد. ثم أرسلت لها الوزارة رسالة انتظار فتوجهت إلى مكتب مفوض المعلومات، الذي طلب من الوزارة الإسراع في الرد. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أبلغت وزارة الخارجية آنا أخيرًا أن الطلب مكلف للغاية: استغرق الأمر أربعة أشهر ونصفًا لاتخاذ قرار بأن الرد سيستغرق أكثر من ثلاثة أيام ونصف.
طلبت آنا مراجعة داخلية، وفي يناير/ كانون الثاني 2024 أصدرت وزارة الخارجية والكومنولث نسخة منقحة من “ورقة القرار” لعام 2019 التي سبق مناقشتها في المحكمة، مشيرةً إلى استثناءات الأمن القومي. لكنها لم تُجب على الأسئلة الأخرى التي كانت لدينا. وفي الوقت نفسه، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تقدمت آنا بشكوى أخرى إلى مكتب مفوض المعلومات، واستغرق الأمر من مكتب مفوض المعلومات حتى أبريل/ نيسان 2024 لتخصيص موظف مختص. لم تستجب وزارة الخارجية والكومنولث للتحقيق في غضون ثلاثة أشهر، ثم أخّرت الوصول إلى المواد المحجوبة. تبع ذلك المزيد من التأخيرات وتجاوز المواعيد النهائية “بسبب تعقيدات هذه القضية تحديدًا”، وفقًا لمكتب مفوض المعلومات.
كان أحد العوامل وراء ذلك اشتراط حضور مسؤولي مكتب مفوض المعلومات شخصيًا إلى وزارة الخارجية والكومنولث للاطلاع على المواد المحجوبة، مما أثار تساؤلًا حول صيغة الاحتفاظ بها. وبعد فوات الموعد النهائي المحدد من قبلهم للقضايا المعقدة، وهو 12 شهرًا، أصدر مكتب مفوض المعلومات إشعارًا بالقرار في اليوم السابق لنشر هذه القصة. أيد قرار وزارة الخارجية والكومنولث، لكنه طلب منها تقديم المشورة بشأن كيفية تنقيحه؛ كما طلب من وزارة الخارجية والكومنولث إصدار نفس نسخة ورقة القرار لعام 2019 التي سبق أن نشرتها محكمة الاستئناف ضد تجارة الأسلحة.
ديفيد كاميرون والتستر على غزة
شعرنا وكأننا وصلنا إلى نهاية الطريق لكن بقي خيار أخير: أن نطلب أي معلومات وفرتها لنا الوزارات عند نظرها في طلباتنا على مدار السنوات القليلة الماضية. تُعرف هذه الطلبات باسم “طلبات الوصول إلى المعلومات”، وقد أتاحت أحيانًا رؤيةً خفيةً لعملية صنع القرار الحكومي عندما فشلت الوسائل التقليدية. فعلى سبيل المثال: في عام 2019، أظهرت الوثائق الصادرة بموجب هذا الطلب كيف سارعت وزارة العدل إلى وقف المزيد من التغطية لتقرير تم تسريبه إلى الصحفية في موقع “بازفيد” آنذاك إميلي دوغان، والذي تضمن شهادات من القضاة والمدعين العامين حول ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون اتهامات جنائية دون محامٍ.
صرح المكتب الصحفي لوزارة العدل لموظفيه في وثائق داخلية: “تجنبوا التحدث إلى إميلي دوغان عبر الهاتف بأي تفاصيل أكثر مما هو ضروري للغاية”. وفي العام الماضي، علم الناشط البحريني سيد الوداعي، من خلال طلب وصول إلى معلومات، أن وزارة الخارجية حاولت منع وزارة الداخلية من منحه الجنسية، رغم استيفائه جميع الشروط القانونية، لما قد يؤثر على العلاقات البريطانية البحرينية. لذا، قدمنا طلبات للتحقيق في الكيفية التي تم بها استقبال تحقيقنا، وانتظرنا مرة أخرى.
بحلول أواخر عام 2023، كانت حرب إسرائيل على غزة تتكشف، وشعرنا بتكرار غريب. كانت البنية التحتية المدنية تُقصف، وكان المدنيون في غزة يُقتلون في غارات جوية إسرائيلية ربما استُخدمت فيها أسلحة بريطانية الصنع.

أراد أعضاء البرلمان معرفة: ما هو تقييم وزارة الخارجية؟ في يناير/كانون الثاني 2024، خضع وزير الخارجية المُعيّن حديثًا، ديفيد كاميرون، لضغوط أمام لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما إذا كان قد أُبلغ بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي. قال كاميرون، الذي أشار مرارًا إلى أنه ليس محاميًا: “الإجابة القصيرة على ذلك هي لا”. لكن بعد عشرة أيام فقط، اضطرت وزارة الأعمال والتجارة إلى تقديم وثائق قانونية إلى المحكمة، عقب دعوى رفعتها منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان للطعن في استمرار صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
كشفت هذه الوثائق أن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية أثاروا، منذ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 -بعد شهر واحد من بدء الحرب -مخاوف بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني. وفي الأسابيع اللاحقة، تم تسريب تسجيل صوتي لـأليسيا كيرنز، النائب المحافظة ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية، وهي تؤكد لمتبرعين من حزب المحافظين أن الحكومة تلقت بالفعل رأيًا قانونيًا داخليًا يفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني في غزة لكنها لم تعلن ذلك. وأضافت أن نشر هذه التقييمات رسميًا كان سيؤدي إلى تعليق فوري لصادرات الأسلحة البريطانية.
عند مواجهتها بالتسجيل، لم تنكر كيرنز ما قالته، وأكدت لصحيفة الغارديان: “ما زلت مقتنعة بأن الحكومة أكملت تقييمها المحدث بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وخلصت إلى أنها لا تلتزم به”. في كل مرة كان الستار يُرفَع قليلاً، كان أندرو ميتشل، الوزير الرفيع في وزارة الخارجية في مجلس العموم، يواجه سيلًا من الأسئلة من النواب لتوضيح ما توصل إليه المحامون ومتى ستُعلن نتائجهم (حيث أن كاميرون، بصفته لوردًا، لم يكن بإمكانه الجلوس في الغرفة السفلى).
أسبوعًا بعد أسبوع، كان الوزراء يتجنبون الإجابة. في 26 مارس/ آذار 2024، وبعد أن استشهد ما لا يقل عن 32.414 فلسطينيًا في غزة واتُهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، سأل وزير الخارجية الظل حينها، ديفيد لامي، ميتشل إن كان بإمكانه تقديم “إجابة بسيطة بنعم أو لا” على سؤال واحد: هل تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن الأسلحة البريطانية قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل جرائم حرب؟ رد ميتشل قائلاً إن المملكة المتحدة لديها “نظام صارم لتراخيص تصدير الأسلحة”، وأن التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي يُراجع بانتظام وأن الحكومة “تعمل وفقًا لذلك”. وأضاف أن وزارة الخارجية لن تنشر أي نصائح قانونية.
على الرغم من الوثائق المحكمة، والتسريبات، والأسئلة البرلمانية، ظل أعضاء البرلمان والجمهور غير مدركين لتقييمات وزارة الخارجية وما إذا كانت الحكومة ما زالت تمنح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل دون قيود. أصبحت هذه الأسئلة أكثر أهمية بعد مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة البريطانيين في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على قافلة “المطبخ المركزي العالمي” في غزة في 1 نيسان/ أبريل 2024. وتكهن ناشطو الأسلحة بأن التكنولوجيا العسكرية قد تكون تضمنت محركات صنعت في المملكة المتحدة.

في الواقع، كانت هذه المرة الثانية خلال الحرب التي يتعرض فيها عمال الإغاثة البريطانيون لهجوم من قبل إسرائيل، ربما باستخدام أسلحة مصنوعة في المملكة المتحدة. في حوالي الساعة 6 صباحًا من 18 يناير/كانون الثاني 2024، ألقت طائرة إف-16 قنبلة تزن 1,000 رطل على مجمع في منطقة الموازع كان يضم أطباء بريطانيين، من بينهم آخرون يعملون مع “إغاثة طبية لفلسطين” ومؤسسة “اللجنة الدولية للإنقاذ” الأمريكية التي يترأسها وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد ميلباند.
أصيب عدد من العاملين وحارس شخصي، وتعرض المجمع لأضرار جسيمة. لكن قبل شهر من ذلك، كانت القوات العسكرية الإسرائيلية قد أخبرت الملحق الدفاعي البريطاني في تل أبيب أن الموقع قد تم تحديده كموقع محمي إنساني. وبعد أربعة أشهر، تعرضت قافلة “المطبخ المركزي العالمي” للهجوم.
هل سيغير هذا الهجوم القاتل على مواطنيها في غزة، ربما باستخدام أسلحة مصنوعة في المملكة المتحدة، موقف الحكومة بشأن تراخيص تصدير الأسلحة؟ لم يكن الأمر إلا في 9 أبريل/نيسان 2024، في إجابة على سؤال صحفي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، عندما أوضح كاميرون، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه لم يكن هناك أي تغيير في سياسة المملكة المتحدة بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقد بدا هذا التصريح غير منطقي تمامًا وجانب الحقيقة وكل المعلومات المتاحة علنًا. كان من الصعب تصور أن النصائح القانونية المحدثة قد أصبحت أكثر تأكيدًا بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

بعد خمسة أشهر، في 2 سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا أنها ستعلق حوالي 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن أظهرت المراجعة أن هناك بالفعل خطرًا واضحًا من أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة قد تُستخدم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
كان هذا الخبر قد تصدر العناوين. لكن القصة الأقل بروزًا التي نُشرت في اليوم التالي في صحيفة “الغارديان” كانت هي التي لفتت انتباهنا حقًا. قال شخص ساعد في صياغة النصائح القانونية لوزارة الخارجية إنه تم إبلاغ السياسيين قبل سبعة أشهر بأن إسرائيل كانت تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة. وقد تَرك كاميرون النصائح دون اتخاذ إجراء.
وأشار مصدر لم يذكر اسمه إلى مذكرة أصدرتها حكومة حزب العمال في اليوم السابق، موضحًا سبب تعليق تصدير الأسلحة، وقال إن المذكرة “مشابهة لما كان يتم إرساله إلى الحكومة منذ فبراير/شباط على الأقل”. وقال المصدر: “يجب أخذ المأساة بعين الاعتبار. كم من الأرواح كان يمكن إنقاذها لو تم تعليق تراخيص تصدير الأسلحة حينها وليس في سبتمبر/ايلول، وما هو التأثير المحتمل على كيفية رد فعل البلدان الأخرى في وقف التجارة”.
لقد أثارت القصة نقاشات في مجموعات واتساب الخاصة بالمنظمات التي تعمل في مجال السيطرة على الأسلحة والإغاثة. لكن هذه التفاصيل الأساسية – بأن النصائح من داخل وزارة الخارجية كانت مشابهة لمدة سبعة أشهر في حين استشهد أكثر من 13,000 فلسطيني في غزة – اختفت من الاهتمام العام بمجرد أن خرجت من الصفحة الرئيسية لصحيفة “الغارديان”.
ماذا قالت الحكومة عنا
في خضم كل ما كان يحدث، بدأت طلبات الوصول إلى المعلومات الخاصة بنا في العودة في فبراير/شباط 2024. كان ملف آنا في وزارة التجارة يتضمن بشكل رئيسي لمحة عن عملها مع اللجان البرلمانية والجماعات المعنية بالحملات. أما وزارة الخارجية فكانت أكثر حذرًا في التعامل: “… نحتاج إلى دراسة هذا بعناية في سياق الطلبات السابقة التي قدمتها آنا [تم حجب البيانات] [تم حجب البيانات]، حيث نجحت آنا في استئناف رد على طلب معلومات في عام 2019”. كما تم الإشارة إلى أنه خلال تقديم الأدلة أمام لجنة مراقبة تصدير الأسلحة أنها قد “سيطرت” على الجلسات وكانت “منتقدة بشدة للحكومة”.
من المهم أن نلاحظ أن عملية طلبات الوصول إلى المعلومات يجب أن تكون “مجهولة المتقدم”: لا يُفترض بالمسؤولين أخذ هوية الشخص الذي يطلب المعلومات بعين الاعتبار، حيث تهدف هذه العملية إلى نشر المعلومات في المجال العام. كما أن طلبات الوصول إلى المعلومات وطلبات الوصول إلى البيانات الشخصية يجب أن تُعالج دون الإشارة إلى دوافع المتقدم.
كشفت طلباتي المزيد من التفاصيل. مع مرور الوقت، وعندما قمت بتقليص فترة طلباتي، أظهرت رسائل بريد إلكتروني محجوبة بشدة أن وحدات الوصول إلى المعلومات في وزارة الخارجية ووزارة التجارة كانت على اتصال مستمر مع بعضها البعض.
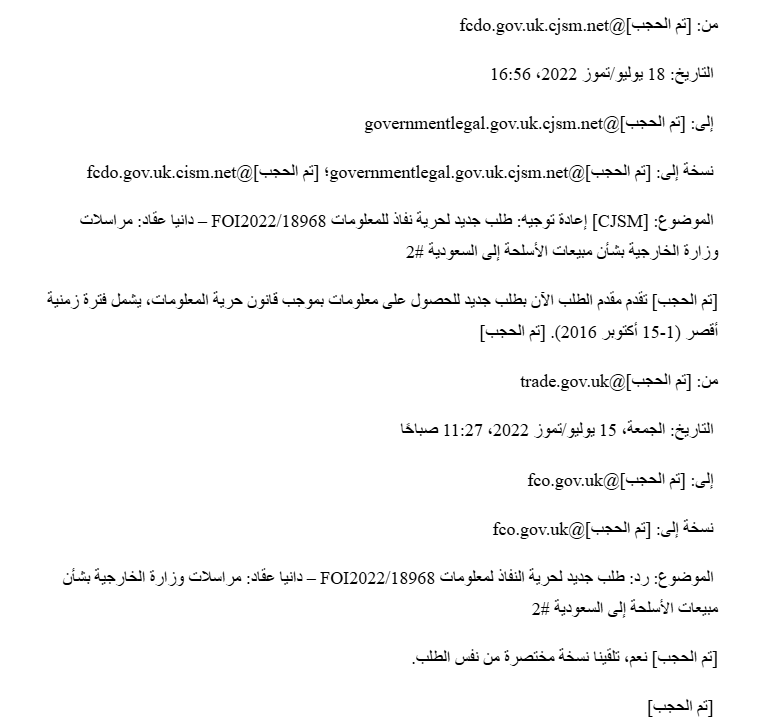
“لقد تلقينا طلبًا جديدًا للحصول على معلومات بشأن تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. الطلب مشابه للذي تلقيناه في مارس/ آذار ولكن مع إطار زمني أضيق”، كتب شخص في وزارة الخارجية، تم حجب اسمه، إلى شخص آخر تم حجب اسمه في وزارة التجارة الدولية في 15 يوليو/تموز 2022.
“في السابق، أصدرنا استثناء بناءً على القسم 12 نظرًا للعرض الأوسع للطلب الأصلي”، أضاف، مشيرًا إلى استثناء التكاليف المفرطة. بعد ثماني دقائق، رد شخص في وزارة التجارة الدولية قائلاً: “نعم، تلقينا نفس الطلب المعدل.” وفي 18 يوليو/تموز 2022، أرسل شخص في وزارة الخارجية بريدًا إلكترونيًا إلى شخصين في قسم الشؤون القانونية الحكومي ملاحظًا طلب الوصول إلى المعلومات الأخير “المتقدم كتب الآن مرة أخرى مع طلب جديد يشمل إطارًا زمنيًا أضيق”.
كما أظهرت الرسائل الإلكترونية أنه كانت هناك بعض المناقشات – وربما حتى التوترات – داخل وزارة الخارجية حول كيفية الرد على الطلب. “من المؤسف أن المتقدم قد اتبع نصائحنا بشأن تعديل الطلب في الرد السابق ونحن الآن نقول إنه لا يمكن تعديل الطلب”، كتب شخص في يوم غير محدد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، سأل شخص في بريد إلكتروني: “هل تأكدت الوزارة تمامًا من أنه لا يمكننا أن نطلب من المتقدم تقليص أي طلب مستقبلي؟”. بعد شهرين، كتب شخص في وزارة الخارجية: “أعتقد أنه من الضروري إضافة بعض الإرشادات حول كيفية تقليص الطلب. إذا أدى هذا إلى شكوى إلى مكتب مفوض المعلومات، فإنهم سيعلقون على نقص المساعدة المقدمة للمتقدم بالطلب”. ردًا على هذا البريد الإلكتروني، قال شخص آخر إنه تم التوصل إلى أنه، بغض النظر عن نطاق التواريخ، سيتم تطبيق الاستثناء بأن الطلب مكلف للغاية لأن ما تم طلبه موجود عبر عدد كبير من الملفات المادية والأوراق المفككة. “هناك نقطة نهائية لهذا النوع من الأنشطة ويبدو أن هذه هي نهايته”.
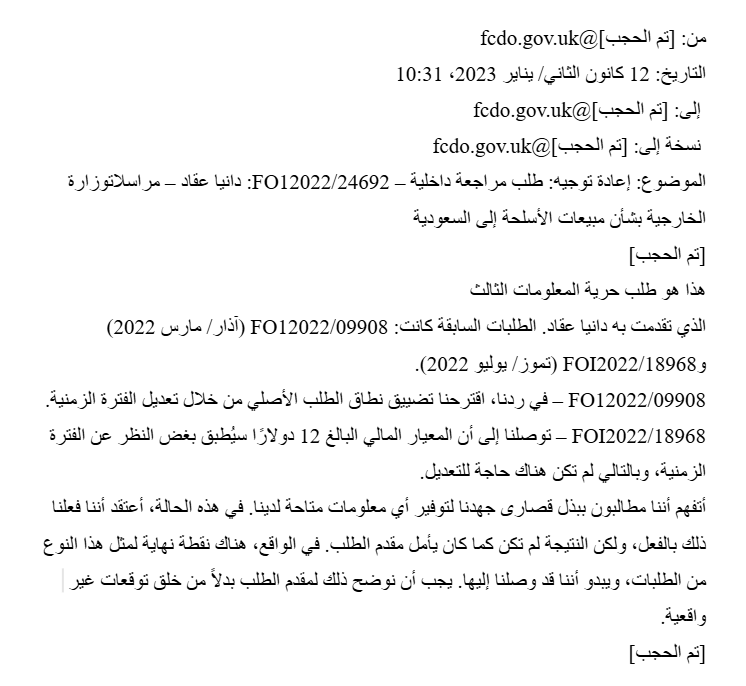
كان مثيرًا لاهتمامنا أن نوع الوثائق التي كنا نطلبها، مثل المراسلات بين الوزراء وفرق وزارة الخارجية ووزارة التجارة التي تمت في عام 2016، كان من المفترض في عصر البريد الإلكتروني والرسائل النصية أن يتم تخزينها في ملفات كأوراق مفككة. ولكن أيضًا مجرد فكرة أن الملفات والأوراق كانت موجودة في مكان ما جعلتنا نعتقد، إذا قمنا بتقديم طلبنا بشكل مختلف، أنه ربما يمكننا الحصول على شيء. لم تكن وزارة الخارجية ستقدم لنا نصائح حول كيفية القيام بذلك. لكن ربما كان من الأفضل أن نجربها للمرة الأخيرة.
التستر على هجوم قاعة العزاء في اليمن
في آخر طلب للوصول إلى المعلومات في أبريل/نيسان 2024، طلبت تحديدًا “قراءات، جداول أعمال، ملاحظات، رسائل إلكترونية، مستندات، تقارير أو أي وثائق أخرى تتعلق بأي اجتماعات عقدت في وزارة الخارجية بين 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 و14 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بشأن قصف التحالف الذي تقوده السعودية لقاعة عزاء في صنعاء في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016”. كانت هذه محاولة أخيرة لتحديد أنواع الوثائق المرتبطة بالاجتماعات التي نفترض أنها قد حدثت بعد الهجوم الجوي.
هذه المرة، حصلت على شيء. في أغسطس/ آب 2024، وصل إلى بريدي الإلكتروني ملخص من 10 صفحات لرسائل إلكترونية محجوبة بشدة تم إرسالها بين المسؤولين في أعقاب الهجوم. في البداية، لم أصدق ما أراه، لكنني بدأت القراءة. حتى مع وجود المقاطع المحجوبة، كان من الواضح من الفوضى البريدية أنه، نعم، كان المسؤولون البريطانيون قلقين صباح ذلك اليوم في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعد يومين فقط من مذبحة العشرات من اليمنيين في جنازة.
فعلى سبيل المثال، تم الإشارة عدة مرات إلى اجتماع عُقد في ذلك اليوم تم وصفه في أحد عناوين البريد الإلكتروني بـ “اجتماع وزير الخارجية يوم الإثنين حول اليمن”، مما يشير إلى أن وزير الخارجية بوريس جونسون كان حاضرًا في الاجتماع. كما ذُكر في الرسائل مجموعة من “المطالبات التي يجب طرحها على السعوديين”، والتي تم التوصل إليها خلال الاجتماع. وكان من المقرر أن يتولى وزير الشرق الأوسط آنذاك توبياس إلوود نقل هذه المطالب خلال زيارته إلى الرياض في ذلك الأسبوع.
تفصّل الرسائل الإلكترونية أيضًا أن شخصًا ما سيتولى “تدوين الملاحظات”، مع وجود إشارة إلى تقرير يتضمن على الأرجح النقاط الرئيسية التي تم تناولها في الاجتماع. وبطبيعة الحال، كنا نعتقد أن هذه الوثائق يجب أن تكون مشمولة في طلبات الوصول إلى المعلومات التي قدمناها، بما في ذلك الطلب الذي قدمته للحصول على محاضر أي اجتماعات حضرها جونسون وإلوود في أكتوبر/ تشرين الأول. ولكننا لم نتمكن من الحصول عليها.
يوم الأربعاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول، أرسل نيل بوش، رئيس قسم شبه الجزيرة العربية وإيران، بريدًا إلكترونيًا إلى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية المعنيين بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى سفراء المملكة المتحدة لدى السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، من بين آخرين.
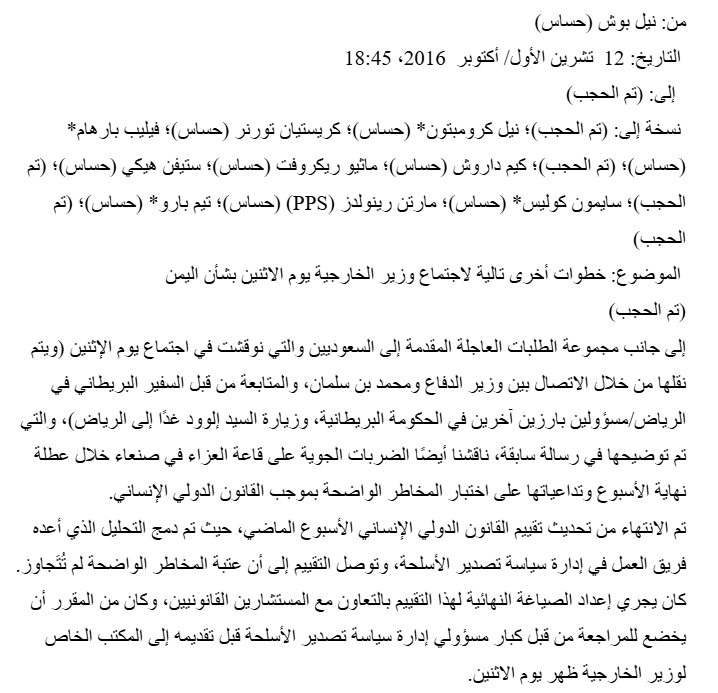
أشار البريد الإلكتروني إلى أن التقييم الأخير لامتثال المملكة العربية السعودية للقانون الدولي الإنساني قد تم الانتهاء منه في الأسبوع الذي سبق الهجوم على قاعة العزاء. علاوة على ذلك، كان من المقرر أن يتم تسليمه إلى المكتب الخاص لوزير الخارجية، بوريس جونسون، بحلول ظهر يوم الإثنين 10 أكتوبر/ تشرين الأول.
كتب بوش أن التقييم “خلص إلى أن عتبة المخاطر الواضحة لم تُتَجاوز، لكن الحكم كان يتسم بتوازن دقيق بشكل متزايد”. وخلال عطلة نهاية الأسبوع التي تلت الهجوم الجوي، تم مناقشة الهجوم على قاعة العزاء في صنعاء وتداعياته على اختبار المخاطر الواضحة في القانون الدولي الإنساني.
كتب بوش: “هجوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول على قاعة العزاء في صنعاء كان تطورًا جديدًا مهمًا، وأوصى المسؤولون بأنه يجب أخذ هذا بعين الاعتبار في تقييمنا للقانون الدولي الإنساني”. وأضاف بوش أن جونسون وافق على ذلك وطلب دمج جميع الحوادث التي وقعت حتى نهاية عطلة الأسبوع في “تقييم محدث”. وكان التقييم المحدث الآن قيد إعادة الصياغة. كتب بوش: “نحن نطور في الوقت نفسه خطة تعامل كإجراء احترازي في حال اعتُبر أن اختبار المخاطر الواضحة قد تم تجاوزه”.
كان هذا أمرًا بالغ الأهمية. لقد أصبحنا نعلم الآن أنه حتى قبل الهجوم على قاعة العزاء، كان السؤال حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية قادرة وملتزمة باتباع القانون الدولي الإنساني محل تساؤل. كما أننا عرفنا أن الهجوم قد دفع إلى إجراء تقييم جديد أو محدث. كان الموظفون الحكوميون قد شعروا بالقلق الكافي بشأن احتمال تجاوز اختبار المخاطر الواضحة لدرجة أنهم أعدوا خطة للتعامل معها أو خطة احتياطية.
مع ذلك، ظل الأمر غير الواضح هو نتيجة هذا التقييم الجديد وكيفية تفسير واستخدام الوزراء لهذه النصائح. وكان أيضًا غير واضح ما تم تحريفه أو حذفه من جميع الرسائل الإلكترونية. لقد أصبح هذا السؤال أكثر إلحاحًا عندما ظهر أحد المبلغين عن المخالفات في فبراير/ شباط 2025، قائلاً إنه كان شاهدًا على صياغة سياسة تصدير الأسلحة البريطانية خلال حرب اليمن واستقال بسبب ذلك.
كتب مارك سميث في صحيفة “الغارديان” أن الحكومة البريطانية تجاهلت النصائح القانونية بوقف بيع الأسلحة للسعودية أثناء الحرب في اليمن. كان سميث مستشارًا رئيسيًا في سياسة مبيعات الأسلحة في وزارة الخارجية، ومكلفًا بجمع المعلومات لتوجيه المستشارين حول ما إذا كانت مبيعات الأسلحة قانونية أم لا.
قال إنه كان هناك اجتماع رفيع المستوى لعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، بمن فيهم المستشارون القانونيون، حيث تم “الاعتراف بأن المملكة المتحدة قد تجاوزت العتبة اللازمة لوقف مبيعات الأسلحة”. وأضاف سميث: “لكن بدلاً من تقديم نصيحة للوزراء بتعليق الصادرات، تم تحويل التركيز إلى إيجاد طرق لـ ‘العودة إلى الجانب الصحيح من القانون'”.
لم يذكر سميث توقيت هذا الاجتماع رفيع المستوى، ولم يرد على طلبي عبر الوسيط لإجراء محادثة قد يقدم خلالها مزيدًا من التفاصيل. مع ذلك، قام سميث بتوضيح الثقافة التي لاحظها داخل وزارة الخارجية، قائلًا إن “المسؤولين يُجبرون على الصمت” لتطوير قواعد تجارة الأسلحة التي “تخلق واجهة شرعية بينما تسمح بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية”.
وأشار سميث إلى أنه تم توجيهه لـ “إعادة التوازن” في تقريره، وأن تقاريره قد تم تعديلها، وأنه تلقى تعليمات شفوية كانت محمية من طلبات الوصول إلى المعلومات. وأضاف أنه طُلب من المسؤولين الذين قدموا نصائح معارضة البحث عن “معلومات إضافية”، وتم تمديد مواعيد تقديم التقارير. وقال إنه شاهد ذلك في حروب اليمن وغزة المتعلقة بمبيعات الأسلحة إلى السعودية وإسرائيل. وبمجرد أن خرج من مجال ترخيص تصدير الأسلحة، تم تحذير سميث من وضع مخاوفه كتابة، وأُمر بحذف أي مراسلات ذات صلة.
ما تعلمناه بعد ثلاث سنوات
كان مقال سميث بمثابة كشف لنا أنا وآنا، حيث بدا كأنه تأكيد لما مررنا به طوال ثلاث سنوات من البحث دون أن نحقق الكثير. نتج عن هذا سؤال مهم: ما الذي تم حذفه من المعلومات القليلة التي حصلنا عليها؟ وما هي النصائح والمعلومات التي لم يتم توثيقها أساسًا؟
منذ ذلك الحين، استفسرت من وزارة الخارجية البريطانية حول ما إذا كان صحيحًا كما ذكر سميث أن المسؤولين البريطانيين قد أقروا بتجاوز المملكة المتحدة العتبة القانونية لوقف مبيعات الأسلحة. وإذا كان الأمر كذلك، فهل كان ذلك نتيجة لهجوم قاعة العزاء؟ كما استفسرت عن نتائج التقييم الذي تم طلبه مباشرة بعد الهجوم على قاعة العزاء.
في ردها، قدمت وزارة الخارجية البريطانية الإجابة المعتادة التي سمعناها مرارًا: “يتم تقييم كل طلب ترخيص تصدير بعناية وفقًا لحالة كل طلب بناءً على معايير الترخيص الاستراتيجي للصادرات. “لن نقوم بإصدار ترخيص للتصدير إذا كان ذلك يتعارض مع المعايير، بما في ذلك إذا كان هناك خطر واضح من أن هذه المواد قد تُستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”.
وبعد ثلاث سنوات من البحث، بدأنا نعتقد أنه لا يوجد دليل قاطع عندما يتعلق الأمر بتقييمات القانون الدولي الإنساني التي تستند إليها تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية. ليس بسبب غياب الاعتراضات داخل الدولة، بل لأن أي اعتراض يتم إسكاته من خلال المناورات البيروقراطية والتوجيهات السياسية.
في الحالات النادرة التي توجد فيها أدلة قاطعة، مثل شهادة سميث المدعمة حول تجاهل الحكومة للنصائح خلال حرب اليمن، فإن تلك الأدلة تصبح غير ذات تأثير عندما يتضح أنه من الصعب محاسبة الأفراد وآلية الدولة. ومن المفارقات أنه في الوقت الذي كان سميث يسعى للدفاع عن قدرة المسؤولين على “تقديم النصائح الموضوعية دون خوف من التدخل السياسي”، كانت الحكومة تستخدم بشكل مستمر استثناء “النصيحة الحرة والصريحة” لإخفاء المعلومات عن الجمهور وفقًا لقانون حرية النفاذ للمعلومات.
هذه تصرفات حكومة تعمل على قمع التزامات موظفيها المهنية وحقوق الجمهور في المعرفة. ولا يقتصر ذلك على الحكومة الحالية: بدأنا بحثنا تحت حكومة سابقة، وكان التوجه نحو مبيعات الأسلحة مشتركًا بين حزب العمال والمحافظين، الذين حكموا من عام 2010 حتى يوليو/تموز من العام الماضي. وبدلًا من ذلك، استمر معظم ما تعلمه الجمهور في التوارد عبر القضايا القضائية والمبلغين عن المخالفات.
كيف تصرف المسؤولون البريطانيون بعد أن قام التحالف الذي تقوده السعودية بقتل 155 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 525 آخرين كانوا يحضرون جنازة مكتظة في اليمن في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016؟ لقد جعلنا التأخير والإنكار والتحويل الذي شهدناه نستنتج أن الحكومة تعمدت تجاوز القانون لتواصل بيع الأسلحة. لكننا لا نزال غير قادرين على تأكيد ذلك بشكل قطعي.
المصدر: ميدل إيست آي









