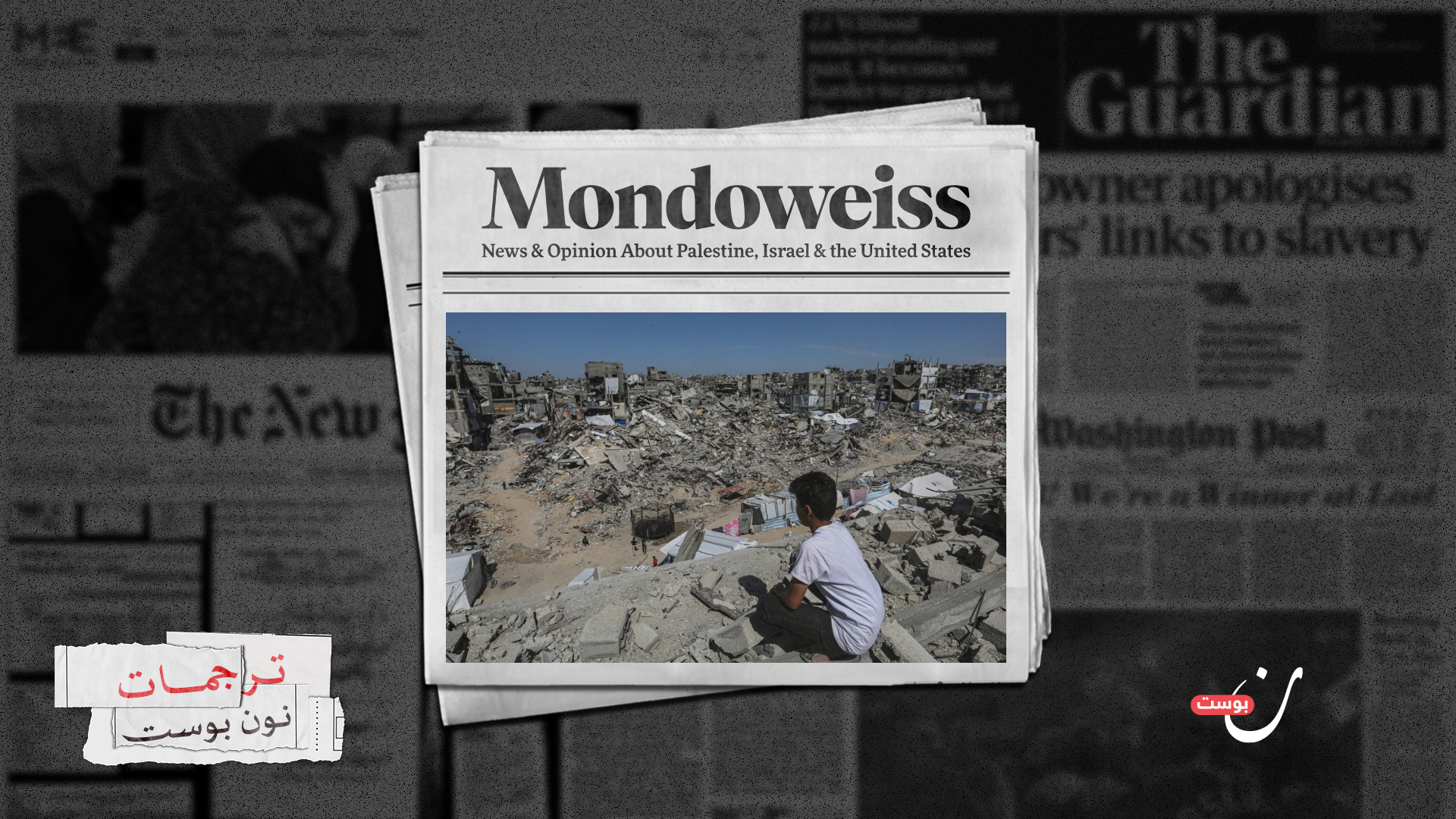ترجمة وتحرير: نون بوست
كثيرًا ما يُستحضر مفهوم الاستثنائية لشرح “القضية الفلسطينية” داخل النظام الدولي. تُصوّر فلسطين على أنها حالة شاذة: مشروع استعماري استيطاني عفا عليه الزمن، يقوم على الفصل العنصري والاحتلال وممارسات الإبادة الجماعية في عالم ما بعد الاستعمار. وبالتالي، يُعتبر عنف إسرائيل وممارساتها غير القانونية وإفلاتها من العقاب استثناء في نظام دولي يستند إلى قيم مشتركة ومؤسسات محايدة وإطار معياري عالمي.
لكن هذه الرواية مضللة بشكل خطير، فهي تخفي بين طياتها تجذر الاستعمار في النظام العالمي الحديث. وبعيدًا عن كونها حالة شاذة، فإن فلسطين تكشف الأسس الاستعمارية للعلاقات الدولية. ممارسات إسرائيل الاستعمارية ليست حالة شاذة في عالم عادل ومنصف؛ بل هو التجسيد الأوضح لنظام عالمي مصمم ومُهيكل لدعم آليات “النيوكولونيالية” وحمايتها وإضفاء الشرعية عليها.
البنية الاستعمارية للقانون الدولي
لقد استُحدث القانون الدولي لإضفاء الشرعية على استعباد الملايين من الأفارقة، والغزو الاستعماري لما يسمى “العالم الجديد”، ولإخضاع شعوبه الأصلية اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا. وعلى مدار أكثر من 500 عام، نظم القانون الدولي ممارسات الاستغلال والتهجير الأوروبية، وعمل على التوسط بين القوى الإمبريالية المتنافسة وإضفاء الشرعية على التوسع الإقليمي.
يتجسد ذلك في أعمال فرانسيسكو دي فيتوريا وهوغو غروتيوس، وهما من آباء القانون الدولي. أرسى تصورهما لـ”القانون الطبيعي” معيارًا للحضارة يستند إلى أنماط الحياة الأوروبية كمعيار لتعزيز الغزو الإقليمي وقمع الشعوب غير الأوروبية.
ووفقًا لهذا المعيار، كان من حق “المتحضرين” غزو الدول الأخرى واستعباد “غير المتحضرين” واستغلالهم وإخضاعهم وإبادتهم، وأصبحت أي وسيلة مقاومة يتخذها “غير المتحضرين” مرادفًا للوحشية والإرهاب، وأصبح معيار الحضارة يتمثل أساسًا في القوة المؤسسية للاستعمار.
تطور القانون الدولي مع مرور الزمن وتكيف مع الأشكال الاستعمارية الجديدة. ما يزال النظام العالمي الذي انبثق من رماد الحرب العالمية الثانية محكومًا بالقوى العظمى ومصالحها، لكن يتم تصويره كنظام عادل ومنصف تحت واجهة الشرعية الدولية التي تضمنها مؤسسات دولية مستقلة بقيادة الأمم المتحدة.
يكشف عن هذه الاستمرارية ترسيخ نظام الأقاليم المشمولة بالوصاية في ميثاق الأمم المتحدة، والاعتماد على نظرية المركزية الأوروبية في تدوين المعاهدات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اتفاقية الإبادة الجماعية وغيرها من المعاهدات. لقد أعيد “تغليف” المعيار القديم للحضارة، وتُرجم إلى ثنائيات جديدة أكثر قبولًا مثل الديمقراطية مقابل الاستبداد، والتقدم مقابل التخلف، والليبرالية مقابل الانغلاق.
أصبحت المُثُل الأوروبية، مثل الديمقراطية والتنمية والليبرالية الاقتصادية المبرر الجديد للسيطرة على المناطق والشعوب الأخرى واستغلالها. يعد حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التجسيد الأكثر وضوحًا لهيمنة القوى العظمى على نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية.
لم تُحقق موجة إنهاء الاستعمار التي امتدت من خمسينيات إلى سبعينيات القرن الماضي سوى استقلال شكلي، إذ ظلت المستعمرات السابقة أسيرة أشكال جديدة من الهيمنة، وتم طمس الاستقلال السياسي بأشكال من التبعية الاقتصادية المستمرة التي مورست من خلال المؤسسات المالية، واتفاقيات التجارة غير العادلة، والشركات متعددة الجنسيات التي تستخرج الثروات، والتي عززتها برامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقد وصف الرئيس الغاني السابق والمنظر السياسي كوامي نكروما هذه المرحلة بأنها فترة انتقال من الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستعمار الجديد.
تم إضفاء الشرعية على هذه التبعية الاقتصادية من خلال سرديات أيديولوجية صوّرت التنمية الرأسمالية على أنها مُعادل للمعايير العالمية لحقوق الإنسان، مُخفيةً بذلك أجندتها الاستغلالية. لقد بشّر القانون الدولي والمؤسسات الدولية في الجوهر باستقلال رمزي، لا تحرر مادي من الاستعمار.
الحق في الكفاح المسلح
تعكس قوانين الحرب، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، هذا التناقض. إن التظاهر بتنظيم الكفاح ضد الاستعمار في ظل الأطر القانونية نفسها التي تحكم النزاعات بين الدول يعيد إنتاج الخلل المتأصل في توازن القوى بدلًا من التخفيف من حدته.
هذا النهج، وإن بدا عالميًا في تطبيقه، إلا أنه يفترض تكافؤًا قانونيًا شكليًا بين المستعمِرين والمستعمَرين، بين قوة الاحتلال ومن يقاومون الهيمنة. لا تراعي هذه المعايير أوجه عدم المساواة الهيكلية وديناميكيات القوة التي تحدد العلاقات الاستعمارية، ومن خلال إخضاع المقاومة للقيود القانونية التي تخضع لها جيوش الدول، تحجب هذه الأطر القانونية الظروف المادية والتاريخية للقمع الاستعماري.
علاوة على ذلك، تنزع هذه القواعد القانونية في كثير من الأحيان الشرعية عن المقاومة وتجرّمها، وتحافظ على الهيمنة الهيكلية للمستعمِر. على سبيل المثال، لا يأخذ مبدأ التمييز -الذي يهدف إلى حماية المدنيين- في الاعتبار بشكل كافٍ أن الأنظمة الاستعمارية تطمس الخطوط الفاصلة بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولا يعالج العنف المتأصل في الاحتلال نفسه.
وبالمثل، فإن حظر بعض أساليب الحرب يقيد بشكل غير متناسب حركة أولئك الذين يقاومون الحكم الاستعماري، ويحد من وسائل دفاعهم عن النفس، بينما يحافظ على تفوق المستعمِر عسكريا.
وبالتالي، فإن هذا الإطار القانوني لا يعمل بشكل محايد لتحقيق العدالة، بل يمثل آلية لترسيخ ديناميكيات القوة ذاتها التي يدعي أنه يعمل على تقنينها. ومن خلال حصر العنف والأطراف المتنازعة داخل إطار من التكافؤ الزائف، تمكّن هذه المعايير القوى الاستعمارية من تصوير الشعوب المستعمَرة على أنها لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي، وبذلك فإنها تجعل حروب التحرير المناهضة للاستعمار مستحيلة ضمن هذه المعايير الدولية.
حرب القانون الدولي على فلسطين
تجسد قضية فلسطين جوهر الهيمنة في القانون الدولي؛ فقد نشأت الأيديولوجية الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية ضمن الإطار السياسي والاقتصادي لتاريخ أوروبا الإمبريالي، ولا تزال تعمل في هذا الإطار، وتكرس وجودها كجزء لا يتجزأ من النظام الدولي نفسه.
لقد قسَّم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 فلسطين، وأضفى الشرعية على نزع ملكية الأراضي، ورسَّخ الاستعمار الاستيطاني في القانون الدولي. ورغم أن القرار كان معيبًا من الناحية القانونية؛ حيث تجاوز سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يكن ملزما، إلا أنه أصبح أساسًا لشرعنة وجود إسرائيل والإرث الاستعماري للنظام الدولي.
وهكذا يعكس تاريخ فلسطين الحديث هذه الجدلية بين أنظمة الهيمنة المقننة دوليًا ومقاومة الإطار الاستعماري الذي تقوم عليه تلك الأنظمة.
رسخت اتفاقيات أوسلو هذه الثنائية تحت ستار “مفاوضات السلام”، في خطوة سياسية لتعزيز الاحتلال الاستيطاني وإطفاء جذوة المقاومة الفلسطينية وتعزيز طموح إضفاء الشرعية على الصهيونية من الفلسطينيين أنفسهم.
من خلال هذه الاستراتيجية وسردية “المقاربة البراغماتية”، يقدم المجتمع الدولي الاستعمار الاستيطاني على أنه “حل عادل ومنصف” يقضي على حقوق وتطلعات السكان الأصليين في التحرر والعدالة والعودة إلى الأرض.
وفي هذا الإطار، تترسخ السيطرة الاستعمارية والقمع من خلال التبعية الاقتصادية والسياسية النيوليبرالية التي تطبّع مع العنف والهيمنة تحت ستار بناء الدولة، كما أنها تضفي طابعًا رسميًا على العلاقة الاستعمارية من خلال خلق طبقة متواطئة من المستعمَرين – السلطة الفلسطينية – واستخدامها كحارس للسلطة الاستعمارية، مما يعزز في نهاية المطاف بنية العنف الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي.
إن حملة الطرد الجماعي والتدمير المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في شمال الضفة الغربية – وهي الأكبر منذ عام 1967 – بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تقدم دليلًا صارخًا على هذا الواقع المستمر.
وليس من قبيل المصادفة أن يتجدد الحديث عن مشروع دولة فلسطينية في كل مرةٍ تتعرض فيها القوة الاستعمارية لتهديد وجودي وتتجدد التعبئة لإنهاء الاستعمار، مما يسلط الضوء على حدود النظام الدولي وتناقضاته على المدى الطويل.
إن الدعوات لتأسيس دولة فلسطينية هي استمرار تاريخي لتقسيم فلسطين، واللحظة الراهنة تشهد على ذلك: في ظل الإبادة الجماعية التي تُبث على الهواء مباشرة، فإن الاستراتيجية الوحيدة التي يُعاد طرحها على المستوى الدولي هي الإشارة إلى “الحلول الشرعية” و”الأطر القانونية” التي لا تشكك في الأسس الاستعمارية الاستيطانية لنزع ملكية الفلسطينيين، بل تعتبرها أمرًا واقعًا.
وهذا مسارٌ استراتيجي مقنّع يهدف لتطبيق آليات المساءلة والعدالة من خلال تدخل المؤسسات الدولية التي لا تعد “أطرافًا محايدة”، بل أدوات للهيمنة الاستعمارية.
من الأمثلة الرمزية في هذا السياق مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، والتي صدرت في البداية ضد إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، ما لم يُقتلوا على يد السلطة الاستعمارية ذاتها التي كانا يقاتلان ضدها قبل التصديق على المذكرات.
وبينما أشاد العالم بهذا القرار -الذي يفتقر إلى آليات التنفيذ- باعتباره قرارا تاريخيًا، إلا أنه لم يكن سوى أداة لتكريس علاقات القوة غير المتكافئة بين المستعمَر والمستعمِر، والمساواة بين قادة المقاومة المناهضة للاستعمار، وسلطات الدولة التي أمرت ونفذت مجازر استعمارية لإبادة شعب بأكمله والقضاء عليه. هذه “الازدواجية”، والإصرار على “الحياد” المزعوم، أصبحا القاعدة التي تكبح أي محاولة لإدانة عدم تكافؤ القوة وإيقاف هذا المسار.
لقد حيّدت الأسس الاستعمارية للقانون الدولي علاقة المستعمَر بالمستعمِر، وأغرقتها في دوامة من التحيز للطرف الأقوى، والذي لا يُمسك فقط بمقاليد القوة، بل يمتلك أيضًا سلطة سرد الأحداث من منظوره الخاص.
تفكيك الاستعمار
إن استعمار فلسطين ليس حالةً شاذة في هذا النظام العالمي، بل هو الإدانة الأوضح له، فهو يفضح نفاق النظام الدولي الذي يندد بالاستعمار خطابيًا، بينما يضفي عليه طابعًا مؤسسيًا وشرعيًا وعمليًا.
لطالما أعطت أطر القانون الدولي والحوكمة الدولية، التي صممتها القوى الاستعمارية واستغلتها لصالحها، الأولوية للحفاظ على تراتبية القوة تحت ستار الشرعية والعدالة، بما يجعل من الاستعمار الاستيطاني دعامة شرعية للعلاقات الدولية.
منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم التشكيك بشكل جوهري في عالمية النظام الدولي، والكشف عن تناقضاته العميقة.
ظهرت بشكل واضح محدودية القانون الدولي وآلياته، واصطفافه المستمر مع الهيمنة الاستعمارية وإفرازاتها الطبيعية: الامتيازات العرقية وعدم المساواة الممنهجة وتراكم رأس المال.
تستدعي هذه اللحظة التاريخية إعادة تقييم نقدي للأطر المفاهيمية والعملية التي تقوم عليها العدالة والتحرر. يقول أودري لورد إن “أدوات السيد لن تفكك بيته أبدًا. قد تسمح لنا مؤقتًا بالتغلب عليه في لعبته، لكنها لن تمكننا أبدًا من إحداث تغيير حقيقي”.
إن المضي قدمًا نحو عالم أفضل يتطلب تحولًا هيكليًا عميقًا، وتحولًا يعالج ويفكك أنظمة القانون الدولي والحوكمة الدولية الراسخة التي تكرس القمع، مع ضرورة استبدالها بنماذج أخرى ترسخ المساواة الحقيقية والنضال المشترك والعدالة المناهضة للاستعمار.
يجسد النضال الفلسطيني من أجل التحرر هذا التحدي الكبير، مما يفرض مواجهة الأسس الاستعمارية للنظام العالمي، من أجل عالم تتجاوز فيه العدالة الشعارات، وتصبح واقعًا يتسع للجميع.
المصدر: موندويس