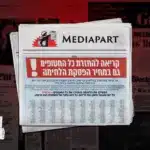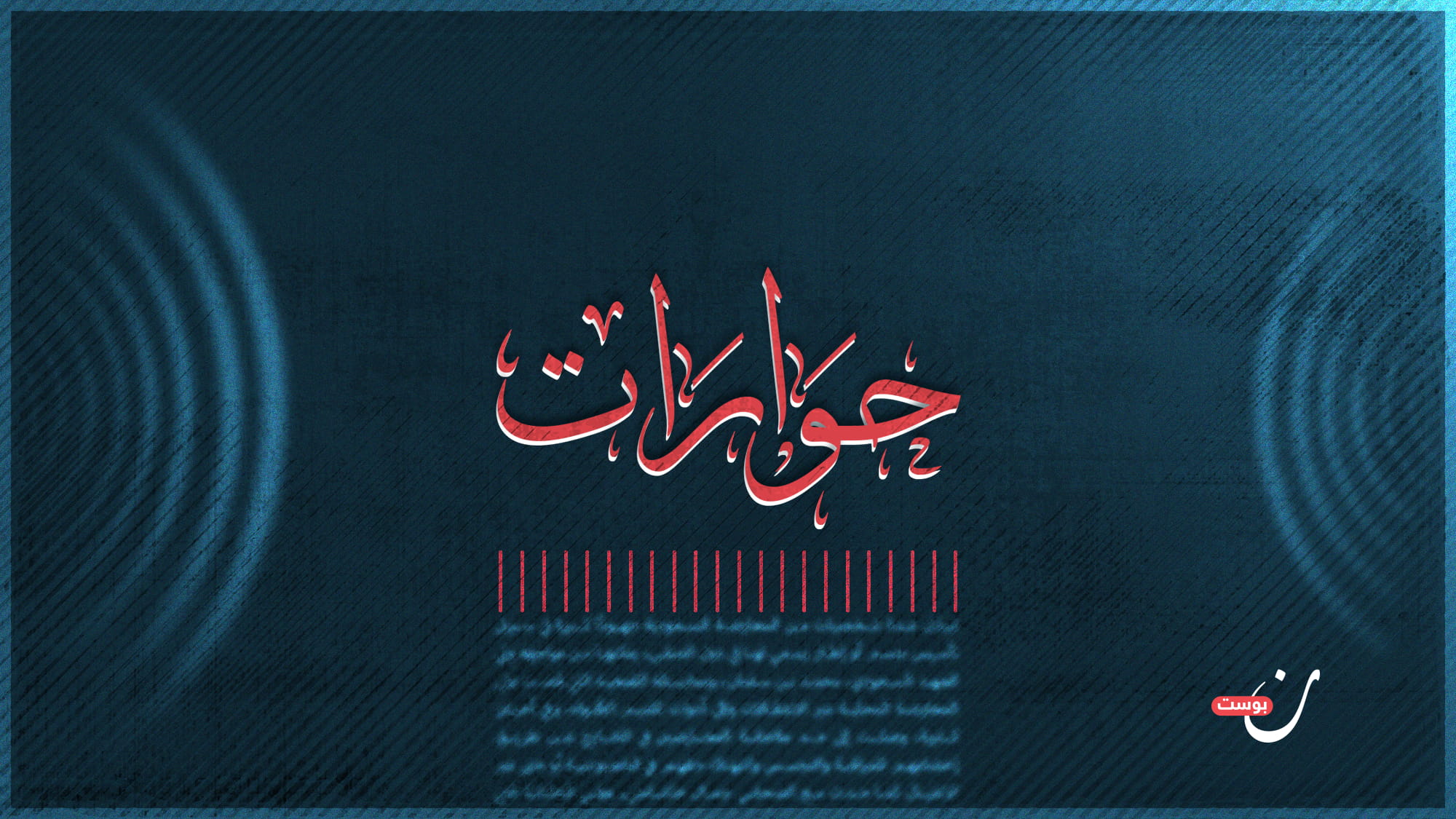في زمنٍ تحوّلت فيه الحروب إلى أرقام وإحصائيات وأخبار مختزلة، يُصرّ الكاتب الفلسطيني يسري الغول، الذي اختار البقاء في شمال قطاع غزة رغم القصف والمجاعة، على أن يكون للصمود وجهٌ ثقافي وكلمةٌ لا تُنسى، حاملاً قلمه كوسيلةٍ للبقاء، ورافعًا صوته دفاعًا عن الحكاية الفلسطينية.
لم يُغادر يسري الغول شمال القطاع قط، بل بقي هناك، متنقلًا من محطة خطر إلى أخرى، وسط الدمار والجوع والقصف، من دون أن يتوقف قلمه عن الكتابة، ولا صوته عن التعبير. ظلّ وفيًّا لدور المثقف الحقيقي، الذي لا يكتفي بالرواية من بعيد، بل يعيش التفاصيل ويكتبها من قلب المعاناة، معبرًا عن نبض الناس، ومدافعًا عن روايتهم، ومُصرًّا على أن يكون للصمود صوتٌ ثقافي يُحاور العالم بلغته ومفرداته.
في هذا الحوار الخاص مع “نون بوست”، نتوقف مع الغول عند محطات من تجربته الشخصية خلال الحرب، ونسأله عن المشهد الثقافي في غزة، والسردية الفلسطينية، وتقييمه لموقف المثقفين العرب، ومشاهد إنسانية اختزلت الألم الفلسطيني العابر للأرقام والعناوين.
كيف يبدو المشهد الثقافي في غزة اليوم تحت وطأة الحرب؟ وهل بقي للثقافة مساحة تتحرك فيها رغم الموت والدمار؟
اليوم، تركّز اهتمام المواطن الفلسطيني في قطاع غزة على تأمين ضروريات الحياة الأساسية؛ من مأكل ومشرب، في ظل انهيار شبه كامل للمؤسسات التعليمية، وغياب تام تقريبًا للمؤسسات الثقافية. ومع ذلك، هل ما زال هناك متسع للثقافة وسط هذا الدمار؟ نعم، بالتأكيد.
الثقافة لم تكن يومًا حكرًا على الفعاليات الرسمية، أو طباعة الكتب، أو تنظيم الندوات الجماعية. إنها تتجلى في الجهود الفردية، في الروايات والقصائد التي تُكتب، في المقالات التي تُنشر في كبريات الصحف العالمية، وفي الحملات الطلابية التي تُحرّك الجامعات حول العالم.
هذه كلها أشكال من الفعل الثقافي، وإن بدت غير منظمة، لكنها تشكّل امتدادًا عضويًا للهوية الفلسطينية، تلك الهوية التي تأبى الاندثار، لأن الوجود الفلسطيني ذاته متجذر في ثقافته.
اليوم، الصمود بات ثقافة، والبقاء على الأرض في حد ذاته فعل ثقافي مقاوم، يحمل في جوهره رسالة أعمق من كل بيان.
هل ترى أن الأدب والفن قادران على الصمود والاشتباك مع الواقع في مثل هذه اللحظات المفصلية؟ وكيف؟
بالتأكيد، الأدب والفن يمثلان أدوات فاعلة من أدوات الصمود. فبدونهما، تصبح قيمة النخبة الثقافية لا تساوي شيئًا. لا معنى للمثقف إذا لم يكن قادرًا على التأثير في الشارع.
نحن اليوم ما زلنا نقرأ غسان كنفاني، ومحمود درويش، وناجي العلي، وهارون هاشم رشيد، وتوفيق زياد، وسميح القاسم وغيرهم من كبار الكتّاب والشعراء، لأنهم شكّلوا وجدانًا وهوية.
الثقافة هي الهوية. القصيدة تمثل هوية الفلسطيني، كما تمثلها الرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو، والدراما، والسينما، والمسرح. لذلك، نعم، الفن قادر على تعزيز الصمود، بل إنه أحد أبرز أدواته.
ومن هذا المنطلق، وجّهنا كثيرًا من اللوم للأدباء والكتّاب الذين غادروا غزة ولم يصمدوا فيها. بعضهم خرج حتى من المحيط الفلسطيني بالكامل، وللأسف، لم يقوموا بدورهم في تعزيز صمود الناس. بل إن بعضهم شجّع على الخيارات الفردية، بدلًا من الانحياز لفكرة الصمود الجمعي، ولم يدركوا أهمية هذا الصمود في مواجهة الرواية الصهيونية، والعمل على إفشال مشروع التهجير.
لم تغادر غزة طوال الحرب، وتحديدًا شمالها الذي عاش شهورًا من الحصار والتجويع والقتل.. كيف تصف هذه التجربة؟
نعم، عشنا تجربة الجوع بكل تفاصيلها القاسية. لم أغادر شمال غزة رغم المحاولات، وسأسرد هذه التجربة بتفصيل أكبر في كتابي القادم بعنوان “نزوح نحو الشمال – من يوميات الحرب على غزة”، حيث أتناول فيها هذه المرحلة المؤلمة بإسهاب، لأن ما مررنا به لا يمكن اختصاره في هذا الحوار لكثرة التفاصيل ومرارة التجربة.
عشنا الجوع بكل معانيه، وعانينا الأمرّين. اضطررنا لأكل علف الحيوانات، ولم نجد ماءً للشرب. جدتي كانت تشرب الماء المُقطر الخارج من مكيف الهواء في مقر إحدى المؤسسات الدولية التي حُوصرت فيها، وهو ماء ملوث قد يهدد حياة الإنسان. كنا نشرب مياهًا مالحة كملوحة البحر، وهذه لم تكن حالات استثنائية، بل جزء من واقعنا اليومي.
لكن رغم ذلك، لم يكن أمامنا خيار سوى الصمود. لأن الخروج من شمال غزة، أو مغادرة القطاع عمومًا، كان يعني القبول بتنفيذ “خطة الجنرالات” وخطط التهجير التي تهدف إلى دفع سكان الشمال نحو الجنوب، ومن ثم إلى سيناء ومناطق أخرى. بقينا لنُفشل هذا المخطط، لأن البقاء بحد ذاته كان فعل مقاومة.
ما أصعب اللحظات التي عشتها خلال الحرب؟ وهل تغيّر شيء فيك ككاتب وإنسان بعد هذه التجربة؟
اللحظات الصعبة كانت كثيرة جدًا. استُشهد لي الكثير من الأصدقاء، وتعرضنا للاستهداف أكثر من مرة. بيتي دُمّر بالكامل، مكتبتي مُسحت عن الوجود، كُتبي أُحرقت ودُمّرت. حتى آلة الجيتار والكمان – تلك التي كنت أحتفظ بها في منزلي – طالها حقد الاحتلال، فحطموها وكأنهم يريدون كسر كل ما يمتّ للجمال بصلة.
الصعوبة لم تكن لحظة واحدة، بل كانت حاضرة في كل تفصيلة: في النزوح، في الانتقال من حيّ النصر إلى مخيم الشاطئ غرب غزة، ومنه إلى جباليا، وبين هذه المحطات كنا نمر بلحظات موت حقيقي.
كنا نُستهدف، ونشاهد شبابًا يُقنصون على مقربة منّا، ونمشي ونحن نعلم أن كل خطوة قد تكون الأخيرة. كانت كل حركة في هذه الحرب أشبه بالسير بين شظايا الموت الذي يخيّم في كل زاوية.
وحتى هذه اللحظة، لا تزال المعاناة مستمرة، ولا تزال لحظات الصعوبة تتجدد. هذه التجربة بالتأكيد تركت أثرًا في داخلي، كإنسان أولًا، وككاتب يسعى لأن يُترجم هذا الألم إلى سردية تحفظ الحقيقة، وتواجه المحو.
كيف تقيّم التزام وتضامن الكُتّاب والأدباء العرب مع غزة وقضية الإبادة؟
للأسف، تم إشغال النخبة العربية بهموم الحياة اليومية، وإلهاؤها بحوافز لا ترقى إلى مستوى القضايا القومية والوطنية الكبرى التي يفترض أن تكون محور اهتمامها.
قيمة النخبة، وقيمة الأديب، تتجلى في مواقفه، لأنه من المفترض أن يكون صمّام الأمان للمجتمع. لكن المؤسف أن المثقف العربي أصبح رهينة للجوائز، وفرص السفر، والرواتب، والمحفزات المادية والمناصب.
تقييمي للموقف الثقافي العربي، للأسف، يتجاوز وصفه بالضعف الشديد، ليصل إلى مرحلة الموت السريري. المثقف العربي خذلنا كثيرًا. ونأمل أن تصل هذه الرسالة كصرخة مدوية، كطرق على جدران الخزان: “أيها العربي، قم من رمادك، حفّز المجتمعات العربية على الثورة في وجه هذا الظلم”.
الأنظمة العربية قادرة على وقف الإبادة، لو أرادت. ويكفي أن تطرد دول الطوق – على الأقل – السفراء والقناصل والمكاتب الدبلوماسية التابعة لدولة الاحتلال، أو التابعة للدول المشاركة والداعمة للإبادة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي تزوّد الاحتلال بالسلاح وتوفّر له الغطاء.
أؤمن أن المثقف قادر على لعب دور فاعل؛ أن يرفع صوته، أن يطالب دول الخليج بوقف تصدير النفط، أن يحشد المظاهرات في الشوارع والجامعات. من المفترض أن يكون صوت المثقف هو صوت الإنسان المقهور، لا أداة في يد السلطة، بل على النقيض منها، مهمته تقويمها لا خدمتها.
كيف ترى تطوّر السردية الفلسطينية خلال هذه الحرب؟ هل استطاعت أن تعبّر عن الواقع وتخترق جدران السردية الإسرائيلية والعالمية؟ وما أبرز نقاط القوة والضعف في السردية الفلسطينية اليوم؟ وما المطلوب لتكاملها بشكل يخدم القضية الفلسطينية؟
السردية الفلسطينية خلال هذه الحرب كانت قوية جدًا، ونجحت في إيصال رسائلها إلى العالم، لكنها للأسف ليست ثابتة ولا مضمونة الاستمرارية. لقد استفادت بشكل كبير من أدوات التواصل الاجتماعي، وهي أدوات فاعلة لكنها متغيرة، وتتأثر بسياق الثورة التكنولوجية وسرعة العصر، مما يجعل تأثيرها عابرًا ومرتبطًا بثقافة “الترندات”.
نعم، استطاعت السردية الفلسطينية أن تؤثر على الرأي العام العالمي، وكان ذلك جليًا في حراك الجامعات الغربية، والذي جاء نتيجة جهود نشطاء وطلاب جامعات متعلمين وواعين. لكن لا يزال ينقصنا القدرة على إدارة الحوار والمناظرة مع الغرب، الذي يحمل ثقافة مختلفة عن ثقافتنا.
هذا النوع من الاشتباك يحتاج إلى تفكيك عميق للرواية المقابلة، وتدريب على تقديم السردية الفلسطينية بشكل متماسك، بحيث نراكم على ما تحقق بدل أن نكتفي به.
أستطيع القول إننا نجحنا في مواجهة السردية الإسرائيلية بل وتجاوزها في كثير من المحافل، لكن هذا النجاح بحاجة إلى تعميق وتطوير. الفلسطيني يجب أن يكون مثقفًا، قادرًا على فهم الآخر، وأن يُقدّم قضيته بلغة تخاطب الوجدان العالمي وتنسجم مع أهمية عدالة قضيته. فكلما ارتفعت قدرة الفلسطيني على التعبير الواعي، اتسعت دائرة التضامن.
أما عن نقاط الضعف، فهي عديدة، أهمها غياب العمل الجماعي والتكامل بين الجهود. كذلك هناك ضعف واضح في استثمار اللغات العالمية في تقديم السردية الفلسطينية. صحيح أن اللغة الإنجليزية مهمة، لكنها ليست كافية. نحتاج إلى إيصال صوتنا بالفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الصينية وغيرها من اللغات التي تخاطب شعوب العالم.
المطلوب اليوم هو أن نُؤسس لسردية فلسطينية شاملة، مدروسة، متينة، عابرة للغات والمنصات، تتكامل فيها الجهود الثقافية والإعلامية، وتكون قادرة على بناء جسر متين بين مظلومية الشعب الفلسطيني ووعي الشعوب الحرة حول العالم.
من واقع تجربتك في شمال غزة، ما المشاهد التي لا تزال تسكنك ولا يمكن أن تنساها؟
أكثر المشاهد التي لا تفارقني هي مشاهد الدمار. بيتي دُمّر بالكامل، وحتى البيت الذي انتقلت إليه لاحقًا تعرّض لأضرار جسيمة، وما زلت أعيش فيه رغم الخراب. مكتبتي الشخصية، التي كانت تمثل لي العالم كله، دُمّرت أيضًا.
لكن رغم ذلك، لن نتوقف. سنواصل القراءة، والكتابة، والإبداع بكل ما هو متاح لنا. سنرمم ما نستطيع ترميمه، وسنعيد بناء ما تهدّم. سنعيد افتتاح مكتبتنا الوطنية، وسنفتح المكتبات من جديد، لتعود دورة الحياة إلى قطاع غزة، عاجلًا أم آجلًا. لأن الثقافة، كما الحياة، لا تموت.
هل هناك قصة أو موقف إنساني شعرتَ أنه يلخّص كل ما جرى؟ أو يختصر وجع غزة في لحظة؟
المواقف الإنسانية في غزة لا تُعد ولا تُحصى. هناك الكثير من القصص التي نعجز عن الحديث عنها، لا لأننا لا نعرفها، بل لأننا نخجل من قسوتها، نخجل من أن نرويها وكأننا نعيد على الناس ألمًا لم يتوقف أصلًا. كيف للكاتب أن يصف أزمة الخيام والنازحين؟ كيف نتحدث عن أهالي بيت حانون، وبيت لاهيا، ورفح، الذين تحولت بيوتهم إلى ركام، وأصبحوا اليوم يعيشون في خيام بلا خصوصية، بلا مأوى حقيقي، بلا أبسط مقومات الحياة؟
هل يمكن الحديث عن احتياجات النساء في تلك الخيام؟ عن غياب الخصوصية؟ حتى الضوء الخافت داخل الخيمة قد يكون انتهاكًا لحرمة الجسد والنفس. المساحة التي كانت يومًا بيتًا ومكانًا خاصًا للفرد، تحوّلت إلى قطعة قماش لا تقي حرًا ولا بردًا، ولا تحفظ كرامة.
القصة التي تختصر هذا الوجع؟ كثيرة. طفل يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت الركام، وأمام أعين رجل الدفاع المدني الذي لا يملك المعدات الكافية لإنقاذه. أو ذاك الأب الذي يبكي بجوار جثمان ابنه، يتوسّل إليه أن يعود للحياة، أن يصحو من موته، يهمس له: “اصحى يابا، أنت سندي، يابا أنت صاحبي… سامحني.”
غزة اليوم غارقة في مليارات القصص. مليارات التفاصيل التي تختزن المعاناة، وتفيض بالألم، وتُدهشك في كل مرة بصلابة أهلها وصمودهم. كل قصص الأرض لن تكفي لوصف ما يعتمل في صدور الفلسطينيين. وللأسف، لا يزال صوتهم الحقيقي عاجزًا عن الوصول إلى المواطن العربي، المنشغل في دوامة الحياة اليومية.
ما رسالتك اليوم ككاتب فلسطيني بقي في أرضه، في ظل حرب الإبادة؟ ولمن توجهها؟
رسالتي موجهة أولًا للمواطن العربي، وتحديدًا للنخب: للسينمائي، وللكاتب المسرحي، وللأديب، وللرياضي، ولكل شخص يمتلك تأثيرًا وصوتًا. أين أنتم من فلسطين؟ كثيرًا ما سمعنا من يردد أن الفلسطيني باع أرضه، لكن هذه الحرب كشفت الحقيقة: من الذي باع الفلسطيني؟ من الذي خذله؟ من الذي وقف متفرجًا وهو يُباد؟
أين الأنظمة العربية التي تزوّد “إسرائيل” بالبترول؟ التي تفتح لها الحدود باسم السياحة؟ التي تُدخل لها الطعام، بينما يُحاصر الفلسطيني ويُقتل، وتُرسل له بعض الدول العربية فقط الأكفان؟!
رسالتي للمواطن العربي هي ما قاله غسان كنفاني ذات يوم: “لك شيء في هذا العالم، فقم”.
التاريخ لن ينسى، سيسجل الخذلان العظيم الذي تعرّض له الإنسان الفلسطيني، لكنه أيضًا سيسجل صموده، وسيشهد على انتصاره، عاجلًا أم آجلًا.