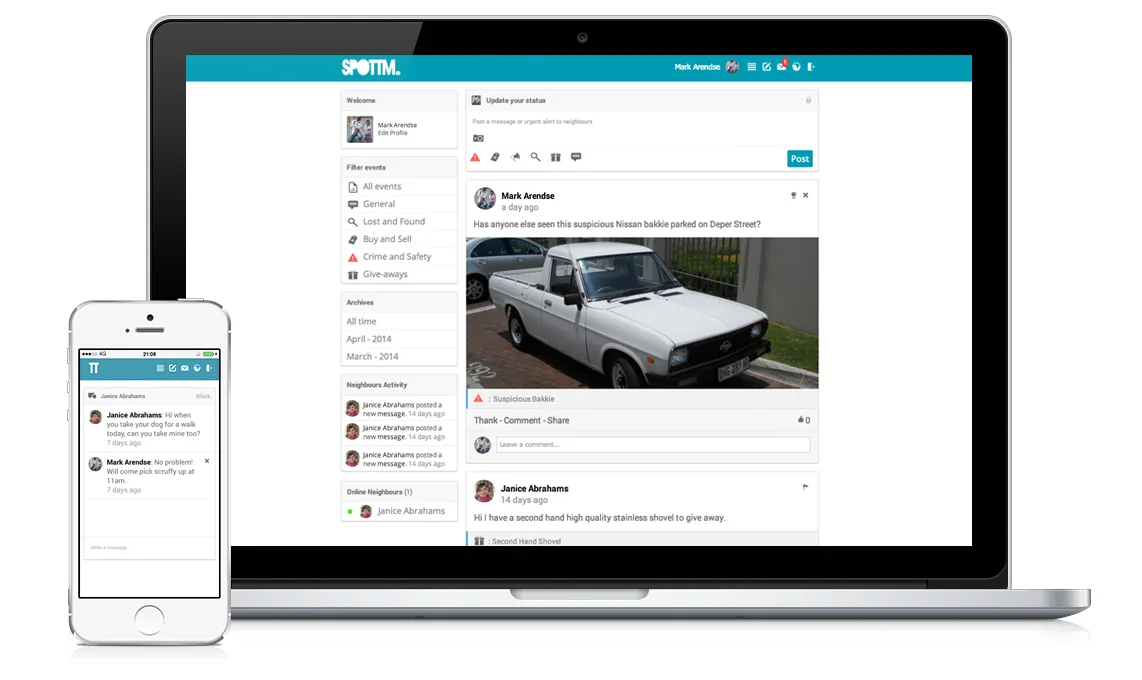تمثل المقارنة بين مصر وتونس إحدى وجوه الجدل المتكررة حول الثورة والثورة المضادة في العالم العربي. وكانت هذه المقارنة برزت في أجلى صورها خلال ندوة حول التطورات العربية، التحقت بها الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية، لندن، بدعوة من منتدى الشرق والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
شهدت الساعات الأولى من الندوة ما يشبه الإجماع من الزملاء الأوروبيين والأمريكيين في كيل المديح لتجربة الإسلاميين التونسيين في الحكم، سيما قبولهم الطوعي بالتخلي عن حكومة التحالف الثلاثي التي كانوا يقودونها. ولكن النقاش طال أيضاً جوانب أخرى من تجربتي البلدين اللذين شهد كل منهما واحدة من أبرز حلقات حركة الثورة والتحول الديمقراطي في العالم العربي.
ليس هذا مجال استعراض الندوة، أو حتى عقد مقارنة شاملة بين ثورتي تونس ومصر. ولكن المدهش في هذا الجدل أن المديح الوحيد الذي يستحقه الإسلاميون الديمقراطيون اليوم، في خضم الحراك الثوري الهائل الذي يعيشه العرب منذ 2011، يتعلق بتخليهم الطوعي عن الحكم بعد فوزهم الصريح في انتخابات عادلة وشفافة، شهد لها العالم أجمع. بمعنى، أن الإسلاميين هم صنف جيد من البشر فعلاً طالما كانوا خارج مؤسسة الحكم والسلطة. بغير ذلك، فليس ثمة خطيئة، سياسية أو غير سياسية، يصعب إلصاقها بهم. الحقيقة، بالطبع، أن ليس ثمة اختلاف جوهري بين المسار الذي اختطه التونسيون وذلك الذي ذهب إليه المصريون للمرحلة الانتقالية. كلاهما قبل بإطاحة نظام الحكم بدون المس بمؤسسة الدولة؛ كلاهما قرر أن تبدأ المرحلة الانتقالية بانتخابات تشريعية ورئاسية، وقبل وضع مسودة الدستور الجديد للبلاد؛ وكلاهما شهد حالة انقسام واستقطاب حادة بين الإسلاميين وحلفائهم، من جهة، والليبراليين والعلمانيين والكتلة السياسية للنظام السابق، من جهة أخرى. في مصر، بدأت المرحلة الانتقالية بجلسات حوار واسعة ومتعددة الأطراف، استهدفت تشكيل تحالف وطني انتخابي. ولكن مناخ الاستقطاب والانقسام أجهض المحاولة. في المقابل، ولد مناخ الانقسام التونسي سلسلة من الاغتيالات السياسية، مشبوهة المصدر، ولم يبدأ الحوار الوطني إلا متأخراً، وبمبادرة من اتحاد الشغل، تمحورت من البداية حول تخلي النهضة وحلفائها عن الحكم.
ما جعل تونس مختلفة لم تكن خطوات وإجراءات المرحلة الانتقالية. هذه، في معظمها، لعبت دوراً هامشياً في تحديد مصير الثورتين. الاختلاف بين التجربتين لم يكن في الدستور أو الانتخابات أولاً، بل بين طبيعتي الدولتين، وميزان القوى بين مؤسسة الدولة، وذراعها العسكري، بصورة خاصة، في جانب، والشعب وقواه السياسية، في الجانب الآخر. كما أن الاختلاف يتعلق بالأهمية الجيوسياسية لكل من البلدين، بحجمها، وتأثيرها على الإقليم وعلى خارطة القوة العالمية. في النهاية، أدرك الإسلاميون التونسيون، بحكمة لا جدال فيها، أن انهيار التجربة الديمقراطية في مصر هو تطور بالغ التأثير على ميزان القوى في العالم العربي، ولابد أن يؤخذ في الاعتبار.
بيد أن هذا الجدل لا يخلو من دلالات هامة، سواء في محاولة قراءة ما حدث منذ اندلعت حركة الثورة، أو محاولة استشراف المستقبل القريب لشعوب ودول المجال العربي. ليس ثمة شك أن الانتقال السريع للحراك الشعبي الثوري، وتسلحه بمطالب الحرية والكرامة الإنسانية والدولة العادلة، أطلق تفاؤلاً واسعاً في المجال العربي وخارجه، وأن كثيرين رأوا أن المشرق سيمضي في طريقه، أخيراً، ليلتحق بحركة التحول الديمقراطي التي تجتاح العالم بأسره. ولكن الأمور لم تسر كما ينبغي لها، أو لم تسر بالسرعة المأمولة. في مصر، على سبيل المثال، ومهما كان الموقع السياسي الذي يختاره المرء، ثمة ما يشبه الإجماع الآن على أن عملية التحول الديمقراطي قد تعثرت، أو ربما حتى أجهضت. وستحتاج مصر على الأرجح حركة شعبية ثورية جديدة للعودة إلى طريق الحرية والديمقراطية، لا أحد يعرف على وجه اليقين متى وكيف ستقع، وكيف ستكون تجلياتها عندما تقع. وبالرغم من أن الثورتين السورية والليبية بدأتا بحركة شعبية سلمية، فقد انتهتا إلى ما يشبه الحرب الأهلية، بالغة الدمار والقسوة في سورية، وأقل دماراً وقسوة وانتشاراً في ليبيا. ثمة مسار انتقالي في اليمن، لم يزل يتحرك، بالفعل، ولكن قلة تعرف في أي اتجاه وما إن كان سينتهي إلى دولة عادلة، ونظام حكم ديمقراطي، يعبر عن إرادة الشعب. في العراق، الذي التحق بحركة الثورة متأخراً، في ديسمبر/ كانون أول 2012، وأخذ حراكه الشعبي سمة سنية، فئوية، يبدو أن أوضاع البلاد تنحدر نحو حرب أهلية أخرى. فلماذا تتعثر حركة الثورة والتحول الديمقراطي في العالم العربي، لماذا يصبح التخلي عن الحكم، أعظم خطوة يمكن أن تتخذها قوة سياسية، فازت في انتخابات حرة ونزيهة؟
أحد أهم أسباب هذا التعثر لابد أن يرى في الارتباط الوثيق، الثقافي، الديني ـ الطائفي، العشائري، السياسي والجيوسياسي، بين دول المشرق (والمشرق هنا تعني أيضاً المغرب العربي)، ليس فقط دوله العربية ولكن أيضاً غير العربية، مثل إيران وتركيا. ولأن حركة الثورة انطلقت من إطار الدولة الوطنية، بمعنى ثورة تونسية، مصرية، ليبية، يمنية، سورية، إلخ، كان من الطبيعي، والمتوقع، أن تنقسم قوى المنطقة، التي لم تصلها رياح التغيير، حول ما تعنيه حركة الثورة، وما يمكن أن ينجم عنها، ليس فقط فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطي، الذي يستبطن المس بشرعية الدول غير الديمقراطية، ولكن أيضاً ما يتعلق بالحسابات الطائفية – الدينية وموازين القوى الإقليمية. ولم يكن مستغرباً بالتالي أن تقف دول متناقضة التوجهات والحسابات، لا يربطها أي مستوى من التحالف، مثل السعودية والإمارات وإيران، موقفاً متشابهاً من حركة الثورة العربية في مجملها.
أما السبب الثاني فلابد أن يرى في حجم وعمق الانقسام السياسي ـ الاجتماعي الذي تعيشه شعوب المشرق منذ نهاية القرن التاسع عشر.
لا يقتصر الانقسام السياسي ـ الاجتماعي، بالتأكيد، على العرب أو شعوب المشرق، بل هو سمة عرفتها كل الأمم والشعوب، التي عصفت بها تيارات الحداثة والتحديث. في الغرب الأوروبي، حسم الانقسام في حروب أهلية أو حتى قارية، كما حدث في حرب الثلاثين عاماً، الحروب النابليونية، الحربين العالميتين الأولى والثانية، والحرب الباردة. وبالرغم من أن التصور السائد للنظام الديمقراطي أنه يوفر آلية سلمية لإدارة الصراع السياسي ـ الاجتماعي، فالحقيقة أن الديمقراطية لا يمكن أن تستقر بدون تحقيق اجماع حول المسائل الكبرى التي تستند إليها الأمم. بمعنى، أن الديمقراطية آلية لإدارة الخلاف حول المسائل الطارئة والجزئية، ما يعرف بالسياسات العامة، وليس التوجهات الأساسية والاستراتيجية للأمة. ثمة حل عقلاني، تفاوضي، لتحقيق مثل هذا الإجماع؛ ولا يجب أن تكون الحروب الطاحنة والصراعات الدموية الطريق الوحيد. ولكن حتى الخيار الأقل تكلفة وتجنباً للدمار والموت، يتطلب هو الآخر نضالات طويلة وشاقة، وتضحيات متواصلة من شرائح الشعب المختلفة.
أما السبب الثالث فيتصل بمسألة أكثر تعقيداً وتركيباً، تشمل وجود الدولة العبرية في قلب هذه المنطقة من العالم منذ عقود، وتشمل الأهمية الاقتصادية الحيوية لموارد الطاقة، التي يعتبر المشرق أحد أهم وأثرى مصادرها في العالم، ولا تنتهي عند الموقع الفريد للمشرق في خارطة خطوط الاتصال وتماس كتل القوة، وعند أهميته الثقافية ـ التاريخية. ليس ثمة بقعة في العالم تجد هذا الاهتمام من العالم مثل المشرق العربي ـ الإسلامي. وعندما تجتمع الاهمية الاقتصادية، الثقافية، الجيوسياسية مع وجود الدولة العبرية، تصبح معادلة التغيير الديمقراطي الأكثر تعقيداً.
الآن، هل المقصود بهذا كله أن التغيير الديمقراطي العربي مستحيل؟ بالتأكيد، لا، سيما أن الطريق أمام الشعوب بات واضحاً. المقصود، أن ما يشهده المجال العربي ليس غريباً، بالضرورة، ولا مفاجئاً.