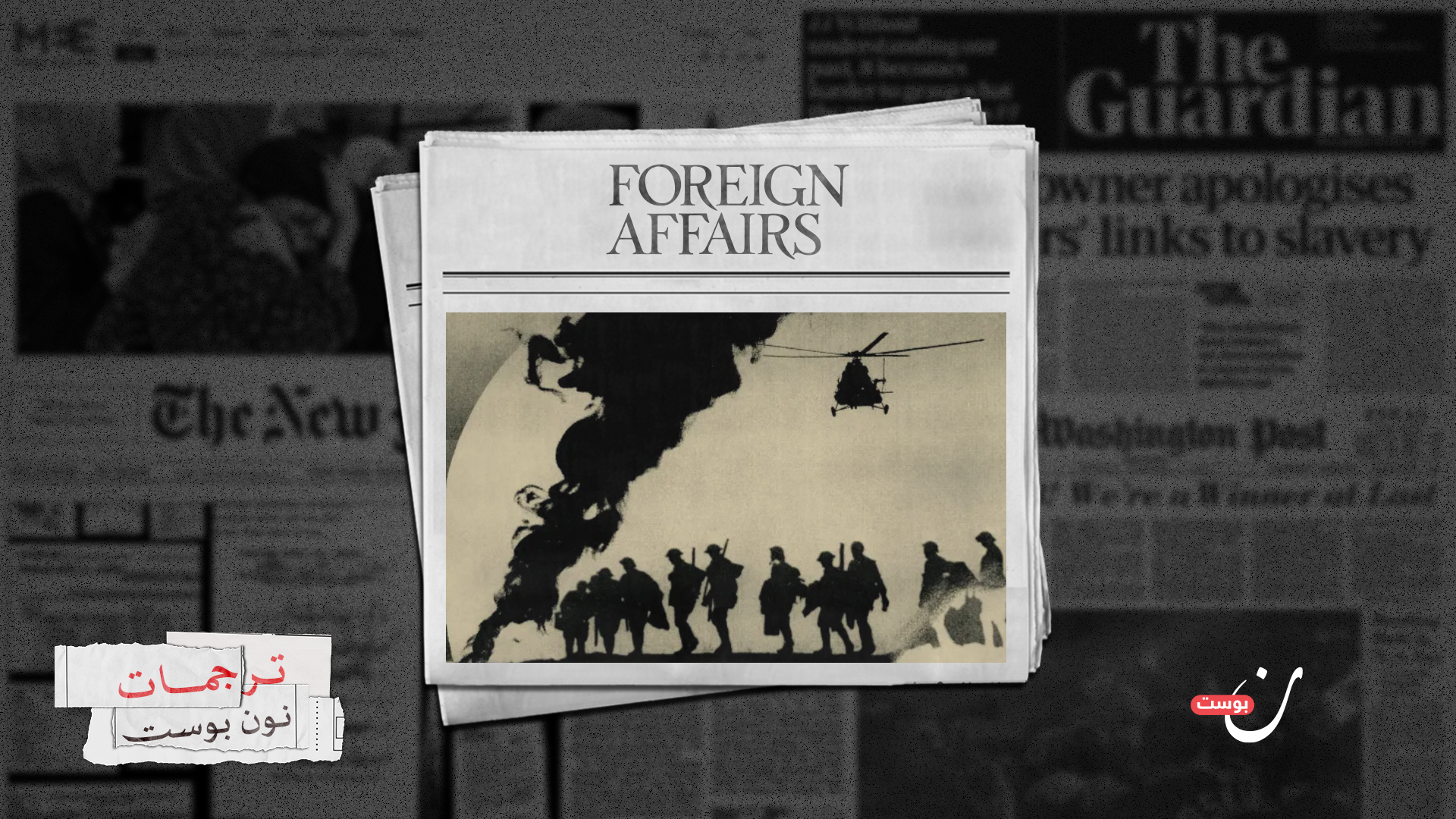ترجمة وتحرير: نون بوست
في عملية “عاصفة الصحراء” سنة 1991، وهي الحملة التي هدفت إلى تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها في التحالف العنان لقوتهم البرية والجوية والبحرية الهائلة. وحُسمت المعركة في غضون أسابيع قليلة. وكان التباين صارخًا بين هذا الانتصار السريع وبين الحرب الشاقة وغير الناجحة التي خاضتها الولايات المتحدة في فيتنام، وتلك التي خاضها الاتحاد السوفيتي في أفغانستان.
وأدى هذا النصر الخاطف إلى الحديث عن حقبة جديدة في أساليب الحروب، عُرفت بما يُسمى بـ”الثورة في الشؤون العسكرية”. ووفقًا لهذا التصور، فإن الحروب المستقبلية ستحسم من خلال السرعة والمناورة، بالاعتماد على معلومات استخباراتية فورية لحظية توفرها أجهزة الاستشعار الذكية، التي تُوجّه هجمات فورية باستخدام الأسلحة الذكية.
تبددت تلك الآمال سريعًا؛ حيث اتّسمت حملات مكافحة التمرّد التي خاضها الغرب في العقود الأولى من هذا القرن، والتي أصبحت تُوصَف بـ”الحروب الأبدية”، بطول مدّتها لا بسرعتها. فالحملة العسكرية التي شنّتها واشنطن في أفغانستان كانت الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، وانتهت في نهاية المطاف دون تحقيق النجاح المنشود. فعلى الرغم من طرد حركة طالبان في بداية الغزو الأمريكي، فإنها عادت إلى السلطة لاحقًا.
هذه المشكلة لا تقتصر على الولايات المتحدة وحلفائها. ففي فبراير/ شباط 2022، شنّت روسيا حربًا شاملة لأوكرانيا، كان من المفترض أن تُسقط البلاد خلال أيام. إلا أن الحرب، حتى في حال تم التوصّل إلى وقفٍ لإطلاق النار، ستكون قد استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، وطغت عليها المعارك الاستنزافية المرهِقة، لا العمليات الجريئة والحاسمة.
وبالمثل، عندما شنّت إسرائيل حربها على قطاع غزة ردًا على هجوم حماس وأخذها رهائن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن تكون العملية الإسرائيلية “سريعة، وحاسمة، وساحقة”. لكنّها استمرت لخمسة عشر شهرًا، وتوسّعت خلال ذلك إلى جبهات أخرى في لبنان وسوريا واليمن، قبل التوصّل إلى وقف هشّ لإطلاق النار في يناير/ كانون الثاني 2025.
وبحلول منتصف مارس/ آذار، كانت الحرب قد اشتعلت من جديد. ولا يشمل هذا الحديث العديد من النزاعات الأخرى في إفريقيا، بما فيها تلك الحرب الدائرة في السودان ومنطقة الساحل، والتي لا تلوح لها نهاية في الأفق.
بدأت فكرة أن الهجمات المفاجئة يمكن أن تحقق انتصارات حاسمة تترسخ في التفكير العسكري في القرن التاسع عشر. ومع ذلك، أثبتت التجارب مرارًا وتكرارًا مدى صعوبة إنهاء الحروب بسرعة وبنتائج مرضية. فقد كان القادة العسكريون الأوروبيون واثقين من أن الحرب التي اندلعت في صيف سنة 1914 يمكن أن تنتهي بحلول عيد الميلاد، وهي عبارة لا تزال تُستخدم حتى اليوم كلما بدا أن القادة العسكريين يغرقون في التفاؤل المفرط. لكن الحرب استمرت حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 1918، وانتهت بهجمات سريعة ولكن بعد سنوات من حرب الخنادق المدمرة على طول خطوط المواجهة الثابتة تقريبًا.
وفي سنة 1940، اجتاحت ألمانيا أجزاءً واسعة من أوروبا الغربية في غضون أسابيع قليلة باستخدام أسلوب الحرب الخاطفة، التي جمعت بين القوات المدرعة والقوة الجوية. إلا أنها لم تتمكن من حسم المعركة بالكامل، وبعد تقدمها السريع ضد الاتحاد السوفيتي في سنة 1941، وجدت نفسها منخرطة في حرب وحشية أدت إلى خسائر بشرية هائلة من الجانبين، ولم تنتهِ إلا بعد قرابة أربع سنوات بانهيار الرايخ الثالث تمامًا.
وبالمثل، فإن قرار القيادة العسكرية اليابانية بشن هجوم مفاجئ على الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 1941 انتهى بهزيمة كارثية للإمبراطورية اليابانية في أغسطس/ آب 1945.
وفي كلتا الحربين العالميتين، لم يكن مفتاح النصر هو التفوق العسكري بقدر ما كان القدرة الهائلة على الصمود.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التاريخ الطويل من الصراعات الممتدة، لا يزال المفكرون العسكريون يصممون خططهم العسكرية على أساس الحروب القصيرة، التي يُفترض أن تُحسم نتائجها في الأيام الأولى، أو حتى في الساعات الأولى، من القتال.
ووفقًا لهذا النموذج، لا يزال بالإمكان وضع إستراتيجيات تُفاجئ العدو بسرعة الهجوم، واتجاهه، ووحشيته. ومع الاحتمال الدائم لانجرار الولايات المتحدة إلى حرب مع الصين بسبب تايوان، أصبحت جدوى هذه الإستراتيجيات مسألة ملحّة: هل تستطيع الصين أن تستولي على الجزيرة بسرعة خاطفة باستخدام قوة ساحقة، أم أن تايوان، بدعم من الولايات المتحدة، ستكون قادرة على صدّ هذا الهجوم منذ لحظاته الأولى؟
وما هو واضح في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وتنوع عدد من الخصوم، هو وجود خلل جوهري في التخطيط الدفاعي. ومع إدراك حقيقة أن الحروب تميل إلى الاستمرار لفترات طويلة، بدأ بعض الاستراتيجيين يحذّرون من مخاطر الوقوع في “خرافة الحرب القصيرة”. إذ إن التركيز المفرط على الحروب السريعة يجعل الاستراتيجيين يعتمدون بشكل كبير على خطط المعركة الأولية، التي قد لا تسير كما هو متوقع، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة.
وجادل أندرو كريبينيفيتش بأن حربًا طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين “ستنطوي على أشكال من القتال ليست لدى الأطراف المتحاربة خبرة كافية بها”، وقد تُشكّل “الاختبار العسكري الحاسم في عصرنا”. علاوة على ذلك، فإن الفشل في الاستعداد لحروب طويلة يخلق نقاط ضعف من نوع آخر. إذ إن الانتقال من حرب قصيرة إلى حرب ممتدة يفرض متطلبات مختلفة على الجيوش، وعلى المجتمعات بأسرها. كما يستلزم الأمر إعادة تقييم للأهداف، ولما يمكن تحمّله من التكاليف والتضحيات من أجل تحقيقها.
وبمجرد أن يُقِر المخططون العسكريون بإمكانية ألا تنتهي أي حرب كبرى معاصرة بسرعة، يصبح من الضروري أن يتبنّوا عقلية مختلفة. فالحروب القصيرة تُخاض باستخدام الموارد المتاحة في اللحظة الراهنة، بينما تتطلب الحروب الطويلة تطوير قدرات تتماشى مع متطلبات عملياتية متغيرة، كما يتجلى في التحول المستمر لأساليب حرب الطائرات المسيّرة في أوكرانيا.
وتُحدث الحروب القصيرة اضطرابات مؤقتة فقط في اقتصاد الدولة ومجتمعها، ولا تحتاج إلى خطوط إمداد واسعة النطاق، أما الحروب الطويلة فتتطلب إستراتيجيات للحفاظ على الدعم الشعبي وضمان استمرارية الأداء الاقتصادي وتأمين وسائل فعّالة لإعادة التسلّح وتوفير الإمدادات وتعويض الخسائر البشرية. كما أن الحروب الطويلة تستوجب قدرة دائمة على التكيّف والتطور؛ فكلما طال أمد الصراع، ازدادت الحاجة إلى ابتكارات في التكتيكات والتقنيات يمكن أن تحقق اختراقًا حاسمًا. وحتى بالنسبة إلى قوة عظمى، فإن الفشل في الاستعداد لمثل هذه التحديات، ومن ثم عدم القدرة على مواجهتها، قد تكون له عواقب كارثية.
ولكن من الإنصاف أيضًا أن نتساءل عن مدى واقعية التخطيط لحروب لا تملك نهاية واضحة. فهناك فرق كبير بين الاستمرار في حملة طويلة لمكافحة التمرّد، وبين الاستعداد لصراع ينطوي على خسائر مستمرة وكبيرة في الأرواح والمعدات والذخائر على مدى فترة طويلة من الزمن.
وبالنسبة للمخططين الدفاعيين، قد تعترضهم عقبات كبيرة في هذا النوع من التخطيط، إذ قد تفتقر الجيوش التي يخدمون فيها إلى الموارد اللازمة للاستعداد لحرب طويلة الأمد. والحل لهذه المعضلة لا يكمن في الاستعداد لحروب بلا نهاية، بل في تطوير نظريات للنصر تكون واقعية في أهدافها السياسية، ومرنة في الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الأهداف.
خرافة الحرب القصيرة
إن مزايا الحروب القصيرة، كالنجاح الفوري بتكلفة معقولة، واضحة لدرجة أنه لا يمكن تقديم حجة لبدء حرب طويلة عن عمد. وبالمقابل، فإن الاعتراف بإمكانية أن تصبح الحرب طويلة قد يبدو وكأنه يعكس شكوكًا بشأن قدرة الجيش على الانتصار على العدو.
وإذا كان لدى الاستراتيجيين القليل من الثقة أو لم يكن لديهم أي ثقة بأن الحرب المحتملة يمكن أن تُختتم بسرعة، فمن الممكن القول إن السياسة الحكيمة الوحيدة هي عدم خوضها من الأساس. ومع ذلك، بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة، قد لا يكون من الممكن استبعاد صراع مع قوة عظمى أخرى ذات قوة مماثلة، حتى وإن لم يكن النصر السريع مضمونًا.
وعلى الرغم من أن القادة الغربيين يتحاشون التدخل في الحروب الأهلية بشكل مفهوم، إلا أنه من الممكن أن تصبح أفعال خصم غير دولتي مستمرة ومدمرة إلى درجة تجعل اتخاذ إجراء مباشر للتعامل مع التهديد أمرًا حتميًا، بغض النظر عن مدة المدة التي قد يستغرقها ذلك.
ولهذا السبب، يستمر الاستراتيجيون العسكريون في صياغة خططهم بناءً على الحروب القصيرة، حتى عندما لا يمكن استبعاد احتمال حدوث صراع طويل الأمد. فخلال فترة الحرب الباردة، كان السبب الرئيسي وراء عدم تخصيص الجانبين موارد كبيرة للاستعداد لحرب طويلة هو الافتراض بأن الأسلحة النووية سيتم استخدامها عاجلاً وليس آجلاً.
وفي العصر الحالي، لا يزال هذا التهديد قائمًا، لكن احتمال تحول صراع بين القوى الكبرى إلى شيء يشبه الحروب العالمية الكارثية في القرن الماضي أمر مخيف، مما يزيد من الإلحاح على الخطط المصممة لتحقيق نصر سريع باستخدام القوات التقليدية.
وتُصمَّم الإستراتيجيات الخاصة بتنفيذ هذا النوع المثالي من الحروب بالدرجة الأولى لتحقيق التحرك السريع، مع عنصر من المفاجأة والقوة الكافية، لقهر الأعداء قبل أن يتمكنوا من الرد بشكل مناسب. وعادةً ما تُقيَّم تقنيات الحرب الحديثة بناءً على مدى مساعدتها في تحقيق نجاح سريع على أرض المعركة، بدلاً من تقييمها بناءً على مدى قدرتها على تأمين سلام دائم.
وعلى سبيل المثال، يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، كما يُفترض، لتكون الجيوش قادرة على تقييم المواقف على أرض المعركة وتحديد الخيارات ثم اختيار وتنفيذ تلك الخيارات في ثوانٍ معدودة. وقد تُتَّخذ القرارات الحيوية قريبًا بسرعة لدرجة أن القائمين على الأمر، ناهيك عن العدو، قد لا يدركون ما يحدث.
إن الانشغال بالسرعة متأصل إلى درجة أن أجيالًا من القادة العسكريين الأميركيين قد تعلموا أن يرتجفوا عند ذكر حرب الاستنزاف، معتمدين على المناورة الحاسمة كطريق للنصر السريع. فالحروب الطويلة التي تحدث الآن في أوكرانيا – حيث يسعى الطرفان لتقليص قدرات بعضهما البعض، ويُقاس التقدم بعدد القتلى والمعدات المدمرّة وكمية الذخائر المستهلكة – لا تعد محبطة فقط للدول المتحاربة، بل أيضًا تستهلك وقتًا طويلاً وموارد باهظة.
ففي أوكرانيا، استهلك كلا الجانبين موارد استثنائية، ولا يقترب أي منهما من تحقيق ما يمكن أن يُعتبر انتصارًا. وليست كل الحروب تُخاض بهذه الشدة مثل الحرب الروسية الأوكرانية، لكن حتى الحروب غير النظامية الممتدة يمكن أن تفرض تكاليف باهظة، مما يؤدي إلى شعور متزايد بالعجز بالإضافة إلى تكاليف مرتفعة.
وعلى الرغم من أنه من المعروف أن الهجمات المفاجئة الجريئة غالبًا ما تحقق أقل بكثير مما ووعدت به، وأن بدء الحروب أسهل بكثير من إنهائها، لا يزال الإستراتيجيون يقلقون من أن الأعداء المحتملين قد يكونون أكثر ثقة في خططهم الخاصة بالنصر السريع، وسيتصرفون وفقًا لذلك. وهذا يعني أنه يتعين عليهم التركيز على المرحلة الافتتاحية المحتملة للحرب. ويمكن الافتراض، على سبيل المثال، أن لدى الصين إستراتيجية للاستيلاء على تايوان تهدف إلى مفاجأة الولايات المتحدة، مما يترك واشنطن للرد بطرق إما لا أمل لها في النجاح أو من المحتمل أن تجعل الأمور أسوأ بكثير.
ولمواجهة مثل هذا الهجوم المفاجئ، خصص الإستراتيجيون الأمريكيون وقتًا كبيرًا لتقييم كيفية قدرة الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين على مساعدة تايوان في إحباط خطوات الصين الأولى – كما فعلت أوكرانيا مع روسيا في فبراير/ شباط 2022 – ثم جعل من الصعب على الصين الحفاظ على عملية معقدة بعيدًا عن البر الرئيسي.
لكن حتى هذا السيناريو قد يؤدي بسهولة إلى صراع طويل؛ فإذا كانت الخطوات المضادة الأولى التي اتخذتها القوات التايوانية وحلفاؤها الغربيون ناجحة، ووجدت الصين نفسها عالقة لكنها لم تنسحب، فإن تايوان والولايات المتحدة سيواجهان مشكلة التعامل مع وضع تتواجد فيه القوات الصينية على الجزيرة. وكما تعلمت أوكرانيا، من الممكن أن تتورط في حرب ممتدة بسبب حسابات خاطئة من طرف خصم متهور.
ولا يعني ذلك أن النزاعات المسلحة الحديثة لا تنتهي أبدًا بانتصارات سريعة. ففي يونيو/ حزيران 1967، استغرق الأمر من إسرائيل أقل من أسبوع لهزيمة تحالف الدول العربية في حرب الأيام الستة بشكل حاسم، وبعد ثلاث سنوات، عندما تدخلت الهند في حرب بنغلاديش من أجل الاستقلال، استغرق الأمر 13 يومًا فقط من القوات الهندية لهزيمة باكستان. كما أن انتصار المملكة المتحدة على الأرجنتين في حرب الفوكلاند في سنة 1982 تحقق بسرعة كبيرة. ولكن منذ نهاية الحرب الباردة، كانت هناك العديد من الحروب التي تعثرت فيها النجاحات المبكرة وفقدت الزخم أو لم تحقق ما يكفي، مما حول الصراعات إلى شيء أكثر صعوبة وتعقيدًا بكثير.
وفي الواقع، بالنسبة لبعض أنواع المتحاربين، قد توفر مشكلة الحروب الطويلة السائدة ميزة هامة، فقد يبدأ المسلحون والمتمردون والإرهابيون والانفصاليون حملاتهم وهم يعلمون أن الأمر سيستغرق وقتًا لتقويض هياكل السلطة القائمة، ويفترضون أنهم ببساطة سيتفوقون في النهاية على أعدائهم الأكثر قوة. فمجموعة تعرف أنه من غير المحتمل أن تحقق النصر في مواجهة سريعة قد تدرك أن لديها فرصًا أكبر في النجاح في صراع طويل وشاق، حيث يتم استنزاف العدو ويفقد معنوياته.
وبالتالي، في القرن الماضي، بدأت الحركات المعادية للاستعمار، ومؤخرًا الجماعات الجهادية، حروبًا استمرت لعقود ليس بسبب ضعف الإستراتيجية، بل لأنها لم تكن تملك خيارًا آخر. خاصة عندما تواجه تدخلًا عسكريًا من جيش أجنبي قوي، فإن الخيار الأفضل لتلك المنظمات غالبًا هو أن تترك العدو يتعب من القتال غير الحاسم ثم تعود عندما يحين الوقت، كما فعلت طالبان في أفغانستان.
وعلى النقيض من ذلك، تميل القوى العظمى إلى الافتراض بأن تفوّقها العسكري الكبير سيكفي لهزيمة الخصوم بسرعة. ويؤدي هذا الإفراط في الثقة إلى فشلها في إدراك حدود القوة العسكرية، ومن ثم تضع أهدافًا لا يمكن تحقيقها – إن أمكن تحقيقها أصلًا – إلا من خلال صراع طويل الأمد. والمشكلة الأكبر أن التركيز على النتائج الفورية في ساحة المعركة قد يجعلها تغفل العناصر الأوسع اللازمة للنجاح، مثل تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم، أو إدارة فعّالة لدولة محتلة أُطيح بنظامها المعادي، لكن لم يُشكَّل فيها بعدُ نظام شرعي.
لذلك، فإن التحدي في الواقع لا يكمن فقط في التخطيط لحروب طويلة بدلًا من قصيرة، بل في التخطيط لحروب تستند إلى نظرية قابلة للتطبيق لتحقيق النصر، بأهداف واقعية، مهما طال الوقت اللازم لبلوغها.
عدم الخسارة ليس انتصارًا
إن الإستراتيجية الفعالة في خوض الحروب لا تتعلق بالأسلوب العسكري فحسب، بل أيضًا بالهدف السياسي. فمن الواضح أن التحركات العسكرية تكون أكثر نجاحًا عندما تقترن بطموحات سياسية محدودة.
لقد نجحت حرب الخليج سنة 1991 لأن إدارة الرئيس جورج بوش الأب كانت تهدف فقط إلى طرد العراق من الكويت، دون السعي إلى الإطاحة بالدكتاتور العراقي صدام حسين. أما الغزو الروسي لأوكرانيا في سنة 2022، فربما كان ليحقق قدرًا أكبر من النجاح لو ركّز على منطقة دونباس بدلًا من محاولة فرض السيطرة السياسية على البلاد بأكملها.
وعندما تكون الطموحات محدودة، يصبح من الأسهل أيضًا الوصول إلى تسوية. إذ تتطلب نظرية النصر القابلة للتطبيق إستراتيجية تتماشى فيها الأهداف العسكرية مع الأهداف السياسية. وقد يكون الحل الوحيد للنزاع في بعض الحالات هو الهزيمة الكاملة للعدو، وفي هذه الحالة يجب تخصيص الموارد الكافية لتحقيق هذا الهدف. وفي أحيان أخرى، قد تُطلق مبادرة عسكرية على أساس توقع راسخ بأنها ستقود إلى مفاوضات مبكرة.
هذا ما كانت تعتقده الأرجنتين في أبريل/ نيسان 1982 عندما استولت على جزر الفوكلاند. وعندما أمر الرئيس المصري أنور السادات قواته المسلحة بعبور قناة السويس في أكتوبر/ تشرين الأول 1973، فعل ذلك لتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. ورغم أن قواته أُجبرت على التراجع، إلا أنه حقق هدفه السياسي.
ويُعد التقليل من شأن الموارد السياسية، إلى جانب الموارد العسكرية للعدو، أحد الأسباب الرئيسية لفشل إستراتيجيات الحروب القصيرة. فقد افترضت الأرجنتين أن المملكة المتحدة ستقبل بالأمر الواقع عندما استولت على جزر الفوكلاند، ولم يخطر ببالها أن البريطانيين سيرسلون قوة مهام لتحرير الجزر.
وغالبًا ما تُشَنّ الحروب بناءً على اعتقاد خاطئ بأن سكان الدولة المعادية سوف يرضخون بسرعة تحت وطأة الهجوم. وقد يفترض الغزاة أن جزءًا من السكان سيرحب بهم، كما حدث في غزو العراق لإيران سنة 1980، ومثله في الغزو المضاد الذي شنّته إيران على العراق. وقد استندت روسيا في هجومها الشامل على أوكرانيا إلى قراءة خاطئة مماثلة؛ إذ افترضت وجود أقلية مضطهدة – وهم الناطقون بالروسية في هذه الحالة – سترحب بقواتها، وأن الحكومة في كييف تفتقر إلى الشرعية ويمكن الإطاحة بها بسهولة، وأن وعود الغرب بدعم أوكرانيا لن تترجم إلى دعم فعلي يُذكر. ولم يصمد أي من هذه الافتراضات في وجه الأيام الأولى من الحرب.
وعندما تفشل خطة الحرب القصيرة في تحقيق النصر المتوقع، تصبح مهمة القادة العسكريين هي إعادة التوازن بين الوسائل والأهداف. فبحلول سبتمبر/ أيلول 2022، أدرك الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا مهددة بهزيمة مهينة ما لم تتمكن من إرسال المزيد من الجنود إلى الجبهة وتحويل اقتصادها إلى وضع الحرب الشاملة.
وباعتباره زعيمًا لدولة استبدادية، استطاع بوتين قمع المعارضة الداخلية والسيطرة على وسائل الإعلام، ولم يكن مضطرًا للقلق كثيرًا بشأن الرأي العام. ومع ذلك، كان بحاجة إلى سردية جديدة، فبعد أن كان قد أكد قبل اندلاع الحرب أن أوكرانيا ليست دولة حقيقية، وأن قادتها “النازيين الجدد” استولوا على السلطة عبر انقلاب في سنة 2014، لم يتمكن من تفسير سبب عدم انهيار أوكرانيا رغم تعرضها لهجوم من قوة روسية متفوقة. لذلك، غيّر بوتين روايته؛ فقد زعم أن أوكرانيا تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتحقيق أهداف معادية لروسيا مدفوعة بالكراهية لها.

وعلى الرغم من أن الكرملين صوّر الغزو في البداية على أنه “عملية عسكرية خاصة” محدودة، إلا أنه يصوّره الآن على أنه صراع وجودي. وهذا يعني أنه بدلًا من العمل فقط على إيقاف أوكرانيا من أن تكون مصدر إزعاج، تسعى روسيا الآن إلى أن تثبت لدول الناتو أنه لا يمكن كسر شوكتها بالعقوبات الاقتصادية أو بإمدادات الأسلحة التي يقدمها الحلف لأوكرانيا.
وبوصفها الحرب بأنها حرب دفاعية، كانت الحكومة الروسية تخبر شعبها بمدى الخطر الذي يتربص بهم، محذرة إياهم في الوقت نفسه من أنه لا يمكن أن يتوقعوا تحقيق نصر سريع الآن. وبدلاً من تقليص أهدافها للاعتراف بصعوبات هزيمة الأوكرانيين في المعركة، قام الكرملين بتوسيع نطاقها لتبرير الجهد الإضافي.
فقد جعلت روسيا إنهاء الحرب أصعب وليس أسهل من خلال ضم أربع مقاطعات أوكرانية بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، ومن خلال الاستمرار في المطالبة باستسلام الحكومة في كييف، ويوضح هذا الوضع صعوبة إنهاء الحروب التي لا تسير على ما يرام: فإمكانية الفشل غالًا ما تضيف هدفًا سياسيًا – وهو الرغبة في تجنب الظهور بمظهر الضعف وعدم الكفاءة – وقد كانت المخاوف المتعلقة بالسمعة أحد أسباب تمسك الحكومة الأمريكية بالحرب في فيتنام لفترة طويلة بعد أن أصبح من الواضح أن النصر كان بعيد المنال.
إن استبدال إحدى النظريات الفاشلة عن النصر بأخرى واعدة لا يتطلب إعادة تقييم نقاط القوة الفعلية للعدو فحسب، بل يتطلب أيضًا إدراك عيوب الافتراضات السياسية التي استندت إليها الخطوات الافتتاحية.
لنفترض أن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار أتت بثمارها، مما يوقف الحرب عند خطوط المواجهة الحالية، وهذا قد يسمح لموسكو بإظهار مكاسبها الإقليمية على أنها نوع من النجاح، لكنها لا تستطيع ادعاء النصر الحقيقي طالما أن لدى أوكرانيا حكومة مستقلة فاعلة وموالية للغرب.
إذا قبلت أوكرانيا مؤقتًا بخسائرها الإقليمية، بينما لا تزال قادرة على بناء قواتها والحصول على شكل من أشكال الضمانات الأمنية بمساعدة شركائها الغربيين، فإن النتيجة ستظل بعيدة كل البعد عن مطلب روسيا المتكرر بأن تكون أوكرانيا محايدة منزوعة السلاح، وستتحمل روسيا مسؤولية إدارة ودعم منطقة مدمرة ذات سكان مستائين، بينما يتعين عليها الدفاع عن خطوط وقف إطلاق النار الطويلة.
ولكن على الرغم من أن روسيا لم تتمكن من الانتصار في الحرب، إلا أنها لم تخسرها حتى الآن؛ فقد أُجبرت على الانسحاب من بعض الأراضي التي احتلتها في بداية الحرب، لكنها تحقق منذ أواخر عام 2023 مكاسب بطيئة ومستمرة في الشرق. من ناحية أخرى، لم تخسر أوكرانيا أيضًا؛ فقد قاومت بنجاح محاولات روسيا لإخضاعها، وأجبرتها على دفع ثمن باهظ لكل ميل مربع استولت عليه، والأهم من ذلك، أنها لا تزال دولة فاعلة.
لا نهاية تلوح في الأفق
يعد التمييز بين “الفوز” و”عدم الخسارة” أمرًا بالغ الأهمية في التعليق على الحرب المعاصرة، وإن كان من الصعب فهمه، فالفرق ليس بديهيًا نظرًا للافتراض القائل إنه لابد دائمًا من منتصر في الحرب، ولأن أحد الطرفين يمكن أن يبدو منتصرًا في أي وقت، حتى لو لم يفز بالفعل.
إن حالة “عدم الخسارة” لا يمكن التعبير عنها بدقة من خلال مصطلحات مثل “الجمود” و”الوصول إلى طريق مسدود” لأن هذه المصطلحات تعني ضمنيًا وجود تحركات عسكرية قليلة، ويمكن لكلا الطرفين أن يكونا “غير خاسرين” عندما لا يستطيع أي منهما الانتصار على الآخر، حتى لو كان أحدهما أو كلاهما قادرًا في بعض الأحيان على تحسين مواقعه، وهذا هو السبب في أن مقترحات إنهاء الحروب طويلة الأمد تتخذ عادةً شكل دعوات لوقف إطلاق النار.
إلا أن مشكلة وقف إطلاق النار تكمن في أن أطراف النزاع تميل إلى اعتبارها مجرد توقف مؤقت للقتال، وقد يكون لها تأثير ضئيل على النزاعات الكامنة وراءها، وقد تتيح ببساطة الفرصة لكلا الطرفين للتعافي وإعادة تنظيم صفوفهما للجولة التالية. لقد استمر وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الكورية في عام 1953 لأكثر من 70 عامًا، لكن النزاع لا يزال دون حل، ويواصل الطرفان الاستعداد لحرب مستقبلية.
لا تزال معظم نماذج الحرب تفترض وجود تفاعل بين قوتين مسلحتين نظاميتين. ووفقًا لهذا التأطير، يأتي النصر العسكري الحاسم عندما تعجز قوات العدو عن العمل، وينبغي أن تترجم هذه النتيجة بعد ذلك إلى نصر سياسي أيضًا؛ حيث لا يكون أمام الطرف المهزوم خيار سوى قبول شروط المنتصر، وبعد سنوات من التوتر والقتال المتقطع، قد يصل أحد الطرفين إلى وضع يسمح له بادعاء تحقيق نصر قاطع. ومن الأمثلة على ذلك هجوم أذربيجان في ناغورنو كاراباخ في عام 2023، والذي قد يُنهي حربًا استمرت ثلاثة عقود مع أرمينيا.
وبدلاً من ذلك، حتى لو ظلت القوات المسلحة لدولة ما سليمة إلى حد كبير، فقد تتزايد الضغوط على حكومتها لإيجاد مخرج من الصراع بسبب التكاليف البشرية والاقتصادية المتراكمة، أو قد لا يكون هناك أمل في تحقيق نصر حقيقي، كما أدركت صربيا في حربها ضد حلف الناتو في كوسوفو عام 1999، كما يمكن أن يؤدي تغيير النظام الداخلي لدى أحد أطراف النزاع إلى نهاية مفاجئة للأعمال العدائية. ولكن حتى عندما تنتهي الحروب الطويلة، فإنها من المرجح أن تترك إرثًا مريرًا ودائمًا.
بل إن النزاع قد لا يُحل حتى في الحالات التي يمكن فيها التوصل إلى تسوية سياسية، وليس مجرد وقف إطلاق النار، فالتسويات الإقليمية، وربما التنازلات الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي يقدمها الطرف الخاسر، قد تؤدي إلى استياء ورغبة في التعويض بين السكان المهزومين، وقد تظل الدولة المهزومة مصممة على إيجاد طرق لاستعادة ما فقدته.
كان هذا موقف فرنسا بعد أن خسرت الألزاس واللورين لصالح ألمانيا عام 1871 بعد الحرب الفرنسية البروسية. وفي حرب فوكلاند، ادعت الأرجنتين أنها تستعيد الأراضي التي فقدتها قبل قرن ونصف من الزمان. وعلاوة على ذلك، بالنسبة للمنتصر، فإن أراضي العدو التي تم الاستيلاء عليها وضمها ستظل بحاجة إلى حكمها وضبطها. وإذا لم يكن بالإمكان إخضاع السكان، فإن ما يبدو في البداية استيلاءً ناجحًا على الأراضي قد ينتهي إلى وضع متقلب من الإرهاب والتمرد.
وعلى النقيض من النماذج القياسية للحرب، والتي عادة ما يكون للأعمال العدائية فيها نقطة بداية واضحة وتاريخ نهاية واضح بنفس القدر، فإن النزاعات المعاصرة غالبًا ما تكون لها حدود غير واضحة؛ حيث تميل إلى المرور بمراحل، والتي قد تشمل فترات من الحرب وفترات من الهدوء النسبي.
خذ على سبيل المثال صراع الولايات المتحدة مع العراق؛ في عام 1991، هُزمت القوات العراقية بسرعة على يد تحالف تقوده الولايات المتحدة، فيما بدا ظاهريًا حربًا قصيرة وحاسمة. ولكن لأن الولايات المتحدة قررت عدم احتلال البلاد، فقد تركت الحرب صدام في السلطة، وخلق تحديه المستمر شعورًا بعدم اكتمال العمل، وفي عام 2003، في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، أعادت الولايات المتحدة غزو العراق وحققت نصرًا سريعًا آخر، وأطيح هذه المرة بديكتاتورية صدام البعثية، لكن عملية استبدالها بشيء جديد عجلت بسنوات من العنف الطائفي المدمر الذي اقترب في بعض الأحيان من حرب أهلية شاملة، واستمر بعض من عدم الاستقرار هذا إلى الآن.
ونظراً لأن الحروب الأهلية وعمليات مكافحة التمرد تُخاض بين السكان، فإن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من الأضرار الناجمة عن هذه الحروب، ليس فقط بوقوعهم في أعمال عنف طائفي متعمد أو تبادل إطلاق النار، ولكن لأنهم يضطرون أيضًا إلى الفرار من منازلهم، وهذا أحد الأسباب التي تجعل هذه الحروب تؤدي صراع وفوضى طويلي الأمد، وحتى عندما تقرر القوة المتدخلة الانسحاب، كما فعل كل من الاتحاد السوفييتي، وبعد ذلك بكثير، التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان، فإن ذلك لا يعني انتهاء الصراع، بل يعني أنه يتخذ أشكالًا جديدة.
في عام 2001، كان لدى الولايات المتحدة خطة “حرب قصيرة” واضحة للإطاحة بحركة طالبان، وقد نفذتها بنجاح وكفاءة نسبيًا باستخدام القوات النظامية والتحالف الشمالي بقيادة أفغانستان، ولكن لم تكن هناك إستراتيجية واضحة للمرحلة التالية. فالمشاكل التي واجهتها واشنطن لم تكن ناجمة عن خصم عنيد يقاتل بقوات نظامية بل عن عنف متوطن؛ حيث كانت التهديدات غير نظامية وانبثقت من المجتمع المدني وكانت أي نتيجة مرضية تعتمد على أهداف مراوغة تتمثل في تحقيق الحكم الرشيد والأمن للسكان، وفي غياب قوات خارجية لدعم الحكومة، تمكنت حركة طالبان من العودة، واستمر تاريخ الصراع في أفغانستان.

إن انتصار إسرائيل في عام 1967 – وهو حالة نموذجية للنصر السريع – تركها أيضًا تحتل أراضٍ شاسعة ذات سكان ساخطين، وهيأ الظروف للعديد من الحروب التي تلت ذلك، بما في ذلك حروب الشرق الأوسط التي اندلعت مع هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومنذ ذلك الحين، خاضت إسرائيل حملات ضد الحركة في قطاع غزة الذي انسحبت منه عام 2005، وضد حزب الله في لبنان حيث خاضت إسرائيل عملية سيئة الإدارة عام 1982. واتخذت الحملتان أشكالاً متشابهة، حيث جمعتا بين العمليات البرية لتدمير منشآت العدو، بما في ذلك شبكات الأنفاق، وبين الضربات ضد مخزونات الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ وقادة العدو.
وتسبب كلا الصراعين في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتدمير واسع النطاق للمناطق المدنية والبنية التحتية. ومع ذلك، يمكن اعتبار الحملة على لبنان ناجحة لأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار بينما كانت الحرب في غزة لا تزال جارية، وهو أمر قال إنه سيرفض القيام به.
وعلى النقيض من ذلك، لم يكن وقف إطلاق النار الذي لم يدم طويلًا في غزة انتصارًا، لأن الحكومة الإسرائيلية وضعت هدفًا لها هو القضاء التام على حماس، وهو ما لم تحققه.
وفي مارس/ أذار، وبعد انهيار المفاوضات، استأنفت إسرائيل الحرب، ولكن دون إستراتيجية واضحة لإنهاء الصراع بشكل نهائي. وعلى الرغم من استنزافها الشديد، إلا أن حماس لا تزال فاعلة، وفي غياب خطة متفق عليها للحكم المستقبلي لغزة أو بديل فلسطيني قابل للتطبيق، ستبقى حماس حركة مؤثرة.
في أفريقيا، تبدو النزاعات طويلة الأمد ظاهرة متوطنة، ويعد أفضل مؤشر على العنف المستقبلي هناك هو العنف الماضي؛ حيث تندلع الحروب الأهلية في جميع أنحاء القارة ثم تخمد، وغالبًا ما تعكس هذه الحروب انقسامات عرقية واجتماعية عميقة تتفاقم بسبب التدخلات الخارجية، فضلاً عن أشكال أكثر فظاظة من الصراع على السلطة.
ويضمن عدم الاستقرار الكامن وراءها استمرار الصراع الذي يمكن أن يكون للأفراد والجماعات مصلحة فيه، ربما لأن القتال يوفر حافزًا وغطاءً للاتجار بالأسلحة والبشر والسلع غير المشروعة. تنطوي الحرب الحالية في السودان على اقتتال أهلي وولاءات متغيرة، حيث أطيح بنظام قمعي على يد تحالف انقلب على نفسه فيما بعد، مما أدى إلى حرب أشد ضراوة، كما تضم الحرب أطرافًا خارجية مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، اللتين تهتمان بمنع الخصوم من تحقيق مكاسب أكثر من اهتمامها بإنهاء العنف وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي وإعادة الإعمار.
وإثباتًا للقاعدة، بأن اتفاقات وقف إطلاق النار ومعاهدات السلام، عندما حدوثها، غالبًا ما تكون قصيرة الأجل؛ فقد وقعت الأطراف السودانية أكثر من 46 معاهدة سلام منذ حصول البلاد على الاستقلال في عام 1956. وعادةً ما يتم تحديد الحروب عندما تتطور إلى مواجهة عسكرية مباشرة، لكن الغليان الذي يسبق الحرب ويليها هو جزء من العملية نفسها، وبدلًا من اعتبارها أحداثاً منفصلة لها بداية ووسط ونهاية، قد يكون من الأفضل فهم الحروب على أنها نتيجة لعلاقات سياسية سيئة ومختلة يصعب إدارتها بالوسائل السلمية.
نوع مختلف من الردع
إن الدرس الرئيسي الذي يمكن للولايات المتحدة وحلفائها استخلاصه من تجربتهم الكبيرة في الحروب الطويلة هو أنه من الأفضل تجنبها، فإذا ما تورطت الولايات المتحدة في صراع طويل الأمد مع القوى العظمى، فإن اقتصاد البلاد ومجتمعها بأكمله سيحتاج إلى أن يوضع في حالة حرب، وحتى لو انتهت مثل هذه الحرب بما يقارب النصر، فمن المرجح أن يشتت السكان وتستنزف الدولة جميع قدراتها الاحتياطية.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى شدة الحرب المعاصرة، وسرعة الاستنزاف، وتكاليف الأسلحة الحديثة، فإن زيادة الاستثمار في المعدات والذخائر الجديدة قد لا يكون كافيًا لاستمرار الحرب المستقبلية لفترة طويلة. كحد أدنى، ستحتاج الولايات المتحدة وشركاؤها إلى شراء مخزونات كافية مسبقًا للقتال لفترة كافية لبدء تعبئة أكثر شمولًا وحدة.
ثم يأتي بالطبع خطر نشوب حرب نووية، ففي مرحلة ما خلال حرب طويلة الأمد تشمل روسيا أو الصين، قد يكون الإغراء باستخدام الأسلحة النووية لا يقاوم، وقد يؤدي مثل هذا السيناريو على الأرجح إلى نهاية مفاجئة لحرب تقليدية طويلة، فبعد سبعة عقود من النقاش حول الإستراتيجية النووية، لم يتم التوصل بعد إلى نظرية موثوقة للانتصار النووي على خصم قادر على الرد بالمثل.
وكما هو الحال بالنسبة لإستراتيجيي الحرب التقليدية، ركز المخططون النوويون على السرعة والحركات الافتتاحية المنفذة ببراعة، بهدف القضاء على وسائل العدو للرد بالمثل والقضاء على قيادته، أو على الأقل إثارة ذعره وإرباكه لإحداث حالة من الشلل والتردد. ومع ذلك، فقد بدت جميع هذه النظريات غير موثوقة وافتراضية، لأن أي ضربة أولى يجب أن تواجه خطر إطلاق العدو لضربات استباقية عند الإنذار، بالإضافة إلى بقاء أنظمة كافية لرد مدمر. ولحسن الحظ، لم يتم اختبار هذه النظريات على أرض الواقع. فأي هجوم نووي لا يؤدي إلى انتصار فوري، ويؤدي بدلا من ذلك إلى مزيد من الاشتباكات النووية، قد لا يطول أمده، لكنه سيكون مدمرًا بلا شك، وهذا هو السبب في وصف هذه الحالة بأنها حالة “تدمير متبادل مؤكد”.
ومن الجدير بالذكر أن أحد أسباب الحماس الكبير الذي تبنت به المؤسسة الدفاعية الأمريكية العصر النووي كان لأنه قدم بديلًا عن الحروب العالمية المدمرة في أوائل القرن العشرين، فقد كان الإستراتيجيون يدركون تمامًا أن المعارك بين القوى العظمى يمكن أن تكون طويلة ودموية ومكلفة للغاية.
ومع ذلك، وكما هو الحال مع الردع النووي، قد تحتاج القوى العظمى الآن إلى الاستعداد بشكل أوضح لحروب تقليدية أطول مما تفترضه الخطط الحالية – ولو كان ذلك فقط من باب المساعدة في ضمان عدم وقوعها – وقد أظهرت الحرب في أوكرانيا بشكل مؤلم، أن القوى العظمى يمكن أن تتورط في حروب طويلة حتى عندما لا تكون متورطة بشكل مباشر في القتال. ستحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تحسين قواعدهم الصناعية الدفاعية وبناء مخزونات من الأسلحة للاستعداد بشكل أفضل لهذه الحالات الطارئة في المستقبل.
ومع ذلك، فإن التحدي المفاهيمي الذي يطرحه هذا النوع من الاستعدادات يختلف عما هو مطلوب للاستعداد لمواجهة هائلة بين القوى العظمى، وعلى الرغم من أن هذا الاحتمال قد يبدو غير مستساغ، إلا أن المخططين العسكريين بحاجة إلى التفكير في كيفية إدارة صراع طويل الأمد بنفس الطريقة التي فكروا بها في إدارة التصعيد النووي. فمن خلال الاستعداد لإطالة أمد الصراع وتقليل ثقة أي معتدٍ محتمل في القدرة على شن حرب قصيرة ناجحة، يمكن أن يوفر الإستراتيجيون الدفاعيون نوعاً آخر من الردع: فهم يحذرون الخصوم من أن أي انتصار، حتى لو أمكن تحقيقه، سيأتي بتكلفة باهظة غير مقبولة على جيشهم واقتصادهم ومجتمعهم.
تبدأ الحروب وتنتهي بالقرارات السياسية، فالقرار السياسي ببدء صراع مسلح يرجح أنها ستكون حربًا قصيرة الأمد؛ أما القرار السياسي بإنهاء القتال فيعكس التكاليف والعواقب التي لا مفر منها لحرب طويلة الأمد. وبالنسبة لأي قوة عسكرية، فإن احتمال نشوب أعمال عدائية طويلة الأمد أو لا تنتهي، واحتمالية حدوث عدم استقرار اقتصادي وسياسي كبير، هي أسباب وجيهة للتردد قبل الشروع في حرب كبرى والبحث عن وسائل أخرى لتحقيق الأهداف المرجوة، ولكنها تعني أيضًا أنه حتى عندما تكون الحروب أمرًا لا مفر منه، فإن أهدافها العسكرية والسياسية يجب أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق ومحددة بطرق يمكن تنفيذها بالموارد العسكرية المتاحة. إن إحدى أكبر المغريات التي توفرها القوة العسكرية هي أنها تعد بإنهاء النزاعات بشكل سريع وحاسم، لكنها نادرًا ما تفعل ذلك في الممارسة العملية.
المصدر: فورين أفيرز