عصر الأحادية الأمريكية: كيف ستعيد قوة عظمى مارقة تشكيل النظام العالمي؟
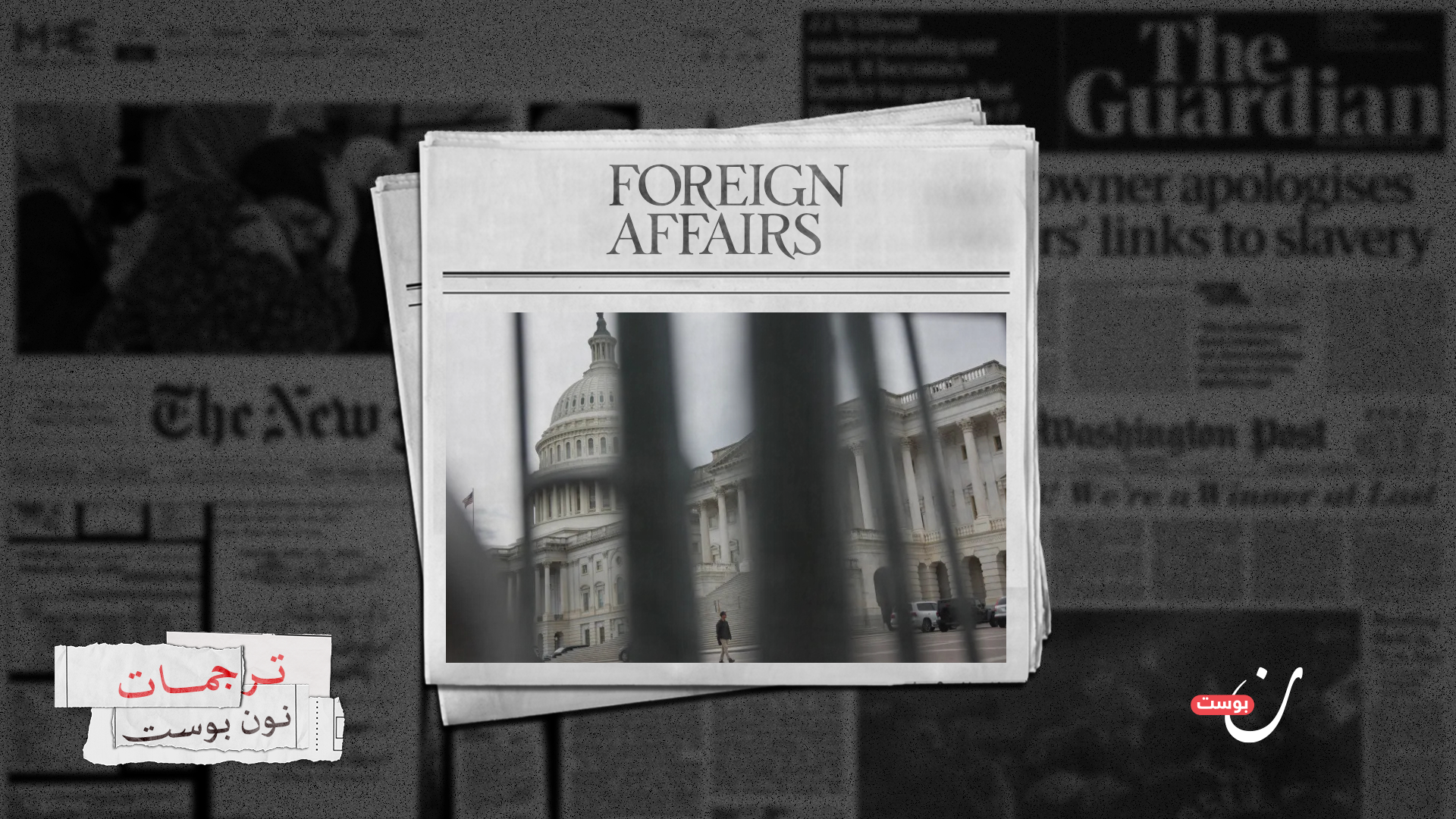
ترجمة وتحرير: نون بوست
منذ نهاية الحرب الباردة، كان من المتوقع أن تتبع الولايات المتحدة أحد مسارين في السياسة الخارجية: الحفاظ على مكانة البلاد كقائدة للنظام الدولي الليبرالي، أو الانسحاب والتكيف مع العالم متعدد الأقطاب ما بعد أمريكا، ولكن كما ذكرتُ في مجلة “فورين أفيرز” في عام 2020، كان المسار الأكثر ترجيحًا دائمًا هو المسار الثالث: أن تصبح قوة عظمى مارقة، لا هي دولية ولا انعزالية، بل عدوانية وقوية وتسعى بشكل متزايد إلى تحقيق مصالحها.
وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفًا حادًا لهذه الرؤية من خلال رفع التعريفات الجمركية إلى مستويات تحاكي قانون سموت- هاولي سيئ السمعة لعام 1930، وخفض المساعدات الخارجية، وازدراء الحلفاء، واقتراح الاستيلاء على أراضٍ أجنبية، بما في ذلك غرينلاند وقناة بنما.
ومع ذلك؛ فإن ترامب يعمل على التعجيل بهذا المسار أكثر من كونه عقلًا مدبرًا له؛ حيث يقوم بتوجيه الإحباطات التي طال أمدها من القيادة العالمية والقوى الهيكلية الأعمق، دافعًا بالإستراتيجية الأمريكية إلى الداخل. والسؤال الحقيقي الآن ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل السير في نهجها الخاص، بل كيف وإلى أي مدى ستفعل ذلك؟
لم يعد فهم دوافع هذا التحول مسألة نقاش أكاديمي، بل إنه أمر ضروري لصياغة ما سيأتي بعد ذلك. فإذا كان قد يُكبح جماح تحول واشنطن أحادي الجانب، فإنه قد يزعزع استقرار العالم ويقوض نفوذها على المدى الطويل. ولكن إذا تم الاعتراف بهذه القوى وإعادة توجيهها، فإنها قد تشكل أساسًا لاستراتيجية أكثر تركيزًا واستدامة؛ إستراتيجية تتخلى عن الهيمنة الليبرالية المفرطة دون التخلي عن نقاط القوة الأساسية للنظام الليبرالي.
لماذا تمضي الولايات المتحدة قدمًا في نهجها الأحادي؟
إن أحد أسباب المسار المارق الذي تمضي فيها الولايات المتحدة هو أنها تستطيع ذلك، فعلى الرغم من عقود من التحذيرات من تراجع القوة الأمريكية، إلا أنها لا تزال قوة هائلة. فالسوق الاستهلاكي في البلاد ينافس حجم الأسواق في الصين ومنطقة اليورو مجتمعة، ويجري نصف التجارة العالمية وما يقرب من 90 بالمئة من المعاملات المالية الدولية بالدولار، ويتم تحويلها من خلال البنوك المرتبطة بالولايات المتحدة، مما يمنح واشنطن القدرة على فرض عقوبات قاسية.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لديها أحد أقل الاقتصادات اعتمادًا على التجارة في العالم: إذا لا تمثل الصادرات سوى 11 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي (ثلثها يذهب إلى كندا والمكسيك) مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 30 بالمئة.
وتوفر الشركات الأمريكية نصف رأس المال الاستثماري العالمي، وتهيمن على إنتاج ضروريات الحياة مثل الطاقة والغذاء، وتحقق أكثر من نصف الأرباح العالمية في صناعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك أشباه الموصلات والفضاء والتكنولوجيا الحيوية، أي ما يقرب من عشرة أضعاف حصة الصين.
تعتمد الولايات المتحدة على الصين في المدخلات الصناعية ذات الحجم الكبير – المواد الكيميائية الأساسية، والأدوية البديلة، والمعادن النادرة، والرقائق منخفضة الجودة – لكن الصين تعتمد أكثر بكثير على الولايات المتحدة وحلفائها في التقنيات المتطورة والأمن الغذائي وأمن الطاقة، مما يعني أن كلا الجانبين سيعانيان في حالة حدوث قطيعة بينها، ولكن تعويض خسائر الصين سيكون أصعب.
أما عسكريًّا، فالولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على خوض حروب كبرى على بُعد آلاف الأميال من سواحلها؛ حيث تعتمد حوالي 70 دولة – تُمثل خُمس سكان العالم وثلث ناتجه الاقتصادي – على الحماية الأمريكية من خلال اتفاقيات دفاعية، وتحتاج إلى الاستخبارات والخدمات اللوجستية الأمريكية لنقل قواتها خارج حدودها. في عالم يعتمد اعتمادًا كبيرًا على السوق والجيش الأمريكي، تتمتع واشنطن بنفوذ هائل يسمح لها بتعديل القواعد، أو التخلي عنها تمامًا.
لا تمتلك الولايات المتحدة الوسائل اللازمة للهجوم بمفردها فحسب، بل تمتلك أيضًا دافعًا متزايدًا للقيام بذلك، فالنظام الليبرالي الذي تقوده أمريكا تجاوز هدفه الأصلي، وتحول إلى متاهة من الأعباء ونقاط الضعف. لم يفشل؛ لكنه انتصر على تهديدات لم تعد قائمة: دمار الحرب العالمية الثانية وانتشار الشيوعية.
بحلول أوائل الخمسينيات، سيطر الاتحاد السوفييتي على ما يقرب من نصف أوراسيا، ونشر ضعف القوة العسكرية لأوروبا الغربية، وسيطرت الأحزاب الشيوعية، الملتزمة بإلغاء الملكية الخاصة، على ثلث الإنتاج الصناعي العالمي، وحصلت على ما يصل إلى 40 بالمئة من الأصوات في الديمقراطيات الغربية الكبرى.
في ظل هذه الظروف؛ كان التهديد الذي يتعرض له أسلوب الحياة الأمريكي واضحًا، وكذلك الحاجة إلى الدفاع عن النظام الرأسمالي، ونجحت هذه الإستراتيجية، وأصبح الغرب مزدهرًا وديمقراطيًا وانهار الاتحاد السوفييتي، لكن النجاح خلق مشاكل جديدة لم يستطع النظام القديم حلها.
على سبيل المثال؛ أصبح العديد من حلفاء الولايات المتحدة الذين ساهمت واشنطن في حمايتهم اليوم عاجزين عن تحمل أعباء جسيمة، وبفضل الضمانات الأمنية الأمريكية، خفضت دول أوروبا الغربية – بالإضافة إلى كندا واليابان – إنفاقها الدفاعي، ووسعت نطاق دول الرفاه، وتورطت بشكل عميق مع الأسواق الصينية وقطاع الطاقة الروسي، ويكافح العديد من حلفاء الولايات المتحدة لتأمين حدودهم، ناهيك عن الحفاظ على الاستقرار العالمي.
وعندما تندلع الأزمات، يلجأون إلى واشنطن – لفرض حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي في مواجهة العدوان الصيني، أو لتسليح أوكرانيا ضد روسيا، أو لحماية الشحن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. لقد أصبحت الدول التي كانت في السابق ركيزة للنظام الليبرالي تابعة، وتستنزف قوة الولايات المتحدة بدلاً من تعزيزها.
والأسوأ من ذلك أن الولايات المتحدة مكّنت أخطر خصومها عندما سهلت اندماج روسيا والصين في النظام الليبرالي؛ حيث استفاد كلا النظامين من نظام التحالف الذي قادته الولايات المتحدة، والذي أدى إلى تهدئة خصومهما التاريخيين في ألمانيا واليابان، وكبح انتشار الأسلحة النووية، وتأمين طرق التجارة العالمية.
ومع تأمين أجنحتهما وخطوط إمداداتها نسبيًا، بدأتا في إعادة رسم خريطة أوراسيا بالقوة: روسيا من خلال غزو جورجيا وأوكرانيا؛ والصين من خلال بناء جزر عسكرية في بحر الصين الجنوبي، والتعدي على أراضي الهند، وتصعيد التهديدات ضد تايوان.
وتمكنوا أيضًا من الوصول إلى الأسواق والمؤسسات والشبكات الغربية، ثم استغلوا هذا الوصول لاختراق النظام والتسلط عليه ونهبه؛ حيث تغسل روسيا ثروات القلة الحاكمة من خلال البنوك الغربية، وتنشر المعلومات المضللة، وتسلح الطاقة لتفتيت أوروبا. أما الصين فتحمي أسواقها المحلية بينما تغرق الأسواق الأخرى بالصادرات المدعومة، وتنفق على السياسة الصناعية عشرة أضعاف متوسط ما تنفقه الدول التي تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتهيمن الصين الآن على قطاعات التصنيع الإستراتيجية مثل بناء السفن والطائرات المسيرة والإلكترونيات والأدوية، وتستخدم هذه الهيمنة كسلاح لإكراه الولايات المتحدة وحلفائها من خلال خفض صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، وتهديد سلاسل توريد الأدوية، وإغراق تايوان بالطائرات المسيرة، وإغراق أوروبا بالسيارات الكهربائية منخفضة السعر.
في الداخل، تفرض بكين رقابة على الأفكار الأجنبية؛ وفي الخارج، تستغل الإنترنت المفتوح لسرقة الملكية الفكرية وزرع البرمجيات الخبيثة في البنية التحتية الغربية ونشر الدعاية، كما أنها تتولى أدوارًا قيادية في مؤسسات مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فقط لتقويض المعايير الليبرالية التي بُنيت هذه المؤسسات لدعمها، لأنه ما كان يومًا ما حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية – الانفتاح – أصبح الآن بمثابة حصان طروادة داخل قلعتها.
علاوة على ذلك، أصبحت السيطرة على النظام الليبرالي أكثر صعوبة، فقد دعمت واشنطن عملية إنهاء الاستعمار ودمج دول جديدة في الأسواق والمؤسسات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى تغذية العولمة و”صعود البقية” ومضاعفة عدد الدول ذات السيادة.
لكن النجاح كان له ثمن، فمع تكاثر اللاعبين الجدد، انقسمت السلطة وتضاعفت الجهات التي تملك حق النقض، وتحولت المؤسسات التي عززت نفوذ الولايات المتحدة ذات يوم – بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي – إلى ساحات للجمود والمواقف المعادية للولايات المتحدة.
وكانت العواقب مدمرة بنفس القدر في الداخل؛ فقد غذت العولمة النمو، لكنها أفرغت الصناعات الأمريكية من قيمتها وركزت المكاسب في أماكن بعينها، حيث انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي بين عامي 2000 و2020 بنسبة 10 في المائة تقريبًا (باستثناء صناعات أشباه الموصلات)، واختفت وظيفة واحدة من كل ثلاث وظائف في المصانع.
وذهب صافي نمو الوظائف بأكمله تقريبًا إلى أغنى 20 بالمئة من المناطق البريدية، تاركًا معظم البلاد في الخلف. وقد كانت التداعيات الاجتماعية مذهلة: ارتفاع مطالبات إعانات الإعاقة، وتعاطي الجرعات الزائدة من المخدرات، وتسرب العمال في سن العمل بأعداد كبيرة من سوق العمل بأرقام تعادل أرقام فترة الكساد الكبير. تحتفظ العديد من المجتمعات المحلية المتضررة بنفوذها السياسي بفضل النظام الانتخابي الذي يضخم الأصوات الريفية على حساب الأغلبية الحضرية. والنتيجة: ابتعاد شديد عن النزعة الليبرالية الدولية واتجاه نحو الحمائية والرقابة على الحدود.
العاصفة المتصاعدة
ووفقًا لما طرحته في عام 2020، هناك اتجاهان قويان – التغير الديموغرافي والأتمتة المتنامية – يعيدان تشكيل المشهد العالمي ويعززان النزعة الأحادية الأمريكية؛ فالتغيّر الديموغرافي السريع يضعف القوى العظمى في أوراسيا ويزعزع استقرار مساحات شاسعة من العالم النامي، وفي الوقت نفسه، تقلل التكنولوجيات الجديدة من حاجة الولايات المتحدة إلى العمالة الأجنبية والطاقة والقواعد العسكرية الكبيرة.
والنتيجة هي حالة من التفاوت المتزايد: فوضى متصاعدة وحلفاء ضعفاء من جهة، واكتفاء ذاتي أمريكي متزايد وقدرات على الهجوم عن بعد من جهة أخرى، ومع اتساع هذه الفجوة، ستواجه واشنطن إغراءات أقوى للمضي قدمًا بمفردها.
وبدءًا بالديموغرافيا، فإن الولايات المتحدة تعد هي القوة العظمى الوحيدة التي من المتوقع أن تنمو قوتها العاملة في سن الرشد خلال هذا القرن، وبحلول عام 2050، ستفقد القوى العاملة في الاقتصادات الرئيسية في أوراسيا حوالي 200 مليون شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عامًا – وهي الفئة التي تحرك الإنتاجية والتجنيد العسكري والنمو الاقتصادي – مع انخفاض بنسبة 25 إلى 40 بالمئة في العديد من البلدان.
وبحلول عام 2100، سيتجاوز هذا الرقم 300 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تفقد الصين وحدها 74 بالمئة من القوى العاملة في سن الرشد.
وستتضاعف نسبة كبار السن في معظم البلدان بحلول منتصف القرن، مما سيدفع بنسب الدعم (عدد العمال لكل متقاعد) إلى مستويات مدمرة؛ فعلى سبيل المثال، ستنخفض نسبة الدعم في الصين من عشرة إلى واحد في عام 2000 إلى أقل من اثنين إلى واحد بحلول عام 2050.
ويؤدي التراجع الديموغرافي بالفعل إلى تراجع يتعدى نقطة مئوية واحدة في النمو السنوي من الاقتصادات الرئيسية في أوراسيا، كما تضخمت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 250 بالمئة في المتوسط. ومع انكماش الاقتصادات الأخرى وإجهادها، سيصبح اقتصاد الولايات المتحدة أكثر مركزية للنمو العالمي، وستصبح قاعدتها المالية وقوتها العسكرية أكثر قوة من حيث القيمة النسبية.
ولكن من غير المرجح أن تُحوّل الولايات المتحدة تفوقها الديموغرافي إلى حقبة جديدة من الهيمنة الليبرالية، بل إن الاضطراب الديموغرافي يزيد من المخاطر التي تهدد دفاعات الحلفاء لأنه يؤجج اختلالًا خطيرًا في التوازن: فالخصوم الاستبداديون يتجهون نحو التسليح رغم انخفاض عدد السكان، بينما يُعيد الحلفاء الديمقراطيون تسليح أنفسهم ببطء، مُقيّدين بشيخوخة الناخبين والتزامات الرعاية الاجتماعية المتزايدة، ومع ميل التوازن الأوراسي نحو الأنظمة الاستبدادية، تستمر المخاطر التي تهدد التزامات الدفاع الأمريكية في التزايد.
وأصبح هذا النمط واضحًا بالفعل، فروسيا والصين وكوريا الشمالية تفعل ما دأبت الأنظمة الاستبدادية المتعثرة على فعله منذ فترة طويلة: اللجوء إلى الجيش لتأمين أنظمتها. عندما يتباطأ النمو وتهدد الاضطرابات، يوجه الديكتاتوريون الموارد إلى القوات المسلحة لقمع المعارضة وردع المنافسين وضمان الولاء داخل صفوفهم.
واتبع الاتحاد السوفيتي هذا المسار في السبعينيات والثمانينيات؛ حيث ضاعف الإنفاق الدفاعي حتى مع ركود اقتصاده وسكانه، واليوم تفعل روسيا الشيء نفسه؛ حيث تخصص 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، وتخفض الميزانيات المدنية، وتعوض خسائر ساحة المعركة في أوكرانيا بمعدل 25000 إلى 30000 جندي شهريًا.
وتقوم الصين، على الرغم من انهيار قوتها العاملة، بأكبر حشد عسكري في زمن السلم منذ ألمانيا النازية في الثلاثينيات. وتواصل كوريا الشمالية، على الرغم من فقرها وشيخوختها، ضخ الموارد في الأسلحة والحرب.
ومن المرجح أن يتعمق هذا النفور الأمريكي المتزايد لتفادي التورط الخارجي مع تزايد الاضطرابات الديموغرافية في العالم النامي. ففي حين أن البلدان الغنية تشهد شيخوخة وانكماشًا سكانيًا، فإن الكثير من بلدان الجنوب العالمي يشهد انفجارًا ديمغرافيًا.
وستضيف أفريقيا وحدها أكثر من مليار شخص بحلول سنة 2050، معظمهم في البلدان التي تعاني بالفعل من الفقر وضعف الحوكمة وضغوط التغير المناخي. وتتجاوز معدلات بطالة الشباب 30 بالمائة في العديد من هذه الدول، فيما تنهار أنظمة التعليم.
ويعاني ما يقرب من نصف البلدان الأفريقية من ضائقة الديون، وربعها في حالة صراع نشط، مع وجود اتجاهات مماثلة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وتؤدي الطفرات السكانية في صفوف الشباب، لا سيما في الدول الأضعف قدرة، إلى عدم الاستقرار والتطرف والهجرة الجماعية. وبينما يفر المهاجرون إلى الأمريكتين وأوروبا، فإنهم يغذون ردود الفعل الشعبوية ويعززون غريزة الولايات المتحدة في عزل نفسها.
وفي الوقت نفسه، فإن التقنيات الجديدة تسهل هذا الميل الانعزالي وتجعل منه خيارًا مغريًا. فبفضل الطائرات المسيّرة والقاذفات بعيدة المدى والأسلحة السيبرانية والغواصات والصواريخ الدقيقة بات بإمكان الولايات المتحدة استهداف أهداف في جميع أنحاء العالم دون الاعتماد الكبير على قواعد دائمة في الخارج، تلك التي أصبحت أكثر عرضة لهجمات خصوم باتوا يمتلكون تقنيات مماثلة.
ونتيجة لذلك، يتحوّل الجيش الأمريكي من قوة موجهة لحماية الحلفاء إلى قوة تركز على معاقبة الأعداء، من خلال شنّ ضربات من داخل الأراضي الأمريكية، ونشر مناطق قتل آلية من الطائرات المسيرة والألغام بالقرب من حدود الخصوم، وإرسال وحدات استطلاعية سريعة لتنفيذ ضربات دقيقة ثم الانسحاب قبل التعرض لخسائر. ولم يعد الهدف هو الردع من خلال التواجد، بل التدمير عن بُعد.
ويعيد المنطق ذاته تشكيل الاقتصاد الأمريكي؛ فالاعتماد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي يقلّص الحاجة إلى العمالة الأجنبية. كما تساهم تقنيات التصنيع الإضافي (كالطباعة ثلاثية الأبعاد) واللوجستيات الذكية في تقليص سلاسل التوريد وتمكين إعادة التصنيع إلى الداخل.
ويحل الذكاء الاصطناعي محل مراكز الاتصال الخارجية. ومع توفر مصانع أكثر أتمتة وطاقة رخيصة وأكبر سوق استهلاكية في العالم، وعودة الشركات الأميركية إلى الوطن – ليس فقط لدواعي أمنية، بل لأن ذلك منطقي اقتصاديًا. وصحيح أن اعتماد الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي لن يختفي، لكنه بات أكثر ضيقًا وانتقائية – وأسهل قطعًا عند وقوع الأزمة العالمية التالية. فاقتصاد الحصن ينهض موازاةً لحصن عسكري، وهما معًا يجعلان الانكفاء يبدو أكثر أمانًا وعقلانية.
ولهذا السبب، فإن فكرة “القوة العظمى المارقة” لم تعد مجرد افتراض نظري، بل تمثل المسار الأسهل والأكثر احتمالًا. فالسؤال لم يعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحول إلى قوة مارقة، بل أي نوع من هذه القوة ستصبح. فهل ستكون قوة متهورة ومفرطة في النزعة القومية تضرب يمنة ويسرة، وتقطع الروابط، وتسعى لتحقيق مكاسب محدودة بثمن إستراتيجي باهظ على المدى الطويل؟ أم أنها ستتمكن من توجيه قوتها نحو وضع أكثر أستراتيجية، تتخلى فيه عن التورط المفرط، لكنها تحافظ على جوهر النظام الليبرالي ضمن دائرة أضيق من الشركاء القادرين؟
عالم حر فعال
لو كانت الحياة تدور فقط حول المال، وكان الهدف من السياسة الخارجية هو جني الأرباح بأسرع ما يمكن، لربما كان ترامب القائد المثالي. فمن خلال فرض الرسوم الجمركية على الأصدقاء والخصوم على حد سواء، وتقليص المساعدات الخارجية، واقتراح الاستيلاء على أراضٍ إستراتيجية، ومطالبة الحلفاء بالاعتماد على أنفسهم، قد ينجح نهج ترامب في انتزاع بعض الأموال الإضافي، على الأقل لفترة مؤقتة.
غير أن الاقتصاد ليس اللعبة الوحيدة على الساحة، فهناك أيضًا الجغرافيا السياسية. ومن خلال التعامل مع الشؤون العالمية كأنها صفقات تجارية آنية، تخاطر الولايات المتحدة بهدم النظام نفسه الذي حافظ على السلام لأجيال. فالحروب التجارية لا ترفع الأسعار فحسب، بل تُفكك التحالفات وتدفع الخصوم نحو المواجهة.
وهكذا انهار العالم في ثلاثينيات القرن الماضي: الحمائية، والخوف، وقوى صاعدة لا ترى سبيلًا للنمو إلا من خلال القوة. ويحب مسؤولو إدارة ترامب تشبيه الصين باليابان في الثمانينيات، كشريك تجاري يمكن إجباره في النهاية على تقديم تنازلات. ولكن الصين ليست حليفًا ديمقراطيًا تحت مظلة الحماية الأمريكية، بل هي دولة استبدادية نووية انتقامية، ترى الاقتصاد والأمن وجهين لعملة واحدة. كما أن عقيدة الاندماج المدني العسكري لديها تُشبه إلى حد بعيد أيديولوجيا “أمة غنية وجيش قوي” التي اعتنقتها اليابان الإمبراطورية.
ومن منظور بكين، لا تُعد الحروب التجارية التي تؤججها واشنطن خلافات اقتصادية عابرة، بل هجومًا على القوة الوطنية الشاملة للصين، ومقدمة محتملة لحرب مسلحة.
ومثلما كانت اليابان قبل هجوم بيرل هاربر، ترى بكين نفسها اليوم في مواجهة قوة أمريكية معادية اقتصاديًا لكنها ضعيفة عسكريًا. فالجيش الأمريكي لا يملك سوى قاعدتين رئيسيتين ضمن نطاق 500 ميل من تايوان، وكلاهما بات مستهدفًا بصواريخ صينية.
كما أن مخزونات الذخيرة الأمريكية قد تنفد خلال أسابيع من اندلاع حرب كبرى. وفي الوقت نفسه، فإن 77 بالمائة من الشباب الأمريكيين غير مؤهلين للخدمة العسكرية، ويرجع ذلك أساسًا إلى السمنة وتعاطي المخدرات وانخفاض مستويات التعليم.
ويعتزم ترامب الكشف عن موازنة دفاعية بقيمة تريليون دولار، لكن إعادة بناء القاعدة الصناعية العسكرية الأمريكية قد تستغرق سنوات. وبفرضه الرسوم الجمركية قبل معالجة النواقص العسكرية، قد تكون الولايات المتحدة بصدد إشعال مواجهة ليست مستعدة تمامًا لخوضها والانتصار فيها.
ويرى البعض أن على الولايات المتحدة تفادي الصراع ببساطة، من خلال التضحية بتايوان وأوكرانيا وقبول عالم مقسم إلى مناطق نفوذ للقوى الكبرى: الصين في آسيا، وروسيا في أوروبا الشرقية، والولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي. ويستشهدون بالحرب الباردة، حينما قبلت واشنطن، على مضض، بهيمنة الاتحاد السوفيتي على أوروبا الشرقية، كدليل على أن مثل هذه الترتيبات يمكن أن تحافظ على السلام.
لكن هذا التشبيه يشوبه خلل خطير. فخلافًا للاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، لا تدافع روسيا والصين عن حدود نصر، بل تسعيان لقلب ما تعتبرانه حدود هزيمة. فمطالبهما الإقليمية لا تتوقف عند أوكرانيا وتايوان، بل تبدأ منهما.
وتسعى موسكو لإحياء “العالم الروسي” الممتد عبر أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وتطالب بكين بمعظم بحري الصين الجنوبي والشرقي وأجزاء واسعة من الهند. وقد لوّح مسؤولون عسكريون ومروجون دعائيون صينيون حتى بتهديدات تطال أراضٍ أمريكية مثل غوام وهاواي، واصفين إياها على أنها بقايا الإمبريالية الغربية.
إن منح الصين أو روسيا أجزاء من تلك المناطق لن يُرضيهما، بل سيمنحهما مزيدًا من القوة للتوسع أكثر. وحيثما تطأ أقدامهم، ستتبعها أعمال العنف والقمع. ففي أوكرانيا، قصفت روسيا مستشفيات الولادة، وعذّبت المدنيين، وخطفت الأطفال، ونهبت الكنوز الثقافية. وفي جورجيا وسوريا والشيشان، سوّت مدنًا بالأرض ودعمت أنظمة وحشية.
أما الصين، فقد سحقت الحريات في هونغ كونغ، وفرضت الأحكام العرفية في التبت، وأنشأت معسكرات اعتقال في شينجيانغ، وعسْكَرت بحر الصين الجنوبي عبر جزر اصطناعية محصنة وميليشيات بحرية بأعداد ضخمة. إن توسّع النفوذ الروسي أو الصيني لن يجلب النظام أو الازدهار، بل سينشر آلة إرهاب الدولتة.
كما أن هذا التوسع لن يتوقف عند هذا الحد. فالتاريخ يُظهر أن القوى العظمى نادرًا ما توقف زحفها ما لم يُعَق ذلك بالقوة أو بالعوائق الجغرافية. فقد توسعت الولايات المتحدة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين حتى بسطت هيمنتها على نصف الكرة الغربي والمحيطات المحيطة به.
أما ألمانيا واليابان، فلم تنتهِ طموحاتهما الإمبريالية إلا بعد سحقهما في الحرب العالمية الثانية. وبريطانيا وفرنسا، رغم ما لحق بهما من دمار خلال تلك الحرب، تمسّكتا بإمبراطورياتهما حتى أجبرتهما الثورات المناهضة للاستعمار والضغوط الأمريكية على التراجع. أما الاتحاد السوفيتي، فقد واصل التمدد، فدعم التمردات في دول الجنوب وسحق حركات الإصلاح في أوروبا الشرقية بالدبابات ونشر صواريخ نووية في كوبا. ولم يُوقف زحفه سوى مقاومة غربية مستمرة، ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن بوتين وشي سيشكّلان استثناءً لهذه القاعدة التاريخية.
وحتى إذا وضعنا المخاطر الأمنية جانبًا، فإن حجة مناطق النفوذ تنهار من الناحية الاقتصادية. فالثروات الهائلة لم تنشأ يومًا من اقتصادات محصّنة ومنعزلة، بل من أنظمة تجارية بحرية مفتوحة تتيح نموًا اقتصاديًا مستدامًا ومتراكبًا. وإذا ما انسحبت الولايات المتحدة إلى الانعزال القاري وتنازلت عن مناطق نفوذ لبكين وموسكو، فقد تظل أكثر أمنًا وثراءً من معظم الدول، لكنها ستكون أفقر بكثير مما يمكن أن تكون عليه، وأكثر عرضة لمواجهة نيران الصراع في المستقبل.
فرصة للخروج من الأزمة
ستكون الإستراتيجية الأفضل هي عدم تقسيم العالم بين الصين وروسيا، بل احتواؤهما من خلال كتلة موحدة من العالم الحر. ويبدأ هذا المشروع من الداخل. فشمال أمريكا يشكل بالفعل أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم. وتمتلك كندا والمكسيك والولايات المتحدة معًا 500 مليون نسمة، واحتياطيات هائلة من الطاقة، وطيف واسع من القدرات الصناعية. إن تعميق هذه النواة القارية، من خلال بنية تحتية مشتركة وسلاسل توريد آمنة وحرية تنقل العمالة، سيوفر للولايات المتحدة قاعدة مزدهرة للتنافس عالميًا دون الاعتماد على الخصوم.
عالميًا، يجب على الولايات المتحدة أن تؤسس دفاعًا متعدد الطبقات ضد محور الأنظمة الاستبدادية: الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا. ويجب تزويد ديمقراطيات الخطوط الأمامية، مثل بولندا وكوريا الجنوبية وتايوان وأوكرانيا، بأسلحة ثقيلة من صواريخ قصيرة المدى وقاذفات صواريخ ودفاعات جوية متنقلة وطائرات مسيّرة وألغام لصد الاقتحامات. ومن خلفهم، يقوم الحلفاء الأساسيون مثل أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة بتعزيز الجبهة بصواريخ بعيدة المدى، وقوات برية وجوية وبحرية متنقلة تهدف إلى ضرب الأهداف عبر المسرح ودعم الدفاعات الأمامية.
وتعمل الولايات المتحدة كظهير وعامل داعم وتمكين في نهاية المطاف، من خلال توفير معلومات استخباراتية من خلال الأقمار الصناعية، وعمليات نقل ثقيلة ولوجيستية، والردع النووي، والضربات الجوية والصاروخية الضخمة عبر حاملات الطائرات وقاذفات القنابل الشبحية، والغواصات.
وسيشكل التحالف العسكري نفسه تكتلًا اقتصاديًّا.د، وستقدم الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى سوقها مقابل التزامات ملموسة من الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي، وفك الارتباط مع روسيا والصين في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والاتصالات والطاقة والتصنيع المتقدم، بالإضافة إلى منح الشركات الأمريكية وصولًا متبادلًا إلى أسواقهم.
وستتضمن الاتفاقيات التجارية قواعد مشتركة بشأن مراجعة الاستثمارات وضوابط التصدير والدعم الصناعي، مع دعم مشروعات الإنتاج المشترك للتقنيات المتقدمة. والهدف ليس إحياء نظام ليبرالي عالمي شامل، بل ترسيخ تحالف اقتصادي محكم، يدافع عن أعضائه ويعزل خصومه ويستخدم قوته التفاوضية الجماعية.
إذا كان هناك جانب مشرق في هذا المشهد القاتم اليوم، فهو أن الأزمات تخلق الفرص. فالنُظم الدولية المستقرة، كنظام ويستفاليا القائم على سيادة الدول، والسلام الأوروبي الذي انبثق عن مؤتمر فيينا سنة 1814–1815، والنظام الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية، تشكّلت في خضم تنافس القوى الكبرى، حين دفع الخوف، لا المثالية، الدول إلى التكاتف. وينطبق الأمر ذاته على تجدد الولايات المتحدة، إذ لم تستثمر على نطاق واسع عبر تاريخها إلا عندما كان بقاؤها الوطني على المحك. فقد أدت الحرب الأهلية إلى التوسع السريع لشبكة السكك الحديدية في الشمال، مما مهّد لبناء خطوط عابرة للقارات. ومخاوف الحرب الباردة – وليس الإجماع في أوقات السلم – هي التي حفزت إنشاء نظام الطرق السريعة بين الولايات وقانون التعليم الدفاعي الوطني. كما موّلت الأبحاث العسكرية الابتكارات التي أنشأت صناعة أشباه الموصلات وتقنية تحديد المواقع والإنترنت. شئنا أم أبينا، تظل المخاوف الأمنية المحرك الأكثر ثباتًا للاستثمار العام في أمريكا.
ويمكن للمنافسة الحالية مع الصين وروسيا أن تلعب هذا الدور المحفِّز من جديد، فتدفع نحو إعادة بناء البنية التحتية والصناعة، وتحصين سلاسل التوريد، وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية، واستقطاب أفضل المواهب العالمية، واستعادة الثقة المدنية. ولا يقتصر الهدف على كسب صراع القوى الكبرى، بل توجيهه، لإصلاح ما هو معطوب في الداخل، وتشكيل عالم يعكس المصالح والقيم الأمريكية. ويعمل عالم حر، للولايات المتحدة، ولمن هم على استعداد وقدرة للوقوف إلى جانبها.
المصدر: فورين أفيرز