كيف يرى الأمريكيون حرية التعبير أهم من حياة الفلسطينيين؟
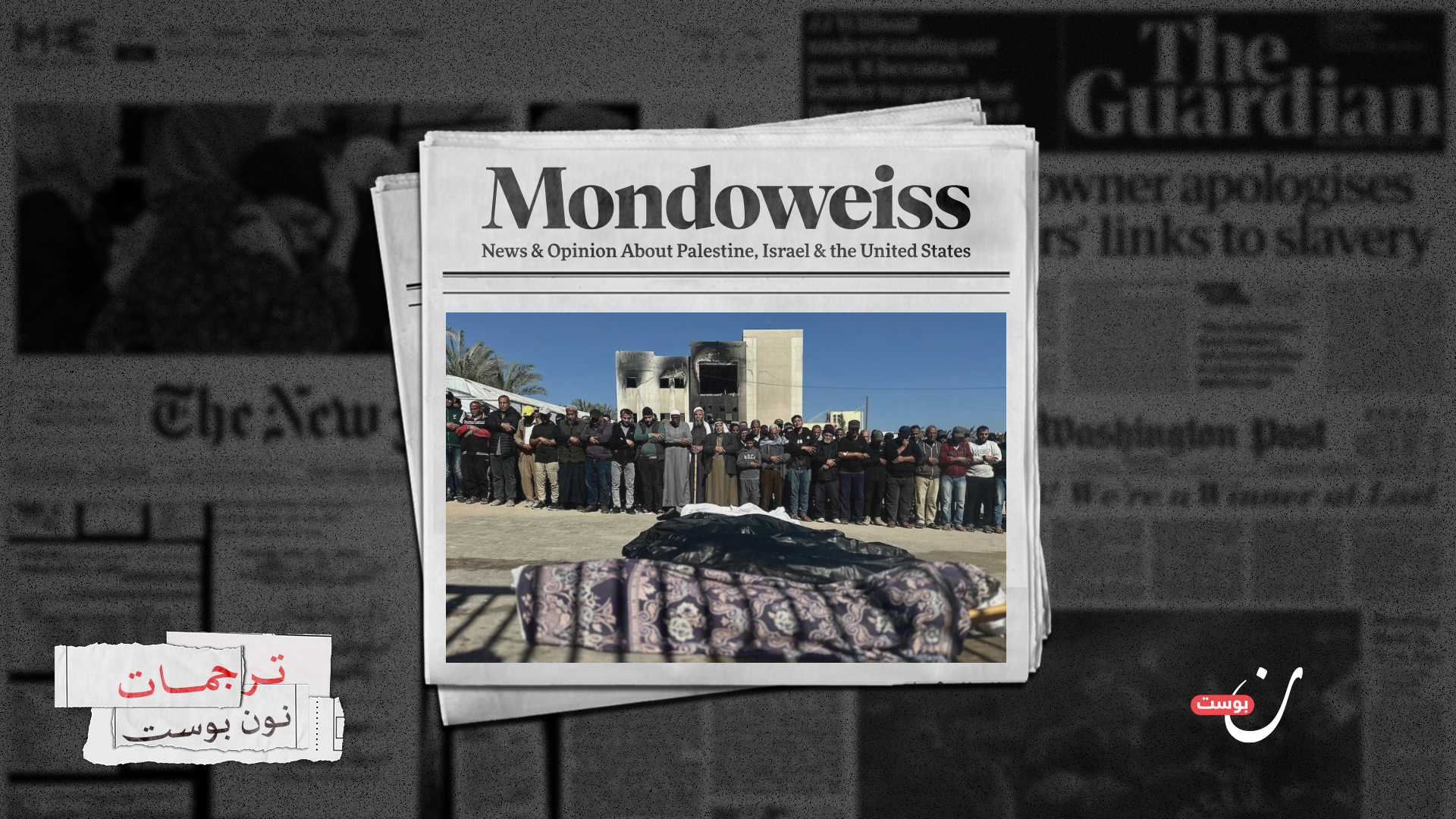
ترجمة وتحرير: نون بوست
بعد يومٍ من اختطاف واعتقال محمود خليل، وجدت نفسي أتحدث مع زميل أمريكي. كان قد مرّ أكثر من خمسة أشهر منذ أن غادر كلانا الولايات المتحدة لمتابعة الدراسات العليا في المملكة المتحدة.
وخلال هذه الفترة، كنا نتابع التوجه المتسارع نحو السياسات اليمينية في الولايات المتحدة، منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب، وصعود كبار رجال التكنولوجيا الذين باتوا يلعبون أدوارًا شبيهة بصانعي السياسات، والتفكيك الممنهج لمبادرات التنوع والإنصاف والشمول في قطاع التعليم، ومؤخرًا الاعتقالات والترحيلات التعسفية للمقيمين الداعمين لفلسطين من المقيمين الدائمين والطلاب الدوليين.
ولم تكن هذه سوى بعض الأفعال التي بدت “غير أمريكية”، لكنها باتت تُعرّف أمريكا الليبرالية، وتحرجها وتثير فيها المخاوف.
وفي بادرة حسنة النية، سألني: “بالنظر إلى كل ما يحدث الآن… هل تشعر بالقلق؟ هل ستزور الولايات المتحدة في أي وقت قريب؟”، كان توتره نابعًا من معرفته بمشاركتي في تنظيم فعاليات مؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة – وما تبع ذلك من قوائم سوداء وعقوبات وكراهية على الإنترنت.
وعلى الرغم من أنني عشت في باكستان معظم حياتي، إلا أنني شرحت له أنني ولدتُ في الولايات المتحدة وأحمل جواز سفر أزرق – وبالتالي لست قلقًا ولا أبدو معرضًا للخطر مثل العديد من أقراني الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي.
تنهد بارتياح ثم بادر بالاعتراف: لقد غيّر اعتقال محمود خليل نظرته إلى “الاحتجاجات” في أمريكا. في البداية، لم يكن الخطاب المؤيد لفلسطين حاضرًا بشكل واضح في تفاصيل حياته الجامعية اليومية، إن وجد أصلاً. أما الآن، فقد أصبح في مقدمة اهتماماته، فاعتقال الطلاب والأكاديميين أصبح محور حملة إدارة ترامب على المعارضة. وأصبحت حرية التعبير تحت الحصار وكان لا بد من القيام بشيء ما. فلا يمكن لأمريكا أن تنزلق مرة أخرى إلى المكارثية.
قال وهو يتنهد: “هذه ليست حقيقتنا… هذا ليس ما نحن عليه”.
في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1975، نظّمت جامعة ميشيغان ندوة تعليمية بعنوان “معضلة الذكرى المئوية الثانية: من المسيطر؟” وخلال الحفل الختامي، ألقى إقبال أحمد، وهو عالم سياسي باكستاني وأستاذ ومفكر عام، محاضرة بعنوان “الثورة في العالم الثالث“، وصفها بنفسه بأنها “حديث متشعب” تناول فيه ما اعتبره “روابط عضوية” بين الإمبريالية في الخارج وتبعاتها المتمثلة في الاستبداد داخل الولايات المتحدة.
وكان إقبال، وهو ناشط بارز مناهض لحرب فيتنام وعضو في مجموعة “هاريسبرغ السبعة” المتهمة بمحاولة تنفيذ “اعتقال شعبي” لوزير الخارجية آنذاك هنري كيسنجر، ملمًا بطبيعة القمع الكامن في الدولة.
وقال ذات مرة: “لا يمكن للرجل أن يكون عنيفًا وساديًا مع عشيقته، ووديعًا مع زوجته”، مشيرًا إلى خطورة إطلاق العنان للوحشية خارج الحدود. وبحلول وقت وفاته سنة 1999، كان إقبال قد شهد بنفسه، وحذّر طويلًا من مخاطر العدوان الأمريكي، أو المدعوم أمريكيًا، في جنوب شرق آسيا وأفغانستان وفلسطين وغيرها.
وشهدت ستينيات وسبعينيات القرن العشرين الدمار الذي تسببت فيه القيادة الأمريكية في فيتنام ولاوس وكمبوديا، بالإضافة إلى الدعم المستمر للأنظمة الاستبدادية في البرازيل وإيران والسعودية وإسرائيل وباكستان وجنوب أفريقيا.
واليوم، تم توثيق العنف الوحشي لهذه الحقبة وآثاره بشكل جيد. ومع ذلك، في وقت إلقاء محاضرته، كان إقبال قلقًا بشدة بشأن كيفية جعل هذا العنف “مخفيًا” عن العين الأمريكية العادية غير المهتمة. وكانت الحرب الأمريكية على الجنوب العالمي تُشنّ خدمة للمصالح الإستراتيجية والرأسمالية.
بالنسبة لإقبال، كان هذا انعكاسًا لتصميم إمبريالي أوسع: تأمين السيطرة على الموارد المادية مع توسيع الرعاية للقوى الإقليمية المكلفة بحماية الطموحات الجيوسياسية الأمريكية.
وكان إخفاء العنف الصارخ الذي يتسم به هذا المشروع عن الأنظار العامة وهمًا ضروريًا، حافظت عليه كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية لضمان الموافقة الشعبية على الحرب.
وسمح نظام معقد ومدار بإحكام من الخداع والسيطرة على المعلومات للولايات المتحدة ليس فقط بالحفاظ على شرعية مساعيها الإمبريالية، بل أيضًا بجعل المواطن الأمريكي العادي يظل غارقًا في جهل منهجي.
وكان من المفترض أن يبقى الإمبراطورية بعيدة وغير ذات صلة. وحسبما قال إقبال، فإن الأمريكيين ظلوا معزولين عن الهزيمة. ولم يختبروا أيضًا عذاب أو صدمة حروب الاستعباد، التي صُنعت خصيصًا لشواطئ وشعوب غير أمريكية. ولم تستطع أمريكا فهم المأساة لأنها كانت محمية منها بشكل خبيث.
وفي الوقت نفسه، كان بقية العالم شاهدًا على همجية أمريكا: المجازر والقصف العشوائي والاغتيالات وتغييرات الأنظمة. وهذه الجرائم غيّرت بشكل مأساوي مسار حياة ملايين الناس حول العالم، مما قلب موازين دول بأكملها. وبالنسبة لبقية العالم، لم تكن هذه الحروب مخفية أبدًا، ولم يكن العنف بعيدًا. فقد كان لا مفر منه وكان يتطلب مواجهة في فوضى الحياة اليومية.
وادعى إقبال أن التصدعات في التوافق الأمريكي أصبحت واضحة عندما “بدأت الحرب تصل إلى الوطن”. فقد تم إرسال التوابيت الأمريكية إلى الوطن، إلى جانب العديد من المحاربين القدماء المعوّقين. وتم إنفاق مئات المليارات في خدمة حرب بدا أنها خاسرة بشكل لا يمكن تداركه.
دفعت هشاشة الوهم الأمريكي الدولة إلى تشديد قبضتها على الحياة الداخلية، خاصة مع ظهور أسباب المعارضة بشكل أكثر وضوحًا. وتحول جهاز الأمن في الدولة، الذي كان قد تم نشره في البداية لصناعة الموافقة على الحرب، ليصبح موجهًا نحو الداخل. وتم اعتقال نشطاء ضد الحرب مثل إقبال نفسه.
وفي جامعة كينت، كان الطلاب الأمريكيون يواجهون فوهة البنادق. وقدمت فضيحة ووترغيت دليلًا إضافيًا على الاستبداد الكامن في الديمقراطية الأمريكية، التي وجدت نفسها الآن مكشوفة بشكل عنيف ومهين. بالنسبة لإقبال، كان ذلك يعني اكتشاف التيارات المضادة للثورة المضادة للإمبريالية الأمريكية لجذورها في الداخل.
ولم تعد الحرب خافية على عين المواطن الأمريكي.
إن براءة زميلي هي تعبير عن البراءة النظامية المدمجة في نسيج الهوية الأمريكية، وهي سمة من سمات المجتمع الأمريكي التي لا تزال تساعد في الدفاع عن الإمبراطورية وصياغتها واستمرارها.
إلا أنه الآن، أصبح لبقية العالم أسباب أقل للتسامح مع هذه الادعاءات بالبراءة. بينما تتكشف الإبادة الجماعية المتلفزة أمام أعيننا؛ حيث الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وآلاف الأطفال المقتولين والدعوات الصارخة للتطهير العرقي – لم يعد لدى أمريكا أي أعذار.
إن الفظائع في غزة أصبحت مرئية بشكل لا لبس فيه: على الحرم الجامعي وفي أماكن العمل وعلى شاشات الهواتف المحمولة؛ حيث إن تجاهل العدوان على فلسطين هو خيار فعلي.
ولطالما كان احتلال فلسطين استثمارًا للولايات المتحدة، وذلك قبل فترة طويلة من إعلان ترامب عن نيته ضم غزة من أجل المكاسب التجارية. لقد كان هذا الاستثمار الذي دام لعقود وسيلة لإرضاء الناخبين واللوبيات الصهيونية، ولضمان بقاء الشراكة الإستراتيجية بين أمريكا ودولة الفصل العنصري قائمة.
ويجب أن تُوضع اعتقالات ترامب في السياق الأوسع الذي يشمل دعم أمريكا وتمكينها وتبريرها لمصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية وحياة الفلسطينيين. لقد تجسد “التحول الاستبدادي” في أمريكا بطرق مختلفة على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، مثل التستر على معاداة السامية على الحرم الجامعي، ومنع الفلسطينيين من الحديث في المؤتمر الوطني الديمقراطي، ورفض مستمر لإعادة النظر في تمويل جرائم إسرائيل ضد الإنسانية.
وحتى الآن، بينما يدين زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، على مضض، اعتقال محمود خليل، فإنه يحذر من ذلك من خلال تشويه “الآراء والسياسات” التي يبدو أن خليل يمثلها.
أما خطاب كورّي بوكر الذي استمر خمسة وعشرين ساعة، فقد ذكر غزة بأدنى شكل ممكن، ناهيك عن دعمه المستمر للاعتداءات الإسرائيلية، مما يجعل الإبادة الجماعية مرة أخرى غير ذات أهمية بالنسبة للضمير الليبرالي.
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن صمت أمريكا وتواطئها، لم يبدأ مع فلسطين، ولن ينتهي بها. ففي حين تواصل الغارات الجوية تمزيق اليمن وقتل المدنيين في المناطق السكنية، يظل معظم الأمريكيين مهووسين بتفاصيل تافهة، كالطريقة التي أُضيف بها صحفي إلى محادثة عبر تطبيق “سيغنال”.
ويتم التدقيق في قصور المسؤولين الإداريين أكثر من الاهتمام بحقيقة أن طفلًا يمنيًا في الخامسة من عمره، يُدعى حمد، قُتل نتيجة “خطط الحرب” التي أصبح العالم يطّلع عليها اليوم.
ويذكرنا تفضيل هذه الأولويات بأن الهجمات على ليبيا والصومال وأفغانستان والعراق وبلدي الأم باكستان لن تصبح يومًا مرئية للمواطن الأمريكي. كما تذكّرنا بنظرات الذهول التي كنا نتلقاها من الديمقراطيين عندما نُفصح عن أننا اخترنا عدم التصويت لأوباما أو كلينتون أو بايدن، بسبب إرثهم في الإبادة الجماعية في الخارج.
وتبقى هذه هي المعضلة الأمريكية: من الأسهل أن نحزن على موت حرية التعبير عن الرأي أكثر من الحزن على موت أكثر من ستين ألف شخص في غزة.
أما محمود خليل، الشخص، فهو شأن ثانوي، وكذلك ما يناضل من أجله. وتفشل أمريكا في التعامل مع حقيقة أن حق محمود في التحدث عن تحرير شعبه لا ينفصل عن أصوله الفلسطينية ولا عن المعاناة المادية لفلسطين. وما يتجاهله الضمير الليبرالي، حتى في هذه اللحظة، هو أنه أُجبر على ممارسة هذا الحق بقسوة الهجوم الممول من الولايات المتحدة.
ولا يمكن لحملات إحياء حرية التعبير أن تتجاهل هذه الحقيقة. وبينما تستيقظ أمريكا على صور الطلاب المختطفين – الذين تم اقتيادهم إلى سيارات لا تحمل علامات في وضح النهار – والتي يتم تداولها على نفس شاشات الهواتف التي تحمل لقطات من غزة، يجب أن تواجه حقيقة أنها لا تزال مسؤولة عن جلب الحرب إلى الوطن.
ويوثق جدل إقبال حول “الحروب الخفية” المنطق الدائم للهيمنة الأمريكية، والأدوات التي تم استخدامها لفرضها في العقود المتعاقبة. إنه إعادة سرد تاريخي للاستبداد الأمريكي وضحاياه المحليين: أول المستجيبين، مثل محمود خليل، الذين يتحملون وطأة قمع الدولة متأثرين بمأساة الغزو الإمبريالي والإبادة الجماعية، والجماهير المنعزلة التي تفتح أعينها متأخرة وعلى مضض على تآكل الحريات داخل البلاد، وداخلها فقط.
بالنسبة للكثيرين منّا ممن يشاركون في الاحتجاجات على الإبادة الجماعية، فإن ترحيل الطلاب هو تطور صادم ومقلق، لكنه تطور لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الأوسع نطاقًا للقمع الذي تمارسه الدولة. كما أنه لا يمكن فصله عن حقيقة أنه تمت تغذيته في مناخ من اللامبالاة، والتي سمحت للمشروع الإمبريالي الأمريكي بالقضاء على حياة عدد لا يحصى من الأرواح، سواء في الداخل أو في الخارج. إذا كان الأمريكيون الليبراليون لا يزالون يفخرون بحرياتهم، فعليهم أن يحسبوا حسابًا لهذه الحرية قبل كل شيء: حرية عدم غض الطرف.
المصدر: موندويس