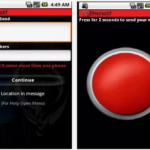يومٌ آخر يمر على عالمنا الاسلامي ونحن كما كنا قبل سبعين سنة، لا جديد في الساحة الا المزيد من الفقر والمرض والحروب والمجاعات والجهل والجاهلية، والكثير من الحقد والعنصرية والإستبداد والظلم. ربما لو كانت دولنا تحت الاستعمار لكان حالنا افضل قليلاً فعلى الاقل لوجدنا من نضع عليه اللوم، فنحن لا ننفع ان نقود انفسنا الا الى التهلكة. ترى لماذا نحن بهذا الغباء؟
في نهاية الحرب العالمية الثانية، كتب الصحفي الروائي البريطاني الشهير جورج أورويل روايةً سماها 1984، يعرض أورويل في روايته هذه تصوراً مشؤماً، يحذير فيها من مستقبل مجهول المعالم، لا قيمة فيه للانسان ككائن حر، هذا السيناريو المستقبلي المخيف يتحدث عن انتشار الاشتراكية وتقسيم العالم الى ثلاث اقطار اشتراكية معادية لبعضها البعض، حيث الحرب بينهم لا تنقطع ويتم تسخير جميع مكتسبات الدول لا للانتصار في الحرب بل لاستمرارها الى مالا نهاية.
تتكون هذه الدولة الاشتراكية التي يعيش فيها بطل الرواية من مجتمعي طبقي بحت، طبقة الحزب الداخلي وهو الحزب الوحيد في الدولة ونسبة اعضائه تمثل ٢٪ من السكان الدولة، وطبقة الحزب الخارجي ونسبتها ١٣٪ من الشعب, وأخيراً الطبقة العامة، وفوق هذه الطبقات الثلاث يوجد الحاكم المسيطر الاوحد “الأخ الأكبر” الذي لا يرى ولا يشيخ ولا يموت، ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن شعبه (الزعيم).
وكأن هذه الرواية تحكي حالنا اليوم، تحت القمع والاستبداد والحزب الاوحد الذي لا ند له! هنا تتحقق نبؤات الكاتب بشل ما، مع فرق شاسع في طريقة تعامل الحزب الاوحد مع المشككين فيه، حيث انه في الرواية لا يقتلهم ببساطة بل يغير عقولهم ويعيدهم الى ايمانهم بالحزب ثم يقتلهم بعد ان يقنعهم انهم يستحقون الموت حقاً لخيانتهم العظمى ولا يقتلون الا بعد تصديقهم بانهم حقاً خونة.
فكرة الأخ الأكبر في هذه الرواية تختلف عن غيرها، فهو ليس شخصاً بل نظام مستبد، لا يعاقب شعبه جسدياً بل فكرياً لان تغيير الافكار اصعب من القتل العشوائي، فالشعارات والثورات في ظل حكم الاخ الاكبر يتم التعامل معها بشكل مختلف تماماً، حيث يتم استدراج الناس للاعتقاد بان هناك مقاومة سرية للنظام وبعد وقوعهم في هذا الفخ يتم وضعهم في معسكرات لتطهير العقول، لدرجة التشكيك في كل شيء حتى يشك الشخص في عدد اصابع يده، هل هي اربعة ام خمسة!
وبعد هذا الاصلاح الفكري، يتم ترقية الضحية ووضعها في منصب مرموق في الدولة. هنا يوضح الكاتب اهمية الافكار وخطرها على الانظمة الاستبدادية، فلو نجحت مجموعة من الشعب في تنظيم نفسها ولو بشكل سري في التفكير والتشكيك في النظام فإن هذا بحد ذاته خطر على النظام ولو لم يقم هؤلاء باي عمل ثوري سوى التفكير.
ما اريد قوله هنا هو ان الثورات لا قيمة لها بدون تطهير فكري لشعوبها وبدون فلسفة راسخة تجمع هؤلاء الطامحين في التغيير، الثورة الفرنسية رغم عظمتها ونبل افكارها الا انها كانت بلا قيمة بالمقارنة بالعدد الهائل من القتلى، ومع هذا لم يتحقق منها شيء ملموس الا بعد ٢٠٠ سنة! فبين همجية الثوار والمحاكمات الدرامية التي تنتهي بالركوع تحت المقصلة وبين الجمهوريات الهشة والملكية المتعطشة للثأر يتضح ان لكل ثورة وقت معين يصلح لها ولشعبها ولا يمكن غصبها على المجتمع والا فستكون ردة فعل المجتمع كارثية.
والفكرة الثانية التي احاول ايصاله هنا هي ان النظم القمعية عادة تستنزف كل مكتسبات الوطن وثرواته للاستعداد وقمع اي ثورة قد تطيح بالنظام، ولذا تجد نوعية الاسلحة المكدسة في مخازن الانظمة العربية لا قيمة لها في حرب مفتوحة مع عدو خارجي ولكنها فعالة لقمع اي ثورة داخلية، مسلحةً كانت او سلمية. فالعدو الحقيقي للنظام هو الشعب.
الحاكم المستبد ماهو الا قناع يخفي النظام العميق المتشعب في كل اطراف الدولة، ولولا هذا النظام السرطاني لما صمد القناع. لذا مازلت اقول واكرر ما قلته في مطلع هذه الثورات العربية في ٢٠١١، لتنجح الثورة عليك ان تتخلى عن افكار عديدة، الثورة ليست كلمات رنانة بل خطة عملية فعالة، عبارة “الشعب يريد” لن تجدي نفعاً امام الدبابات والطائرات، لان ارادتك كشعب خطر على النظام، اذاً اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يعمل لها ويخطط لها بشكل دقيق وعملي، لا ان يخرج ويصيح في الطرقات ليل نهار.
قد يزعج كلامي هذا بعض الناس، ولكن ما قيمة تغيير الحكام والرشوى والاختلاس والفساد الاخلاقي وظلم القضاء واستبداد الشرطة ما يزال قائماً كما كان قبل الثورة؟ التغيير الجذري ياخذ الكثير من الجهد والوقت، نحتاج الى سنوات وسنوات من الاصلاح الحقيقي للمجتمع لتغيير أفكار الامة باسرها شخصاً بعد شخص، من شارع الى شارع ومن قرية الى قرية حتى تتحول الأفكار الصعبة والشبه مستحيلة الى بديهيات، وحينها تصبح الثورة حقيقة ملموسة، بدون الحاجة الى وضع تاريخ لها او يومٍ وطني للاحتفال بها.
اظن ان بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي افضل مثال لما احاول ايصاله هنا، حيث جلس يدعو قومه بشكل سري في بيئةٍ سادت عليها الوثنيّة والجهل والظلم والاحتقار والطبقية والحميّة الجاهلية، وضاعت فيها معالم الانسانية واحترام حياة الآخر، وهذا تماماً ما نعيشه اليوم في عالمنا الاسلامي بدون استثناء. في هذه المرحلة من الدعوة السرية لم يكن أمام النبي – صلى الله عليه وسلم – تجاه هذا الواقع سوى أن يؤجّل إعلان دعوته على المجتمع، ويكتفي بدعوة من حوله من الاقرباء سرّاً، حتى لا يكون الصدام العنيف مع الشعب المغيب في ظلمات الجاهلية.
استمرّ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة السرّية أكثر من ثلاث سنوات، ظلّ فيها يعلّم اصحابه حقائق التوحيد بالله عز وجل، ويغرس معاني الإيمان ومكارم الأخلاق، وبهذا تمكن صلى الله عليه وسلم من اعداد النواة الصالحة لمجتمع جديد يقوم على التوحيد والمساواة والعدل. فما كان من هذه النواة الا ان اصبحت هي الطاقة الفاعلة من أجل التغيير المنشود، حيث اصبحوا هم سفراء للرسالة ودافعين عنها وعن قيمها.
وهنا يتضح الفرق بين التخطيط العملي والعاطفة الجياشة، بين الهمجية في اشعال الثورات وبين الدراسة والاعداد الفعلي، مثال هذا هو ما تعيشه مصر اليوم من انقلاب على رئيسها المدني الاول والمنتخب بشكل نزيه وحر، ما قام به اعدائه من حشد وتنسيق وتدبير، ورغم فساد تدبيرهم الا انه يستحق المتابعة، فلقد صبروا ودبروا وخططوا واعدوا العدة لعامٍ كامل وربما اكثر ولكن المهم هنا هو التروي والتخطيط والسرية في حشدهم وتآمرهم.
ومع هذا فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، فمن يتدبر التاريخ يتضح له ان المظلوم قوي بصموده وعزة نفسه، لا يهزم ولو قتل وسحق وابيد، فالتاريخ يكتب الاحداث كما هي لا كما يريدها الجلاد، ومفهوم النصر ليس في وضع الرايات على مباني العدو وسحقه بل النصر الحقيقي هو بإكتساب قلوب الشعوب وترسيخهم للغاية المرجوة، هذا من جهة ومن الجهة الثانية فعلى المظلوم المطهد ان يدرك حقيقة قرآنية مهمة وهي قوله عز وجل: “إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ” وقال ايضاً: “وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ” فالمكر والتخطيط الفاسد مهما كان محكما وناجحاً بشلٍ عملي في الوهلة الاولى الا انه مكرٌ سيئ والمكر السيِّئ لا يحيق إلاَّ بأهله ولو بعد حين.
يقول الفيلسوف والناقد السلوفيني سلافوي جيجك في حديثه عن فلسفة الثورات؛ مشكلة الثورات هي انها بلا هدف حقيقي او اي خطة عملية مبرمجة للتعامل مع التغيرات التي تتبع قيام الثورة، ويرى جيجك ان الثورات ليست الا انذار بأن النظام ليس مرحباً به وأن هناك حاجة حقيقية للتغيير. ولكن الثورات لا تقدم اي حل عملي او اي تصور واضح للتغيير المطلوب. وعليه فإنه ينصح الثوار بان يتوقفوا عن العمل الميداني والخروج والتظاهر وأن يفكروا بشكل عميق لإعداد رُأية مستقبلية واضح للتدرج نحو التغيير المطلوب. ونصيحته الثانية هي العمل بروية وهدوء لتطبيق الخطط العملية الحكيمة التي يعدونها، ويأكد جيجك على أهمية التدرج في تحقيق التغيير المنشود بالتركيز على أشياء عملية يمكن تطبيقها.
كمجتمع شرقي معقد يبدو أن علينا سماع هذه الأفكار من فيلسوف غربي لنعرف سبب فشل ثوراتنا، فالطبقة الحاكمة ستظل تحكم حتى لو تغير القناع الذي يغطي هذا النظام، والظلم سيظل كما هو، والشباب المتحمس اليوم سيفقد الامل ويصاب بالاحباط لعدم وجود اهداف عملية لثوراتهم ولعدم وجود قيادات حكيمة تنصحهم وترشدهم الى ما يطمحون اليه من تغيير. ليس عيباً ان نعيد ترتيب افكارنا من الحين والآخر، ولكن العيب هو القيام بنفس الاخطاء و.توقع نتائج مختلفة.