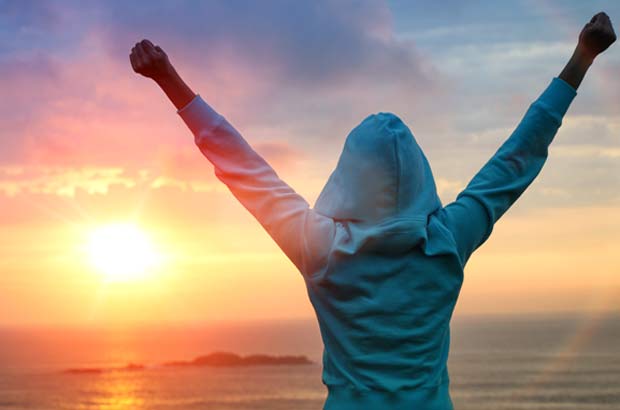عقد من الاضطراب البناء رغم الخسائر والآلام، هو عقد (2010-2020)، عقد عبرت فيه شعوب كثيرة عن رغبتها في الانعتاق والتحرر وبناء أنظمة حكم مستندة إلى شرعيات شعبية بعد عقود طويلة من مشروعيات كاذبة مثل الادعاء بتحرير فلسطين الذي استندت إليه الأنظمة العربية العسكرية، فلم تحرر فلسطين وإنما احتلت شعوبها ودمرت قدراتها الخلاقة باسم التوازن الإستراتيجي مع العدو، أو مشروعيات دينية كزعم خدمة الحرمين الشريفين.
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مركزيًا في بث موجة الحريات في المنطقة العربية خاصة والعالم عامة وجعلت نوافذ كثيرة مفتوحة بين المختلفين، ولكن هذه الوسائل وجدت مهادًا جيدًا لتسير عليه هو انتشار التعليم بعد أن آمن الناس بالمدرسة كمصعد اجتماعي ووسيلة تحرر ثقافي وسياسي، رغم أن الأنظمة السياسية والعربية منها بالخصوص عملت على جعل المدرسة وسيلة إخضاع لا وسيلة تحرر.
هذا العقد المضطرب بالحرية والأمل هو الذي سيؤسس القرن الواحد والعشرين العربي خاصة و”النامي” عامة، ومن سيدرك آخره سيعلم أن أوله طمع إلى إعادة بناء العالم على أسس من العدالة والحرية.
تراكمات من الفشل والأمل
الثورة لم تأت بغتة، بل ثمرة تراكمات طويلة وكان منتظرًا أن كم الفشل السياسي والاقتصادي الذي راكمته الأنظمة العربية سيقيم شعوبها ضدها فتسقطها، غير أن الجميع كان ينتظر القادح وقد جاء من تونس، فكانت الاستجابة واحدة في كل الأقطار، وفي مقابل الفشل المتراكم كانت الشعوب تراكم الأمل والصبر وتبحث عن بداية.
كان هناك أمران يسيران بالتوازي، فبقدر ما كانت الأنظمة تخيب ظن شعوبها بها كانت تحفزها للثورة والتغيير، لكن دون تتبع المحطات التاريخية للثورة العربية في القرن الـ21 نحاول أن نتتبع أسباب مراكمة الأمل وأدواته التي جعلت القادح فعالًا ومنتجًا للتغيير.
يمكن القول إجمالًا إن المدرسة حررت الناس، أما وسائل الاتصال الحديثة فقد فتحت نوافذ بين الأفكار والتطلعات وجعلت المنطقة العربية متفقة في كثير من الأفكار والطموحات
لقد فعلت المدرسة فعلها عبر الزمن، فلم يكن التعليم في مجمله ممتازًا ومنتجًا لمعرفة علمية إذا قارنا نتائجه بالمدرسة الغربية، ولكن نسبة المتعلمين كانت دومًا في ازدياد وآمن الناس بالمدرسة كمصعد اجتماعي رئيسي وآمن بها كثيرون كوسيلة تغيير فكري وثقافي بما جعلها وسيلة تغيير سياسي أيضًا، ولذلك تلقف المتعلمون التطورات في مجال الاتصال وانخرطوا في نشر رغبتهم بتغيير أوضاعهم.
يمكن القول إجمالًا إن المدرسة حررت الناس أما وسائل الاتصال الحديثة فقد فتحت نوافذ بين الأفكار والتطلعات وجعلت المنطقة العربية متفقة في كثير من الأفكار والطموحات، وترجمت شعارات الثورة العربية هذه الوحدة لفظًا ومعنى رغم وجود ترسبات فكرية أيديولوجية أعاقت حتى الآن تحول وحدة الشعوب إلى وسيلة بناء ديمقراطي.
بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك إلى القول إن شعوب العالم الثالث (وهي تسمية مجمعة لشعوب وأقطار مستضعفة منذ قرون بالاستعمار المباشر ثم بالديكتاتوريات المسنودة غربيًا) توحدت حول نفس الأفكار والمشاريع الثقافية والسياسية في وضع مشابه نسبيًا لتوحدها في مرحلة تصفية الاستعمار، غير أن الجديد الآن هو القدرة العالية على التواصل بين مكونات هذه الشعوب، فحتى حواجز اللغة بدأت تتلاشى بفعل الاختصارات التعبيرية في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك نجد تونسيًا يتحدث عن فلاح رواندا في التحرر من الاستعمار الفرنسي، فيتفاعل معه مغربي وإريتري بشأن نفس الموضوع.
في الاتجاه إلى الشرعيات الشعبية
أمام موجة الحريات التي خلقتها وسائل الاتصال الحديثة فقدت الأنظمة قدرتها على الإقناع بالقوة (القمع)، لذلك نراها تأتي خاضعة لمطالب شعوبها مقللة قدر الإمكان من وسائل القمع التي اعتادت استعمالها، ويمكن قراءة الحالة الجزائرية ضمن المنطقة من زاوية أن النظام ذا الطبيعة العسكرية الذي رأينا شراسته ضد شعبه طيلة عقد التسعينيات فقد شرعية استعمال العنف فرافق الشارع المنتفض منذ سنة وانتهى إلى قسمة الطريق، ولأن الشارع لم يهمد ولم يرض بنصف انتصار فإنه يواصل الاحتجاج، ولأن النظام فقد قدرته على القمع فهو يواصل التنازلات لشعبه، والحالة المغربية (رغم زعم الولاية الدينية المزعومة للملك) يسير في نفس الاتجاه، نهاية العنف والقبول المتدرج للمشروعية الشعبية عبر الانتخاب أي عبر الحرية السياسية.
مرة أخرى نجد وسائل التواصل الاجتماعي وراء هذه الصورة التي تهدم والأخرى التي تبنى بالتدريج
يختلف الأمر كثيرًا في بلدان المشرق العربي ولكن قراءة التفاعلات الشعبية العربية مع الحالة التونسية كشفت أن أمل الشعوب في الحرية كبير وأن سعيها إليها يراكم المكاسب عبر بث حالة رفض عامة للقمع والولاء للأجنبي (في الحالة العربية الولاء للكيان الصهيوني)، وتونس ليست الدرس الوحيد فالنجاح الاقتصادي والسياسي التركي يتحول إلى نموذج قيادي وكذلك النجاح الإثيوبي والرواندي والجنوب إفريقي، فضلًا عن نماذج النمور الآسيوية وآخرها الفيتنام الفقير الذي يفرض نفسه في قائمة الناجحين.
ليست هناك صورة موحدة لهذه البلدان كأن نقول مثلًا إنها نجحت اقتصاديًا وتحررت سياسيًا بنفس المستوى ولكن الملاحظ أنه حيث ما كان هناك وجه من وجوه النجاح اهتم الناس وقارنوا وتمنوا وسعوا في أوركسترا جماعية لبناء صورة النظام السياسي الأمثل لدولهم في مواجهة صورة سلبية لم يعد يرغب بها أحد هي صورة النظام العسكري القادم على ظهر دبابة أو النظام الذي يصطنع شرعية دينية. ومرة أخرى نجد وسائل التواصل الاجتماعي وراء هذه الصورة التي تهدم والأخرى التي تبنى بالتدريج.
عدوى النجاح الكونية
عند انطلاق الثورات العربية أجرى كثيرون مقارنات بينها وبين حركات التحرر الوطني من الاستعمار (في منتصف القرن العشرين) وكتبنا أنها تكملة لمعارك الاستقلال، ذلك أن معركة التحرر أنتجت أنظمة محلية (وطنية)، لكن في غياب قوة اقتصادية عادت الأنظمة إلى ربقة الاستعمار مكرهة. نصف قرن من إدارة الفقر استعملت فيه الأنظمة أبشع وسائل القهر، لكن تحت القهر راكمت الشعوب مطالب الحرية ودخلت في موجة تغيير ثانية غير أننا نراها مهددة بالعودة إلى نقطة الصفر مثل سابقتها في غياب قدرة الأنظمة الجديدة على بناء قوة اقتصادية تحميها، سيكون هذا ممكنًا في بلدان المغرب العربي التي تشكل إقليمًا اقتصاديًا على تخوم أوروبا وإفريقيا. سيتأخر كثيرًا في بلدان المشرق العربي ولكن لنقف عند نقطة أخيرة ذات تأثير بالغ هي عدوى النجاح.
إن أي نجاح في أي مكان بالعالم في أي ميدان يصير هدفًا جماعيًا (كونيًا) بفضل سرعة انتقال المعلومة وسرعة استيعابها، وعدوى النجاح لا تحفز الشعوب فقط على المزيد من المطالبة بل تربك الأنظمة الفاشلة، وهنا تتضح المعادلة الجديدة الأنظمة التي كانت تقمع شعوبها وصارت تلاحقها لكي لا تسقط تحت ضغط مطالبها وتحت ضغط النجاحات بجوارها.
هنا انقلب القرن الماضي وهنا بدأ القرن الجديد. القيادة الفعلية صارت بيد الشعوب بدرجات ولكن كل نجاح فردي صار نجاحًا جماعيًا.