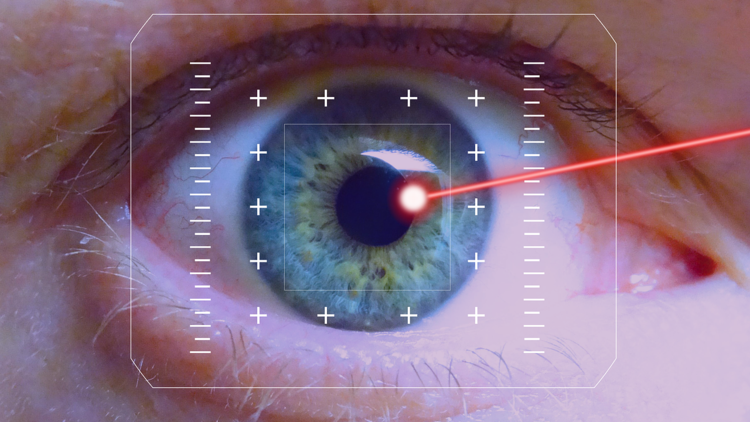أثارت الاستجابة السلبية من الشعب المصري تجاه الدعوات إلى الثورة وتطوير الحراك، تزامنًا مع ذكرى يناير وجمعة الغضب، أو تخليقًا لأيام ثورية جديدة مشتقة من الذكرى الأصلية على غرار يوم 31 يناير، التي كان أبرز الداعين إليها المقاول المتمرد محمد علي، طيفًا من المشاعر المتناقضة بين طرفي الصراع المؤدلجين في مصر.
رأى مؤيدو النظام من فريق “تحيا مصر” و”تسلم الأيادي” هذا العزوف الجماهيري عن النزول مدعاةً للانتشاء بحالة الاستقرار السائدة في البلاد ودليلًا جديدًا على تنامي نضج الجماهير التي غُرر بها خلال “النكسة” منذ تسعة أعوام، فيما ضربت حالةٌ سلبية قاسية، من الإحباط والإرهاق والصدمة، صفوف الكثيرين من مؤيِدي يناير ورافضي الانقلاب العسكري، احتجاجًا على سلوك الجماهير المتقاعسة عن تلبية نداء الثورة.
بيد أن الحقيقة تقف في المنتصف من هاتين الرؤيتين المتطرفتين، ليس لأن الحقيقة تتموضع في الوسط دائمًا كما يُشاع، وإنما لأن كلا الفريقين يتجاهلان – كعادتهما – كثيرًا من تفاصيل القصة لصالح الانحياز إلى سردية معينة تتلاءم مع موقعهم الحاليّ، وموقع الجماهير من هذا الصراع، صعودًا أو هبوطًا.
هذا الجزء الغائب عن القصة هذه المرة، الذي ينبغي طرحه في سؤال مكثف بدلًا من جلد الذات أو الاحتفاء بإنجازات وهمية هو: لماذا استجابت الجماهير لدعوات التظاهر منذ أربعة شهور فقط خلال سبتمبر/أيلول الماضي خلال فوران أزمة المقاول بينما تجاهلت نفس الجموع دعوات مشابهة هذه المرة؟ ما الذي تغير بين اليوم والبارحة؟
مثيرات نوعية
بشكل عام، تمتلك الجماهير في مصر كثيرًا من الدوافع المنطقية الكافية للنزول إلى الشارع والعمل على إسقاط النظام الحاليّ، ولكن المحتوى الذي قدمه المقاول في المرة السابقة خلال سبتمبر الماضي، كان – بمصطلح علم النفس – مثيرًا جديدًا يختلف على مستوى الشكل والمضمون، الكم والنوع، عن أي محاولة تقليدية منزوعة الدسم لحث الجماهير إلى نزول الشارع قبل ذلك. كان المثير في دعوة سبتمبر شعبويًا، واضحًا، متكاملًا، حقيقيًا، وأبعد ما يكون عن الغطاء الحزبي.
قضايا الفساد “على عينك يا تاجر” يمكن لأي مواطن معاينتها بنفسه بمنتهى البساطة، وموضوعها الرئيس جد خطير، القصور الفارهة، والمتهم رئيس الدولة وحرمه المصون، والمفارقة قد حفرها الجنرال لنفسه على مهل: ففي الوقت الذي يخرق فيه المتهمون آذان المصريين ليل نهار بالحديث عن الفقر المتأصِل في البلاد والتبشير بالقحط والمزيد من “الصب في المصلحة” وضرورة شد الحزام، فإنهم في واقع الأمر يقضون جزءًا غير هين من حياتهم في الإشراف على متابعة تشطيبات قصورهم الجديدة وترتيبات إجازاتهم السنوية. الموضوع إذًا يمس المصريين، ذاتهم الجمعية، بشكل شخصي، فثمة شعور عام بالامتهان.
أما الداعي إلى هذه الثورة وصاحب هذه الليلة – كما يقول المصريون – هو في الأصل واحد منهم، ولو حالفه الحظ بجوار البرجوازية العسكرية التي يحلم كثير من المصريين بالتقرب منها بلا مواربة، فسنوات عسله مع النظام كانت ضئيلة وقصته جديرةٌ بالتصديق: خلاف مالي ضخم واستقواء عسكري متغطرس ورغبةٌ ملحة في الانتقام بعد الوصول إلى “البرِ الثاني”.
وفي هذا التوقيت الذي فلتت خلاله السِكين وانهارت قواعد الاشتباك وقرر المقاول “نشر الغسيل” والطرق على الحديد الساخن، يمكن للجمهور الذي طالما ظل صامتًا استغلال الموقف واجترار كل الملفات القديمة وإعادة تأويل السرديات الكبرى من جديد، بدءًا من “سبوبة المقاولات” التي يبتلعها الجيش، مرورًا بـ”فناكيش المشروعات القومية”، وصولًا إلى “بيع الأرض والعرض”، والتفريط في الماء عما قريب.
سكب اعتراف السيسي البنزين على نار المصريين الذين أحسوا بإهانة كرامتهم، كما دمر في نفس الوقت مناعة جمهور النظام
في المقابل من هذا التصعيد والضرب تحت الحزام كان تعامل رأس النظام مع الأزمة مؤذيًا لنفسه ومخيبًا لآمال جماهيره، فقد خان الرِئيس لسانُه كالعادة “واعترف” بالاتهامات التي وجهها إليه المقاول المنشق، بمنتهى الصلف والتبجح، بدلًا من محاولة تفنيدها أو تجاهلها في أقل تقدير، ضاربًا عرض الحائط بنصائح الجهاز البيروقراطي للدولة، ليؤكد مضمون خطاب المقاول: “إن فرعون طغى في الأرض”، وفي نفس السياق، بدا الرئيس لأول مرة مهزومًا أمام الجمهور، فاقدًا للسيطرة، يخبط بعشوائية هنا وهناك، وقد دفعته محنته إلى استخدام أسلوب جديد لم يعتده المصريون، وهو “ابتزازهم عاطفيًا” بدوره في حركة الثالث من يوليو 2013.
سكب اعتراف السيسي البنزين على نار المصريين الذين أحسوا بإهانة كرامتهم، كما دمر في نفس الوقت مناعة جمهور النظام، فعزلهم عن المصريين وأوقعهم في نفس الفخ الذي نصبوه للإخوان سابقًا، خاصة أن ثمة عداوة حقيقية كامنة بين جمهور المصريين وشخص السيسي، تراكمت تدريجيًا خلال فترة حكمه، نتيجة انسحاقه المعنوي أمام الآخرين، أي آخرين، في مقابل استمرائه جلد أبناء شعبه على الفقر وسوء التغذية، بل واتهامهم بالكذب في بعض الأحيان.
على المستوى النفسي، جرد هذا الاعتراف أنصار السيسي من ربقة أي سرديات أخلاقية ودفاعات سيكولوجية جمعية، وحولها إلى كليشيهات ممسوخة، مثل الكلام عن نزاهة الرئيس وشرف الجيش وحماية الوطن، وداعب من جهةٍ أخرى مخيال التغيير المهيمن على نفوس المصريين، وهو المخيال المتأثر بأحداث ثورة يناير في الأساس، حيث يكون تحرك الشعب كتلة واحدة، في لحظة ما، مرهونًا بسطوته النفسية والأخلاقية على شريحة مؤيدي النظام وعصابته الأمنية المنبوذة، كما حدث في الـ28 من يناير.
حوامل الثورة
وبلغة عزمي بشارة في كتاباته المورخة لثورة يناير، فقد تهيأت “حوامل الثورة” وبيئتها بلغة علم نفس وشروطها الموضوعية بلغة علم الاجتماع، لإخراج مشهد حركة الـ20 من سبتمبر الماضي على هذا النحو التي ظهرت به، ومن ذلك رحيل السيسي إلى نيويورك في رحلة رسمية تستغرق أسبوعًا كاملًا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعني ضمنًا أن تحرك الجماهير في هذا التوقيت بالذات قد يجبره على عدم العودة إلى البلاد، مما سيُجنِب الوطن مخاطر التورط في صراعات دموية في فرصة قد لا تكرر مجددًا، وقد انتشرت بالفعل إشارات كثيرة من أشخاص ذوي حيثية، تقول بهذا المعنى، بل تؤكده أحيانًا مثل تغريدات تميم البرغوثي.
تأكدتِ الجماهير في هذا التوقيت أيضًا، من أن النظام، من بعد اعترافات الرئيس، بات في أسوأ حالاته على الإطلاق، وأن حالةً من “الهلع” غير المفهوم قد ضربت أركانه، حيث لجأ النظام إلى استدعاء كتائب ضخمة من الممثلين والفنانين ورجال الدين، في حالة “هيستريا جماعية” من أجل مهمة واحدة: لعن المقاول على شاشات التليفزيون بلا منطق وتحذير الجماهير من عواقب النزول إلى الشارع، ومن المعروف أن هذه الحالة من الفوضى الرسمية “والتطبيش” السياسي لم يرها المصريون من قبل إلا أيام يناير، كعلامة على تداعي النظام وإشارة إلى ضرورة التحرك لملء الفراغ المنتظر من غياب الدولة.
وقد سرت في الأوساط العامة “نبوءة/ بشارة” تحمل بعضًا من الوجاهة تقول إن بعض الأجهزة الأمنية الساخطة على أداء السيسي سوف تتواطأ مع الجماهير فور تحركها، إذا جاز التعبير، بيد أنها تنتظر التأكد من نزولها دفعًا لمخاطر التحرك دون غطاء شعبي، وهو ما فهمه الجميع بأننا أمام “انقلاب ناعم” جديد يشبه ما جرى في الـ30 من يونيو، وأن النزول لن يُكلف استقرار البلاد أكثر من الإطاحة بورقة السيسي المحروقة واستبدالها بورقة جديدة أكثر حكمة من نفس المعسكر.
عزز “الانحياز التأكيدي”، وهو مفهوم معروف في علم النفس يشير إلى عملية يقوم خلالها الفرد أو الجماعة بـ”انتقاء شواهد” (وتجاهل أخرى) لإضفاء نزعة منطقية على قرار ينحاز له بالفعل، من هذه النبوءة، التي يبدو أن النظام بدوره قد وقع ضحية لها أيضًا، ومن هذه الشواهد التي أعاد الجمهور تأويلها لتأكيد قرار النزول – رغم خلوها من أي مضامين واضحة – كانت تصريحات وزير الدفاع التي قال فيها إن الجيش ينحاز للمصريين، ودعوة المقاول إلى الاكتفاء بالتظاهر تحت البيوت، مع الإقرار بصحة وقائع ترحيب بعض ضباط الشرطة بالمتظاهرين خلال الساعة الأولى للتحرك للحد الذي دعا إحدى شبيحات النظام إلى بث إطلاق الاستغاثة الأشهر:”انقذ مصر يا سيسي، مصر بتضيع”.
ما الذي تغير؟
ما الذي تغير في المشهد لكي تختلف استجابة الجماهير تجاه نفس الدعوات؟ هذا هو السؤال المهم، فجميع العناصر الفاعلة في المشهد ظلت على حالها، إذ كان المقاول موجودًا والسيسي رئيسًا “بيبني وهيبني” والنظام العسكري لا يزال قائمًا والجمهور بعد أربعة أشهر عاد إلى موقع المراقب الصامت. والإجابة هي: صحيح أن عناصر المشهد لم تتغير، ولكن وعيها بمواقعها وإدراكها للمشهد وقراءتها للواقع قد تغيرت، مع استجلاء الجماهير لحقيقة بعض المواقف المشوشة التي دفعت لرسم مشهد النزول في حينها، جنبًا إلى جنب مع تغير السياق العام وغياب الشروط الموضوعية بين الماضي والحاضر.
نجح النظام من جانبه في التعافي من “الصدمة” سريعًا، ملوحًا بالتراجع عدة خطوات إلى الوراء عبر صياغة خطاب يبشر بعقد اجتماعي جديد أكثر رشدًا وإجراءات اقتصادية فورية لاسترضاء المصريين الغاضبين من فاتورة “الإصلاح”، فقد تحدث السيسي بنفسه عن مراجعة قرار حذف الملايين من كشوف الدعم، وقررت الحكومة تخفيض أسعار المحروقات نسبيًا. وهو بذلك (النظام) وإن قرر نجاح حركة المقاول في إحداث تأثير سياسي واضح بشكل رسمي، فإنه قطع الطريق عليه في نفس الوقت لزيادة الشحن الجماهيري وأرسل إلى الشعب رسالة مفادها: إننا نستمع إليكم، والأيام القادمة قد تحمل المزيد.
وعلى المستوى الداخلي من السلطة، تفاعل النظام مع الأزمة إيجابيًا على غير عادته واستجاب لسلطة المنطق وأعلن العودة إلى مربع السياسة بدلًا من القوة الغاشمة، من خلال ترتيب الأوراق الفاعلة ضمًا واستبعادًا، وقد سمعنا جميعًا خبر تسفير نجل السيسي إلى روسيا، بالتزامن مع الإطاحة بـ”أحمد شعبان” الضابط المسؤول عن ملف الإعلام، في مقابل رجوع قيادات عسكرية بارزة إلى الواجهة من جديد بعد إقصائها في السابق مثل الفريق أسامة عسكر والفريق محمود حجازي، في نفس الوقت الذي أفرج خلاله عن الفريق سامي عنان بقرار رئاسي.
كانت القبضة الأمنية الأخيرة هي الأضخم على الإطلاق منذ الـ3 من يوليو، وقد زادتها ظروف الاحتجاز القاسية سوءًا
لا شك أن النظام دُفع إلى هذه التغيرات دفعًا وأنها لم تكن بإرادته، وإنما جاءت استجابة لمعطياتٍ جديدة أرستها حركة سبتمبر، ولكن المؤكد أيضًا أنها لم تقلص من سطوة السيسي إلى الحد الذي يجعلنا نقول إنه فقد السيطرة على الحكم أو دوائر نفوذه المؤثرة، بل على العكس من ذلك، فقد خرج بأقل الخسائر الممكنة بعد هذه الحركة غير المسبوقة، وهو ما نستطيع تلمسه في عودته إلى حدود خطابه القديم الذي حاول المقاول إثناءه عنه، خطاب تعيير المصريين وتهديدهم والاستعلاء عليهم.
أما الجماهير المغضوب عليها حاليًّا، فقد رأت أنها أكبر الخاسرين مما جرى في سبتمبر بالحسابات المباشرة، فمع إجماع كل منظمات حقوق الإنسان، كانت القبضة الأخيرة هي الأضخم على الإطلاق منذ الـ3 من يوليو، وقد زادتها ظروف الاحتجاز القاسية سوءًا، بعد أن وجد المتهمون محاميهم ينامون بجوارهم في نفس معسكرات الاحتجاز، وهو عكس ما شاع في الساعات الأولى من النزول عن تساهل عناصر الشرطة في التعامل مع المتظاهرين، وقد تأكدت هذه الشريحة التي تمثل السواد الأعظم من المصريين أن “النبوءة” التي عززت رغبتهم في النزول كانت كاذبة، بل باتت مُستهلكة، فمن لم يتحرك في ظل الظروف المثالية السابقة لاستغلال غضب الجماهير، لن يتحرك بعد تعافي النظام من الصدمة أبدًا.
ولأن “المثير” بطبيعته مؤقت، فقدت تسريبات المقاول فاعليتها بمجرد تفريغ الجماهير مشاعر الغضب المكبوتة بتحدي النظام وإحراق صور البطل الشعبي الذي بات مكروهًا، واستحالت مشاعر الغضب رعبًا بعد نجاح النظام في القبض على معظم البسطاء الذين استجابوا إلى دعوات النزول بأقل مجهود واحتجازهم في ظروف تشيب لها الولدان داخل معسكرات الأمن المركزي، ثم إرسائه قواعد اشتباك جديدة في تعامله مع الجمهور تبيح تحويل المجال العام معسكرًا وتسوغ لعناصره الأمنية انتهاك أدق خصوصيات المواطن بلا رادع.
وفي ظل هذه الظروف التي تغيرت فيها قواعد اللعبة تمامًا، زاد المقاول نفسه الطين بلةً بارتكاب عدد من الأخطاء التي ساهمت في انفضاض الجماهير من حوله، مثل النزوع إلى العمل النخبوي وطريق الوثائق والمؤتمرات بدلًا من الاستثمار في المتاح، والحيد عن رحاب الوطنية الجامعة إلى ضيق الحزبية المفرقة، بل وإحراج (إحراق) من استمروا في الرهان عليه رغم بوادر نهايته التي لاحت في الأفق بعد انتهاء الأزمة، بعد الزج باسمه في ملاسنات “تمويل” أجنبي نشأت من عنده لا من خصومه هذه المرة، وهي الأمور التي حولت ملاحظات مثل ضعف خلفيته التعليمية وانحرافه الأخلاقي، كانت تراها الجماهير نوعًا من “الصعلكة” والتمرد المقبول في أثناء حالة الزخم، إلى صورة ذهنية متكاملة عن انعدام المسؤولية والاستحقاق في الوقت الحاليّ.
ولسوء الحظ، فقد غابت أهم الشروط الموضوعية السابقة عن المشهد الحاليّ، حيث تزامنت دعوات النزول إلى الشارع مع صعود “تريند” تدخل مصر عسكريًا في ليبيا لمواجهة تركيا، وهي الحرب التي يبدو – من خلال تحليل رسائلها الملقاة في مياة المتوسط – أن السيسي يريد ثمارها السياسية والإعلامية دون التورط فيها مباشرة، وذلك بالتزامن أيضًا مع زيادة معدلات “الشوفينية” الوطنية والاحتفاء بالجيش على خلفية افتتاح بعض القواعد العسكرية الجديدة، وهي الحال التي منحت السطوة النفسية هذه المرة إلى معسكر الدولجية، خاصة في ظل الإحباط الشديد في صفوف المعارضين.
هل انتهى الأمر؟
نظريًا، كان من الضروري ألا يدفع محمد علي بكل أوراقه دفعةً واحدة، كي لا يحرق نفسه، وليضمن استمراره كأحد أبرز الفاعلين في المشهد المصري، ولكن إذا تناولنا الأمر بواقعية، سيكون من الظلم تصور قدرة المقاول على لعب “جيم” بهذا المستوى، في الوقت الذي كان خصمه نفسه، النِظام بكل ما يمتلكه من أجهزة استخبارات ومراكز بحث وآلة إعلامية، يتخبط كحاطب ليل خلال الأزمة.
ويُحسب للمقاول، أيًا كانت تحالفاته، سواء كانت من جناح عمر سليمان في المخابرات العامة أو مجرد اجتهادات شخصية، نجاحه في تجريد السيسي ونظامه من كل وسائل المشروعية التي كان يضفيها على سلوكه، وتمكنه من وسم السيسي وسمًا أبديًا بالسرقة وتبديد المال العام وإجباره على إبعاد نجله المدلل عن المشهد، بشكل غير معهود في الأعراف السياسية المصرية. وهي أنجح تجارب المقاومة السياسية منذ انقلاب الـ3 من يوليو/تموز 2013 بلا شك.
حركة الجماهير ليست اعتباطية أبدًا وإن كان المثير بطبيعته مؤقتًا، فإن آثاره تظل عالقةً في اللاوعي الجمعي
ربما فشل المقاول في إقناع الجماهير بالنزول في المرة الثانية، ولكن استجابة الجماهير كانت واقعية تمامًا هذه المرة، كما هي الحال في الاستجابة الأولى، فحركة الجماهير ليست اعتباطية أبدًا كما يتخيل البعض، وإذا كان المثير بطبيعته مؤقتًا، فإن آثاره تظل عالقةً في اللاوعي الجمعي.
وما زالت الأسباب الحقيقية للتغيير قائمة كما هي، سواء كانت بنيوية، على غرار التعارض اللازم بين مصلحة الطغمة العسكرية النيوليبرالية التي تشعر باستحقاق رأسمالي محمي بالسلاح وبين العدالة الاجتماعية المنشودة، أو فشل هذا النظام في بلورة نظرية سياسية أخلاقية تبرر وجوده أكبر من سياسة “أنا أو سوريا والعراق” التي يقتات عليها، وهو ما يفتح المجال واسعًا أمام إمكانية تخليق “مثيرات” جديدة، سواء كانت ذاتية، بأيادٍ صديقة، نتيجة فشل الجهاز البيروقراطي في إدارة “اليومي” (حادثة مقتل أحد الشباب إثر إجباره على النزول في أثناء تحرك القطار نموذجًا) أم عبر بعض التنظيم والتخطيط غير التقليدي، كما فعل المقاول الحاذق.