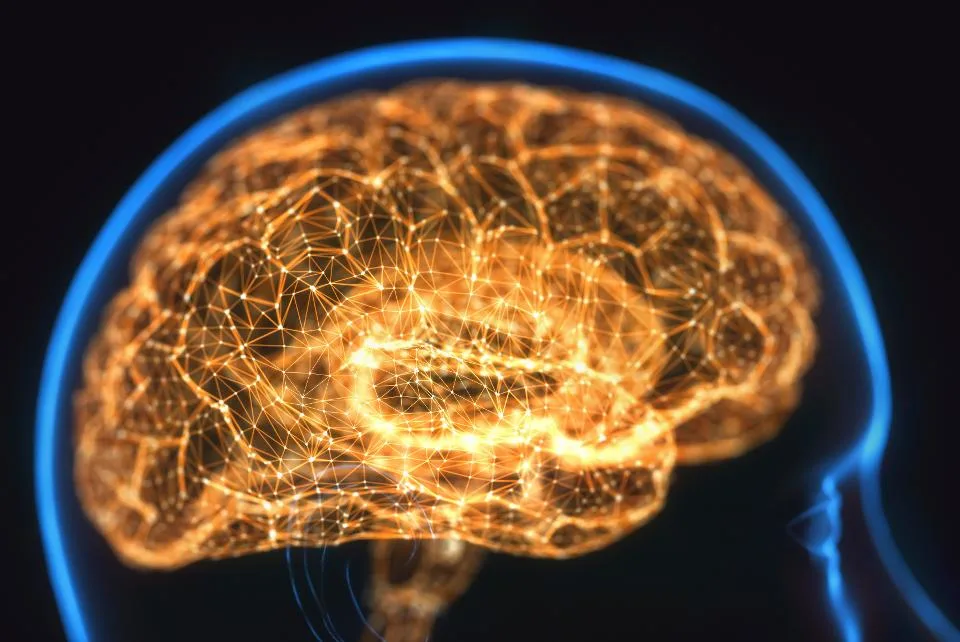كما للديمقراطية مزايا لا تعد ولا تحصى، في التعددية والشفافية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لها مزايا لا يمكن وصفها أيضًا في مواجهة تحديات انتشار الفيروسات القاتلة، بالمقارنة مع البلدان المعروفة بصناعة الديكتاتورية التي ما إن تصيبها كارثة من كوارث الأوبئة حتى تنغلق على نفسها وتصبح سردابًا سريًا لا يمرر إلا الشائعات والخوف والهلع والمرض للعالم الخارجي، وداخليًا تصبح الفرصة عظيمة لتمرير المزيد من التفسيرات العجيبة لإبقاء المواطن حيز التحكم، بداية من جعل الفيروسات مؤامرة عالمية من الأعداء، نهاية بالدعوة للتضامن مع الحكام والالتفاف حولهم للنجاة من العالم الذي لا طاقة لهم بالوقوف ضده إلا من خلالهم.
الانضباط الصيني في مواجهة شفافية الديمقرطية
منذ أكثر من 60 يومًا، على تفشي الفيروس التاجي الجديد المعروف باسم COVID-19، والعالم يكتشف طرقًا جديدة في التنظيم المركزي الصيني الذي استطاع بشكل مثير للانتباه فرض الحجر الصحي على مدن بأكملها خلال أيام، وفرض قيود صارمة على الجميع.
سريعًا شرعت السلطات الصينية في بناء مستشفيات متخصصة خلال أقل من 10 أيام، وروج الإعلام الصيني بعض لقطات من عمليات البناء التي استمرت ليل نهار، لاستعراض القوة أمام العالم في المواجهة والتنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن منح الشعب الصيني المزيد من الثقة في حكومته التي تتدخل في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة لحمايتهم.
الطريقة التي تدار بها الأزمة في الصين وإشادة منظمة الصحة العالمية بها، تطرح العديد من المقارنات بين طريقة الحكومات شديدة المركزية على غرار حكومة بكين مقابل البلدان الديمقرطية، وخاصة التي تطبق النمط الليبرالي منها، والفرق بين المنهجين في اتخاذ التدابير اللازمة، خاصة أن اشتراط الفحوصات الصحية دون شك يحد من الحركة وسيكلف المواطنين إلزامهم بالحجر الصحي الأمر الذي قد ينتهك بشكل واضح حرياتهم الفردية، وبالتالي اللجوء للقانون والدخول في متاهات قضائية قد لا تنصف الدولة التي تبني أمجادها على “الفردانية”، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتصور أن الحكومات الاستبدادية، أصبحت مجهزة بشكل أفضل من الديمقراطيات في مواجهة تحديات الأوبئة والفيروسات القاتلة.. والسؤال: هل هذا صحيح؟
في أي اختبارات للشفافية والنزاهة لا يمكن أن تنجح الصين ولا أي حكومة استبدادية أخرى، فالبراعة الشديدة في بناء أنظمة المراقبة لا تقابلها براعة مماثلة في منح وسائل الإعلام المستقلة الفرصة لنقل الأوضاع للأمة بنزاهة ومصداقية ودون تزييف للواقع، والقضية هنا لا تخص الصين فقط، بل وسائر الأنظمة الديكتاتورية التي رُصد كيفية تصرفها في الكوارث، بدءًا من أزمة انفجار مفاعل شيرنوبل النووي في الاتحاد السوفيتي السابق، مرورًا بمجاعة إثيوبيا عام 1984، وصولًا إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران، نهاية بكورونا.
تتبع تاريخ الصين الحديث والممارسات الحكومية وبنية النظام السياسي الحاكم، كان خلف الكثير من كوارث الأوبئة بسبب اللجوء للتعتيم وعدم الشفافية
في الأزمة الحاليّة، يعيش العالم مع الديكتاتورية أيامًا صعبة في محاولة للوصول إلى معلومة تقوده لمصدر فيروس كورونا الذي بدأ من مدينة ووهان الصينية، وربما لا يعرف أحد ما مصدره الحقيقي حتى الآن، سواء كانت بعض الوجبات الشعبية مثل الخفاش أم أنه حصيلة إنتاج أنظمة زراعية لا تراعي المعايير الصحية.
في الأيام الأولى للفيروس، تعمد المسؤولون الحكوميون إخفاء حقيقة الوضع عن أعداد الضحايا والمصابين وتضليل الرأي العام العالمي، ليتفاجأ العالم في أيام معدودة بالكارثة التي أضرت من خلفها عشرات الآلاف من المواطنيين الصينيين، كما خلفت أزمة عالمية بسبب انتشار الفيروس خارج أراضيها، وخاصة بعدما عرقلت مساعي الدول الديمقراطية في معرفة الحقيقة، وتجاهلت دعواتها للمساعدة على أمل إيجاد علاج له.
يمكن القول إن تتبع تاريخ الصين الحديث والممارسات الحكومية وبنية النظام السياسي الحاكم، كان خلف الكثير من كوارث الأوبئة بسبب اللجوء للتعتيم وعدم الشفافية، ما جعلها تنكر التقارير المبكرة عن فيروس قاتل عرف باسم “سارس” عام 2003، الذي صنف في النهاية كوباء عالمي، بعدما تباطأت بكين ولم تخبر المجتمع الدولي للتعاون معها في كيفية محاصرة المرض قبل أن انتشاره، لدرجة أن السلطات المحلية احتجزت الأطباء الذين ناقشوا المرض وسربوا تفاصيله، بالضبط كما حدث في النهاية المأساوية للطبيب الذي اكتشف مرض كورونا.
في أول يناير الماضي، كان “لي وينليانج” طبيب العيون بمستشفى ووهان المركزي، على موعد مع التاريخ والمأساة في الوقت نفسه، إذ لاحظ الطبيب الشاب إصابة سبع حالات بأعراض مشابهة لمرض سارس، فبعث على الفور برسالة إلى زملائه خلال دردشة جماعية على إحدى وسائل التواصل الصينية، محذرًا إياهم من تفشي الفيروس ونصحهم بارتداء ألبسة واقية لتفادي العدوى.
التقطت أجهزة المراقبة على مواقع التواصل رسالة لي، وخلال أربعة أيام وجد أمامه مسؤولين من مكتب الأمن العام الذين طالبوه على الفور بالتوقيع على خطاب ينص على اتهامه بالإدلاء بتعليقات غير صحيحة، قد يترتب عليها إخلالًا جسيمًا بالنظام العام، وحذرته الأجهزة الأمنية بشكل رسمي من التمادي في “العناد والوقاحة”، حتى لا يمثل أمام القضاء.
صمت لي ولم تنجح ثقافة التعتيم في حماية الصين من خطر الفيروس، وخضعت السلطات في النهاية، بل وركعت تمامًا بعدما اضطرت لإصدار توجيهات بعد مرور عشرة أيام فقط، تعلن فيها حالة الطوارئ بعد تفشّي فيروس كورونا، بعدما تركت درسًا قاسيًا للأطباء من إذلال مكتشف كورونا الذي لم يفعل شيئًا أكثر من تحذير زملائه، وأكدت للعالم أن وجود بيئة صحية عامة أكثر أمانًا، يستلزم وجود آلاف النماذج من أمثال وينليانج، ولكن في حكومات أخرى، تحترم العقل وتدين بالشفافية.
الديكتاتورية مع الوقت تجعل من المجتمعات كانتونات منفصلة، تبقي الطبقات الغنية والنافذة في المجتمع تتمحور حول نفسها
المثير للدهشة أن الطبيب الشاب لم يدفع ثمن موقفه المسؤول من ترهيبه ووضعه تحت ملاحظة سلطات معروفة بالخشونة الشديدة في التعامل مع المخالفين فقط، ولكنه دفع حياته بعدما عالج عين امرأة مصابة بالمياه الزرقاء، ولم يكن يعلم أنها مصابة بفيروس كورونا الجديد، ليداهمه السعال في العاشر من يناير وتصيبه الحمى ويسلم روحه، لتصبح قصته دليلًا على ظلامية الديكتاتورية.
ثقافة الحواجز الأمنية على المعلومات الصحية وثقها بحث علمي جديد نُشر في مجلة “نيوساينتيست” المتخصصة في العلوم، وأكد أنها لا تقف فقط خلف إخفاء كوارث الجراثيم والأوبئة، بل في توليد ثقافة الخوف من لقاء الغرباء خوفًا من أن يكونوا حاملين لجراثيم أمراض.
ويوضح أن الخوف من العدوى يصيب الأمة بأكملها بالخوف المرضي تجاه الأجانب، بما يثبط التفاعل حتى بين مختلف الجماعات داخل المجتمع نفسه، ويمنع التواصل بين فئاته وطبقاته المختلفة انطلاقًا من تحاشي احتكاك لا لزوم له.
يؤكد البحث أن الديكتاتورية مع الوقت تجعل من المجتمعات كانتونات منفصلة، تبقي الطبقات الغنية والنافذة في المجتمع تتمحور حول نفسها، وترفض اقتسام الثروة والنفوذ مع من حولها، كما تمنع الطبقات التحتية من التمرد على هذا الوضع أو مجرد التساؤل عن شرعية السلطة التي يتمتع بها من هم فوقها، لتصبح هذه المجتمعات في النهاية تربة غير صالحة لنمو الديمقراطية، وانتهي البحث الذي مسح 98 دولة ومنطقة إلى أن المناطق التي تعاني من انتشار الأمراض، تعاني بالتبعية أيضًا من وقوعها في أيدي الأنظمة الشمولية والاستبدادية.
الديمقراطية في مواجهة الفيروسات.. ما الفارق؟
توضح لنا أي طريقة لمراقبة المجتمعات المتطورة أن الممارسة الجيدة للصحة العامة تتطلب الشفافية والثقة العامة والتعاون، وملاحظة أداء السلطات في كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا التي داسها الفيروس، تكشف تباينًا كبيرًا بين هذه البلدان والصين في مستويات الصراحة والمساءلة.
في إيطاليا كان الهم الأول للحكومة تهدئة خوف الجمهور، وظهر رئيس الحماية المدنية في وسائل الإعلام ليؤكد ويعترف أولًا بإصابة أكثر من 400 شخص بالمرض، كما تناوب حكام الولايات على الظهور بالتليفزيون الحكومي، للحديث عن أعداد المرضى وآلياتهم في التعامل للسيطرة على الفيروس، ولكن هذا لم يمنع الصحافة الإيطالية من نقد الحكومة، بل والبحث خلف أصل الفيروس في وقت شديد الحساسية، وأثبتت أنه ربما كان موجودًا لبعض الوقت في إيطاليا، ولم تعف المقصر من المسؤولية عن تخاذله.
المزايا التي تتمتع بها الديمقراطية للارتقاء بالصحة العامة أصبحت تواجه تحديات خطيرة
تُمكن الديمقرطية أعضاء المجتمع العالمي من مواجهة الأمراض، ولا تضع العراقيل أمام تعاونهم في العمل معًا لبناء أنظمة تكتشفها بسرعة وتستجيب لها بفعالية، ولهذا تميل المجتمعات الديمقراطية دائمًا للحصول على مؤشرات أفضل للتنمية الصحية والبشرية، حتى وإن لم تكن الأكثر ثراءً من نظيرتها الشمولية، ولهذا تستثمر كل البلدان الديمقراطية في أنظمة الرعاية الصحية الدائمة ويلجأ صانعو السياسة إلى الاهتمام بالنتائج الصحية لبرامجهم.
الثراء الديمقراطي في مواجهة هذه الكوارث يمثل أحد المخاوف الكبيرة التي يحمل همها قطاعات ليست قليلة من المجتمع الأمريكي اليوم، فالمزايا التي تتمتع بها الديمقراطية للارتقاء بالصحة العامة، أصبحت تواجه تحديات خطيرة من الشعبيين والقوميين ذوي الأفكار المتشابهة في جميع أنحاء العالم، حتى في الولايات المتحدة التي سحقت كل أشكال التعاون الدولي في عهد ترامب لدرجة أنه فكك مكتب البيت الأبيض المكلف بمنع الأوبئة، من أجل توفير 3 مليارات دولار كانت مخصصة لتمويل التعاون في مجال الصحة العالمية، ليثبت للعالم أن كل فكر شمولي هو انعكاس لكل قبيح ولكل ضار بالبشرية!