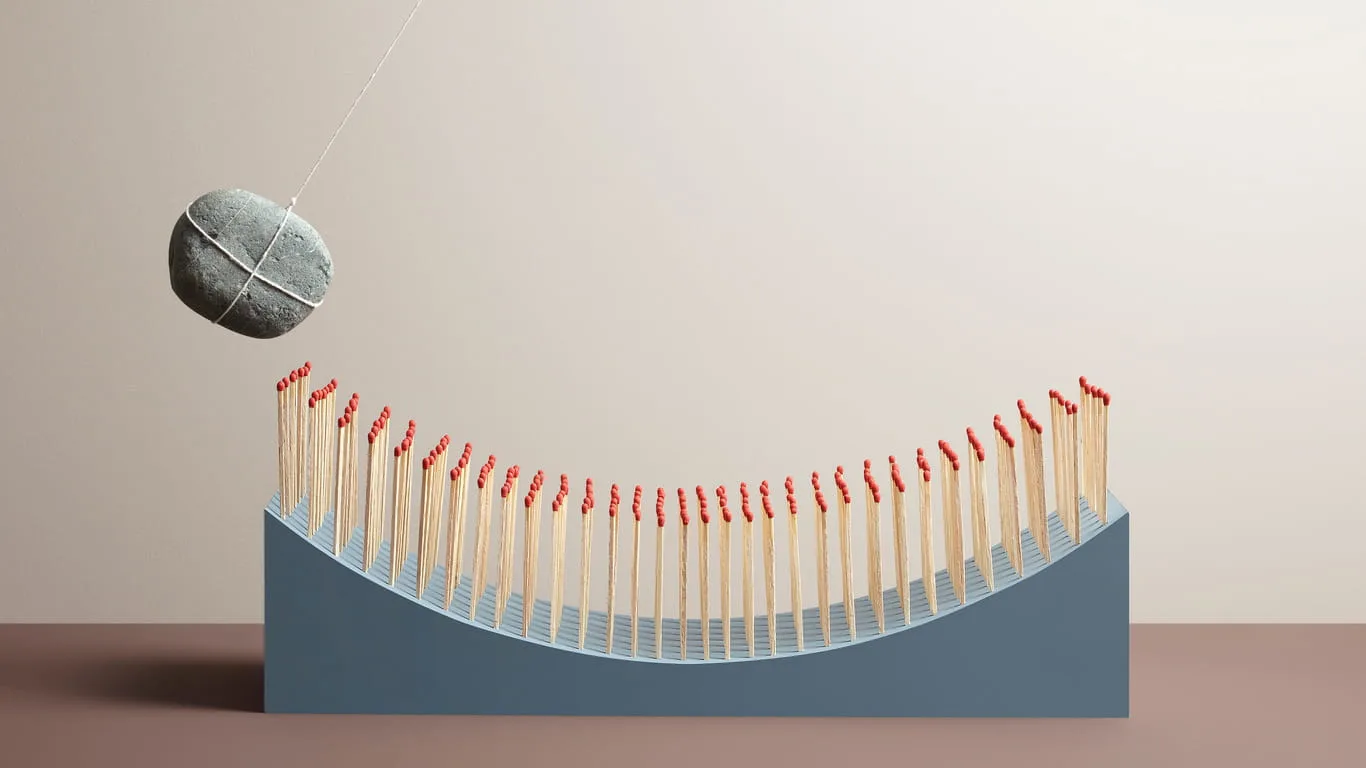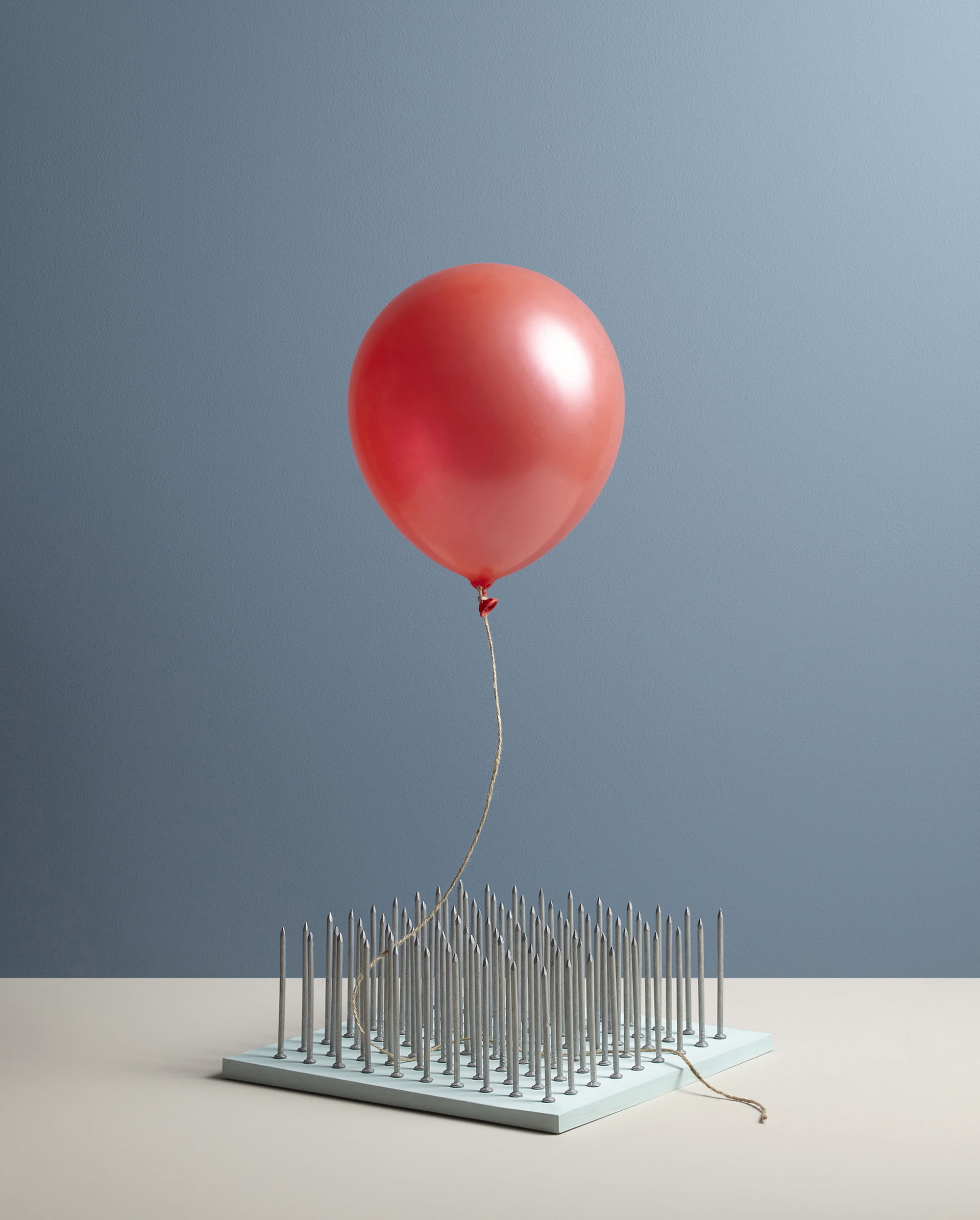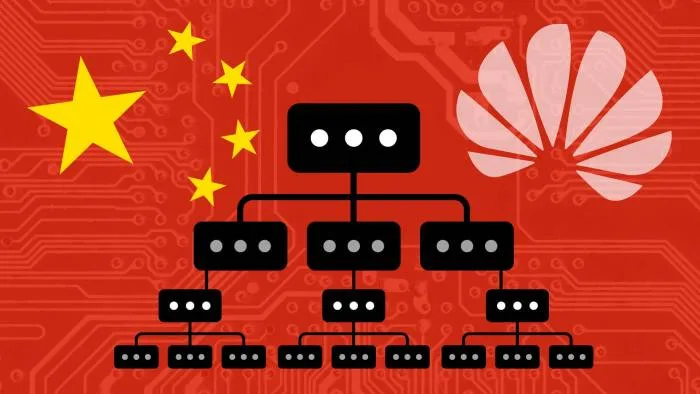ترجمة وتحرير نون بوست
يوم 18 آذار/ مارس، تجاهل المحتفلون في ميامي هذا الوباء القاتل واستمروا في الاحتفال بعطلة الربيع، راقصين بأجساد عارية، متشاركين نفس الأرجيلة، متجولين في أرجاء المدينة عبر عربات الغولف التي توزع الدعوات لحفلات أعياد الميلاد – لقد كان المشهد حقًا صادمًا.
ألا يدركون خطورة الوضع؟
يثبت فيروس كورونا أنه معلّم رائع لعلم النفس البشري، وهو يستفز عنصريتنا الكامنة وكراهية الأجانب وكذلك قدرتنا الفطرية على الطيبة الرائعة. لكن بالنسبة لي، كان الدرس النفسي الأكثر روعة من الوباء هو الدور الذي لعبه القلق – أو كما رأينا في ميامي، الغياب الغريب للقلق على ما يبدو- في تحديد استجابتنا لما يسمى أخطر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
من الناحية التطورية، كانت وظيفة القلق حمياتنا تمامًا من مثل هذه الكوارث. لكن على مر العصور، تغيرت هذه الرواية بشكل كبير. لقد جُرّد الشعور بالقلق من معناه وصُنّف بطريقة اختزلته في كلمة قذرة – شيء للتعامل معه بدلاً من التعلم منه. لذلك، بينما كان الانتباه إلى هذا الإحساس البدائي أمرا طبيعيا، فإن ما نمجده الآن هو العكس تمامًا: التمرد ضده وتقويضه بكل تباهي.
من تغير المناخ إلى فيروس كورونا، دفعنا هذا النمط من التفكير مرارًا وتكرارًا إلى التصرف بطرق خطيرة، مما أدى إلى إبعاد أولئك الذين يعرفون بشكل أفضل باسم “مُنظرو المؤامرة”. في الحقيقة، يقدم لنا هذا الوباء فرصة غير متوقعة لضغط زر إعادة الضبط وإصلاح علاقتنا المحطمة مع القلق.
كيف ساهم فيروس كورونا في تقسيم البشرية
قبل أن تبدأ مدينة تلو الأخرى في فرض عمليات الإغلاق، أظهر فيروس كورونا شكلين متناقضين بشكل حاد من السلوك العام. قُسّم العالم بين أولئك القلقين بشأن ما هو قادم ووظفوا هذا القلق لحماية أنفسهم والآخرين. وأولئك الذين قللوا من شأنه واعتبروه رد فعل مبالغ فيه وحتى هجوم على حريتهم.
لعل خير مثال على هؤلاء الأشخاص القلقين، مستخدم “تويتر” جايسون يانويتز، الذي اقتبس عن مواطن إيطالي لم يذكر اسمه ليقدم لنا تحذيرًا قاتمًا: “إذا كنت لا تزال تتسكع مع الأصدقاء وتذهب إلى المطاعم/الحانات وتتصرف وكأن شيئا لم يحصل، عليك أن تستيقظ وتدرك خطورة الوضع”. وضع الناس في جميع أنحاء العالم أنفسهم تحت الإقامة الجبرية للحد من انتشار العدوى. كما ظهرت ثورة شعبية صغيرة تحت مسمى “#تسطيح المنحنى”.
في عالم موازٍ، كان لدينا المصطافون في فلوريدا، وزائري النوادي في برلين، وأولئك الذين احتشدوا خلال “الحفلات المغلقة” في فرنسا وبلجيكا، دون الاكتراث لخطورة الوضع، مرددين الكلام نفسه: “سأصاب بالكورونا في جميع الأحوال”.
كانت تكلفة هذه اللامبالاة مثيرة للاشمئزاز. في برلين، وفي غضون يومين في نهاية شباط/ فبراير، تبين أن 26 شخصًا ممن حضروا ملهين ليلين منفصلين في المدينة كانوا مصابين بالفيروس. وأعلنت جامعة تامبا في فلوريدا في 23 آذار/ مارس أن خمسة من الذين كانوا يحتفلون بعطلة الربيع ثبتت إصابتهم بهذا الفيروس على حد سواء. وهذا يعني أنه ربما أصيب العشرات دون علمهم في كلتا الحالتين.
في بلدي الهند، ناشد رئيس الوزراء فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة على الصعيد الوطني في 22 آذار/ مارس. لكن الانضباط تراجع في فترة ما بعد الظهر، عندما شارك الناس في مواكب جماهيرية مبتهجة ورقصوا في الشوارع، كما لو كانوا يحتفلون بمهرجان تحت ذريعة التصفيق للعمال الذين يحاربون الفيروس في البلاد، كانت بعض المشاهد لا تصدق بصراحة. من جهته، غرّد إيلون ماسك، الذي يعد من بين أكثر الرجال ذكاءً على وجه الأرض، قائلاً: “إن الذعر من فيروس كورونا تصرف غبي”.
في الواقع، استهانت الحكومات حول العالم بهذا الخطر كذلك. ففي إيطاليا، على سبيل المثال، يشتبه في أن مباراة كرة قدم نظمت في 19 شباط/ فبراير تضم أكثر من 40 ألف مشاهد تسببت في الانتشار السريع للفيروس في ذلك البلد، حيث أقيمت المباراة على الرغم من أن إيطاليا أعلنت حالة الطوارئ في 31 كانون الثاني/ يناير. في فرنسا، توجّه الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته، في السابع من آذار/ مارس، بخطاب إلى الشعب قائلين: “الحياة ستستمر، ليس هناك داعٍ لتغيير عاداتنا، باستثناء الفئة الضعيفة”.
في مكان آخر، اقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قيادة الجرارات وشرب الفودكا لقتل الفيروس، بينما أمر الديكتاتور قربانقلي مالكقليفيتش بردي محمدوف بمقاومته عن طريق حرق عشب محلي. وعلى الرغم من تزايد الأدلة على ضرورة فعل العكس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “الفيروس لن يتغلب علينا”.
الدور الأساسي للقلق
مع ميزة الإدراك المتأخر، نحتاج إلى أن نتساءل عما يفسر مثل هذا السلوك. من السهل إلقاء اللوم على الشباب الحمقى وعدم تعودنا بانتشار مثل هذه الأوبئة، أو سوء الحوكمة أو ثقتنا العمياء في التقدم الطبي. لكن ما يمكن أن ننظر إليه حقًا هنا هو خلل في أحد الدروع المدمجة الأكثر موثوقية للجنس البشري للتوقي من الخطر، ألا وهو القلق.
بالنسبة للإنسان البدائي الذي بقي على قيد الحياة عن طريق الصيد، كانت الحياة غادرة. كان القلق آلية الدفاع التي ساعدتهم على تحديد المخاطر (المحتملة) وحجبها. وكان الوخز في الجزء الخلفي من الرقبة هو الذي جعلهم يقفزون ويجرون في اللحظة التي يسمعون فيها صوت حفيف الأشجار.
ما زلنا نختبر هذه المخلفات عندما نقف على ناطحة سحاب وننظر للأسفل، الارتفاع يخيفنا، على الرغم من أننا نعرف أننا بأمان تام. إنه تذكير تطوري بمخاطر تسلق الأشجار العالية في أيامنا البدائية. وفقًا لعلماء النفس العصبي، يتم التحكم في القلق لدى البشر المعاصرين من خلال الجهاز النطاقي للدماغ، وهو “شبكة الدماغ الأساسية التي تدعم المزاج وشبكة من المناطق التي تعمل معًا لإدراك العالم واستيعابه”. بعبارة أخرى، هذا هو مجال غريزة البقاء الخالصة (من بين أمور أخرى). وتشرح عالمة النفس نيتاشا بوراه أن “القلق كان عاطفة تكيفية للغاية، لو لم يستمع البشر لقلقهم، لما كنا بقينا على قيد الحياة حتى الآن”.
كيف أصبح القلق اضطرابًا يمكن معالجته
مع مرور الوقت، أصبحنا مرتبكين. توقف القلق عن كونه صديقًا لنا، وصُنف على أنه “اضطراب” أو “مرض”. صنف الأطباء والفلاسفة اليونانيون واللاتينيون القلق على أنه اضطراب طبي، ولكنه لم يُصنف كمرض منفصل في الفترة الممتدة بين العصور الكلاسيكية القديمة وأواخر القرن التاسع عشر.
دمج الطبيب النفسي الألماني إميل كريبيلن (1926 – 1856) دراسة القلق الحاد بالهوس الاكتئابي، متوقعًا أعراض “الضائقة القلقة” للاضطرابات ثنائية القطب في كتاب التشخيص النفسي: الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية. ويشير عالم النفس غراهام سي. إل ديفي إلى أنه كان هناك “تحول تدريجي في المبادئ الاجتماعية المحيطة بالقلق. كان هذا التغيير متناقضًا تقريبًا في الرسائل التي يرسلها إلينا، حيث قيل لنا إن القلق هو رد مشروع على ضغوط الحياة العصرية، ويُعتبر القلق رمزًا تقريبًا يشير إلى مدى انشغالنا ونجاحنا”. ولكن في نفس الوقت، نحن نُقاد إلى الاعتقاد بأن القلق يمثل مشكلة تحتاج إلى علاج.
حسب ديفي، تزايدت الفئات التشخيصية لمشاكل القلق على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وتحرص صناعة المستحضرات الصيدلانية أكثر من أي وقت مضى على علاج القلق وبيع أدوية له، وتحاول الحملات المخصصة لزيادة الوعي بالقلق بشجاعة لإزالته – فقط لمساعدتنا في البحث عن علاج له.
في الولايات المتحدة، حيث يمثل القلق أكثر الأمراض العقلية شيوعًا، يُعتقد أن الإدمان على الحبوب المضادة للقلق قد يكون أكثر خطورة من أزمة المواد الأفيونية. والواقع أن الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة التي تشمل عقاقير شائعة مثل زاناكس وليبريوم وفاليوم وأتيفان، التي تُستخدم عادةً لعلاج القلق والرهاب ونوبات الهلع والنوبات والأرق، تضاعفت أربع مرات بين سنتي 2002 و2015. وفي سنة 2015، تسببت الجرعات الزائدة من البنزوديازيبين في وفاة 8791 شخص مقارنة بـ 1135 حالة وفاة في سنة 1999. هذه هي المفارقة المركزية للقلق كما نفهمها اليوم. إذا لم تكن تعاني من القلق، هل تعد على قيد الحياة؟ وإذا كنت تعاني منه، ماذا ستفعل للتخلص منه؟
التحدي هو طريقة للتخفيف من القلق
هناك تفسير آخر أبسط لسبب تصرف الناس بشكل خطير أثناء الأزمات، وهو ظاهرة التفاعل النفسي. حيال هذا الشأن، تقول بوراه: “يميل الناس إلى رد الفعل بطريقة معاكسة للقواعد والقيود التي تفرضها القوى الخارجة عن سيطرتهم، خاصة في الأوقات الحرجة. عندما تبدو الكثير من الأشياء خارجة عن سيطرتنا، فإننا نمارس السيطرة عندما نستطيع”.
في سياق متصل، تضيف بوراه أنه “سيقول بعض الناس ‘يمكنك حظر كل شيء، ولكن لا يزال بإمكاني اختيار الاحتفال. حتى إذا شكل ذلك خطرًا على صحتي، فإنني أختار أن أؤكد استقلالي’. قد تبدو هذه التصرفات غبية بالنسبة لنا، لكنها تعني شيئًا للشخص الذي يؤديها”.
لجعل الأمور أكثر إشكالية، يعتبر مرض فيروس كورونا أول جائحة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعني أن هناك جمهورًا جاهزًا لكل مشاعرنا وسلوكنا. ويجعل ذلك الظهور في موقع التحكم أكثر قيمة: “انظر إلي، أنا بخير ولا زلت أحتفل”.
مع ذلك، إن التصرف بطرق تتحدى الفطرة السليمة أثناء الأزمة يمكن أن يمثل طلبا يائسا لتلقي المساعدة. وفقا لبوراه، غالبا ما يدافع الناس عن أنفسهم ضد القلق أو عدم اليقين من خلال ترشيد السلوك الذي يبدو غير منطقي. عندما تخرج من المنزل وتلتقي بالأصدقاء وتستمتع بوقتك، فأنت تبرر تصرفاتك بأنه من المحتمل أن لا يكون هناك غد.
القلق جيد طالما أنه لا يتحول إلى ذعر
كيف نستخدم قوة القلق لمصلحتنا؟ أولا، من خلال التعاطف. جلب الفيروس معه أسوأ نوع من التحيز، وخلق المشاكل بين الجيران، كما رأينا في ووهان. في الهند – التي دعتها منظمة الصحة العالمية لقيادة العالم في مكافحة فيروس كورونا بسبب نجاحها في القضاء على الأمراض الفتاكة الأخرى – كانت هناك تقارير عن عمل الدولة الوحشي، وحتى عنف الشرطة ضد العاملين في المجال الطبي بحجة فرض حظر التجوال. وقد أجبر التأمين الصحي والعسكري المفاجئ آلاف العمال المهاجرين على المشي لمئات الكيلومترات إلى منازلهم. والواقع أن مثل هذه القصص لا تحقق شيئًا سوى دفع الشعوب المتوترة بالفعل إلى الذعر الأعمى.
بعد ذلك، نحتاج إلى أن نذكّر أنفسنا بأن القلق لا يمثل في كل الحالات عقبة يجب التغلب عليها. طالما أنه لا يشلنا، يمكننا استخدام القلق وجعله يعمل لصالحنا. حيال هذا الشأن، تقول بوراه: “يمكن للقلق أن يساعدك على الاستعداد، واعتبار ما أنت على وشك القيام به شيئا مهما، وبذل جهد أكبر مما هو مطلوب تمامًا”.
بالطبع، يعني بذل جهد أكبر مما هو مطلوب تمامًا أنه إذا سارت الأمور على النحو المنشود وإذا ساعدنا في الواقع على منع النتائج السيئة، فسوف يظهر حتمًا مثل رد فعل مبالغ فيه. ولكن كما نكتشف الآن، لا يوجد اختلاف بين رد الفعل المفرط والتهاون.
يجب أن يشمل إرث مرض فيروس كوفيد-19 الطريقة التي ذكّرنا بها أن القلق ورد الفعل المفرط يُعدان من السمات المرغوبة، وهي علامات على وجود قيادة قوية واستباقية. لنأخذ بعين الاعتبار واحدة من الدول التي واجه فيها الفيروس أقوى مقاومة، أي كوريا الجنوبية. في وقت كتابة هذا التقرير، ظهرت الاكتشافات الجديدة في أربعة أسابيع كحد أدنى، مما يجعلها مثالًا رائعًا للبلدان الأخرى. ويرجع الفضل على نطاق واسع في هذه النتائج إلى الخطوة السريعة التي اتخذتها حكومة كوريا الجنوبية، وهي قرارها باختبار الأشخاص بلا هوادة للكشف عن الفيروس.
متأثرة بتجربتها خلال تفشي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، عندما وقع عزل 16 ألف شخص ووفاة 38 شخصًا، اختبرت كوريا الجنوبية 20 ألف شخص يوميًا للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا – وهو معدل يفوق أي بلد آخر في العالم. ولتحمل العبء الضخم، أنشأت كوريا الجنوبية شبكة واسعة من المختبرات العامة والخاصة، ومراكز اختبار في ممرات السيارات ومراكز اختبار تُشبه كشك الهاتف حيث يستغرق كل اختبار سبع دقائق فقط.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت حكومة كوريا الجنوبية إجراءات عدوانية قد يُنظر إليها على أنها مبالغ فيها في الأنظمة الديمقراطية الأخرى، بما في ذلك محاكمة الكنائس بسبب عصيانها لمبادئها التوجيهية. كما واجهت كوريا الجنوبية انتقادات أيضا، لا سيما في وسائل الإعلام الغربية لاستخدامها المكثف لتكنولوجيا المراقبة لتعقب الأشخاص لاختبارهم.
في مثل هذا الوقت، لا توجد حلول مثالية أخلاقيا. من غير المنصف أن نتساءل عما إذا كان انتهاك الخصوصية في نموذج كوريا الجنوبية أكثر معقولية من تقييد حرية التنقل بشدة في إيطاليا وفرنسا – وبشكل متزايد في الهند والولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة. لكن إذا سألتني عما إذا كانت حكومة قلقة ومفرطة النشاط أفضل من شعب مذعور في مواجهة تهديد عشوائي غير مرئي، فأنا أعرف جوابي.
المصدر: ذا كورسباندنت